ما الذي يجعل أبا قتادة مطمئنا إلى وسامته، وهو الذي يرغب في أن يكون موضوعاً للتصوير ولا يخفي وجهه كما يفعل الآخرون ممن يقدّمون إلى المحاكمة؟
الرجل الذي سلّمته بريطانيا إلى الأردن على الرغم من كونه بريطاني الجنسية، اتضح أخيرا أنه كان بريئاً مما نُسب إليه من تهم الارهاب، وجميلاً أيضاً من غير أن يبتسم. ثقته ببراءته لا تساويها سوى ثقته بجماله الشخصي الذي ينبعث من جمال أفعاله. سيكون علينا أن نتحدث عن مكافأة بريطانية للعدالة الأردنية. لقد خرج الجمال الإسلامي من القفص الذي كان من المحتمل أن يبقى فيه منسياً إلى الأبد.
ذكّرني مشهد ابي قتادة بعباس الجزائري الذي يعمل جزّاراً في باريس، والذي كان قد تزوج أربع نساء في الوقت نفسه، الأمر الذي يتعارض مع القوانين الفرنسية وخصوصاً أن الرجل كان مسجلاً في قائمة العاطلين عن العمل، وهذا ما يعني تمتعه ونساءه وأطفاله بامتيازات الضمان الاجتماعي. كان عباس عالّة على المجتمع الفرنسي، غير أنه كان في الوقت نفسه اسلامياً متشدداً لا يقبل بأقلّ من النقاب لنسائه، وهو من دعاة تفجير الحانات الفرنسية على رؤوس مرتاديها والمارّين بها بحثاً عن علبة سجائر.
لقد احتجّ عباس حين قُدِّم إلى القضاء، بإسلامه، منكراً ما يمليه حق المواطنة عليه من واجب التزام القوانين.
لم يخلص الرجل إلى مواطنته الفرنسية في مقابل ثقته بالعدالة التي كانت محلّ ريبة في النص الديني، فهل كان أبو قتادة مواطناً بريطانياً حقيقياً، هو الذي لا يخفي ميوله الدينية المتطرفة؟
الوسيم في عمان كان قبيحاً في لندن. في صوره الإعلامية على الأقل. لقد رُحِّل الرجل المريض بإسلامه مثلما يتمّ التخلص من وباء. هذا ما يجعلنا ننظر بريبة إلى عمليات تسهيل رحيل الشباب المتحمسين للإنضمام إلى تنظيم "داعش" من أوروبا، بشرط أن لا يعودوا إلى الأماكن التي ولدوا وترعرعوا ولعبوا ودرسوا فيها. هذا ما يمكن أن يكون نوعاً من النفي الذي يتعارض مع لائحة حقوق الإنسان. لقد قطعت جهة ما لهم تذاكر سفر للذهاب إلى تركيا فقط، وأرسلت اليهم من طريق الانترنت. كان أبوان بلجيكان، أحدهما من أصول مغاربية، قد سافرا إلى تركيا ودخلا إلى الأراضي السورية سراً والتقيا ابنيهما من أجل حضّهما على العودة إلى بلجيكا. قال الصبيّان: "سيكون السجن في انتظارنا. نفضّل البقاء هنا. لعبة الحرب أفضل من عفن السجن".
كان عبّاس الجزائري يدافع عن حقه الشرعي في الزواج من أربع نساء، وهذا ما نصّ عليه القرآن، ليضع القوانين الأوروبية في ورطة، هي التي لم تُسَنّ لمواطن مسلم ولم تتخذ من الشريعة الإسلامية مصدراً لها.
هناك من يطالب بتطبيق الشريعة في أوروبا. هذه حقيقة وليست مزحة.
عبّاس لا يرى أن الإسلام، إسلامه، ليس في مكانه الصحيح. فبعد أكثر من 1400 سنة على سكوت الوحي، لا يزال الفقهاء يتحدثون بلسان جبرائيل الذي يخاطب البشرية جمعاء. حكاية أن تكون مسلماً، لا تزال رهينة في اختلافك عن الآخرين الذين صارت هويتكَ تقع على رؤوسهم مثل مطرقة قبل أن يلتفتوا إلى مواطنتكَ الضائعة بحسرة. مشهد النساء المسلمات هو الرهان الذي يحاول من خلاله إسلاميو أوروبا إزاحة النقاب عن عنصرية مضيفيهم من الأوروبيين. إنه امتحان هشّ ورقيع بل وصفيق للديموقراطية التي هي نهج حياة في أوروبا، القارة التي قدّمت الملايين من الضحايا من أجل أن تصل إلى ما هي عليه اليوم من استقرار روحي ومادي، وهذا ما لا يمكن أن تتراجع عنه.
لا يدرك إسلاميو أوروبا أن حرية المرأة كانت واحدة من أهم فقرات عصر التنوير وما تلاه من عصور حداثة في هذه القارة التي انتفضت على نفسها منذ أكثر من خمسة قرون حين وضعت المسيحية في مكانها الطبيعي، الكنيسة.
لا يفهم عبّاس أن نظام الرعاية الاجتماعية كان جواباً عن سؤال فلسفي عميق، كانت الملايين من البشر قد ناضلت من أجل أن يكون استحقاقاً واجباً.
لن يكون أبو قتادة معنياً بعصر الأنوار ولا بالعصور التي تلته تمهيداً لعصر الرفاهية الاجتماعية الذي تعيشه أوروبا الآن، وهذا من حقّه. لدى الرجل ما يشغله من تبرج المرأة، ما ظهر منه وما خفي. شيء ساحر وساخر في الوقت نفسه. المرأة بالنسبة إلى أبي قتادة وإلى عبّاس أيضا وإلى رواد الحسينيات، هي مركز الاهتمام الديني.
لا تتجسد هويتنا الاسلامية إلاّ من خلال كائنات مقنّعة، هي عبارة عن كتل سوداء نغزو بها شوارع أوروبا وقطارات أنفاقها ومخازنها التجارية.
لكنه اهتمام بدائيّ بالعدوّ الذي سيكون في اخفائه من طريق هزيمته نوع من إعلان هويتنا. "هذه هي المرأة المسلمة"، وهذا ما يؤكد سطوتنا الذكورية أمام الآخرين. سلطة الذكر الذي يستطيع أن يُحكم سيطرته على الواقع من خلال صورة أنثى مغيّبة داخل كتلة سوداء تتبعه باعتبارها أسيرة لرغبته في إظهارها كياناً لا يصلح أن يكون موضوعاً بصرياً لشهوات الآخرين. يصلح ذلك الكيان أن يكون موضوعاً لفزع الأطفال ولشبهات رجال الشرطة ومرتادي الأماكن العامة.
من سوء حظ المرأة المسلمة أنها صارت رمزاً لهوية مستلبة. هوية؛ وضعها الذكور في محفظاتهم مطمئنين إلى أن أحداً لن يسألهم عنها. فهي مكشوفة مثل فضيحة.
لم يعد لدينا ما نقدّمه إلى الغرب من عناصر هويتنا سوى صورة المرأة المحاصَرة بحجابها ونقابها وعباءتها وتدنّي مستواها الذي تكشف عنه تبعيتها لما هي فيه من ذل ومهانة، وهي صورة لا تنفع في شيء إلاّ حين يتم التركيز على الهاتف النقّال الذي تخفيه الصوماليات تحت حجابهن.
نساء المسلمين هنّ في حقيقة مشهدهن البصري بضاعة صالحة للاستهلاك السياحي. إنهن يزاوجن من طريق أشكالهن بين ما هو فولكلوري طاعن في رخائه اللوني المتخيّل، كما عند بعض الصوماليات، وبين ما هو مقيم في عتمته كما لدى النسوة اللواتي اخترن أن يلبسن العباءة الخليجية السوداء بشعور طاغٍ من التفوق.
في الحالين، ما من أحد يعلن رغبته في الحديث عما يفيض من المرأة.
صارت الصومالية تتقدمني وهي تقول ما يُمكن أن يكون وثيق الصلة بالإسلام.
بالنسبة إلى الأوروبي، لن أكون مسلماً إلاً إذا كنت صومالياً لا يخفي عداءه الاستعراضي لمن يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر. لكنك تقابل نساء متبرجات في دائرة الضمان الاجتماعي، يجيبك بوقاحة: أدعو الله أن يسخطهن بقراً. وماذا لم أسأله: عن البقرة التي تقف إلى جانبك؟ كنا نقف على أرضين متباعدتين. هناك بقرة تقف بيننا. لا هو ينظر إليها ولا مسموح لي بأن اراها باعتبارها امرأة. وهي فكرة ضرورية من أجل أن يعترف كلّ واحد منا بإسلام صاحبه. إننا نعود إلى الأصل. البقرة أمّنا. ترى أمراء الخلافة يمشون بدشاديشهم القصيرة ذاهبين إلى الجامع وهم يلقون نظرات مزدرية على العابرين، غير مكترثين بما يظهر من سلوكهم العنصري. الصوماليون يكرهون الجميع وفي الأخص العرب. غرباء لكنهم أباطرة. مشهدهم الاستعراضي فيه شيء من الظرافة، لكنه الظرف الذي لا يخفي قسوته المجانية. كان أحد العراقيين يشير إلى زوجته باعتبارها حصاناً. يقول: "إنها غبية. لا تفهم شيئاً من أصول الدين". بعد سنوات اكتشفتُ بالمصادفة أن تلك الغبية كانت قد أتقنت الحديث بالأسوجية التي لا يفهم زوجها منها إلاّ بضع كلمات. غير أن ذلك لم يضع ذلك الزوج في مواجهة حقيقة مختلفة: "إنها حصان يتحدث الأسوجية".
ما بين المرأة - البقرة والمرأة – الحصان، يقف الإسلام ديناً للتشويه، بسبب حماقات ذكوره الذين لا يزال خيالهم يعمل في منطقة الخيانة التي تقع في كل لحظة سهو. وهي منطقة غادرها العقل البشري منذ قرون، حين تعرف الإنسان إلى نفسه كائناً حرّاً ومستقلاً وفريداً من حيث احتكاره للغة، التي هي اختراع بشري.
لقد تمّ دفن نصف الإسلام حين صارت المرأة المسلمة عبارة عن خزانة سوداء متحركة، وها هو نصفه الآخر يُدفَن على أيدي العصابات التي صارت ترفع رايات "الله أكبر" من أجل القضاء على ما بقي من ذكورة في منطقة لم تعد صالحة حتى لإنتاج العقائد.
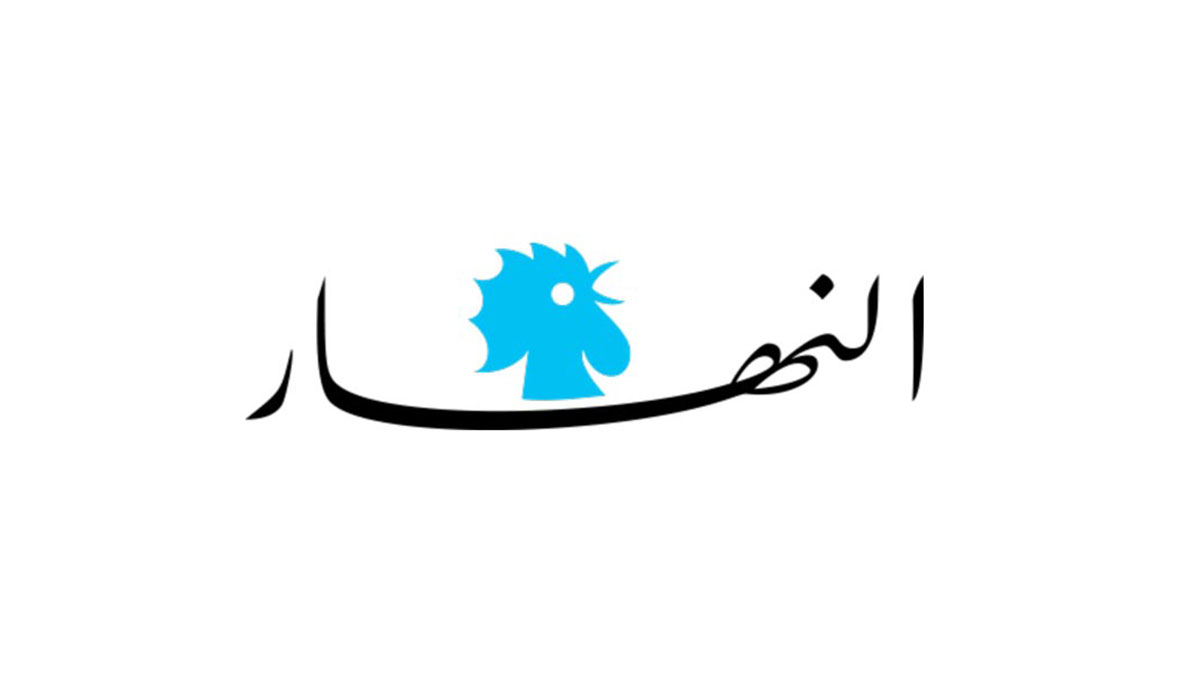

 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية

























