مواقع التواصل الاجتماعي وصحّة طفلك النفسيّة... إرشادات وحلول!

في زمن أصبحت فيه الشاشات جزءاً من الطفولة اليومية، لم يعد الحديث عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال رفاهية، بل ضرورة. بين صور تُبهج ومقاطع تُربك، يتشكّل عالم نفسي جديد يعيشه الجيل الصغير بصمت. كيف ينعكس هذا الواقع على الصحة النفسية للأطفال؟
كيف تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال والمراهقين النفسية؟
لا بد من توضيح حالتين تختلفان في تأثيرهما على الأطفال، يشرح البروفيسور سامي ريشا، رئيس قسم الطب النفسي في كلية الطب في جامعة القديس يوسف، في حديث لـ"النهار".
الحالة الأولى، عندما يكون لدى الأطفال الاستعداد للإصابة بمرض نفسي، وتعرّضهم للشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي وإدمان الإنترنت يسهم في زيادة هذا الخطر ويصبح هو المشكلة. فمثلاً، إن كان طفل يعاني من الـADHD، فسيعاني طبعاً من زيادة في الانفعالية، وسيبحث بكل السبل لإظهار هذه الانفعالية على الإنترنت، ويمكن أن يدمن الألعاب الرقمية أو الألعاب الخطيرة، مثلاً. بالتالي، إن كان الطفل يعاني من اضطراب نفسي، فإنّ إدمانه على الشاشات سيزيد من هذا الاضطراب. فمثلاً، إن كان يعاني من الاكتئاب، فسيرى في ألعاب الفيديو ومواقع التواصل علاجاً لاكتئابه، لكن طبعاً هي لا تشكّل هذه الحلول، واعتبارها حلولاً سيؤدّي إلى الإدمان عليها. بل يكمن الحل في الدعم النفسي من مختصّين ومن الأهل والمدرسة.
الحالة الثانية، عندما يكون الطفل خالياً من أيّ مشكلة نفسية. يمكن أن يؤثر تعرّضه لوسائل التواصل الاجتماعي على رفاهه وصحته النفسية بطريقة غير مباشرة، من خلال: اضطرابات النوم (فالنوم هو من أهم المعايير لصحة نفسية جيدة لدى الطفل)، التأثير على حركته ونشاطه، شعوره بالقلق ولأنّه سيبقى في حالة تنبّه وانتظار وبحث في الجوّال. لكن في هذه الحالة، لا يمكن البت إن كان إدمان الشاشات والإنترنت هو السبب في حدوث الاكتئاب والقلق هذا، أم لدى الطفل هذا الاستعداد، أم هناك أسباب أخرى اجتمعت، لأنّ من الصعب وجود سبب واحد يؤدي إلى الاكتئاب أو القلق. فمثلاً، لا يمكن للطفل أن ينتحر من جرّاء إدمانه الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هناك عوامل أخرى تؤدّي إلى الانتحار. فأمراض القلق والاكتئاب وحدوث الانتحار هي حالات متشعّبة جداً تدخل فيها عوامل عديدة.
ما الآثار النفسية لتعرّض الطفل لمواقع التواصل الاجتماعي؟
تتأثر الصحة النفسية للطفل على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعرّضه للتنمّر الإلكتروني، التمييز العنصري، الكراهية، التحرّش الإلكتروني، محتوى غير لائق وغيرها. وبحسب ريشا، إنّ احتمال أن تزيد هذه الحالات كثيراً مع إدمان الإنترنت إذ ازدادت نسبة التنمّر لدى الأطفال والمراهقين في العالم، لأنّ حصولها يمتدّ على مدار اليوم عبر الجوّال ولم يعد يقتصر على وجود الطفل في المدرسة كما كانت الحال في العقود الغابرة، ومع تواصل هذه الحالة يزداد تأثيرها.
ومن تأثيرات هذه المشاكل، وفق ريشا، أن يقوم الطفل بالسلوك الذي يراه ويسمعه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا قد ينزلق في سلوك التمييز العنصري والكراهية وسواهما دون أن يشعر، ولا سيما إن كان هشّاً، أو محاطاً ببيئة تكثر فيها المشاكل العائلية.
وتأثير هذه المشاكل على صحته النفسية، يظهر على شكل القلق بالدرجة الأولى ومرض الاكتئاب، يشرح ريشا. فاضطرابات القلق تجعل الطفل يعاني من أعراض جسدية مثل الصداع، اضطرابات في الجهاز الهضمي، غثيان، أو تعب. أعراض سلوكية مثل الغضب، إزعاج محيطه، معاندة أهله. أعراض إدراكية بحيث يتأثر تركيزه وذاكرته.
في ما يتعلق بأعراض الاكتئاب، إضافة إلى كل ما ذُكر من أعراض للقلق، يشهد الطفل نوعاً من الحزن، القهر، البكاء دون سبب، تغيّراً في نمط سلوكه وتصرّفاته، العزلة. وهنا قد تنمو الأفكار السوداء أو الانتحارية لدى بعض المراهقين. وفي كلتا الحالتين (القلق والاكتئاب) يشهد الطفل اضطرابات في الشهيّة والنوم. ولا تختلف التأثيرات بين الأطفال والمراهقين كثيراً في هذا الإطار، لكن قد يعاني مثلاً الأطفال من القلق ليلاً، بينما قد ينام المراهق أكثر خلال النهار. وقد لا يعاني الطفل من مشاكل في الشهيّة، بينما يكون المراهق معرّضاً أكثر لأن يعاني من اضطرابات في الشهيّة. لكن قد تختلف الحال بين طفل وآخر باختلاف طبيعة كلّ منهم ورغباته.
المدة والعمر الأمثل للطفل للتعرّض لمواقع التواصل الاجتماعي
يشرح ريشا أنّ وجهات النظر تختلف في ما يتعلق بتحديد المدة الأسلم لهذا التعرّض، لكن لا تتعدّى كلّها ثلاث ساعات في أيام الأسبوع. لكن برأيه الشخصي، يكون التعرّض لمدة ساعة إلى ساعتين مقبولاً في أيام الأسبوع ويمكن أن يضاعَف في عطلة نهاية الأسبوع ليصبح ساعتين إلى أربع ساعات في اليوم.
كذلك، هناك نظريات تتحدث عن عمر 12 عاماً كعمر سليم لاقتناء جوّال، لكن حالياً يطلب الأطفال في أعمار مبكرة جداً اقتناء الجوّال، خصوصاً إن كان أقرانه وأقرباؤه من سنّه يحملون جوّالاً. وأصبح الوصول إلى الجوّالات ومواقع التواصل أمراً سهلاً جداً وإن لم يكن بجوال خاصّ بالطفل.
ويستذكر ريشا نظرية الـ3-6-9-12، للطبيب النفسي الفرنسي سيرج تيسرون، التي تقتضي بألّا يحمل الطفل أيّ شاشة قبل الثلاث سنوات، وألّا يلعب بأيّ لعبة فيديو قبل الست سنوات، وألّا يكون لديه إنترنت قبل التسع سنوات، وألّا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي قبل الـ12 سنة. هذه النظرية متَّبعة عامّة في دول أوروبا، وبنظر ريشا، هي من القواعد التي يمكن تطبيقها في ما يتعلق بالاستخدام الآمن لصحة نفسية سليمة للأطفال والمراهقين في الفضاء الرقمي.
ويشدّد ريشا على أنّه "لا يمكن منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الجوّال أو الانترنت"، وهو يعارض هذا المنع، على الرغم من أنّها خطوات بدأت بعض الدول الغربية تعتمدها. لكن المنع لا يؤدي الغاية منه، بل يبثّ الإصرار لدى الطفل على الاكتشاف.
حماية الطفل في الفضاء الرقمي تبدأ بالحديث عنه لا بمنع الطفل عنه!
من المهم أن يحدّد الأهل مدة تعرّض أطفالهم للشاشات، وحتى لهم شخصياً أي الأب والأم، فالطفل يمشي على خطى أهله، يقول ريشا. ومن الضروري أن يتحدّث الأهل مع طفلهم يومياً لمدة خمس إلى عشر دقائق عمّا رآه، إيجابياً كان أو سلبياً، على هذه المواقع وشرح المخاطر المحتمَلة، ليشعر بالراحة والأمان والثقة بأن يعبّر لهم ويخبرهم إذا تعرّض لموقف سيّئ على هذه المواقع، "فحماية الطفل في الفضاء الرقمي تبدأ بالحديث عنه لا بمنع الطفل عنه". أيضاً، على الأهل ألّا يخبّئوا أي مشكلة نفسية يعاني منها طفلهم، مثل الخجل الاجتماعي، الاكتئاب، اضطرابات الهلع، قلق الانفصال، بل عليهم معالجتها للتخفيف من وطأة التأثير النفسي لمواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال وإدمانهم عليها.
وعلى المدرسة أن تخصّص حصة ولو لربع ساعة في اليوم لاكتشاف ما يمر به الأطفال من أمور إيجابية وسلبية على هذه المواقع، بهدف التوعية، وضرورة التمييز لهم بين الأمور الواقعية والأمور الافتراضية والتأكيد أنّ ما يرونه على هذه المواقع ليس واقعياً، كحالات المشاهد الإباحية، وأن يُشرح للأطفال أنّ هذه الحالات غير واقعية ولا تمت بأي صلة إلى علاقة الحب التي تجمع المرأة والرجل.
كيف نعلّم الأطفال أن يضعوا حدوداً لأنفسهم في الفضاء الرقمي؟
بتعدّد أنشطتهم، يجيب ريشا، كممارسة الرياضة، الرسم، الرقص، أو أي موهبة أخرى يمكن أن ننمّيها لديهم ومساعدتهم على تطويرها كي لا يقضوا وقتاً طويلاً على الشاشات، ومحاولة اصطحابهم للعب في الطبيعة.
كيف تتحوّل مواقع التواصل الاجتماعي إلى مصدر ابتكار وإبداع؟
أساساً، هي مواقع تحمل جوانب إيجابية أكثر بكثير من الجوانب السلبية يمكن أن نعلّمها للأطفال، يتابع ريشا، تماماً كما حدث خلال انتشار جائحة كورونا، عندما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي أداة فعالة لتعليم الأطفال على عادات مثل الطبخ والرياضة وغيرهما. لكن الأهم من تعليمهم إيّاها، ممارستها معهم كأهل أو كعائلة، فهذا سيحمّسهم وسيلمسون الإيجابية في هذه المواقع.
مبادرات تطبّقها "اليونيسف" لحماية الطفل نفسياً في الفضاء الرقمي
في إطار مبادراتها لحماية الأطفال والمراهقين النفسية في الفضاء الرقمي ودعمهم نفسياً واجتماعياً، تتعاون "اليونيسف مع الجهات المعنية، مثل تعاونها مع المجلس الأعلى للطفولة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، الذي بدوره يتعاون مع جمعيات ووزارات أخرى. "المبادرات عديدة لكن الحاجة تبقى أكبر بكثير"، هذا ما تؤكّده رولا أبي سعد، مسؤولة في برنامج حماية الطفل في "اليونيسف" – لبنان، في حديث لـ"النهار".
أطلقت "اليونيسف" مع وزارة التربية وجمعية "Himaya" والمركز التربوي للبحوث والإنماء، كتيّب "أبطال الإنترنت" الرقمي، وهو عبارة عن نشاطات يقوم بها الطفل لاستكشاف عالم الإنترنت بأمان، وهناك سعي إلى نشر فكرته في المدارس.
وأخيراً، أطلقت "اليونيسف" تطبيق "Daleela" العامل على نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وهو كناية عن لعبة يلعبها الطفل حتى دون أن يكون أونلاين، متوفرة باللغات العربية )وبالتسجيل الصوتي) والفرنسية والإنجليزية، وتهدف إلى تعزيز الصحة النفسية لدى الأطفال وتثقيفهم على الأمان في الفضاء [RA1] الرقمي، وتنقلهم إلى أربعة عوالم:
- المشاعر
- الثقة بالنفس
- الحماية الرقمية
- التنمّر
واستكملت Daleela بدليل يستخدمه ميسّرون مدرّبون لترسيخ المعلومات التي مرّت على الطفل في هذه اللعبة لترسيخ المعلومات التي تلقّاها الطفل خلال اللعبة، وآلية للتعبير أو الإبلاغ عن أيّ مشكلة حصلت معه شبيهة [RA2] بالتي رآها في اللعبة، بهدف تحويلها إلى الجهة المعنية لمساعدته.
وعلى صعيد الأهل، توفر "اليونيسف" جلسات توعية وإرشاد لهم حول سبل حماية ودعم أطفالهم في الفضاء الرقمي. ومن خلال برنامج "Qudwa"، تتعاون "اليونيسف" في هذه الجلسات مع أشخاص يمثّلون نماذج وقدوة لرفع الوعي لدى الأهل حول مخاطر الإنترنت على صحة الأطفال النفسية وكيفية حمايتهم، بالإضافة إلى مبادرات عديدة أخرى ككالشراكات التي أقامتها اليونيسف مع الجمعيات المحلية للعمل مع مراكز [RA3] توزيع شبكات الإنترنت في بعض المناطق، على سبيل المثال، بحيث يتم إرشادهم حول كيفية تطبيق الحماية التقنية من جانبهم.










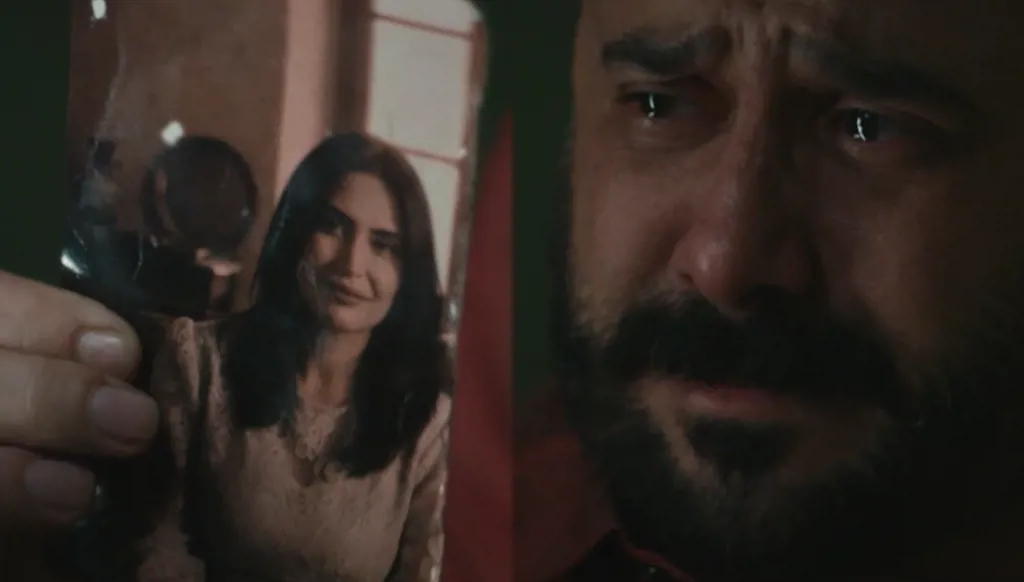

 تویتر
تویتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز



 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة








