"زقاق ضيق يذكرني بالمطر" لآلاء حسانين: والمدائن إذا تنفَّست
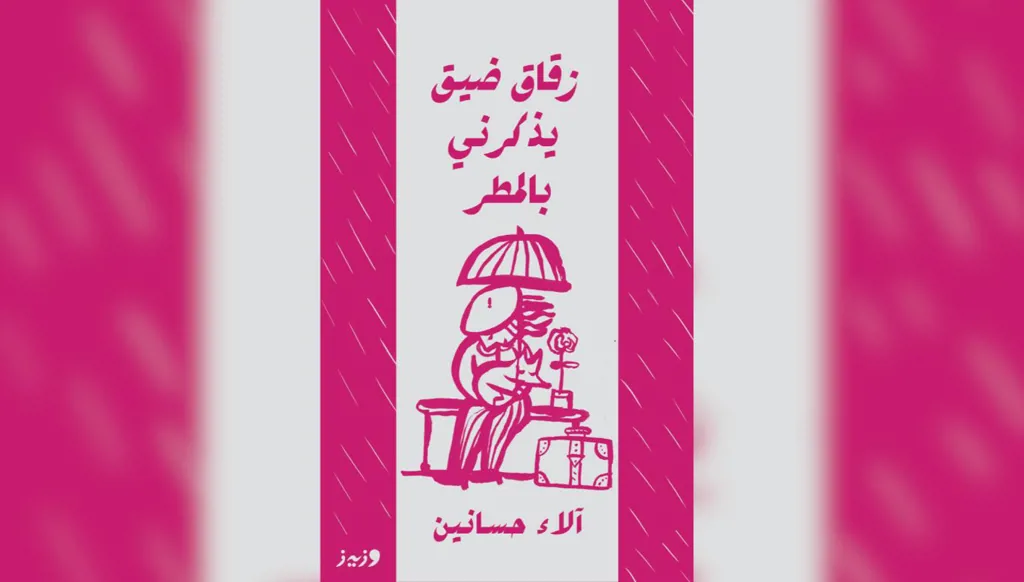
بهاء إيعالي
ثمَّة فكرةٌ سائدة عن شعر الحياة اليوميَّة بأنَّه الشعر الذي يلتقطُ التفاصيل الصغيرة ويُكتبُ بلغةٍ شفَّافةٍ وحميمةٍ ذات إيقاعٍ خافت يعتمد الجملة الخفيفة والتدوين السريع، وهذا صحيح. غير أنَّ اليوميَّ في نصوص مجموعة «زقاق ضيق يذكرني بالمطر» للشاعرة المصريَّة آلاء حسانين (وزيز للنشر - 2025) هو بمثابة الفخ الذي توقعنا فيه هذه النصوص، فهنا اليومي يتجاوزُ المذكَّرات العابرة والجًا إلى تجربةٍ وجوديَّةٍ كاملة. هذه التجربة الوجوديَّة التي نرى فيها تكثُّف حاضر المنفى في أسماء الأمكنة ومحطّات المترو والبارات والمكاتب والمنظّمات، وصياغة الشعور بميزانٍ دقيق من الجُمل القصيرة والبياضات، كما لو أن النصّ يختبر رئتَيه مع كلّ سطر. من اللحظة الأولى يعلن الصوتُ الشعريّ برنامجه الجمالي: «أريد أن أكتب شعرًا يشبه الكلام/وأقول للحملان الصغيرة "صباح الخير"»؛ ثم يقرن القول بالفعل عبر نَسَق تدوينيّ يتعاقب فيه التاريخ والمكان، ويُربط تعهُّد الكتابة بإيقاع السير والتنقّل: «كل يوم سأكتب قصيدة عن الخطوات/والأيدي في الجيوب/ومنظمة فناني المنفى الذين قالوا لي: "تعالي غدًا"!/غدًا سأحمل حقيبتي/ وأذهب مرة أخرى».
على هذا الأساس يُصاغ اليومي بوصفها "أرشيفَ عيش": سيرةٌ تتحرّك من باريس إلى نانت وأنجيه، من مقعدٍ في شارع ريڤولي إلى ماكينة قهوة في مخفر الشرطة، ومن مرآةٍ تعكس زمنًا مغايرًا إلى غرفةٍ تُضاء طوال الليل بلا مشاهدين. تتجاوز النصوص حنينَ المنفى المعتاد إلى سؤالٍ أعمق: كيف تُصبح المدينةُ جهازَ قياسٍ للشعور؟ وكيف يتجسّد التنفّسُ إيقاعًا بديلًا عن الوزن؟ وكيف تُعيد المؤلِّفةُ بناء ذاتها عبر أفعال قولٍ موجّهة (نداء الأم، مخاطبة الطفلة، مناداة الذات والأشياء)؟ وكيف تترك الهُجنة اللغوية أثرَها على الجسد والصفحة معًا؟
جغرافيا على جهازِ القلب
تظهر المدن هنا بوصفها أجهزة سيكولوجية تُقاس بها أحمال الذاكرة والجسد بدل الخلفية السردية، بحيث تقول حسانين بعد جولاتٍ بين نانت وأنجيه: «الأشياء ليست عن نانت أو عن أنجيه/فهما قلعتان كبيرتان لا تأبهان حقًّا/إنها عنّي أنا/عبرت يومًا على هذه الأرض/بندوبٍ غير ظاهرة/ووجهٍ جميلٍ يُبرِع في تغطية الوحدة». هنا يتبدّل "المكان" إلى "أداة قياس"، فتغدو المدينة، بما فيها من ريحٍ وبارٍ وممرّات، مقياسًا للثقل والخفّة، للتوتّر والسكينة، للانكشاف والتستّر. وفي لحظاتٍ بعينها يُصرَّح بالتقشّف العاطفي في المنفى، كما في قصيدة «المنفى جميل» ص 259: «كل يوم سأقول إن المنفى جميل… سأضحك في وجوه الأصدقاء… ولن أقول: يا أصدقائي أنا متعبة».
هذا التصوّر يلتقي حرفيًا مع ما يقترحه ميشيل دو سرتو حين يرى "المشي في المدينة" ممارسةً تُنتج المعنى وهي تعيد ترسيم الخريطة من الداخل: هذه المشاهد العابرة (محطة شاتليه، مقعد ريڤولي، نُزلٌ في نانت) هي «جملٌ ماشية» تعيد كتابة المدينة في جسد السائرة. حين تقول الشاعرة: «قابلت غابريال البارحة، رآني أعبر شارع ريڤولي فنادى على اسمي... جلسنا لساعات نتحدث وبعض الكلمات ابتلعتها الموسيقى» نرى كيف يُحوِّل النداءُ والمقهى والموسيقى الشارعَ إلى مقياس للحميمية/للغربة. كما ينسجم هذا مع ما ينادي به هنري لوفيفر الذي يميز بين "الفضاء المُمثَّل" و"تمثيلات الفضاء"، فالقصائد تتجاوزُ وصف عمران المدينة لتُنتج فضاءً معيشًا تتداخل فيه خرائط الرفيف الموسيقي مع خطوط القلق والبرد.
من زاويةٍ أنثروبولوجية تُضيف نصوص المجموعة بعدًا «ظاهراتيًا» باذخًا قريبًا من غاستون باشلار في «جمالية المكان»: البيت ليس جدرانًا بل «دفءٌ يُستعاد»؛ لذا تتكرّر استعادات السكن الآمن/المفقود: «تنفست صباحات أنجيه المشبعة بالبرودة/وتجوّلت كثيرًا في الشوارع ليسقط القلق والذكريات/تركت شبح أمي عند زاوية ما/وعدت بعد أيام فوجدته قد تلاشى/حرق بسيط خلّفه على الجدار». البيت هنا «ذكرى حرارة» أكثر منه عنوانًا بريديًّا، ولذلك تكتب لاحقًا: «لا يكفي أن تعبر إلى الضفة الأخرى/حتى تصل إليها فعلًا/ستظل لغتك المكسرة تذكرك بذلك». هذا القول يجاور أطروحة إدوارد سعيد حول المنفى بوصفه «حياةً متقطّعة» لا تلتئم حدودُها اللغوية والوجدانية بسهولة، فالعبورُ يتحقّق جسديًّا لكن «أجزاء منك ناقصة/متطايرة/متروكة».
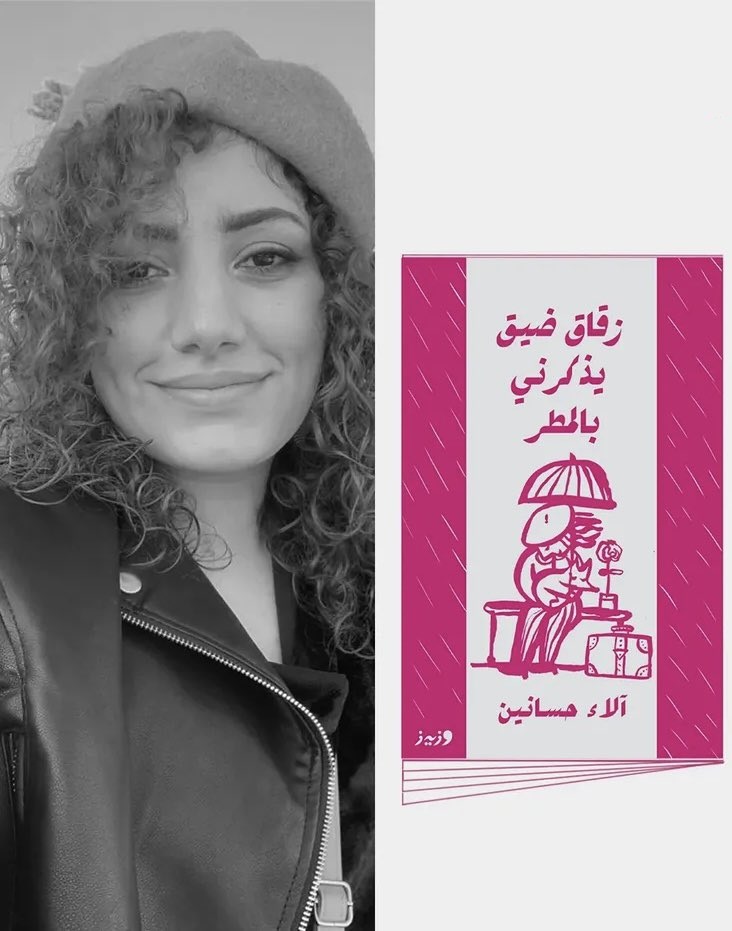
تحت هذه الإضاءة يمكن فهم مشاهد الشرطة والهشاشة بوصفها «خطوطَ شدّ» في جهاز القياس، تحديدًا في نص «ماكينة قهوة في مخفر الشرطة» ص 67 حيث تقول من جملة ما تقول: «بدأ صباحي بالمشي تجاه مقهاي المفضل في نانت... رجلٌ تبعني لعشر دقائق… تذكّرت كلّ المرّات… حتى إني هاجرتُ من بلد إلى آخر هربًا من العنف الذكوري». المدينة تُقاس بالأمن/الخوف، والقصيدة تُدَوِّن هذه القياسات بصوتٍ مشّاءٍ يلوّح لغيره ويعود إلى نفسه.
بياضٌ يعرِّف النَّفَس
في هذه المجموعة يستبدل النصُّ "المِتريكا" التقليدية بما يمكن تسميته "اقتصاد التنفّس": شهيق وزفير ينظِّمان التقطيعَ السرديّ، ومسافات الصمت وأوامر المخاطبة للذات، وهو ما نراه واضحًا في نص «محطَّة بون ماغي» ص18-19 حين تقول: «حاولتُ أن أتنفّس… في KFC... في Lidl... في المترو… ثم وأنا أجر حقيبة الأغراض بين ممرّات محطة شاتليه الضخمة… بونسواغ يا أنا… تنفّسي!». هنا يتكشّف الإيقاع عن "نَفَسٍ" لا عن "بحر": كلّ مشهدٍ وحدةُ تنفّسٍ، وكلّ بياضٍ كِيسُ هواءٍ مؤقّت. يرى هنري ميشونيك الإيقاع "تنظيمًا دلاليًا للقيمة"، أي أن الجملة لا تكتسب معناها من معجمها فحسب، إنَّما من توزيع النَّفَس فيها: أين ينكسر؟ أين يطول؟ أين يُستأنف؟ وهو ما يجعل اليوميّات المؤرَّخة (قهوة في أوتيل دو ڤيل، مقعدٌ خشبي في شارع ريڤولي، استديو في سيتيه ديز آغ…) أكثر من عناوين مكانية، فهي نقاط توازنٍ هوائيّ يربط الحركةَ بإعادة الضبط الداخلي.
هذا "الإيقاع-النَّفَس" يتجاوب أيضًا مع ما سمّته جوليا كريستيفا بـ "الدفق السيميائي" في اللغة، حيث تتحوّل الأصواتُ والوقفاتُ والتنهيداتُ إلى حاملٍ للمعنى لا يقلّ شأنًا عن المعجم، ومن هنا تأتي قدرة النصّ على تجسير الهوَّة بين "قولٍ عاديّ" و"نشيدٍ داخليّ". لا يأتي قول الشاعرة «أريد أن أكتب شعرًا يشبه الكلام» بمثابة إعلانٍ تبسيطيٍّ فحسب، إنَّما هو برنامجٌ إيقاعيٌّ: يكتسبُ الكلام حين يُصاغ بهذا الوعي طبقةً ثانية من الموسيقى، موسيقى الانكسار والتوسّل والتكرار، ما يذكّر بفكرة أنسي الحاج عن "الوزن الداخلي" في قصيدة النثر حيث "المقياس" هو التوتّر لا التفعيلة.
تؤكِّد النصوص هذا الاختيار عبر حيلة "المونتاج"، لا سيّما حين يتقاطع التفكير السينمائيّ مع الشهيق السرديّ («أريد أن أصنع فيلمًا عن أشياء كثيرة، عن الرقة التي يمسك بها غريب الباب أمامك حتى تخرج/عن الربتة على الكتف حين يومئ إليك شخص تتحدث إليه وينصت. عن الأحضان المرافقة للتحايا. وعن صباح الخير التي تتداولها بلطف مع الجميع»). وهكذا فإنَّ الومضة الفيلمية شحنة إيقاعية تعيد توزيع الهواء بين لقطات المشهد، كأن الكاميرا تُنعش رئة القصيدة. وفي مواجهة "ليل التلفاز"، حيث «ما يزال يعمل كل يوم في الليل/ويبعث على الوحدة»، يَظهر النفسُ الشعريّ وسيلةَ مقاومة: كتابةٌ تُطفئ ضجيجَ الشاشة وتردُّ المدينةَ إلى معدل تنفّسٍ إنساني.
ضمائرُ تفتحُ غرفًا
تشتغل القصائد بوعيٍ حادّ على سياسات المخاطَب: تتواتر نداءاتٌ للأمّ («فهمت أن هذا كله طريقتك في قول أحبك/وطريقتك في قول وحشتيني») ، وللطفلة المختبئة («هذا الكلام والنحيب ليسا لي. إنهما للطفلة المختبئة في أعماقي»)، وللذات («بونسواغ يا أنا/لدينا شهر كامل للمتعة/والآن/تنفسي!»)، وللأمكنة (ريڤولي/الكنيسة/البار…). هذه النداءات ليست أداءات بلاغية فحسب: إنّها أفعال كلامٍ علاجية بالمعنى الذي حدّده جون أوستن ثم جون سيرل: القولُ هنا يفعل، يُطمئن، يُعيد توزيع السلطة بين «أنا/أنت/هي»، ويُنشئ علاقةً جديدة بالذات والعالم.
تفسّر جوديث بتلر الأداء بوصفه تكرارًا مُنظَّمًا يُنتج هويّة، وهذا ما يتبدّى في خطاب الذات إلى نفسها: تأتي مقطوعة «بونسواغ يا أنا» بمثابة تكرارٍ يصنع "أنا" قادرةً على التحمّل أكثر من كونه تحيّة، وفي خلفية هذا الاشتغال تلوح أطروحة إميل بنفينيست في الذاتية اللغوية: "أنا" لا تُعرَّف إلا في مواجهة "أنت"، والضمير موقع وجود في الكلام أكثر من كونه علامة نحوية بريئة. من هنا يتغيّر أثر القصيدة كلّما تغيّر المخاطَب: حين يوجَّه القولُ إلى الأمّ يتقوّى رجعُ الذاكرة؛ وحين يُوجَّه إلى الطفلة يتحوّل النصُّ إلى جلسة ترميم؛ وحين يُوجَّه إلى الذات يُعاد ضبط الإيقاع الداخلي.
بل إنَّ "نحوَ العلاقات" هذا يفتح باب الجرجاني في نظرية النَّظم: المعنى يُولَد من علاقات الكلمات لا من مفرداتها، وهنا تُبنَى علاقاتُ القول على تحويلات المخاطَب، وعلى التوازي والقطع والسكوت. إنّ حوار الذات مع "الطفلة"، بوصفه انتقالًا من ضميرٍ لآخر، يصنع دلالةً لا يقدر عليها تقريرٌ سرديّ محض. ومن ثمّ تتكامل البراغماتيةُ مع الأخلاقي: النداءُ يُعيد الاعتبارَ لمن لا صوت له داخل الذات (الطفلة)، ويُحوّل القصيدة إلى فعلِ رعايةٍ لغوي.
كلَّما اشتدّ الفراغ، تلجأ القصيدة إلى «شبكة نِداء مدينيّ» تُخفّف العُزلة: «أقول بونجوغ للمرأة العجوز… لكن أحيانًا لا أتمكّن من مراوغة الوحدة… أمسك هاتفي وأكتب قصيدة متهالكة… ثم أبكي كثيرًا حتى أنام». هكذا تتجاور الوظيفة الاتصالية مع الوظيفة الانفعالية والإنشائية، فيتّسع القولُ ليكون علاجًا وعتبةَ تواصلٍ معًا.
أوراقُ إقامةٍ للكلمات
تتعمّد آلاء حسانين إدخال مفرداتٍ وعباراتٍ فرنسية وإنكليزية في جسد نصوصها العربيَّة، وما تفعله لا يأتي بمثابة زينة أسلوبيَّة، إنَّما بوصفه سياسةَ عبورٍ وهُجنةِ هوية. على سبيل المثال، نقرأ ما يلي ص257: «كيف حال الطقس اليوم Anyway؟/إلى أين ستذهبين اليوم Anyway؟»؛ وص232: «We can go to Buddy’s Bar»؛ وص206: «I used to blame my mom whenever I felt sad, but when my mom feels sad, who does she blame?»... هذه الشذرات تُجسِّد ما يسمّيه ميخائيل باختين بـ "تعدّد لغات الخطاب": النصّ ليس صوتًا أحاديًّا، بل تلاقي لهجاتٍ رمزية تتجاور فيها شفراتُ العيش.
ومن زاوية الهوية، تبدو هذه الهُجنة قريبةً مما طرحه هومي ك. بابا عن «الهجنة» باعتبارها منطقة ثالثة تُنتج المعنى بين الثقافات أكثر من كونها "نُقصانَ انتماء": تُسجَّل التحية الفرنسيَّة (بونجوغ/بونسواغ) بوصفها إيقاعًا يوميًّا، لكنها «تخرج من الفم "مختلفةً"» لأن الجسد نفسه في منطقةٍ بين-بين. وهنا تتجاور فكرة عبد الكبير الخطيبي عن ازدواجية اللغة مع أطروحة عبد الفتاح كيليطو حول الكاتب بين لغتين، حيث تُصبح مسافةُ اللغة موردًا للخيال أكثر منها عائقًا للتعبير.
لكن الهُجنة لا تقف عند المعجم، فهي تترك أثرًا يُرى على صفحة الجسد: «ندوبٌ غير ظاهرة»، «الذنب ينطبع على الأشياء»، «صار ندبةً زرقاء في قلبي»... ينهض هنا مفهوم دريدا عن «الأثر» بما هو علامةُ ما غاب/تأجّل، فاللغة تُؤرشف الألمَ ولا تمحوه، وتحوِّل الندبةَ إلى علامةِ ترقيمٍ في النصّ والحياة معًا. وتبلغ الاستراتيجية ذروتها حين يُعاد تعريف الوصول: «لا يكفي أن تعبر إلى الضفة الأخرى حتى تصل إليها فعلًا». لذا يمكن القول إنَّ اللغة بهجنتها وأثرها تصير "أوراق إقامة" رمزية، تُثبت الحضور وتشي دومًا بنقصانِه في آنٍ واحد.
إغلاقٌ على هواءٍ مفتوح
ليس ما نقرأه هنا يوميات عابرة ولا اعترافات على هامش المدن، بل طريقة في حمل الجسد واللغة معًا عبر أزقة لها رائحة المطر. تتكثف الخطوات وتزداد البياضات شفافيَّةً حتى تغدو القصيدة جهاز قياسٍ للحياة: تنفذ بالنداء إلى الأم، إلى الطفلة وإلى الذات، وتستعين بومضاتِ المشهد كي تعيد توزيع الهواء بين اللقطات وتحوِّل أسماء الأمكنة والعبارات المتناثرة بين لغتين إلى أوراق إقامةٍ رمزيَّةٍ للكلمات. هكذا يتبدل المكان من خلفية إلى مرآة، ويتحوّل الخوف والطمأنينة إلى وحدات قياس، فيما يتجاور الهش والمتين داخل أرشيف عيش يتنقَّل ولا يستقر.
من هذا الهواء المفتوح يمكن للكتاب أن يمدَّ ذراعه خارج صفحته: أن يقترح خرائط بديلةٍ لقراءة المدن كما نعيشها لا كما نرسمها، وأن يفتح حوارًا مع فنون الصوت والصورة لصناعة أفلامٍ قصيرة من نبض السطر، وأن يختبر طرائقَ جديدةٍ لمعايرة اللغة حين تعبر ضفةً أخرى ولا تصل تمامًا. لعل الصفحة المقبلة تستمع أكثر إلى تنفُّس الجماعة لا الفرد وحده، وتجرب كتابةً توثّق إيقاعات الأمكنة الصغيرة التي لا توضع على الخرائط، وتجرّب أن يكون النداء وسيلة معرفةٍ لا وسيلة عزاءٍ فقط. فإذا أغلقنا الدفّة بقي الهواء مفتوحًا، يشير إلى الطرق التي لم نسر فيها بعد.










 تويتر
تويتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز



 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة










