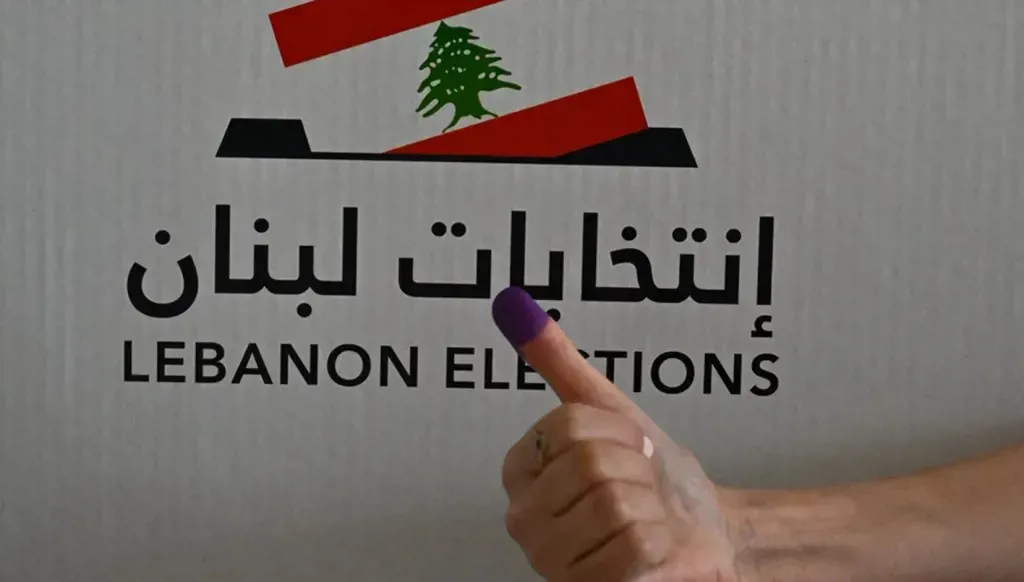مسلسل "معاوية": الحداثة العربية على أسنّة الرماح!

نقل الإسلام قبائل العرب من البداوة إلى إمبراطورية عظمى. وبعدما عاشوا خارج التاريخ أصبحوا في صدارته. رغم عظمة هذه النقلة، ثمة أسئلة ثلاثة ظلت عالقة، حول مفهوم الدولة، طبيعة نظامها السياسي، وعلاقة الدين بالدولة ونظامها.
وحين تُستدعى شخصية مثل معاوية بن أبي سفيان بوصفه أول ملوك الإسلام، في مسلسل رمضاني، فهذا يعني استعادة تلك الأسئلة الشائكة بأثر رجعي. فما الداعي الآن؟
حصانة دينية
أدى الدين دورًا مركزيًا في تأسيس إمبراطورية مترامية الأطراف منذ عهد عمر بن الخطاب، وانتقلت قداسة النص بالتبعية إلى تقديس بعض الأشخاص وعدم السماح بانتقادهم، بدءًا من عموم الصحابة وتحديدًا العشرة المبشرين بالجنة، مرورًا بالتابعين وكبار الفقهاء.
تلك الحصانة الممتدة أوجدت وعيًا زائفًا بوقائع التاريخ وأدوار الرجال، مع ما يشبه "العصمة"، وصدرت فتاوى أزهرية متكررة لا تجيز "تجسيد" الأنبياء جميعًا أو "تمثيلهم"، ومعظم الصحابة الكبار.
وفق تلك التراتبية، لا يبدو أن معاوية يتمتع بتلك "الحصانة" الصارمة، فهو ليس من الخلفاء الراشدين، ولا من أوائل من أسلموا، بل ينتمي إلى عائلة ناصبت الإسلام العداء.
مع ذلك، سعى بعض أهل السنّة إلى تأكيد "حصانته" باعتباره من "كُتاب الوحي"، و"خال المؤمنين"، بحكم زواج النبي من أخته رملة.
فهل يتفق جميع المسلمين على "الحصانة" وتحريم "التجسيد"؟ الإجابة لا، بدليل أن إيران أنتجت مسلسلًا عن النبي يوسف، ومصر أنتجت مسلسلًا عن أبي عبيدة بن الجراح وهو من العشرة المبشرين، ثم توقف بثه بسبب اعتراض الأزهر، وقبل سنوات قليلة عرض مسلسل "عمر"، وبعده "معاوية والحسن والحسين" من إخراج عبد الباري أبو الخير، وشاهد الجمهور كل تلك الأعمال.
هذا يعني أن "الحصانة" غير متفق عليها، بل تحولت إلى دعاية مجانية للأعمال، لأنه بالفعل جرى تجسيد معظم الصحابة وأحفاد النبي وآل بيته.
ربما تكمن فتوى التحريم في الاعتقاد بأن "التمثيل" نوع من التزييف والكذب، إضافة إلى ربط تصور الشخصية بصورة الممثل نفسه، لذلك أعلن أحد المحامين في مصر رفع دعوى لإيقاف المسلسل، ليس بسبب معاوية نفسه بل لأن من يجسد الإمام علي (إياد نصار) سبق له أن لعب شخصية رجل مثلي الجنس! وهذا يذكرنا بسجال خاضه الفنان الراحل نور الشريف من أجل تقديم مسرحية "الحسين ثائرًا"، وموافقته على الاعتزال بعد الدور.
ولا يخفى أن تكرار استهلاك شخصيات ذات مكانة دينية، في أفلام ومسلسلات، قد يسلبها هالة القداسة التي تتمتع بها وينزع عنها الحصانة.
مفهوم الدولة
برغم عظمة إمبراطوريات إسلامية كثيرة، ظل مفهوم الدولة نفسه مرتبكًا. فمثلًا، استعمل المؤرخون "الخلافة" كجهاز مفاهيمي سياسي، بدلًا من "الإمبراطورية" بتقاليدها الرومانية، وهو ما يربط كل حاكم باعتباره خليفة ووارثا للنبي، وينظر إلى امتداد العالم الإسلامي كله كأنه كيان واحد تحت سقفها، مهما تباينت اللغات والثقافات والعرقيات.
لكن المفهوم نظريًا وعمليًا، ظل مختلفًا عليه. فمنذ لحظة وفاة النبي، اختلف الأنصار والمهاجرون في شأن من يستحق الخلافة، وخاض مفكرون ومؤرخون في تلك المسألة حتى يومنا هذا، منهم طه حسين في "الفتنة الكبرى"، حيث كان واعيًا أن الصراع منذ نشأته الأولى لم يكن متعلقًا بالدين، بل بالدولة والسياسة والعدالة.
فانتصار أبو بكر وعمر سياسيًا، كان بقصد ترسيخ مكانة قريش حيث ولد الدين الجديد، من دون اعتداد كبير بالقرابة المباشرة للنبي، وهو ما يظهر في ترشيحات عمر نفسه للمناصب الكبرى في الدولة.
ثم حدث انزياح لصفة "القرشية" لتصبح أكثر التصاقًا بقرابة الدم، وبموجب ذلك ثمة من رأى أن عليًا أولى بالحكم من عثمان، برغم أنهما في نهاية المطاف أبناء عمومة، وعثمان تحديدًا يلتقي مع النبي في القرابة من جهتي الأم والأب معًا.
في ظل تلك الاستقطابات العائلية، رأى بعض المسلمين أن الإسلام في جوهره لا يكرس الملك العضوض، وقرابة الدم، وإنما اختيار الكفاءات بغض النظر عن اللون والعرق.
وثمة من حاول نفي مفهوم "الخلافة" كما فعل الشيخ علي عبد الرازق في كتابه "الإسلام وأصول الحكم"، وهو لا يختلف كثيرًا عن تصورات طه حسين التي تميل إلى أن الإسلام قدم أفكارًا ملهمة وسباقة للديموقراطية، لكن واقع القرون الوسطى نفسه لم يسمح لها أن تنمو.
مع الإقرار بأن صراع علي ومعاوية كان سياسيًا في الأساس، ولا يمس مجمل العقيدة، ولذلك انخرط فيه كبار الصحابة على الجانبين، فهو في جوهره تعلق بـ"شكل الدولة الإسلامية"، خصوصًا بعد استيعابها لدول وممالك أخرى حولها.
يبدو أن عليًا كان أقرب إلى التزام ما هو "ديني" على حساب ما هو سياسي، وأكثر ميلًا إلى مفهوم تداول السلطة، على عكس معاوية الذي انشغل أكثر بما هو سياسي، ولجأ إلى المكر والحيلة، والاحتماء بالعصبية العائلية لبني أمية التي كانت بالفعل تتقلد أهم المناصب.
وحالفه النجاح ليس باعتباره الأكثر كفاءة في صون الدولة، وإنما بوصفه كرّس ملكية وراثية قرشية لا تعتدّ كثيرًا بالقرابة المباشرة للنبي، وعلى المنوال نفسه نشأت الدولة العباسية وإن أضافت عصمة القرابة.
في سبيل مفهوم الدولة الإسلامية وشكلها، جرى دائمًا التلاعب بالخطابات الدينية، وإسباغ القداسة على ما ليس مقدسًا، وحجب ما كان يجب أن يُعلن ويُناقش.
وربما التحدي الحقيقي للمسلسل ليس في رواية قصص تاريخية معروفة، ولا الانحياز إلى أحد الأطراف بمنطق "الخير والشر"، ولا نزع هالة القداسة عن وقائع التاريخ، وإنما في طرح مفهوم الدولة المتعثر حتى الآن نتيجة استهلاك أطنان من المرويات وكأنها رحلة هروب جماعية إلى ماضٍ يتوهم فيه الأحفاد أن آباءهم الأوائل كانوا جميعًا مقدسين.
شرعية النظام
دار صراع الولي (معاوية) والخليفة (علي) وأتباعهما حول شرعية النظام وطبيعة الإجراءات الدستورية كالبيعة والقصاص لقتلة عثمان.
عمليًا، ربح معاوية المعركة، وظل ملكًا قرابة عشرين عامًا، لكنه اكتسب السلطة بحد السيف، وجعلها في أبنائه وأبناء عمومته، بحد السيف أيضًا. وهذا يتنافى مع القيم السياسية التي سعى النبي وخلفاؤها الأربعة إلى ترسيخها. وحتى يومنا هذا لا تزال أنظمة عربية كثيرة يُطعن في شرعيتها، مع افتقادها حتى الهالة الدينية والانتساب إلى النبي وإلى قريش، وهو ما يظهر في المآلات المأسوية للحكام، على امتداد التاريخ الإسلامي كله.
كأن الإشكاليات الثلاث تعيد نفسها، سواء في تصور الناس للدولة أو شرعية النظام وتداول السلطة، أو علاقة الدين بكل قيمه المطلقة، بشؤون السياسة النسبية المتغيرة.
من السابق لأوانه الحكم على المسلسل قبل عرضه، أو معرفة الزوايا التي انشغل بها مؤلفه خالد صلاح. لكن ثمة استغرابا لتأجيل عرضه منذ عامين، ثم الإعلان عنه مجددًا برغم تحفظات مرجعيات شيعية، ورجال دين ينتمون إلى الأزهر كمرجعية سنية. فكيف يقفز صُناعه فوق الحساسيات المذهبية الضاربة بجذورها عبر التاريخ الإسلامي؟
من الواضح أن العمل توافرت له ميزانية ضخمة يقدرها البعض بنحو مئة مليون دولار، وفريق تمثيلي يضم العشرات، من سوريا ومصر والسعودية وتونس، بينهم لجين إسماعيل (معاوية)، إياد نصار (علي بن أبي طالب)، أيمن زيدان (عثمان بن عفان)، وائل شرف (عمرو بن العاص)، أسماء جلال (زوجة معاوية)، سهير بن عمارة (هند أم معاوية).
الأهم من الكلفة الإنتاجية العالية، وإبهار الصورة، وضخامة فريق التمثيل، طرح الأسئلة التي يجب أن تُطرح. فهل ينشغل صُناعه حقًا بمأزق الحداثة العربية وتعاملها مع الإشكاليات الثلاث التي قوضت معظم الدول العربية بكل أسف، أم يكتفي بتطويب معاوية كرجل دولة أسس أول ملكية في الإسلام؟
هل يظل العرب يهربون من استحقاقات عصرهم في ردة سلفية، تُبقي أسئلة الحداثة عالقة فوق أسنة الرماح داخل قصة قديمة مضى عليها ألف عام؟












 تویتر
تویتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز



 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة