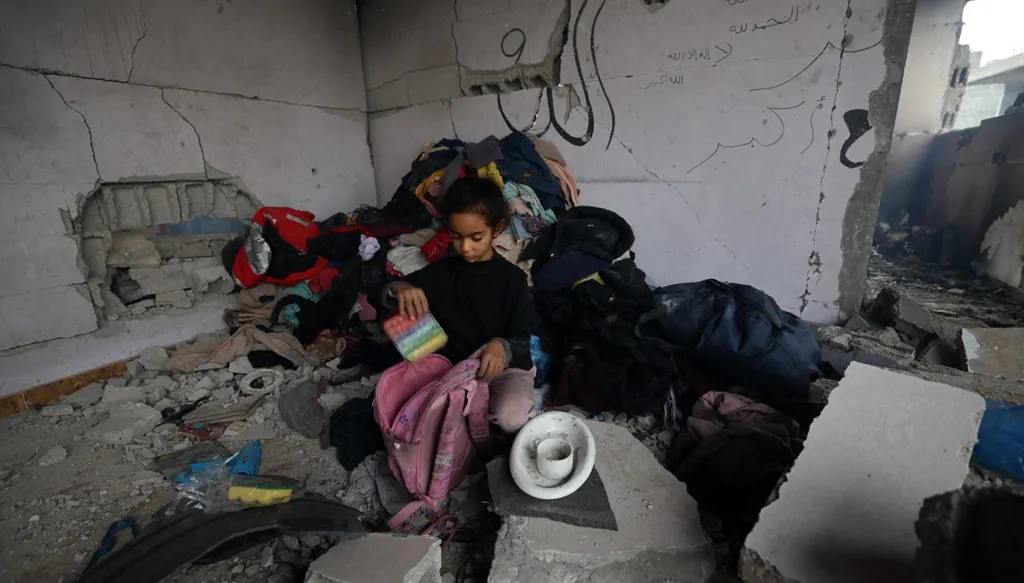ترانيم في ذاكرة كلكامش للشاعر سعيد لحدو قيامة الشعر وطين الأسطورة

إبراهيم اليوسف - المانيا*
ليست ترانيم في ذاكرة كلكامش للصديق سعيد لحدو مجرّد مجموعة شعرية، بل تكاد تكون سمفونية طويلة من اثنتين وعشرين قصيدة، تمتد من تموّجات كلكامش وتوهّجات تموز إلى الحقول الظامئة، والأناشيد التي تغنيها النوافذ لظلّها الأخير. عوالمها تتوزع بين الحب، التيه، الغربة، الطفولة، التراب، والنداء الأخير، منطلقة من الداخل لا من موضوع خارجي، من ذات ترى في الطين لوحاً وفي الذكرى معبداً وفي القصيدة خلاصاً جزئياً من المحو.
النبرة هنا ليست نداء شاعر، بل صدى ذاكرة تنتمي إلى طين آشور وجراح طور عبدين وجبهات الروح. لذا، تبدو القراءة مضاعفة، إذ لا تقدّم القصيدة كمنجاة، بل كطريق إلى الغياب النبيل. الإهداء موجّه إلى "كلكامش الهاجع في أعماقنا لوحاً من طين"، وإلى دماءٍ محترقة في وهاد طور عبدين وذرى جبال آشور، وإلى صورة متجددة للحب في محطات السفر. إهداءات تشكّل عظام الفقرات التي يقوم عليها الهيكل الشعري، حيث تتراكب العراقة مع الجرح، والبراءة مع النزف.
 سعيد لحدو ابن قامشلي، عرفته عن قرب منذ أيام الوطن. يقيم في هولندا منذ ثلاثة عقود، لكنه حافظ على روحه في نصوصه، وحوّل الغربة إلى معجم داخلي ووطن بالحبر والحنين. المجموعة صدرت عن دار TASQ عام 2024، بطباعة أنيقة بلغت 116 صفحة من القطع الوسط، وغلاف للفنان موسى ملكي، ابن قامشلي أيضاً، ليتكامل الإيقاع بين اللوحة والنص، كما ذاكرة المكان وملامح الجرح.
سعيد لحدو ابن قامشلي، عرفته عن قرب منذ أيام الوطن. يقيم في هولندا منذ ثلاثة عقود، لكنه حافظ على روحه في نصوصه، وحوّل الغربة إلى معجم داخلي ووطن بالحبر والحنين. المجموعة صدرت عن دار TASQ عام 2024، بطباعة أنيقة بلغت 116 صفحة من القطع الوسط، وغلاف للفنان موسى ملكي، ابن قامشلي أيضاً، ليتكامل الإيقاع بين اللوحة والنص، كما ذاكرة المكان وملامح الجرح.
من العناوين: لم يكن قد جاء بعد، يجيء الحلم والذكرى، أخبئكِ الآن أين؟، كتبتكَ في دفتر الأمسيات، تمرّغتُ في وحل خلقي… عناوين تتماهى مع المضمون كأصوات منفردة في كورال شعري واحد.
ترتكز الترانيم على ثلاثة عوالم كبرى: الملحمي بوصفه ذاكرة بشرية جامعة (كلكامش، تموز، طين أوروك)، الوجداني حيث الحب مقاومة والعشق صيغة للبقاء، والخراب حيث النزوح وتحولات الأرض الطاردة. منذ الصفحات الأولى يظهر مجاز الشمس والدم والطين كمعجم عميق. في الترنيمة الأولى: "حين جاء السيلُ طاغٍ في دروب القرية الظمأى لوعدٍ من ضياء / كمنت فيه حروف من دماء" (ص2)، مشهد يضغط الزمن كله في لحظة كونية.
النصوص مكتوبة على نظام التفعيلة الحرة (فاعلن، فعولن، مستفعلن…) بلا تقيد ببحر واحد، منفتحة على إيقاعات داخلية تبحث عن تنفسها الذاتي. الإيقاع ينبع من الصور وتكرار النغمة الشعورية. المجموعة كلها تبدو قصيدة واحدة موزعة على محطات من نداء داخلي. اللغة تشيّد صورها كما المعابد، منخرطة في كون شعري متكامل حيث المفردات أبناء نهر واحد يخرجون من الذاكرة. في الترنيمة الثانية: "أنا الباقي... لأشهد أن إنساناً / تنامى الله في قلبه" (ص10)، عبارة تؤمَن ولا تُفسر.
في ثلاثية الحب والحق والمصير، يرى في الأحلام نبوءات وفي الفقد ذاكرة وفي الأنثى صوت الأرض: "أخبّئكِ الآن أين؟ / وصوت النذير يهرول في الخافقين" (ص32). الخوف هنا تأسيسي، لا يخص عاشقاً منفرداً بل ذاتاً تكتب عن أمة مطرودة. الصور ترتكز إلى خيال مروّض بالتاريخ والجرح، بمفردات بسيطة مشحونة بطاقة روحية: الدم، الطين، المطر، الحقل، الزهر، وكلها لتشييد عالم فيه ألم دائم وحزن كأنه جرح مفتوح.
الفكرة المسبقة تهيمن، لا تنظيراً بل رؤية أيقونية تسبق الكتابة وتمنح القصائد تماسُكاً داخلياً، كأن الشاعر يرتل كراهب أو ناسك أو عاشق. الإيقاع الداخلي ينبثق من حاجة النص للترنيم. في الترنيمة الرابعة: "أغطّيكَ يا موطن القهر بالكلمات الصموتة / وأسحب هذا الفراش اللعين / فقد سوَّس العظم هذا الرياء المزركش" (ص25)، حيث الإيقاع يولده التوازي والتكرار.
ما يميز الديوان هو التداخل بين صوت التاريخ وصوت القلب. في الترنيمة التاسعة: "أمرُّ... ولا أحتفي بالعصافير / تروي حكايا الربيع / أمرُّ... ولا أنثني للمزامير / تنساب آهات راعٍ / ترامت به الروح خلف شتات القطيع" (ص46). المشهد ليس رعويًا بل سقوط كوني، إذ تصير الأرض منفى والراعي صورة للضياع. الصور هنا ضرورة، والمجاز يولد من خاصرة الجرح.
الشعر لا يقف عند الشكل، بل المضمون هو الذي يسوق اللغة ويمنحها تماسكها. من هنا، تبدو ترانيم في ذاكرة كلكامش مخطوطة نقشت بوهج ودم القلب، بلغة بسيطة تخفي تعقيد الحزن. تتحول الترانيم إلى شرفة يطلّ منها الإنسان على وجعه، فلا يرى فيه ضعفاً بل دلالة، ولا يجد فيه نهاية بل بداية للاشتباك مع الزمن والذاكرة والوجود.
المجموعة لا تترك القارئ عند عتبة الألم، بل تأخذه إلى حيث يتماهى الشعر بالحياة، ويصير النص كياناً نابضاً لا يميَّز فيه الدم عن الحبر. هكذا تصبح الترانيم قصيدة تتوزع بين الأرضي والروحاني، بين أنين الطفولة وحنين الوطن وأصداء المصير.
*شاعر وناقد كردي سوري مقيم في ألمانيا












 تویتر
تویتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز



 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة