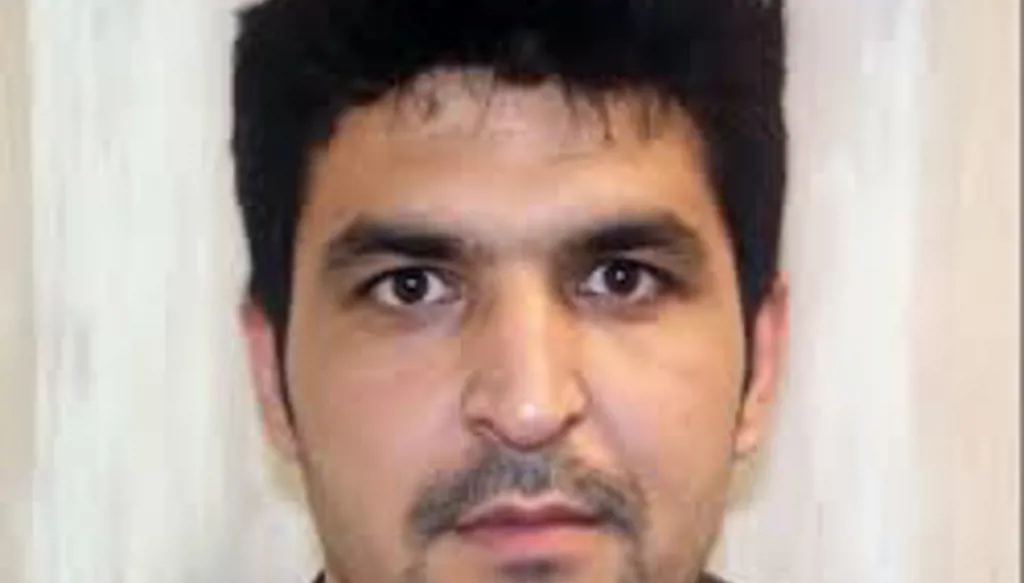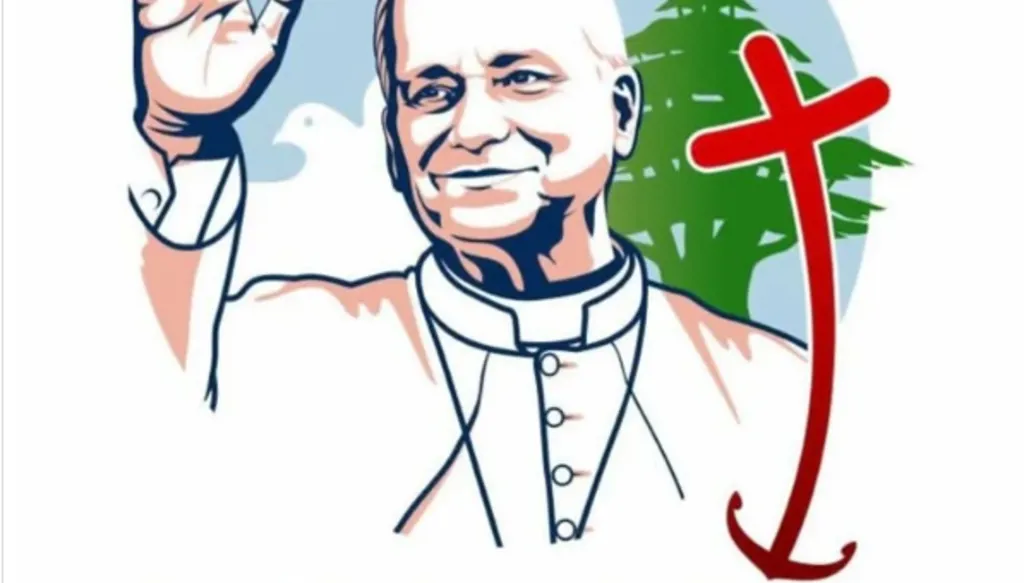من زيدل إلى الساحل السوري: شرارة محلية وسط صراع دولي

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر، يبدو أن سوريا تدخل أسبوعاً عصيباً، إذ انتقل التوتر من حمص إلى الساحل بسرعة ليرسم خريطة حسّاسة يصعب فصلها عن السياق السياسي والإقليمي الذي تراكَم منذ عودة الرئيس أحمد الشرع من واشنطن.
كانت زيارة واشنطن إشارة إلى مرحلة جديدة: انضمام سوريا رسمياً إلى التحالف الدولي، وارتفاع التوقعات بقرب إلغاء قانون قيصر، وعودة القنوات الديبلوماسية إلى العمل. لكن أول ارتداد غير متوقع جاء من تل أبيب التي أعلنت فجأة تجميد المفاوضات الأمنية مع دمشق، وأعقب ذلك تجدد الاحتكاكات في محيط السويداء، ثم زيارة كبار المسؤولين الإسرائيليين للمنطقة العازلة، وكأن الجنوب اختار أن يعلن نفسه مجدداً جبهة تتجاوز قدرة دمشق على تطويقها.

في الأسبوع نفسه، حطّ وفد روسي ضخم في وزارة الدفاع السورية، أعقبه حراك عسكري لافت في القنيطرة، مع حديث عن دور تركي في ترتيبات مراقبة اتفاق فضّ الاشتباك. وعلى الجانب المقابل، خرج مصدر حكومي ليقول للمرة الأولى إن واشنطن بدأت تجهيز مطار المزة العسكري ليكون محطة أميركية دائمة. وكان هذا التزامن كافياً ليُظهر أن زيارة واشنطن لم تكن مجرد محطة عابرة، بل بداية منعطف جديد في المشهد السوري.
وعلى هذه الخلفية المشحونة، جاءت جريمة زيدل لتفتح الباب أمام توتر طائفي سريع الانتشار. وبعد يومين فقط، خرج رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى الشيخ غزال غزال بدعوة إلى اعتصامات في الساحل معتبراً ذلك "خطوة أولية". كانت النتيجة مفاجئة لجميع المراقبين، وقد بدا من الهتافات واللافتات أن المطالبة بالفيدرالية واللامركزية أصبحت جوهر ملفّ الساحل.
اللافت أن هذه الاعتصامات اندلعت في توقيت حسّاس. فمن جهة، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل يوم القضاء على خليةٍ لـ“داعش” في ريف اللاذقية قيل إنها كانت تستعد لتنفيذ عمليات في الساحل، ومن جهة أخرى سُرّب تصريح للجنرال مظلوم عبدي يدعو فيه إلى إشراك العلويين والدروز في مفاوضات تنفيذ اتفاق آذار/مارس مع دمشق. لم يكن الترابط بين هذه الوقائع واضحاً، لكن تزامن ملفات الأمن والفيدرالية والأقليات أعاد طرح السؤال: هل ما يجري مجرد صدفة زمنية، أم بداية فصل سياسي جديد؟
على المدى القريب، تقف دمشق أمام ثلاثة استحقاقات مهمة: الذكرى السنوية لإسقاط النظام، استحقاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة وما يفرضه من تحدّيات تقنية وسياسية، ثم تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية العام، وهو موعد حدده المبعوث الأميركي توم برّاك سابقاً.
هذه الاستحقاقات كلها تتقاطع مع تحوّل أكبر في موقع دمشق الجيوسياسي من المحور الشرقي إلى الغربي للمرة الأولى في تاريخها، انتقال يعيد رسم أولوياتها الأمنية ويغيّر طريقة اشتباك القوى الخارجية فوق أراضيها.
في هذا السياق يصبح السؤال مشروعاً: لماذا تحرك الساحل الآن؟ ولماذا غيّر الشيخ غزال غزال موقفه بعدما كان قبل أشهر رافضاً لأيّ تحرّك خوفاً من انفجار أمني؟ ولماذا اتفقت أطراف علوية مختلفة — بعضها على خلاف عميق مع البعض الآخر — على خطوة واحدة في لحظة واحدة؟ هذه الأسئلة تصبح أشد حساسية حين نضيف إليها معلومة إعادة تنشيط مقر اللواء 107 في زاما عبر إرسال مجموعة من عناصر “الفرقة الساحلية”، بعد أشهر من خروجه من الخدمة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المتكرر، ومع تزايد الحديث عن رغبة تركيا في اتخاذه مقراً لإحدى قواعدها العسكرية.
"قسد" وراء التوتر؟
وربما يكون كل هذا جزءاً من عملية “جسّ نبض” لأداء الحكومة السورية الموقتة بعد صدور القرار 1799 الذي رفع اسمي الشرع وخطّاب من لوائح العقوبات الأممية. فالتوتر الذي اندلع في حمص، وبيان الأمم المتحدة السريع الذي أكد مراقبة الأوضاع، والتصعيد المفاجئ في الساحل، كلها تبدو كأنها اختبار لقدرة الحكومة على الموازنة بين التزاماتها الدولية ورفضها الواضح للفيدرالية. بعض أنصار الحكومة لم يترددوا في اتهام "قسد" بالوقوف وراء التوتر، وهو اتهام يصعب إثباته، لكنه يعكس حجم الريبة المتبادلة بين الأطراف.
حكومة الشرع، من جهتها، حاولت أن تقرأ المشهد بطريقة مختلفة. فالرد الأمني في الساحل كان مضبوطاً، متجنباً الأخطاء القديمة، ومتماشياً مع روح القرار 1799 الذي يفرض حماية الأقليات. وفي العمق، تدرك دمشق أنها لا تستطيع فتح “جبهة الساحل” في لحظة يتربّص فيها الصراع في السويداء، وأن أي انزلاق واسع هناك ستكون كلفته السياسية والأمنية مرتفعة، وتتجاوز حدود ما تستطيع أي حكومة التحكم بكل تبعاته.
ومع ذلك، يبقى ملف الساحل اليوم من أعقد ملفات المشهد السوري. فالساحل يرتبط مباشرةً بالقواعد الروسية على المتوسط، ويتقاطع مع خط الصراع التركي–الإسرائيلي، واستراتيجياً يظلّ محكوماً بملف "شرق المتوسط". ويشكّل الساحل في الوقت نفسه خاصرة رخوة يمكن أن تتسلل منها أجندات كثيرة: شبكات نفوذ قديمة تبحث عن استعادة موطئ قدم، وقوى إقليمية – في مقدمها إيران – تحاول العودة عبر قنوات اجتماعية ودينية واقتصادية، بعدما خسرت حضورها العسكري المباشر، في ظل التصعيد ضد "حزب الله" وفتح دفاتر الديون القديمة.
وتتحرك فوق هذه الخريطة أطراف متعددة: حكومة تحاول تثبيت شرعيتها وسط قيود القرار 1799، "قسد" التي ترفض أن تتحول إلى بند تقني في اتفاق آذار، السويداء التي ترفع سقفها السياسي، وأنقرة وتل أبيب اللتان تتعاملان مع الشمال والجنوب كحافات نفوذ لا كحدود مغلقة، وروسيا التي لا تزال حاضرة وتستعد لتوسيع دورها وصولاً للجنوب.
بهذا المعنى، ما جرى بين زيدل والساحل ليس مجرد توتر عابر، بل عيّنة صغيرة من معادلة أوسع تُعاد صياغتها: توازن هشّ داخل بلد لم يحسم شكل دولته بعد، تتقاطع فوقه حسابات الخارج وتنعكس في داخله على شكل اهتزازات متكررة. أيّ حدث صغير قد لا يغيّر المشهد، لكنه يكشف كل مرة حجم السيولة التي لا تزال تتحكم بالبلاد بعد عام على سقوط النظام.










 تويتر
تويتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز



 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة