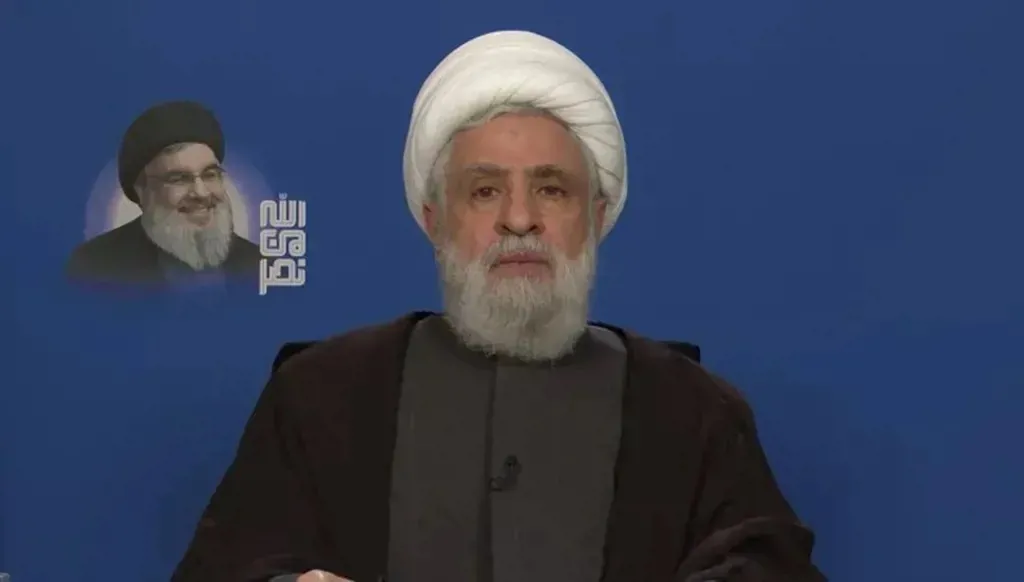الفرد، الجماعة، والاقتصاد السياسي: تأمّلات من الواقع الأرمني اللبناني

ڤاراك كتسه مانيان*
النتائج الإيجابية التي حققتها الأحزاب الأرمنية اللبنانية الثلاثة في الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في أيار/ مايو، ولّدت ارتياحاً لدى كثيرين، حيث فُسّرت بوصفها مؤشراً على حيوية وفعالية النظام المؤسساتي الأرمني في لبنان. وسرعان ما رافق هذا الإنجاز السياسي تجدُّد في الخطاب التقليدي الداعي إلى "وحدة الصف"، باعتبارها الضمانة الأساسية لأيّ نجاح جماعي.
في بلد لا تزال فيه النظرة الطائفية تحكم رؤية المجتمع للعالم، قد يبدو هذا الخطاب مبرراً، إلا أن التمعّن في مضمونه يفرض طرح تساؤلات جوهرية تتعلق بطبيعة هذا التمسّك المفرط بوحدة الجماعة، وبالبنية المجتمعية التي تسعى هذه المقاربة إلى تكريسها.
هل تعني هذه الوحدة انسجاماً حقيقياً داخل الجماعة الأرمنية، أم تُخفي واقعاً مركّباً من التناقضات الطبقية والمصالح السياسية؟ وكيف يمكن لفرد أن يمارس مواطنته في ظل نظام لا يعترف به إلا من خلال الجماعة التي ينتمي إليها؟ بل ماذا نعني حين نتحدث عن "المصلحة الجماعية"؟ وهل يعكس هذا المفهوم إرادة جماعية حقيقية، أم يُستخدم كأداة سياسية تخدم مصالح فئة ضيّقة داخل الجماعة؟
في كل مرة يُرفع فيها شعار باسم "المجتمع"، يتم تجاهل حقيقة أن هذا المجتمع غير موحّد، وأن ما يقدّم كمصلحة عامة، غالباً ما يعكس طموحات مهيمنة تسعى إلى فرض رؤيتها باسم الجماعة بأكملها. فالوحدة، كما تُستخدم في الخطاب السياسي، تتحوّل إلى أداة لإخفاء التعدّد والتباين، وتهميش الأصوات غير المنسجمة مع التوجّه السائد.
الوحدة كمفهوم أيديولوجي
لا يمكن فهم هذا الخطاب الوحدوي إلا من خلال إدخال الاقتصاد السياسي إلى النقاش؛ فهذا الحقل المعرفي يتيح لنا تحليل الروابط بين البنية المؤسساتية الطائفية، والمصالح الاقتصادية التي تدعمها. فالوحدة، بوصفها خطاباً، لا تخلو من البُعد الطبقي، إذ تُستخدم غالباً كغطاء يخدم من يملكون الموارد والسلطة داخل الجماعة، وليس بالضرورة من تعبّر عنهم الجماعة شكلياً.
كثيراً ما يُفترض أن الجماعة الأرمنية كيان متماسك، خالٍ من التناقضات، غير أن الواقع يشير إلى أنها، في جوهرها، شبكة معقدة من العلاقات والمصالح، تشكلت ضمن بيئة الاقتصاد السياسي اللبناني. فعلى مدى العقود الماضية، تداخل البُعد القومي بالبُعد المجتمعي، ما جعل من الصعب التمييز بين ما هو وطني، وما هو طبقي، وما هو حزبي. ونتيجة لهذا الدمج، تراجعت مكانة الفرد كمواطن مستقل، وباتت هويته السياسية والاجتماعية تُستمدّ فقط من الجماعة التي ينتمي إليها.
من هنا، يبدو لافتاً غياب أدوات التحليل السوسيولوجي عن الخطاب الأرمني اللبناني. فمفاهيم مثل "الطبقة" و"الفئة الاجتماعية" غابت طويلاً لمصلحة شعارات هوياتية عامة. وهذا ما حال دون تطوير خطاب قادر على تفكيك علاقات القوة داخل الجماعة، وقراءة الواقع القائم خارج الأطر الأيديولوجية الجامدة.
ضمن هذا الإطار، يبرز سؤال قديم جديد: الاندماج أم الانعزال؟ سؤال لطالما طُرح ضمن ثنائية "الحفاظ على الهوية القومية" مقابل "الذوبان في المحيط"، لكنه نادراً ما نوقش من الزاوية الاقتصادية: ما المصالح التي يخدمها الانعزال؟ وما الذي يمكن أن يخسره النظام القائم إذا انفتح على محيطه؟ وهل مصالح الأرمن اللبنانيين واحدة فعلاً، رغم اختلاف مواقعهم الطبقية والجغرافية والاجتماعية؟
الخطاب القومي الوحدوي يعيد إنتاج تصوّر مغلوط للجماعة ككتلة واحدة، فيما المشاكل المشتركة، مثل القضايا البيئية والصحية والتخطيط المدني، تتطلب تعاوناً خارج حدود الهوية القومية، وتشجّع على بناء خطاب مدني-اجتماعي، لا طائفي.
الهويات المتعددة والمسكوت عنها داخل الجماعة
لقد نجحت النخب الأرمنية اللبنانية، منذ السبعينيات، في تقديم الهوية الأرمنية كهوية منسجمة وموحّدة، وذلك من خلال تهميش الفروقات الأيديولوجية والطبقية، وتصويرها كتهديد للاستقرار. وأُعيد بناء هذا الخطاب استناداً إلى حدث تأسيسي: الإبادة الأرمنية، التي تحوّلت إلى لحظة تأسيس للوعي الجماعي، لا تسمح بأيّ تمايز داخلي، وكأن الجماعة وُلدت موحّدة بحكم المأساة التاريخية.
في هذا السياق، يُختزل الفرد ضمن الجماعة، ويُجرَّد من خصوصيته كمواطن، ثم جاءت الحرب الأهلية اللبنانية لتُعمّق هذا التوجّه، وتُعْلي من شأن أمن الجماعة على حساب الحريات الفردية. هكذا، أصبحت وحدة الجماعة مصدراً للشرعية، بينما بات كل اختلاف يُقدَّم كخطر على الكيان.
ما تُدافع عنه السلطات الأرمنية اليوم بوصفه "حفاظاً على التقاليد"، ليس أكثر من إعادة إنتاج لشرعية تستمدّ وجودها من الجماعة، لا من الناس. والحفاظ على التقاليد، هنا، يُخدم فيه استمرار النظام القائم، لا تطوّره أو تحديثه.
في ضرورة المساءلة
إذا أردنا إحياء الفكر العام، فلا بد من الشروع في مساءلة حقيقية. من يُحدّد مصالح الجماعة؟ وما هو التكوين الطبقي للقيادة الحالية؟ من هم الذين يخسرون بسبب احتضار الحياة الثقافية؟ ومن هم المستفيدون من استمرار الخطاب التقليدي؟ هل مصالح من يملكون رأس المال تتطابق فعلاً مع مصالح من يتحدثون باسمهم؟
في غياب مساءلة كهذه، تتحول مفاهيم مثل "الحفاظ على الهوية" إلى شعارات فارغة، لا تعكس واقع الجماعة المركب. وقد كان هذا النوع من الأسئلة مطروحاً في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، في ظل حراك فكري أرمني تفاعل مع الجدالات اليسارية والليبرالية. أما اليوم، فقد تراجعت هذه التساؤلات، وحلّ محلها خطاب متخشب، يُفرغ الهوية من مضمونها الحقيقي، ويمنع ظهور أصوات بديلة.
إن التحولات التي شهدها المجتمع الأرمني اللبناني خلال العقدين الماضيين – من ارتفاع في التعليم، إلى نموّ في رأس المال، إلى اتساع في التغرّب – لم تُترجم إلى تحديث فعلي في المؤسسات أو الخطاب، بل جرى تثبيت الوضع القائم، واحتُكرت السلطة باسم الجماعة، فيما هُمّش الفرد.
لذلك، فإن إدخال الاقتصاد السياسي إلى قلب التفكير المجتمعي ليس مجرّد خيار فكري، بل ضرورة حيوية لتحليل العلاقة بين "الأرمنية"، و"الوحدة"، و"الانتماء". فالفهم الطبقي والتحليل القائم على المصالح يمكن أن يساعدا على تجاوز الانقسامات الشكلية، وعلى قراءة البنية الاجتماعية اللبنانية – والأرمنية داخلها – قراءة نقدية وواقعية.
*أستاذ مساعد في دائرة التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت.
-المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية.












 تویتر
تویتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز



 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة