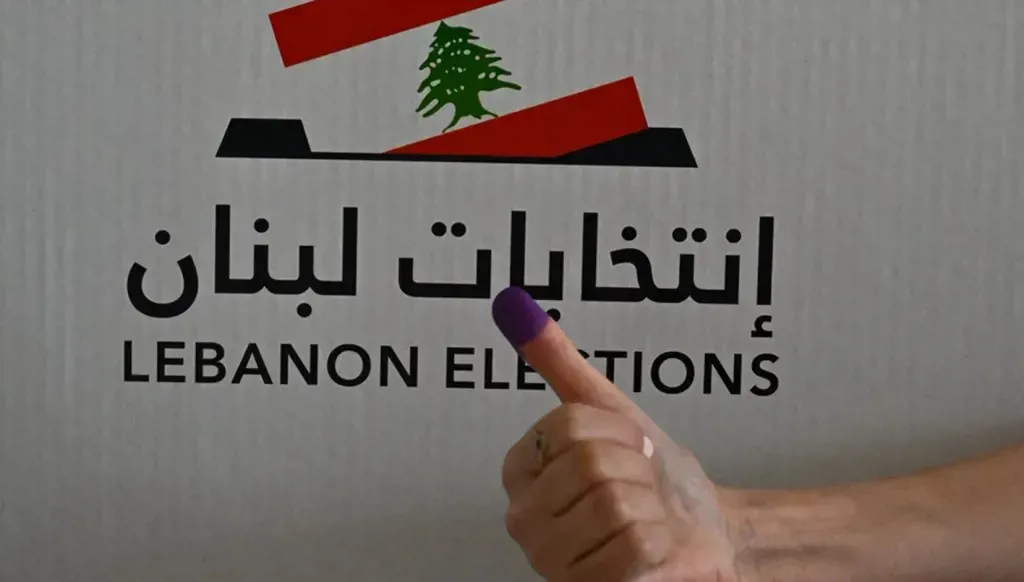نزعُ السلاح غير الشرعي: الميثاقيَّة من ضمانةٍ للتوازن إلى ذريعةٍ للتعطيل

أ. د. هلا رشيد أمُّون
بعد انسحاب الوزراء الشيعة من جلسةٍ لمجلس الوزراء أُقرّ فيها بندُ سحبِ السلاح غير الشرعي من الميليشيات (وفي مقدّمتها حزبُ الله)، عادت مسألةُ “الميثاقية” لتتصدّر المشهد كمرجعٍ فضفاضٍ يُستخدم في كل مرةٍ لتقويض الشرعية الدستورية. فأيُّ "ميثاقٍ" هذا الذي يُستدعى كلّما اقتربت الدولةُ خطوةً من منطقِ بسطِ سيادتها؟ وأيُّ نظامٍ سياسيٍّ هذا الذي يُقدّم اتفاقًا شفهيًا غير مكتوب، على دستورٍ مكتوبٍ صادقَ عليه ممثلو الأمة؟
إنَّ مصطلح “الميثاقية” في السياسة اللبنانية يشير عادةً إلى التمثيل العادل والمتوازن للطوائف اللبنانية كافةً، في مؤسَّسات الدولة، خصوصاً في السلطة التنفيذية والتشريعية. وهذا المبدأ مستمدٌّ من تفاهمٍ سياسي غير مكتوبٍ عُرف بإسم “الميثاق الوطني”، حصل في العام 1943 قبيل الاستقلال عن فرنسا، بين بشارة الخوري ورياض الصلح، (ولم يُدمَج لاحقاً في دستور 1926). وكانت أبرز مضامينه: التوازن الطائفي في الحُكم، احترامُ العيش المشترك، لبنان ذو وجه عربي، لا للشرق ولا للغرب، الذي يعني أن يتخلى المسيحيون عن المطالبة بالحماية الأجنبية (أي فرنسا)، وأن يتخلى المسلمون عن فكرة الوحدة مع سوريا.
هذا “الميثاق” لم يكن مُلزِمًا من الناحية القانونية أو الدستورية، ولكنه شكّل قاعدةً عُرفيةً ارتكزت إليها الجمهوريةُ الأولى. واكتسب قوةً سياسيةً وأخلاقيةً حقيقية، بفعلِ التزام الطبقة الحاكمة به كمرجعيةٍ تأسيسيةٍ غير مكتوبة، إلى أن دمُجت بعض مبادئه في اتفاق الطائف الذي أقرّ رسميًا آليات توازنٍ طائفي انتقالية، في انتظار إلغاء الطائفية السياسية، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
أي إنَّ “الميثاقية” في أصلها، هي مبدأٌ توافقيٌّ يهدف إلى حماية التوازن بين الطوائف اللبنانية، ولكنها في الممارسة السياسية، كرّست الصيغةَ الطائفية، ونزعت الشرعيةَ عن أيِّ سلطةٍ تنفيذية أو تشريعية أو قراراتٍ أساسية (التعيينات، الاتفاقيات، قانون الانتخابات)، ما لم تكن مُمثّلةً لجميع الطوائف الأساسية. وهكذا، تحت شرط الحصول على رضى وموافقة المكونات الطائفية الأساسية، حصل الفراغُ الرئاسي، وسقطت حكومات، عندما استُخدمت "الميثاقيةُ" أداةً للمساومة والعرقلة، ومبرّرًا لفرض ڤيتوات طائفية. وكل ذلك حصل باسم حماية التوازن الطائفي والعيش المشترك في لبنان.
التناقضُ بين الممارسة السياسيَّة اللبنانيَّة والمرجعيَّة القانونيَّة العليا تبرز الإشكاليةُ السياسية/الدستورية في لبنان، من خلال التوتر العميق بين الشرعية القانونية (الدستور) والشرعية التوافقية (الميثاقية). فمن الناحية النظرية، "الدستور" هو المرجعُ القانوني الأعلى في الدولة اللبنانية، وهو الوثيقةُ المكتوبةُ التي تُحدّد شكلَ الدولة ونظامَ الحُكم وصلاحيات السلطات، وتضمن الحقوق، وكلُّ ما يخالفه يُعتبر غير شرعي. ولكن من الناحية الواقعية، فإنَّ الميثاق غير المكتوب هو سلطةٌ أقوى من الدستور، ويُمارَس أحيانًا كقوةٍ سياسيةٍ فوق دستورية، بحيث قد تُعتبر القرارات التي تُتخذ بشكل دستوري (مثلاً: بنصابٍ قانوني في مجلس الوزراء أو البرلمان) “غير ميثاقية”، إذا لم تكن تحظى برضى الطوائف الأساسية. ما يعني أنَّ الشرعية الدستورية لا تكفي وحدها، بل يجب أن تترافق مع شرعيةٍ ميثاقية/طائفية/توافقية.
ولا بدَّ من الإقرار بأنَّ لبنان ليس الدولة الوحيدة التي تُوازن بين الدستور والأعراف السياسية، ولكنَّ النظام الطائفي في لبنان، هو نموذجٌ فريدٌ في كيف يكون التوازنُ بين الطوائف، أقوى أحيانًا من نصوص القوانين. المملكةُ المتحدة مثلاً، لا تمتلك دستورًا مكتوبًا، بل تعتمد على مجموعةِ قوانين وأعراف وتقاليد برلمانية. لكنَّ الأعراف هناك مؤسَّساتية ومنضبطة، وليست طائفية، ولا تُستخدم للتعطيل السياسي. وهناك بالطبع، بعض الدول الأخرى (مثل البوسنة والهرسك والعراق) التي تعمل بأنظمةٍ عُرفيةٍ أو غير مكتملةٍ دستوريًا، وبعضها يشهد توتراتٍ بين الأعراف والتفاهمات الطائفية والتشريعات، لكن لا أحد يشبه لبنان تمامًا في البنية الطائفية المعقّدة، وفي اعتماد “الميثاق الشفهي” كمصدر شرعيةٍ أقوى من الدستور المكتوب، في الممارسة السياسية.
إذًا، لبُّ هذا التناقض في الممارسة السياسية اللبنانية، يتجلّى في تحوُّل “الميثاق” من قاعدةٍ توافقيةٍ مرنة، إلى مرجعيةٍ تعلو على الدستور، وذلك على الرغم من أنَّ دستور الطائف قد تضمّن صراحةً، آلياتٍ لضمانِ تمثيلِ الطوائف بشكلٍ متوازن. ولعلّ أبرز النصوص هي المادة 95 التي تنصُّ على تمثيل الطوائف بصورةٍ عادلةٍ في الوظائف العامة (باستثناء الفئة الأولى التي يُفترض أن تكون غير طائفية). وقد دعا إلى تطبيق اللامركزية الإدارية، كوسيلةٍ لتحقيق توازنٍ مناطقي وطائفي، وتحدَّث عن المساواة بين المواطنين (المادة 7)، ونصّ على آليةِ اتخاذِ قراراتٍ حكومية بالأكثرية (ولا سيما في التعيينات الكبرى، والقضايا السيادية…)، لكنَّ الواقع يحتكم إلى الانتماء الطائفي، قبل أي اعتبارٍ آخر، ويفرض إجماعًا طائفيًا شبه كامل، وإلا اعتُبر القرارُ غير ميثاقي. وكذلك حدَّد الطائفُ صلاحياتِ المؤسَّسات (الرئاسة، الحكومة، البرلمان)، لكنَّ الممارسة الفعلية تشلُّ هذه المؤسسات أحياناً، بانتظار توافقٍ طائفيٍّ خارج النصوص الدستورية.
إذاً، لقد تضمّن دستورُ الطائف ما يُحقق التوازن الطائفي ويحمي مصالح الطوائف، ولكنه فعل هذا كمرحلةٍ انتقاليةٍ نحو إلغاء الطائفية السياسية تدريجيًا (المادة 95)، وذلك عبر إنشاءِ هيئةٍ وطنية تُعنى بذلك، لم تُشكّل أبدًا. لكنَّ القوى السياسية جمّدت النصوصَ الإصلاحية واحتفظت بالجزء الطائفي من الاتفاق فقط، ممَّا أدّى إلى شللٍ سياسيٍّ مزمن؛ وإلى شرعنةِ المحاصصةِ الطائفية باسم التوافق؛ وإلى هشاشةِ الاستقرار السياسي، لأنَّ النظام الذي يحتكم لتوافقِ زعماء الطوائف خارج الدستور، يكون أكثر عُرضةً للانهيار عند غياب هذا التوافق، لأنه يُفرّغ المؤسَّسات من مضمونها، كلما اصطدم القرارُ السياسي بمصلحةِ فئةٍ طائفية.
وبعبارةٍ أخرى، الطبقةُ السياسية اللبنانية، بدلاً من أن تسير في اتجاه بناء الدولة المدنية، كرّست الطائفية أكثر، ومنحت حقَّ الڤيتو لأيِّ مكوّنٍ طائفيٍّ كبير يشعر بأنه متضرر من قرارٍ بعينه،، واستخدمت “الميثاقية” أحيانًا للتعطيل والابتزاز السياسي.
وعليه، فإنَّ القبول بـ”ميثاق” غير مكتوب، كمصدر شرعيةٍ سياسية، هو عملٌ يتناقض فعليًا مع مبدأ دولة القانون، ويُضعف مرجعية الدستور. إذ لا يجوز لأيِّ “عُرف” أو تفاهمٍ سياسيٍّ غير منصوصٍ عليه، أن يُبطِل نصًّا دستوريًّا، خاصةً إذا لم يتم تعديله رسميًا. فهذا مناقضٌ لفكرة الدولة المدنية الحديثة التي تتطلب مرجعيةً واحدةً (الدستور)، لا ميثاقًا “مرنًا” تُرك عمداً كعُرفٍ سياسي، كي يُفسّره كلُّ طرفٍ حسب مصلحته، أو يستخدمه كورقةِ ضغطٍ أو سلاحٍ سياسي عند الحاجة، ضرورة الفصل بين الميثاق كضامنٍ للتوازن، والميثاق كڤيتو طائفي دائم.
إنَّ دعوة مجلس الوزراء إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتجريد الميليشيات من سلاحها، ليست خرقًا للميثاق، بل تطبيقٌ فعليٌّ للدستور وروحه. فالديباجةُ الدستورية،التي تُشكّل جزءًا لا يتجزأ من الدستور، تنصّ بوضوحٍ على أن “لا شرعيةَ لأيِّ سلطةٍ تناقض ميثاق العيش المشترك"؛ وعلى أنَّ "الدولة وحدها تُنشئ القوى المسلّحة"، ما يعني أنَّ أي قوةٍ مسلّحة خارج هذا الإطار، تُعدّ انتقاصًا من سيادة الدولة وخرقًا لمبدأ الشرعية الدستورية. وعندما يُواجَه هذا الحقُّ الدستوري بالاعتراض الطائفي أو بالتهويل بالنزول إلى الشارع أو بالإستقالة من الحكومة، فإنّ "الميثاقية" تكون قد تحوّلت من ضمانةِ توازنٍ، إلى أداةٍ لعرقلة بسط سلطة الدولة.
ومن زاويةٍ فلسفيةٍ وحقوقية، فإنَّ الميثاق الاجتماعي الحقيقي – كما تصوّره جان جاك روسو أو الفلاسفة السياسيون – هو العقدُ الذي يُبرمه الأفرادُ الأحرار لتأسيس مجتمعٍ سياسيٍّ ينظّمهم كمواطنين، ويكون قائمًا على الإرادة العامة. أما في لبنان، فإنَّ “الميثاق” هو اتفاقٌ بين زعماء طوائف وقوى سياسية وحزبية، لا بين مواطنين، وهو ما يجعل الدولة ساحةَ تفاهمٍ مؤقّتٍ بين جماعاتٍ متصارعة، لكلٍّ منها “ڤيتو” مقدَّس.
“الميثاقيةُ”، في معناها الحقيقي في العام 1943، كانت محاولةً نبيلةً لحمايةِ العيشِ المشترك في مجتمعٍ متنوّعٍ طائفيًّا، ويخطو خطواته الأولى نحو بناء الجمهورية، لكنها تحوّلت اليوم إلى ذريعةٍ لتحقيقِ مكاسبِ فئوية. لذلك لا بدَّ من العودةِ إلى منطقِ الدولة، عبرَ تفعيلِ النصوصِ الدستورية، لا الالتفافِ عليها باسم “الميثاقية”، وإلا فستبقى الدولةُ رهينةَ أعرافٍ غير مكتوبةٍ، تُسقِطُ الدساتير، وتغتالُ أيَّ فرصةٍ حقيقيةٍ لبناءِ وطن.
ذلك أنَّه عندما يُفهم “الميثاق” على أنه “حقٌّ طائفيّ”، يفقدُ مفهومُ “المصلحة العامة” معناهُ، ويُختزلُ الوطنُ إلى توازُنِ مصالحَ بين الطوائف، لا مشروعٍ مشتركٍ بين مواطنين، وتُصبحُ مستحيلةً إمكانيةُ قيامِ دولةٍِ حديثةِ ٍمبنيّةٍِ على السيادة والمواطنة، لمصلحةِ قيامِ نظام “القبائل السياسية”، الذي بموجبه يُمنحُ زعماءُ الطوائف سلطةَ تقديمِ سرديّةٍ تاريخيةٍ شفهيّة قامت على توازنٍ هشٍّ عَكَس توازنات ذلك الزمن، وكانت ثمرةَ تسويةٍ سياسيةٍ بين طائفتين (الموارنة والسُنَّة) تخوَّفتا من غلبةِ إحداهما على الأخرى - على نصوصٍ دستوريةٍ مكتوبة، متى اقتضت مصالحهم ذلك.
والمفارقة اللافتة، أنَّ الطائفة الشيعية لم تكن طرفًا فاعلًا في صياغةِ الميثاق الوطني في العام 1943،ولكنها اصبحت اليوم - ولاسيما بعد تغيّر موازين القوى بعد الحرب اللبنانية، وظهور قوى شيعية منظّمة ومسلّحة - أكثر مَن يوظّف "الميثاقَ" لحماية مكتسباتها. وهو ما يكشف عن هشاشةِ التوازنات في لبنان، وتحوّل الميثاق من أرضيةِ تعايشٍ، إلى أداةِ نزاعٍ متجددة، تُعيد إنتاج الانقسامات الطائفية، بدلًا من تجاوزها.












 تویتر
تویتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز



 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة