أبراج غزّة... من ذاكرة الرحّالة إلى ركام اليوم

في غزة، تبدأ الحروب دائماً من الأبراج وتنتهي بها. كأنها رسالة إسرائيل الدائمة: ما زال في هذه المدينة ما يمكن تدميره، وما زالت الحرب "مجدية" حتى لو غابت الرموز واغتيل القادة. برج كامل يُمحى بلمح البصر، فيما الشظايا تتناثر فوق الخيام. وإذا كانت الأبراج بلا حصانة، فكيف بالخيام؟ الرسالة أوضح من أن تُخفى: غادروا الآن...
ومع اشتداد القصف، صار المشهد أكثر قسوة: مواطنون يبيعون أثاث بيوتهم قبل أن يغادروها. أبو عودة، من حيّ الشيخ رضوان، تخلّى عن كل خشب في منزله ليتمكن من استئجار سيارة نحو الجنوب. آخرون رموا الأسرّة والخزائن من الطوابق المرتفعة ليستفيدوا من أثمانها قبل أن يأتي دور البرج الذي يسكنونه. وحتى "غرف النوم" صارت تُعرض في الشوارع لتجار الحطب وأصحاب "التكايا". وكأن الغزيين يودّعون بيوتهم قطعة قطعة، ليخففوا وقع الفقد حين تأتي ساعة الانهيار.

الأبراج ذاكرة عمودية
منذ التسعينيات، حين ضاقت الأزقة القديمة – حي الدرج، الزيتون، الشجاعية، التفاح – كان لا بد من التطلع نحو السماء. هكذا وُلد برج فلسطين عام 1994، 14 طابقاً من الإسمنت، يطل على البحر ويمد المدينة المحاصرة بأفق جديد. تبعته أبراج أخرى: الجلاء، مشتهى، السوسي، هنادي، الشروق، الجوهرة... لم تكن شاهقة بالمعايير العالمية، لكنها بدت بعيون سكانها كناطحات سحاب تفتح شرفاتها على المتوسط، تمنح الأطفال أوّل تجربة لرؤية الغروب من علٍ، وتحوّل المدينة المزدحمة إلى فسحة للتمدّن.

لكن هذه الأبراج لم تُترك حرة في صعودها. الاحتلال فرض سقفاً عمرانياً غير مكتوب: لا أكثر من 14 أو 16 طابقاً. فحتى الحلم المعماري كان مراقَباً، وكان الأفق كذلك مقنَّناً. ومع ذلك، صارت الأبراج علامات مدنية، تؤوي طبقة وسطى ناشئة، وتمنح غزة ملامح مدينة عصرية، ولو محاصرة.
غزة التي كانت
لكن غزة لم تكن يوماً مدينة بلا ملامح. منذ قرون، كانت وجهة للرحّالة والتجار والعلماء.
ابن بطوطة، في القرن الثامن الهجري، أُعجب بالجامع العمري الكبير، وصفه بأنه أنيق البناء ومنبره من الرخام الأبيض، وذكر آل سالم كأعيانها وعلمائها وفق ما نقله في "تحفة النظار في عجائب الأمصار وغرائب الأسفار".

في شتاء 1470، نقل المؤرخ السويسري يوهان لودفيك بركهارت عن الراهب الإيطالي فرانسيسكو سوريانو أنه رأى نصف بيوتها ينهار تحت المطر الغزير، لكنه اندهش من غنى أسواقها وكثرة سكانها. أما الفرنسي لوران دارفيو (1659) فأطلق عليها اسم عاصمة فلسطين، مبهوراً بقصورها وحدائقها وبازاراتها ووفرة بضائعها، وبموقعها الفريد على طريق القوافل بين مصر والشام والحجاز. وكتب الكونت دو فولني عام 1785 أن بصل غزة يُصدَّر إلى إسطنبول، وأن أسواقها تعجّ بالحياة كعاصمة صغيرة على المتوسط.

في القرن العشرين، امتلكت غزة مطاراً دولياً يربطها ببيروت بأربع رحلات أسبوعية مقابل خمس ليرات فقط. كان ذلك قبل أن تتحول اليوم إلى مدينة بلا معبر، بلا ميناء، بلا مطار، وبلا أبراج.

اغتيال العمران
حين تُقصف الأبراج، لا يُستهدف حجر فحسب، بل اغتيال لذاكرة المدينة الحديثة. فالأبراج كانت ملاذاً للحياة اليومية: مقاهٍ في طوابقها الأرضية، صيدليات في مداخلها، مكاتب أطباء وصحافيين في أدوارها العليا، وغرف معيشة مفتوحة على البحر. كل شرفة تُهدم تعني غروباً لن يُشاهد مرة أخرى، وكل نافذة تتحطم تعني ذكريات تتناثر كالشظايا.

إنها سياسة ممنهجة. تدمير الحاضر ليُمحى الماضي، ودفع الناس إلى النزوح تحت وطأة قصف يستهدف الأبراج أولاً وأخيراً. فكما يقول الغزيون اليوم: الأبراج كانت وجه غزة، وهدمها اغتيال للمدينة كلها.
ذاكرة أعلى من الخرسانة
لكن المفارقة أن الأبراج التي لم يُسمح لها بأن تتجاوز الـ 16 طابقاً، ارتفعت اليوم أعلى من ذلك بكثير. ارتفعت في الذاكرة، في الحنين، في الرواية الجماعية. تحوّلت من عمران ملموس إلى معنى لا يُقصف: أبراج ذاكرة تضاف إلى طبقات المدينة التي عرفها ابن بطوطة ودارفيو وسوريانو.

غزة التي وُصفت يوماً بأنها غنية، عامرة بالمساجد والكنائس والسبل والقصور، تتحول الآن إلى ركام. ومع ذلك، فإن كل ركام جديد لا يُلغي ذاكرتها، بل يكدّس طبقة جديدة فوق ما سبق. وكأن المدينة، وهي تفقد أبراجها، تبني في المقابل برجاً آخر غير مرئي: برجاً من الذكريات.



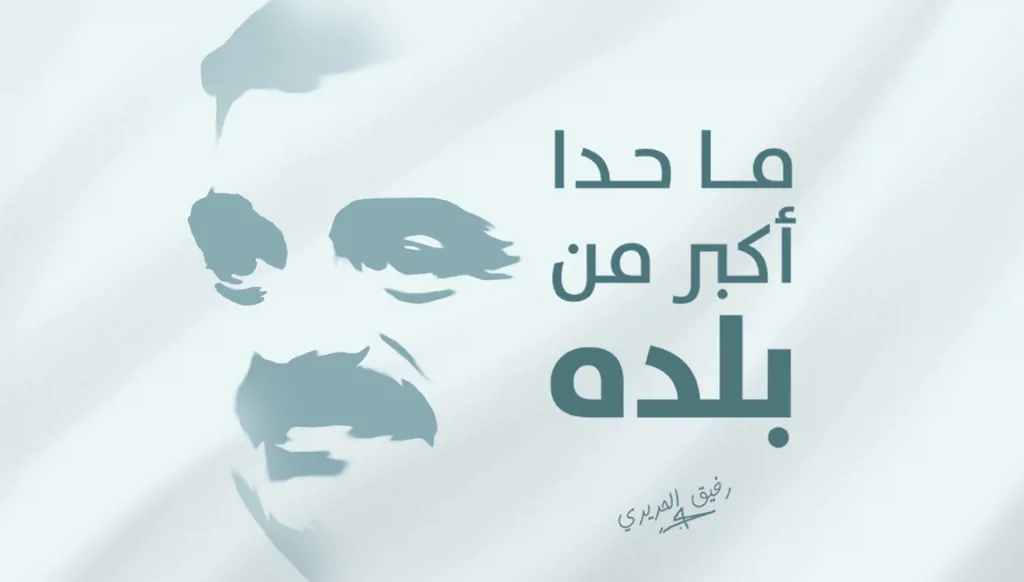






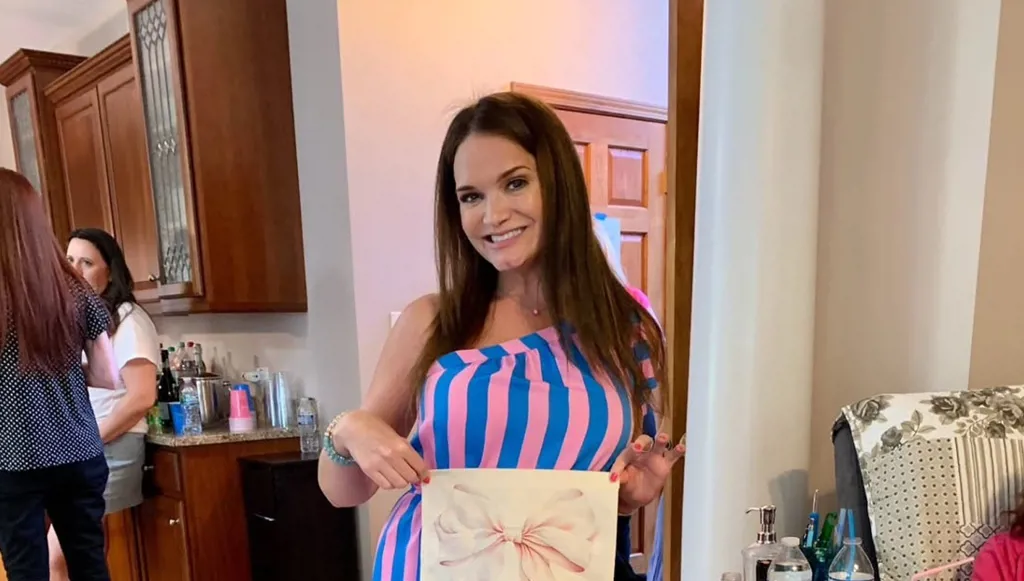

 تویتر
تویتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز



 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة








