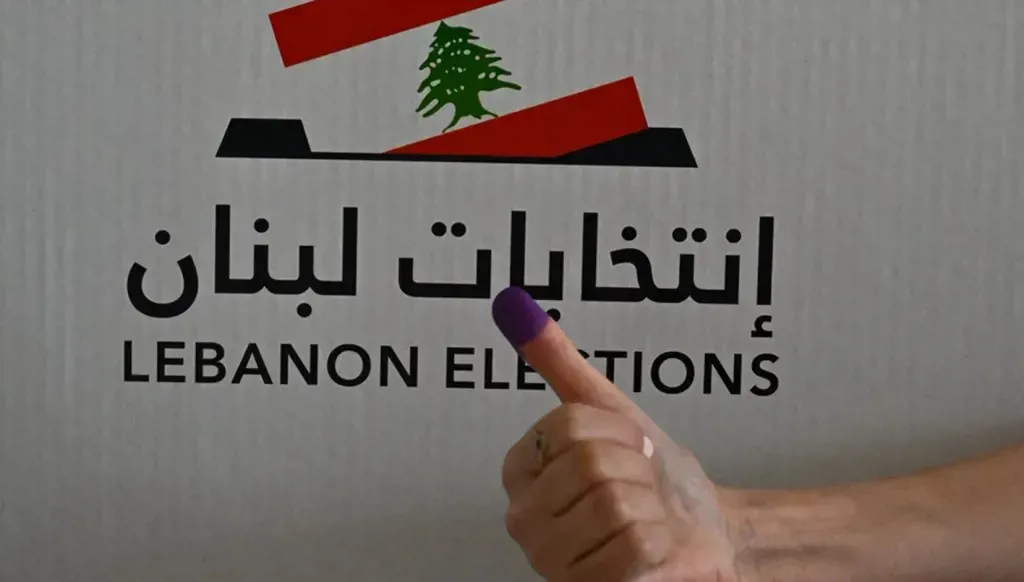حين تتحوّل الصحراء إلى مصدر دخل متجدّد: تجربة الإمارات نموذجاً

حتى الشمس الساطعة وجدت الإمارات طريقة لتحويلها إلى استثمار. اليوم تملأ الألواح الزرقاء أطراف الصحراء، فيما تعمل التوربينات بلا توقف. مشهد يلخّص مسيرة عقدين كرّست خلالهما الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً للطاقة المتجددة، باستثمارات تجاوزت 88 مليار دولار.
الأرقام حاضرة. يقول رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة "إكويتي" أحمد عزام لـ"النهار": بين 2003 ونهاية 2024 استقطب العالم العربي 360 مشروعاً أجنبياً في الطاقة المتجددة بكلفة تفوق 351 مليار دولار وخلق أكثر من 83 ألف وظيفة، بحسب تقرير مؤسسة "ضمان" 2025.
خمس دول فقط – الإمارات ومصر والمغرب وموريتانيا والأردن – اقتنصت 248 مشروعاً (69% من الإجمالي) بتمويل يناهز 291 مليار دولار (83%) وفرص عمل تقارب 68 ألفاً (82%). وعلى رأس القائمة تتقدّم الإمارات: 57 مشروعاً تشكّل 16% من المشاريع العربية، بكُلفة تتجاوز 88.5 مليار دولار (نحو ربع الكعكة) وأكثر من 16 ألف وظيفة. حتى على مستوى الشركات، تتصدّر "إنفينيتي باور" الإماراتية بكلفة تقديرية 34 مليار دولار – نحو 10% من الإجمالي.
ريادة لم تأتِ بالصدفة: العقد قبل الكيلوواط
يشرح عزام أن سرّ التفوّق مؤسّسي قبل أن يكون شمسياً. المستثمر في المتجدّدات لا يشتري فقط كهرباء؛ يشتري يقين التدفقات. الإمارات قدّمت هذا اليقين: مناقصات تنافسية وشفافة، عقود شراء طويلة الأجل مع جهات مشترية ذات ملاءة سيادية، إطار قانوني يسمح بالملكية الأجنبية والتحكيم الدولي، ومؤسسات قادرة على تحمّل المخاطر مبكراً مثل «مصدر» وشركاء صناديق سيادية.
حين تتكرّر السوابق – مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، «نور» أبوظبي، «الظفرة» – ينخفض سعر التمويل في المشروع التالي، ويصبح تسعير المخاطر جزءاً من العائد لا عذراً لتأجيل القرار.
ماذا ربحت الإمارات اقتصادياً؟
العائد ليس كيلوواط فحسب. سلسلة القيمة الممتدة من التصميم والتمويل إلى التشغيل والصيانة ولّدت آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، خفضت فاتورة الوقود، وحرّرت برميلاً إضافياً للتصدير. الصناعات كثيفة الاستهلاك – الألمنيوم، التحلية، مراكز البيانات – باتت ترى في الكيلوواط الأخضر ميزة تنافسية لا بند تكلفة.
النتيجة: تنويع فعلي في الدخل لا يعتمد على النفط، وتقلبات أقلّ في الموازنة العامة مع كل ميغاواط أخضر يدخل الشبكة.
فجوة عربية… مؤسسية لا جغرافية
الشمس واحدة، لكن المؤسسات مختلفة. تمركز 83% من التمويل في خمس دول يعني أن الفارق ليس في الإشعاع، بل في قوة المشتري ووضوح التعرفة واستقرار التشريعات وقدرة الشبكات.
حيث تغيب هذه الأربعة ترتفع كلفة رأس المال بعشرات النقاط الأساسية، فيتبخر العائد حتى لو كان المورد ممتازاً. وهنا تظهر قيمة المبادرات «البينية»: خمس دول – الإمارات والسعودية والبحرين والأردن ومصر – موّلت 90 مشروعاً عربياً-عربياً (ربع المشاريع الأجنبية) بكُلفة تقارب 113 مليار دولار (32%) وأوجدت نحو 22 ألف وظيفة.
هذا ليس كهرباء عابرة للحدود فقط؛ إنه سوق إقليمي يقلّل تقلبات الطلب ويزيد جدوى التخزين والربط.
إلى متى يستمر الزخم؟
على المدى المتوسط، يستند النموّ إلى خطوط أنابيب معلنة وشهيّة صناعية لطاقة نظيفة ورخيصة. على المدى الطويل، الامتحان سيُقاس بقدرة الشبكات على استيعاب حصص أعلى من المتجدّد دون «قصّ إنتاج»، وبسرعة نشر التخزين بالبطاريات والضخّ المائي، وإدارة الطلب عبر تعرفة مرِنة، وربط التحلية بالطاقة الخضراء.
يقول عزام: "إذا حافظت الإمارات على سرعة الإصلاح التنظيمي كما حافظت على سرعة البناء، فستبقى نقطة الارتكاز الإقليمية".

المخاطر… تُرى لتُدار
نعم، المخاطر حاضرة. صدمة معروض موضعية قد تضغط على العوائد إن تراكمت التسليمات في حيّ واحد قبل توسعة الشبكة؛ العلاج في جدول طرح يطابق نموّ الطلب الصناعي وتسريع استثمارات النقل والتوزيع.
سلاسل توريد الألواح والبطاريات تبقى رهينة الرسوم والشحن؛ الردّ في تنويع المورّدين وتشجيع تجميع وتصنيع جزئي محلي يخفض المخاطر. أما مخاطر التشغيل، فدواؤها معروف: إدارة مهنية، صيانة وقائية لا إسعافية، وعقود خدمة شفافة تُبقي العائد الحقيقي قريباً من المعلن.
ماذا تتعلّم بقيّة العواصم؟
الدروس واضحة لمن يريد اللحاق:
• تثبيت عقود شراء 20-25 سنة قابلة للتمويل مع آلية فهرسة واضحة.
• تقوية الجهة المشترية – مرحلياً بضمانات سيادية – لخفض كلفة التمويل.
• إطلاق سندات وصكوك خضراء محلية لتوطين رأس المال وتقليل الاعتماد على الخارج.
• الاستثمار في الربط البيني حتى تجد الكهرباء سوقها دائماً، وفي منصّات بيانات علنية تجعل القرار مستنداً إلى الأرقام لا الانطباعات.
لماذا تحافظ الإمارات على الصدارة؟
ويختم عزام بالقول لـ"النهار": "ما يميّز التجربة الإماراتية ليس وفرة الشمس فقط، بل قدرتها على تحويل المورد الطبيعي إلى ثقة مؤسساتية. المستثمر في النهاية يضع أمواله حيث يجد الشفافية والالتزام، وهذا ما أثبتته الإمارات في العقدين الماضيين".
ويضيف: "إذا أردنا أن نقرأ المشهد بموضوعية، نرى أن الإمارات لم تتعامل مع الطاقة المتجددة كملف بيئي أو كمالي، بل كخيار استراتيجي متكامل. مناقصاتها التنافسية ومشاريعها الضخمة لم تفتح شهية التمويل العالمي فقط، بل رسمت معايير جديدة للمنطقة بكاملها".
أما عن المستقبل، فيرى عزام أن الرهان الأكبر سيكون على قدرة الدولة على إدارة "المرحلة الثانية"، أي ما بعد التوسّع في التوليد. "المعادلة المقبلة ليست بعدد الألواح أو حجم التوربينات، بل بمدى قدرة الشبكات على الاستيعاب، ومرونة التعرفة، وحلول التخزين التي تمنع هدر الإنتاج. هنا تتمايز الدول التي تحوّل الميغاواط إلى قيمة مضافة فعلية، عن تلك التي تكتفي بالاحتفال بالافتتاحات".
ويؤكد أنّ الإمارات بفضل بنيتها المؤسسية الراسخة، وشهيّة سوقها الصناعي، وموقعها كبوابة إقليمية، مرشّحة لتبقى لاعباً محورياً لعقدين آخرين على الأقل. "هذه ليست قصة محطات شمسية متفرّقة، بل قصة عقد اجتماعي-اقتصادي جديد بين الدولة والمستثمر والمجتمع"، يقول.
ويختم: "حين تنجح دولة في تحويل الصحراء إلى مصدر دخل متجدّد، فهي لا تكتب معادلة طاقة فقط، بل تكتب معادلة ثقة. وهذا بالضبط ما جعل الإمارات تتقدّم الصفوف".












 تویتر
تویتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز




 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة