نهاية "نيو ستارت"... هل المخاوف مبررة؟

مفارقة لافتة في "نيو ستارت" أو "ستارت الجديدة".
حين وقّعها الرئيسان السابقان باراك أوباما ودميتري مدفيديف سنة 2010، كانت أميركا ومعها الغرب يعتقدان أن روسيا راغبة بالتقرب منهما. لم يحُل الغزو الروسي لبعض مناطق جورجيا سنة 2008 دون سريان هذا الاعتقاد.
اليوم، وبشكل مشابه، يعتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لديه علاقة مميزة مع الروس تسمح له بتحقيق بعض المكاسب المشتركة معهم. لم يكن التفاوض على "نيو ستارت" محدّثة واحداً منها. وليس أن ترامب حاول ذلك بشكل حثيث.
حين سئل الشهر الماضي عن نهاية "نيو ستارت" في 5 شباط/فبراير الحالي، أجاب ترامب: "إذا انتهت صلاحيتها، فستكون صلاحيتها قد انتهت. سنصنع اتفاقاً أفضل". المرة الأخيرة التي وعد فيها بصفقة أفضل كانت حين خرج من الاتفاق النووي مع إيران.
بين الطموح والعوائق
في جانب معيّن، يمكن ملاحظة نفور ترامب من القيود التي تكبّل طموحاته. وضعت "نيو ستارت" سقفاً على نشر الرؤوس النووية الاستراتيجية عند 1550، وعلى عدد منصات إطلاق الصواريخ الباليستية المنشورة وغير المنشورة (800) وعلى عدد الصواريخ والقاذفات المنشورة (700). كذلك، سمحت المعاهدة بمراقبة للالتزامات عبر الأقمار الاصطناعية وعبر التدقيق الميداني والذي يشمل حتى نقل الرؤوس إلى منشآت الصيانة.
وسبق أن خرج ترامب في ولايته الأولى من معاهدتي "القوى النووية المتوسطة المدى" و"السماوات المفتوحة". في الحالتين، اتهمت واشنطن موسكو بخرق التزاماتها، علماً أن الولايات المتحدة استفادت أكثر من روسيا بموجب "معاهدة السماوات المفتوحة". مع ذلك، برز أول قلق من انتهاك موسكو لواجباتها في ولاية أوباما الثانية.
كانت "نيو ستارت" ستنتهي اليوم في جميع الأحوال، لأنها كانت قابلة للتجديد مرة واحدة، وهذا ما حصل سنة 2021. اقترح بوتين في أيلول/سبتمبر الماضي تمديد الاتفاقية لعام إضافي، وهو مقترح قوبل بإيجابية من ترامب، لكنها لم تُترجَم عملياً.

ربما ساهمت خشية ترامب من اتهامه بـ"استرضاء" روسيا لاتفاق جديد في عدم إطلاق مفاوضات ذات صلة. علّقت روسيا مشاركتها في المعاهدة سنة 2023 لأن الولايات المتحدة دعمت أوكرانيا. إذاً، ليس فصل الملفّين سهلاً. ثم هناك تفضيل ترامب لإشراك الصين في المفاوضات الجديدة، وهو أمر ترفضه بكين لأن الترسانات الثلاث غير متوازنة.
سباق نووي جديد؟
ينتشر خوف جدي من هكذا سباق. لكن التفاصيل مهمة. فحتى من دون ضوابط واضحة على نشر الرؤوس النووية الاستراتيجية، ثمة محاذير لانخراط الدولتين في هذا الجهد. أولاً، تبقى الدولتان ملزمتين بمعاهدة عدم الانتشار النووي (1968)، وإن كانت أقل تكبيلاً من المعاهدة المنتهية الصلاحية. لكن تآكل الثقة بين الطرفين لفترة طويلة قد ينعكس سلباً على المعاهدة الأساسية.
ثانياً، لا تبدو زيادة كبيرة في أعداد الرؤوس النووية مفيدة استراتيجياً. يكفي أن تمتلك الدول "قوة نووية متبقية" لتحقيق الكثير من إمكانات الردع. بالتالي، لن يكون تطوير الأسلحة النووية، بدءاً بالأبحاث مروراً بالبنية التحتية وصولاً إلى أنظمة التسليم والرؤوس، مستحقاً للتكاليف. والإنفاق الدفاعي النسبي لروسيا والولايات المتحدة أقل حالياً بكثير (بالنصف كمعدل عام) مما كان عليه خلال الحرب الباردة. وأظهر تقييم حديث (2025) لوزارة الخارجية الأميركية أن روسيا لم تنتهك "نيو ستارت" بعد تعليق العمل بها. ثالثاً، وكما يشير تقرير في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، يبقى حظر الانتشار ذا طابع دوري، بمعنى أن المعاهدات ذات الصلة ليست متتالية بل تُبرم ضمن موجات، كما حصل خلال الحرب الباردة. إذاً، وفي الصورة العامة، إن المخاوف من انفلاش سباق تسلح في المدى القريب مبالغ به.
مع ذلك، كان العالم بحاجة إلى الانتقال من الحظر النووي الاستراتيجي إلى الحظر التكتيكي، لكنه انتهى عند فجوة خطرة. فبغياب "نيو ستارت" محدّثة، يتلاشى تدريجياً إطارٌ ثنائيّ من الاستقرار والشفافية وقابلية التنبؤ بين القطبين. بكلمات أخرى، لا يمكن الاستهانة بآثار اللايقين بين أكبر ترسانتين نوويتين حول العالم.



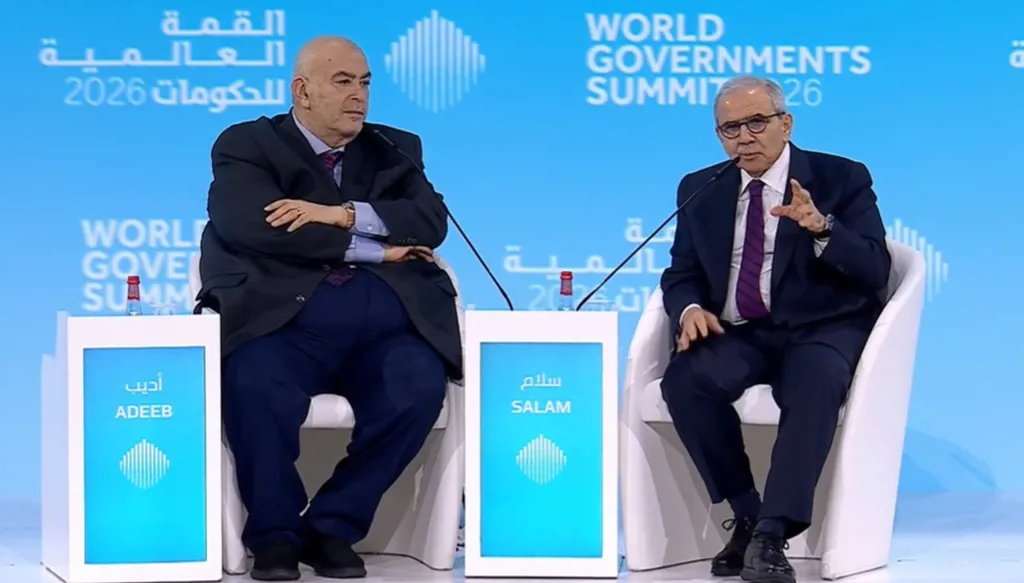








 تویتر
تویتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز



 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة










