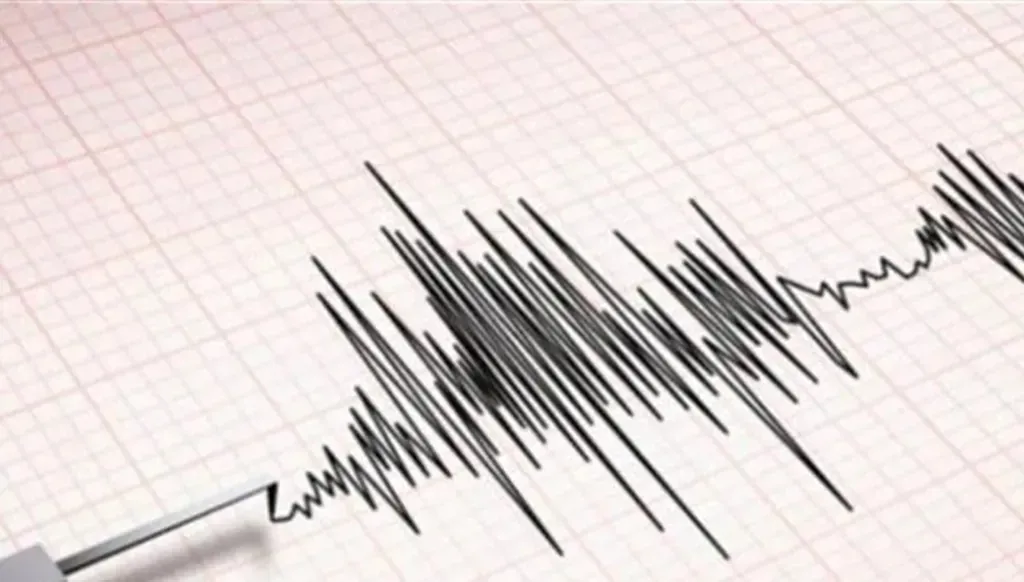التكاذب الثقافي: حفلة فولكلورية متواصلة من البث المباشر

غسان مراد
يكشفُ رصدُ الظواهر الأخيرة في بعض الأوساط الثقافية، وبين المعتبرين أنفسهم من المثقفين، أو مَن سمحت لهم الظروف في الواقع الفعلي والرقمي أن يُدرَجوا تحت هذا المسمى، عن تنامٍ ملحوظٍ لمناخ من الزيف البينيّ والتناقض الأخلاقي، حيث يتحول الفضاء العام إلى مسرح للمجاملات الاحتفالية التي تُخفي خلف كواليسها تنافساً محتدماً على مساحات الظهور، في انفصالٍ تام عن جوهر المشاريع الفكرية الأصيلة.
وانطلاقاً من ذلك، تُطرح بعض التساؤلات: هل هذا السلوك ناتج عن انعكاس جذري لضغوط تتعلق بالحفاظ على الصورة أمام الناس، أم بالخوف من التهميش في مشهد يضيق بفرص الحضور؟ أسئلة تُطرح عندما يصبح التكاذب البنيوي شرطًا للبقاء، لا خيارًا فرديًا؛ وهذا ما أعتقد أنه سيؤدي إلى إفراغ الثقافة من صدقيتها، وستتحول بالتالي إلى لعبة مصالح رمزية واستعراضات رقمية. ففي هذا المشهد المُهيمن عليه من ثقافة التمظهر وهاجس "التريند"، لم يعد لأي فعالية ثقافية قيمة بذاتها، بل أصبحت الصورة هي الأساس، إذ تُنشر مسبقًا قبل التفوه بأيّ كلمة!
إذن، عبر التاريخ الحديث، وفي بلد مثل لبنان، الذي كان يعتبر فضاء ملائماً لحرية الفكر العربي، ويشبه مختبراً للتجارب النقدية ومركزًا للنهضة والحوار الثقافي، يعيش اليوم تغيرات ثقافية جذرية تثير الريبة والقلق. فالانهيارات الاقتصادية والسياسية، وهيمنة الفضاء الرقمي، حوّلت الثقافة إلى "بازار" تحكمه الخوارزميات، حيث لا مكان للفكرة إلا تلك القابلة للتسويق على شكل صورة مرت على "الفوتوشوب" لتجميلها، أو على شكل منشور مثير يجمع ما بين السخافة والتفاهة. ففي هذا المشهد، تبرز ظاهرة التكاذب الثقافي كأحد أخطر أعراض الأزمة. تكاذب يأتي على شكل مجاملات علنية وافتراضية مكثفة، لا تخفي خلافات على مصالح مادية، إنما تكشف عن غيرة دفينة وتنافس على المكانة الرمزية بين من يحسبون أنفسهم على الوسط الثقافي، حيث يسعى كل واحد لتأكيد حضوره في فضاء شكلي خالٍ من الأفكار الفعلية. مشهد كأنه مسرحية عبثية في أحد شوارع المدينة، المغطاة بالنفايات المتروكة على الرصيف بعد الفرز الممنهج من مافيات "النبش"، حيث الجميع يصفّق للجميع، بمن فيهم أصحاب الكلاب، أثرياء الوجاهة الزائفة، الذين يتركون نفايات كلابهم على قارعة الطريق! إذن، الجميع يهنئ الجميع بالقبل الفرنسية والاحتضان، بينما كل واحد يضمر أمنية سقوط الآخر من على خشبة الشهرة، بانتظار الوقت المناسب لتفريغ كلمات التشهير الدفينة في الشق الأيسر من دماغه المتجمد الشمالي! (اللغة تقع في الشق الأيسر من الدماغ)
في ظل كل هذا، هل ما زال للمثقف دور حقيقي أم تلاشى لصالح الاستعراض؟
الملاحظ في الواقع أن المثقف، الذي يحمل مشروعاً فكرياً، بات مهمّشاً أمام منطق الخوارزميات والحائط الرقمي؛ ففي زمن التمظهر الثقافي، صارت القيمة الفعلية تُقاس بالظهور (الـ "M'as-tu-vu" حسب بورديو) لا بالإنتاج المعرفي. ومع ذلك، لا يزال يلوحُ هامش ضيق للدور النقدي، لكنه مرتهنٌ بصعوبة إعادة تعريف الأدوات والانخراط الواعي في الفضاء الرقمي من دون السقوط في فخ التفاهة. لكن هذا الهامش يتقلص كلما ارتفعت أصوات الضجيج الافتراضي، وكلما تحوّل المثقف إلى مؤثّر يلهث وراء "الترند" بدلاً من أن يلهث وراء الفكرة. ففي زمن صار فيه الوعي رفاهية، والمعلومة سلعة، يصبح المثقف الحقيقي أشبه بكائن منقرض، يكتب نصوصاً لا يقرأها أحد، بينما يربح الآخرون ملايين المشاهدات من فيديوات يسيطر عليها اللغو. لقد بتنا حقاً في مرحلة إنتاج "اللامعنى" لكلماتٍ كان لها يوماً ما معنى!
التكاذب ليس مجرد نفاق اجتماعي، بل يتجلى كاستراتيجية بقاء في بيئة مأزومة ومهزوزة، تتأرجح في زواريب المدينة الواقعية والافتراضية. هذه البيئة التي يُعبر عنها بخطابات علنية تمجّد الهمّ الثقافي، يقابلها سلوك خفيّ مبنيّ على الإقصاء والغيرة. لذلك، في زمن الشحّ الثقافي، يصبح التكاذب وسيلة لحجز مكان في المشهد، ولو على حساب القيم المعرفية التي كانت معيارًا للمصداقية الفكرية. ومن الممكن الاعتبار أن انهيار المؤسسات الثقافية أدى إلى بروز الفردانية، كما أن الأزمة الاقتصادية دفعت المثقف إلى الركض وراء أي فرصة للظهور، فيما غياب السياسات الثقافية ترك المشهد للفوضى. فهل تؤدي حالة الإحباط وفقدان الأمل إلى لجوء المثقف إلى ممارسة التكاذب كآلية دفاعية عن الذات، مما يتيح للنرجسية الثقافية تغذية المجاملات المصلحية؟ وهل الخوف من التهميش يؤدي إلى أن يصبح البقاء في الضوء هدفًا بحد ذاته؟
هذه المشهدية ليست بعيدة عن الإعلام الرقمي، وشبكات التواصل الاجتماعي، الذي تحول من أداة تنويرية إلى آلة لتجهيل الشعوب. فالإعلام بدوره لم يكتفِ بنقل الواقع، بل صار يصنع الوهم ويبيعه في قوالب براقة تخفي خواء المضمون خلف لمعان الصورة.
بموازاة ذلك، فإن خوارزميات التصفية تفضل الجدل الفارغ على النقاش العميق. يكفي الولوج إلى بعض المنشورات لنلاحظ كيف أن التفاهة تُكافأ بملايين المشاهدات، فيما بعض المنشورات المُعبرة الطارحة لمواضيع فكرية تقبع في زوايا مظلمة خلف الحائط الرقمي.
من منظور آخر، فإن ممارسة ثقافة التجهيل ليست صدفة، بل تأتي عمداً، لأن إدارة الجهل أسهل من إدارة الوعي على عكس ما يُعتقد. فمن يتلهى بالترفيه الرخيص لن يشكّل خطراً مثل المواطن المسلح بالفكر النقدي. ففي حقبة الضجيج الوبائي، تتحول القضايا الثقافية الكبرى إلى عناوين مثيرة، أما الواقع الفعلي فسيدفن تحت ركام من الصور والفيديوات المصطنعة. هذا الإعلام لم يعد يكتفي بتسويق التفاهة، بل أصبح صانعها باستمرار ويعيد إنتاجها، إلى أن أصبح المثقف الحقيقي، مشرداً في الفضاء الرقمي الذي يُقدّس عدد "الليكات" المبعثرة يميناً وشمالاً، كغبار على أطراف الشاشة، والمزينة بأكسسوارات تتلألأ كفقاعات أرجوانية تتصاعد من الأعماق، لتتناثر بخفة على السطح، تحمل بريقًا بلا جوهر. لذا، عندما يصبح الجهل صناعة، يغدو الوعي لاجئًا في موطنه.
هكذا إذن تبرز أشكال التكاذب في المجاملات الافتراضية لتخفي بعض الخصومات العقيمة، التي تتجلى في تحالفات المصلحة القصيرة، وفي سفسطائية الخطاب. ترفع علناً شعار التضامن، وتخفي التناحر في الخفاء. فأنطونيو غرامشي في كتاباته عن الثقافة والهيمنة، يعتبر أن المثقف العضوي هو الذي يحمل مشروعاً تغييرياً، ومرتبط عضوياً بطبقة اجتماعية، ويعمل على التعبير عن مصالحها وتطوير وعيها، وليس منعزلًا عن الواقع. لكن المشهد الحالي انحرف عن النموذج الغرامشي، وانفصل عن القضايا الفعلية، منشغلًا بحائطه الرقمي. أما المفكّر الفرنسي "غي ديبور"، صاحب كتاب «مجتمع الاستعراض»، فيبيّن كيف أن الحياة تتحول إلى صور، وأن القيمة تُقاس بالظهور لا بالجوهر. فالاستعراض بالنسبة له ليس مجرد عرض بصري، بل نظام اجتماعي واقتصادي يجعل كل شيء سلعة، حتى العلاقات والأفكار. وفي هذه الصورة، فإن الإنسان يعيش في عالم من التمثلات الذهنية، تحتلّ الصورة مكان الواقع، لتصبح أهم من الحقيقة نفسها. وبذا، فإن الإعلام الرقمي جعل الثقافة جزءًا من هذا الاستعراض، والمثقف قدم نفسه كـ"براند"، فيما التكاذب أصبح أداة لتلميع الصورة في فضاء تحكمه الخوارزميات.
السؤال ليس محلياً فقط، بل عالمي الطرح. هل للمثقف دور في صياغة التحولات، أم أن الهدف في مكان آخر، في اللا هدف؟ فما نشهده في الواقع يبين لنا تراجع تأثير المثقف أمام هيمنة ثقافة الإعلام الرقمي ومنطق السوق. ولكن ما زال البعد الوظيفي ممكناً من خلال الانفتاح على دور نقدي، من خلال بناء شبكات معرفية عابرة للحدود والانخراط في القضايا العالمية بمنطق مغاير يتناسب مع التغيرات والتحولات الاجتماعية. ويتضح مما سبق أن التكاذب الثقافي ليس تفصيلاً عابراً في المشهد العام، إنما هو انعكاس لأزمة عميقة في البنية الثقافية في بعض الأوساط، وتكشف عن خلل بنيوي يتجاوز المظاهر إلى جوهر الخطاب والممارسة. بذلك، إن مواجهة ظاهرة التكاذب الممنهجة، بحاجة إلى إعادة بناء المؤسسات أولاً، وترسيخ القيم الفكرية ثانياً، وتطوير استراتيجيات تدافع عن الجوهر أمام منطق التسليع، كي لا يتحول المشهد الثقافي إلى مسرح دائم للتهريج، لا تحتوي خشبته إلا على كلمات جوفاء لا تصلح لأي مشروع.
في المحصلة، عندما تصبح الكلمة أداة تخدير للعقول، والمثقف مجرداً من أي تأثير سوى بيع الوهم في بث مباشر، لا يبقى للوعي سوى خيار واحد، أن يختفي في كتاب لن يقرأ، متروكاً على سطح خزانة في بيت مهجور. ففي زمن التفاهة، لا يُنتظر من الثقافة إنقاذ البشرية، بل عليها إنقاذ ذاتها من الغرق في هذا الضجيج المباح. فصناعة الجهل هي صناعة لمفاتيح السلطة. فما نشهده يشبه حفلة فولكلورية من التكاذب المتبادل، وأصوات متشظية لكلمات خارج الواقع، وتتزاحم بهدف وحيد، هو أن تبدو عميقة!
وبما أننا في زمن ثقافة التهجين السيبراني والسيبورغي والجنس الثالث والسيليكونات التقنية والعضوية، بات مصطلح مثقف يرعب أحياناً ويسبب وخزات اعتباطية في بعض الأماكن الجسدية! لذلك فإن هذه السطور هي تشريح لما يجول في الخاطر لواقع مأزوم، ومجرد ملاحظات وانطباعات تُلاحظ في المشهد الثقافي، طرحها يعتبر محاولة لفهم بعض الظواهر المتكررة، من دون إصدار أي أحكام قاطعة، فالمعرفة لتصبح "معرفة" من الأفضل أن لا تكون مطلقة.





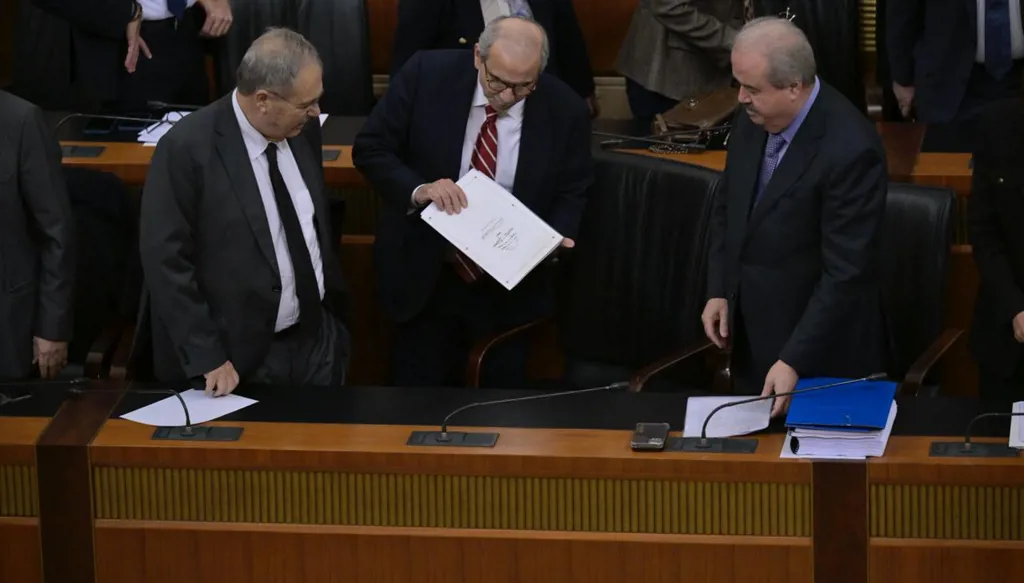






 تویتر
تویتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز



 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة