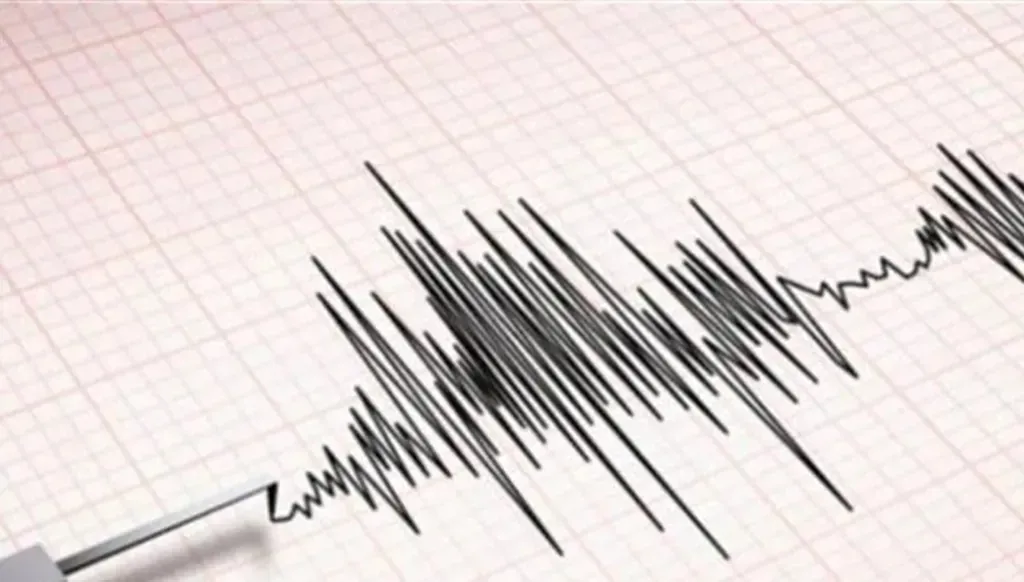"لا أرض أخرى" الفائز بالـ"أوسكار": الضحية فلسطيني والبطل إسرائيلي

بعد نيله "أوسكار" أفضل وثائقي، ها ان الناس يلتفتون إلى "لا أرض أخرى" للفلسطيني باسل عدرا والإسرائيلي يوفال أبراهام، المصنوع بجهد مشترك، رغم انه كان عُرض قبل عام في مهرجان برلين السينمائي حيث فاز بالجائزة نفسها، محدثاً جدالاً في حفل الختام. بعيداً من كلّ المهاترات حوله، يصح القول ان هذا الفيلم الوثائقي، لا يختلف شكلاً ومضموناً، عن غيره من الأعمال التي تضع داود أمام جالوت، سوى في حقيقة انه يعمل على تدويل حكاية قرية صغيرة اسمها مسافر يطا وينقل معاناتها إلى العالم ”الحر".
لا توجد في الفيلم صورة أو كلمة، لم توظّفها السينما الوثائقية الفلسطينية منذ تأسيسها، ولم تلكها الألسنة في نشرات الأخبار عند تناولها بقعة جغرافية ترزح تحت العنف منذ عقود. لكن، كما يُقال، فالشيطان يكمن في التفاصيل، وهنا شياطين كثر وتفاصيل أكثر؛ لقطة من هنا وأخرى من هناك، وها اننا أمام قراءة مغايرة للواقع كما يراه شاب يعيش تجربة المصوِّر والمصوَّر في الحين نفسه.
انها قصّة قرية، قصّة صداقة، قصّة "قوة"، كما يقول باسل عدرا الذي يمسك من أيدينا إلى عالم يحكمه منطق القوة ويميزه مبدأ الفصل، حيث الحقّ يؤخذ بالقوة، وما يصح على إنسان لا يصح على إنسان آخر. ينسحب ذلك حتى على الحركة داخل الكادر، فلا يتحرك الفلسطينيون كما يتحرك الإسرائيليون وهم لديهم كامل الحرية في التنقّل والانتشار، في حين أن تواتر الحياة عند أصحاب الأرض يجعل تلك الحياة مشلولة وحركتهم مقيدة، تخضع لعامل الانتظار والترقب.
 الجرافة الحاضرة دوماً.
الجرافة الحاضرة دوماً.
باسل ويوفال أنجزا معاً هذا الفيلم الذي يتحدّث عن القرية التي تهدم إسرائيل بيوت سكّانها لإنشاء معسكرات تدريب. باسل من مسافر يطا، ويوفال من بئر السبع ويعمل صحافياً بعدما رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية. يوفال يملك الخيار(ات)، باسل لا. ينتصر يوفال للضعيف والمظلوم انطلاقاً ممّا يمليه عليه ضميره، فيما باسل فتح عينيه على التصدّي إلى ما يعيشه هو وأهله. فهذا الشيء معشّش في داخله نوعاً ما، منذ الخامسة عندما رأى الجنود يعتقلون والده. صحيح ان القضية قضية باسل في الدرجة الأولى، لكن يوفال يحوّلها إلى قضية عامة ملك الجميع، ولذلك هو البطل الحقيقي للفيلم. أضف إلى انه كان يمكن ان يكون في صفّ الظالم (أو أقله في صفوف اللامبالين)، لكن قرر ان يكون الشاهد والمبادر، رغم معرفته المسبقة ان تأثيره محدود، اذ يقول في أحد المشاهد رداً على سؤال ان قلّة تهتم بتقاريره. حتى انه لا يفهم كيف ان باسل يفكّر في الهجرة. ويأتي ذلك من كونه مناضلاً لديه الترف ان يكون مناضلاً بدوام جزئي.
هذه الصداقة بينهما التي تتطور في أسوأ الظروف، هي فرصة لنرى الزاوية التي ينظر كلّ منهما إلى الواقع وكيفية تعاطيهما معه. نكتشف الفرق بين مَن يستطيع العودة إلى منزله بعد يوم نضال طويل، ومَن يعيش في النضال 24/24. ومع ذلك، يبقى المخيّر هو البطل الحقيقي. انه الذي سيُقال له "أنتم تدمّرون ما نبنيه"، في ربط بين الشخص والجماعة، ومع ذلك لن يحرك ساكناً. في المقابل، يستغرب باسل اندفاع يوفال، فهو كأي ناشط يعتقد ان حضوره سيحدث كلّ الفرق، وان صراع قابض على الأرواح منذ عقود سينتهي مع مشاركة بعض المقاطع على وسائط التواصل. لكن، دعنا لا نتوهّم. فيوفال يفعل ما يفعله لنفسه أولاً: "حرية الآخرين" يقول، "ستجعلني أكثر أماناً“.
 "أنتم تدمّرون ما نبنيه".
"أنتم تدمّرون ما نبنيه".
يخرج باسل من عتمة الليل، مستحوذاً على أولى لقطات الفيلم. بصوت محتضر يروي الأحداث. وكأنه ميت مع وقف التنفيذ، كلّ ما سيلي بعد مشهد الافتتاحية يؤكّد ذلك. انه ابن عائلة من النشطاء، وعليه ان يحذو حذوهم. تشرّبه مع الحليب. مصيره مكتوب سلفاً. عالمه مكون من مواجهات مع الجيش الإسرائيلي؛ مصادرات واعتقال وهدم. لا شيء آخر. مسافر يطا قرية من دون جماليات بالمعنى المتعارف عليه. جدران البيوت غير مورّقة. عبارة عن كومة حجارة. قطعة أرض توحي بالبؤس والفراغ. لكنه المكان الذي كبر فيه وارتبط به. "20 قرية جنباً إلى جنب في جبال الضفّة الغربية"، هكذا يموضع نفسه داخل الجغرافيا. على مستوى الحضور على الشاشة، مشكلة باسل هي في ثقل ظلّه واستعراضيته. يضع نفسه في الصدارة، أما كلّ الآخرين فيتحلّقون حوله، دون ان يبدي أي اهتمام بالحفر في أعماقهم. إنهم أدوات تخدم سرديته.
لعبة قط وفأر بين الظالم والمظلوم، واصرار على الحياة من جهة، مع تعنّت على تدميرها من جهة أخرى، هذا هو "لا أرض أخرى". وكما في فيلم "خمس كاميرات محطّمة" (فيلم إخراج فلسطيني - إسرائيلي آخر وصل إلى الـ"أوسكار")، كلّ شيء في الفيلم يتعلّق بالتصوير والتوثيق ووجهة النظر. آلة التسجيل تتماهى مع "أعين العالم الحر"، كأن لا حقيقة من دونها. فالكلام لا شيء، اذا لم يكن مدعوماً بالدليل البصري وموثّقاً بصراخ نساء وأطفال وشيوخ يحتجّون ويعترضون مراراً على إجراءات هدم البيوت واخلاء سكّانها. وكما في العديد من هذه الأفلام، الجرافة متأهّبة. تقتلع، تسحق، تجرف، تساوي الذكريات بالأرض، تجسّد البطش وفرط القوة.
أهمية "لا أرض أخرى"، أنه ليس فيلماً تبسيطياً يدلي بما هو متداول ومعروف في هذا الشأن، بل يرفع الخطاب إلى مستوى أعلى قليلاً. في أحد المَشاهد، نفهم من خلال التعليق الصوتي، ان أهل القرية قرروا قبل سنوات الوقوف مع أي جهة تنتصر لقضيتهم بصرف النظر عن هويتها. الأمر الذي لن يفهمه حراس القضية، من كتبة بيانات مكتب مقاطعة إسرائيل الذين لمّحوا أننا أمام حالة من حالات التطبيع. لن يفهموه لأنهم لم يُتركوا وحدهم في مواجهة البطش، كما هي حال أهل مسافر يطا.
 التورط في الهم الفلسطيني.
التورط في الهم الفلسطيني.
جمالياً، مقابل المَشاهد واللقطات العشوائية المصوَّرة بكاميرا مهزوزة التي فرضتها ضرورات التوثيق وجمع الأدلّة، نجد سيلاً من المَشاهد المنمّقة التي تحسب حسابات الكادر والتكوين والعمق، وهذه مشكلة في ذاتها، لأنها تساهم في جعل الخيوط ظاهرة. لكن للانصاف، العديد من الأفلام الوثائقية خلال السنوات الأخيرة أصبحت تأتي على هذا الشكل، وهي في طور التحوّل إلى "مدرسة" جديدة. لكن مع باسل عدرا ويوفال أبراهام، نشعر بالمزيد من الافتعال، وهذا كله يضع المصداقية على المحك. فمثلاً، اللقاء الأول بينهما، يجري قبالة الكاميرا، وكأننا في مشهد ينتمي إلى السينما الروائية على مستوى الإخراج وتنظيم المساحة وحركة الكاميرا التي تنتظر ما سيحدث بدلاً من ان تبحث عنه. مَشاهد أخرى، كسيارة تركن عند المحطّة لتزوّد الوقود، لا تساهم الا في تعزيز الإحساس بالزيف. وهذا كله يأتي في سيرورة مونتاجية تفشل في صناعة وحدة إيقاعية، ذلك ان هناك على الدوام فيلماً ينتهي وآخر يبدأ.
تغيب عن الفيلم الأشعار والأدبيات النضالية الخاصة بالعديد من الأفلام الفلسطينية، فهو ينطلق من الشخصي إلى العام، وكلما أصبحت التجربة معيشة تراجع مستوى الكلام العام. فالأشياء هنا لها مسمّياتها الواضحة، لا تُلفَظ كلمة قضية ولو مرة واحدة. اذا تحدّث الفيلم عن شيء، أظهره أو أشير اليه بطريقة ما. لسنا في القبضات المرفوعة، وما تحمله عادةً ثقافة الإنشاء العربية على راحاتها.
لعل ما يلطّف الفيلم ويقربه من الواقع اليومي، هو تراكم اللحظات العادية، وإن جاءت من داخل كهف أو من تحت خيمة، فالناس تنصرف إلى شؤونها، لتعود وتكافح عندما تدق الساعة. والفيلم، لأنه يحمل توقيع شخص يعرف عمّا يتحدّث، فيكرر لحظات الفراغ تلك، حيث الجالسان يستمتعان بنرجيلة أو بكوب من الشاي، ممّا يحملنا إلى الحديث عن أريحية العلاقات، رغم كلّ شيء. وهذا لا يمدّ الفيلم بخفّة، بل يدعمه. اللقاءات المتكررة بين باسل ويوفال، على ما تحمل من افتعال، تؤسس لشيء أصبح أكثر إلحاحاً بعد 7 أكتوبر.
 لحظات عادية في سياق متوتر.
لحظات عادية في سياق متوتر.
كالعادة في هذا النوع من الأفلام، ثمّة ضبابية، أغلب الظن انها ستتبدّد مع التجارب التالية للمخرجيَن. هذه الضبابية تشمل مسؤولية كلّ مخرج ومدى مساهمته في الفيلم، خصوصاً أننا في زمن نعلم كيف تُصنع فيه الوثائقيات ووفق أي آليات وأي سياسات، ولا سيما انها تأتي تحت رعاية جهات إنتاجية تحرص على الضبط والتحكّم بكل شاردة وواردة.
اذا أخذنا الفيلم بحذافيره التقنية، فقد يسقط في امتحان معاهد السينما. لكن لحسن الحظ ان لا مقاييس صارمة تتحكّم بالفنّ. فهناك الروحية والأجواء والقدرة على التقاط كلّ هذا بلغة الصورة… هذه أشياء يصعب أحياناً على كبار المخرجين الحصول عليها. فما بالك بتلك القدرة على ربط قصّتك الشخصية بقصص الآخرين حول العالم، وهذا ما تفشل فيه حتى أكبر الامكانات الهوليوودية في بعض الأحيان.
أغلب الظن ان الـ"أوسكار" التي نالها الفيلم هي تتويج لجهد ومعاناة وشجاعة، لا تكريماً لموهبة سينمائية هي في الأصل محدودة. ولا يمكن فصل هذا كله عن الأمل الذي يبثّه الفيلم رغم كلّ شيء، وهذا موضوع يجمع أكثر ممّا يفرّق. الأمل في ان يكون هناك في يوم من الأيام حل لقضية، وسيكون الحلّ عبر الحوار والتلاقي.
باسل عدرا دفع أحياناً بجسده النحيل ثمن اللقطة التي تدين ظالمه. ارتمى أرضاً تحت أقدام العسكر غير خائف من سلاحهم. وبجسده نال الجائزة الأميركية، فالعالم أكثر تطلّباً مع هؤلاء، والالتفات في اتجاههم له شروط أقسى تصل إلى حد ”مطالبتهم“ بالاستثمار في الذات. وان ينال الـ"أوسكار" التي حُرم منها سينمائيون عرب وغير عرب أرفع شأناً، فهذا يعني ان العالم يريد من هؤلاء خطوات أبعد من مجرد فيلم جيد.





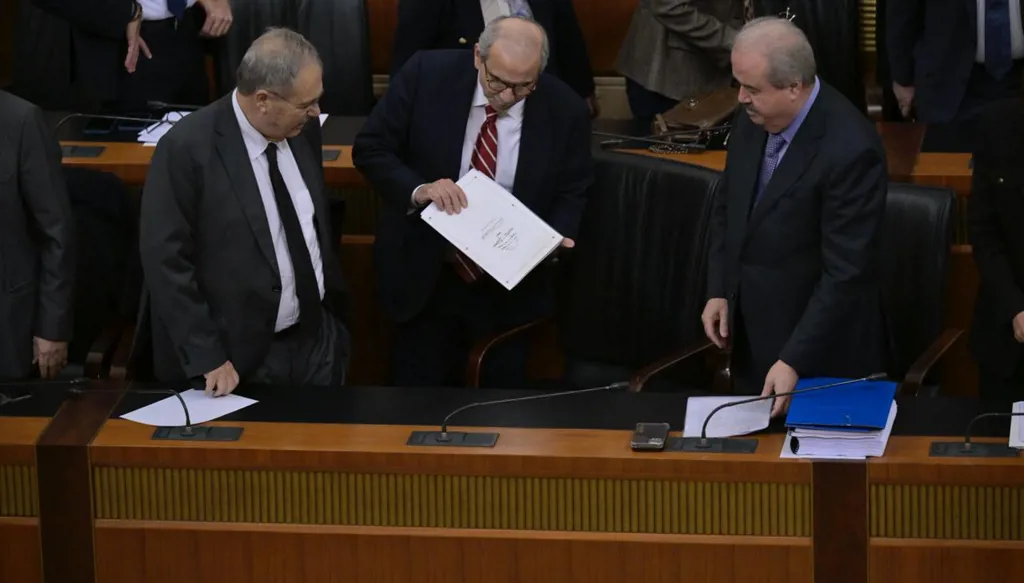






 تویتر
تویتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز



 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة