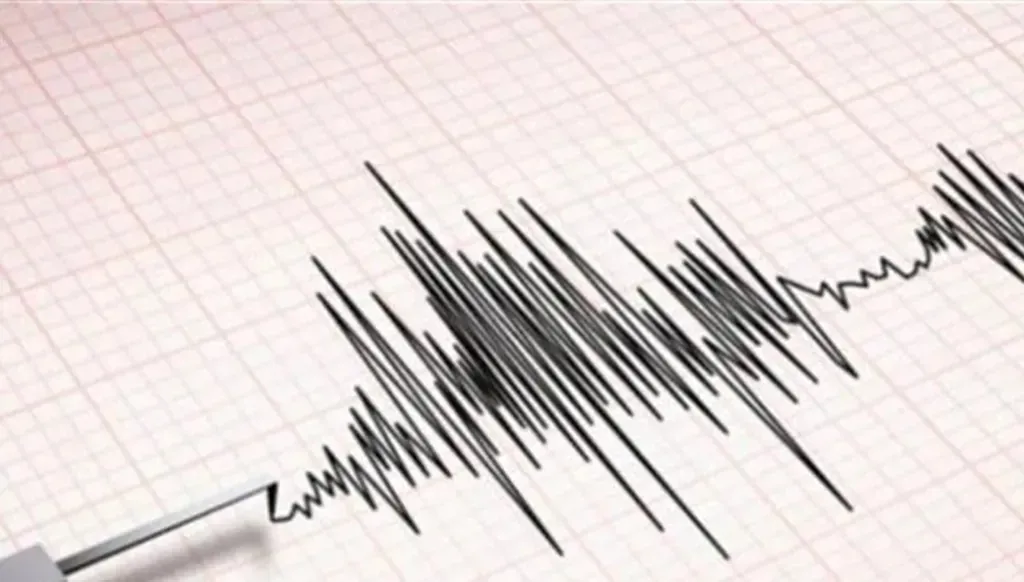فيلم لا يشبه أي فيلم آخر شاهدناه، هبط علينا أو أُلقي أمامنا في اليوم الثالث من مهرجان برلين السينمائي (13 - 23 شباط). لم يتوقّع أحد ان المفاجأة الكبرى سيحقّقها فيلم غامض، ربما لو شارك في أقسام أخرى لما اهتم به أحد. هذا الفيلم جعل كلّ ما سواه يبدو بلا روح، باهتاً ومكرراً وتقليدياً. أتحدّث عن "انعكاس في ألماسة ميتة" (مسابقة) للفرنسيين المقيمين في بلجيكا إيلين كاتيه وبرونو فورزاني اللذين ينجزان فيلمها الرابع كثنائي. من الجنريك إلى الجنريك، يستحيل ابعاد النظر للحظة عن الشاشة. حتى من دون ان أكمل المشاهدات (لا نزال في اليوم الخامس للبرليناله)، أرشّحه بقوة لـ"الدب الذهبّ"، وسيكون صعباً على لجنة تود هاينز صرف النظر عنه، مع العلم ان أفرادها سيحتاجون إلى الكثير من الجرأة لاسناد الجائزة الكبرى إليه. من الضروري أيضاً التعبير عن الاعجاب بجرأة إدارة برلين في ضم فيلم "جانر" (مع انه يميل أكثر إلى محاكاة فيلم "الجانر") إلى المسابقة، في زمن يُراد من السينما، خصوصاً في المهرجانات، ان تنقل الواقع وتدين وتعبّر عن كذا وكذا وتشتكي وتخبر حال العالم، إلخ. هذا خيار رؤيوي غير مسبوق، ولو ان الآراء التي سمعتها من هناك وهناك في شأنه، لا تجعل من الفيلم محل اجماع، بل ثمّة مَن هم ضده ومن هم معه، وذلك نظراً إلى راديكالية الاطروحة.
الفيلم عن جاسوس (فابيو تستي) يتذكّر مغامراته في الستينات وهو جالس على شاطئ أحد فنادق الكوت دازور الفرنسية محتسياً المارتيني. هل ينفع ان نغوص في المزيد من التفاصيل ونحن نتناول فيلماً بصرياً، أجوائياً، تعبيرياً، مملوءاً بمرجعيات من السينما الجماهيرية، إلى هذا الحد؟ لا ضرورة لفهم أي شيء من مسرح العبث الذي نجده أمامنا على الشاشة، وهنا تكمن روعة الفيلم الأشبه برحلة، بأوديسّا، بفتح سينمائي يوفّر لنا متعة خالصة، وكأننا في سفينة تبحر بنا على أمواج متلاطمة ولا ينتهي التمايل المستمر على متنها، الا مع ظهور كلمة "نهاية" على الشاشة.
 إيلين كاتيه وبرونو فورزاني خلال حضورهما في المهرجان.
إيلين كاتيه وبرونو فورزاني خلال حضورهما في المهرجان.
لا يتخطّى الفيلم الـ87 دقيقة، ليرينا في أقل من ساعة ونصف الساعة، بإيجاز وتكثيف لافتين، ما لا قدرة للكثير من الأفلام في قوله بساعتين وثلاث. فكلّ العناصر السينمائية مدفوعة إلى أقصى قدراتها وجهوزيتها. باختصار، يجسّد الفيلم ما لا يمكن أي فنّ آخر تجسيده. لا اللوحة ولا الموسيقى ولا الأدب فنون تجمع بين المونتاج المتوتّر والإيقاع المشدود واللغة البصرية الهائلة التي تحملنا من متاهة إلى أخرى بوتيرة جهنمية.
لا يتعلّق الأمر بأن نفهم ما نشاهده بقدر ما يتعلّق بأن نؤمن بهذه المشاهدة والمضي في احتملات لا تنتهي. انها سيادة المتعة التي لا توفّر بالضرورة لا أسئلة ولا أجوبة، وغير مشغولة بقضية تغيير العالم. وسيادة المتعة كافية لصناعة فنّ، وإن لم يرضَ عنه مَن يبحث عن مغزى وتأويل ورسالة لكلّ شيء وأي شيء. في هذا المعنى، يعيدنا الفيلم إلى واحدة من أساسيات السينما ليذكّرنا بأنها فنّ الترفيه والمتعة بامتياز. وللمناسبة، الفيلم مصوَّر بشريط سينمائي، وما يحضر مع ذلك من عيوب في الصورة تنتمي إلى زمن مضى، مستعاد هنا ببراعة.
نحن حيال فنّ خالص لديه قدرة مغناطيسية بالفطرة. هارمونيا تتولّد بشكل دائم بين الصورة والصوت. لا يترك الفيلم مصدراً بصرياً لا يستعير منه. يمد يده إلى كلّ ما يمكن تحويله وتحريفه واستغلاله: فنّ تشكيلي، قصص متسلسلة وغيرها. الأفلام نفسها أرض شاسعة يحصد منها، بدءاً من "ديفا" لجان جاك بينيكس الذي يحضر كتحية، وصولاً إلى كلّ المخرجين من راوول رويز وبراين دبالما وديفيد لينتش الذين يذكّرنا بهم الفيلم من دون ان تكون هناك بالضرورة أي صلة جوهرية بهم. فنحن في النهاية أمام فيلم عن الأفلام، داخل السينما وخارجها، حيث شد حبال لا ينتهي بين الواقع والخيال. ضربة معلّم.





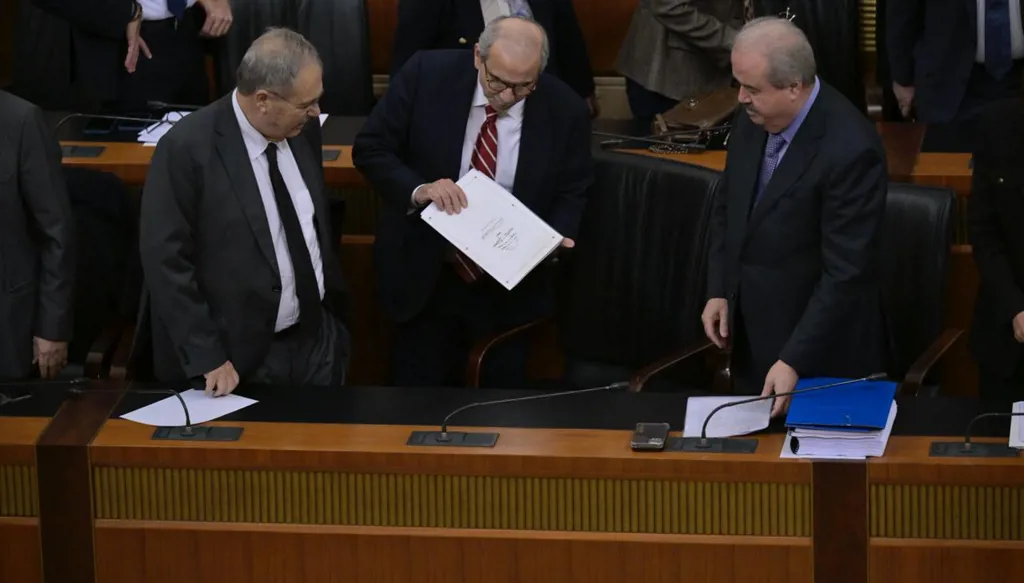






 تویتر
تویتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز



 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة