المقاومة بين التحرير والسلطة

محمد خراط*
تشكلت في الوعي العربي عبر عقود، صورة واضحة عن المقاومة، حركة تنشأ للدفاع عن الأرض المحتلة، واستعادة الكرامة، وتمثيل تطلعات الشعوب. وبحسب هذا المفهوم، فإن شرعية المقاومة تستمد قوتها من الناس لا من السلطة. غير أن التحولات التي شهدتها المنطقة في العقود الماضية أوجدت سؤالاً أساسياً: هل ما زالت المقاومة تؤدي دورها الأصلي، أم أنها انزلقت تدريجاً إلى صراع النفوذ والسلطة؟
حين تقترب الحركات المسلحة من السلطة أو تصبح جزءاً منها، يتغير مسارها تدريجاً؛ فالسلاح، الذي يفترض أن يكون موجهاً نحو الاحتلال، يصبح أداة تأثير داخلي، ويختلط السياسي بالعسكري، والشعبي بالحزبي. ومع الوقت، يتراجع التحرير إلى شعار، بينما يصبح الصراع على السلطة المحرك الحقيقي خلف كثير من القرارات والمواقف. هذا التحول لا يقتصر على ساحة واحدة فحسب، بل يبرز بوضوح في تجارب عربية عدة منها اللبنانية والفلسطينية واليمنية.

في لبنان، سلاح التحرير يتحول إلى سلاح بهدف السلطة. بدأ "حزب الله" بمهمة واضحة، تحرير الجنوب اللبناني المحتل. وبعد تحقيق هذا الهدف، دخل تدريجاً في المشهد السياسي، ثم أصبح لاعباً أساسياً في السلطة. وبذلك تحول السلاح من أداة مقاومة إلى عنصر مؤثر في التوازنات الداخلية، ما أثار تساؤلات حول أولويات مشروعه، هل لا يزال التحرير الهدف الأول أم أن النفوذ السياسي أصبح جزءاً من طبيعة الحركة؟
أما في غزة، فتحولت "حماس" من فصيل مقاوم إلى سلطة حاكمة إذ بدأت كحركة مقاومة ضد الاحتلال، لكنها بعد دخولها الانتخابات وسيطرتها على غزة انتقلت إلى موقع السلطة. ومع هذا الانتقال، تغيرت الحسابات وتداخلت أدوار المقاومة مع ضرورات الحكم، وباتت الحركة مطالبة بإدارة حياة يومية معقدة، في حين بقي خطابها التحرري عنواناً ثابتاً لا يتطور بالوتيرة نفسها.
وفي المثال اليمني، بدأ الحوثيون كحركة معارضة مسلحة تقدم نفسها بصفتها مدافعاً عن فئات مهمشة، لكن مع توسعهم العسكري ودخولهم صنعاء، تحولوا إلى سلطة أمر واقع تدير مؤسسات الدولة وتفرض سلطتها على السكان. وهكذا أصبح السلاح وسيلة لترسيخ السيطرة، تماماً كما حدث مع حركات أخرى في المنطقة.
القاسم المشترك بين معظم حركات المقاومة في العالم العربي هو اعتمادها الكثيف على الخطاب الديني لتعزيز شرعيتها وحشد التأييد الشعبي. فالدين يوفر غطاء أخلاقياً للسلاح، ويقدم المواجهة بصفتها معركة مقدسة تتجاوز السياسة إلى العقيدة.
ومع مرور الوقت، تصبح الشرعية الدينية بديلة من الشرعية الشعبية، وأداة لتثبيت الحكم، وتبرير القرارات السياسية، وإسكات المعارضة.
لا يقتصر تمدد هذه الحركات على السلاح أو الدين فحسب، بل يرتبط أيضاً بغياب الدولة، وتراجع الخدمات، والفقر والبطالة، ما يجعل من الأزمة الاجتماعية أرضاً خصبة لتوسع نفوذها. إذ تقدم هذه الحركات نفسها بديلاً من الدولة، فتقدم المساعدات، وتؤمن الحماية، وتدير بعض الخدمات، فتتحول الحاجة الاقتصادية لدى المواطنين إلى ولاء سياسي.
إن أخطر نتائج تحول المقاومة إلى سلطة هو تأثير ذلك على مصير الدول وشعوبها. ففي معظم التجارب العربية، أدى هذا التحول إلى زج المجتمعات في صراعات داخلية استنزفت مواردها واستقرارها، وتراجع اقتصادي هائل نتيجة العزلة والعقوبات، وتعطل مؤسسات الدولة مع انهيار الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وتفكك النسيج الاجتماعي بسبب الانقسام بين مؤيد ومعارض.
والأخطر من ذلك، أن انخراط الحركات المسلحة في الحكم خلق معضلة ديبلوماسية عميقة، فالشرعية الدولية لا تتعامل مع سلطة لا تعترف بها، والمجتمع الدولي لا يتفاوض مع تنظيم مصنف خارج إطار الدولة. وبذلك، يحرم الشعب قنوات التفاوض والضغط الدولي، وتتحول قضيته إلى ملف معلق، بينما تبقى السلطة بيد حركة لا تمتلك اعترافاً دولياً ولا تمثيلاً سيادياً كاملاً. وهكذا تصبح الأزمات المزمنة جزءاً من بنية الدولة، وتصبح المقاومة التي وجدت لتحرير الشعوب سبباً في استمرار أزماتها السياسية والاقتصادية.
المقاومة فعل صدامي وشعبي، بينما السلطة فعل إداري يسعى إلى الاستقرار. الجمع بين المنطقين يخلق تناقضاً ينعكس سلباً على الدولة والمجتمع، ويقود إلى ضياع الهدف التحرري، وتضخم مشروع السلطة.
تجارب المنطقة تضعنا أمام سؤال، هل المقاومة مشروع تحرر وطني أم مشروع سلطة؟
إذا كانت مقاومة، فعليها أن تبقى خارج الحكم لتحافظ على نقائها وشرعيتها. وإذا أصبحت سلطة، فعليها أن تخضع لقواعد الدولة لا لأيديولوجياتها. أما محاولة الجمع بين الدورين، فقد أثبتت عبر عقود أنها وصفة للانقسام والتراجع وإدامة الأزمات.
*كاتب وناقد




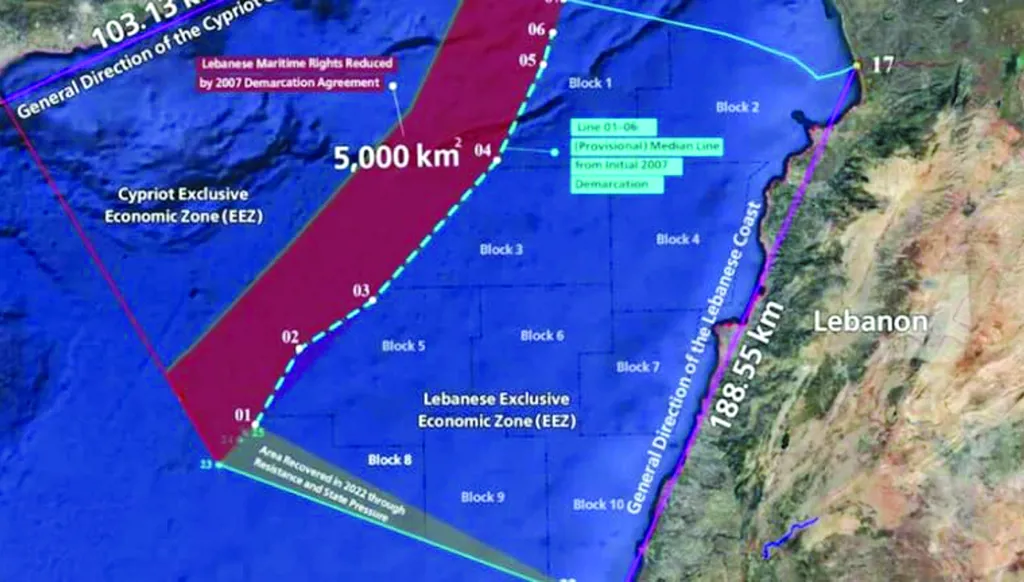





 تویتر
تویتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز



 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة








