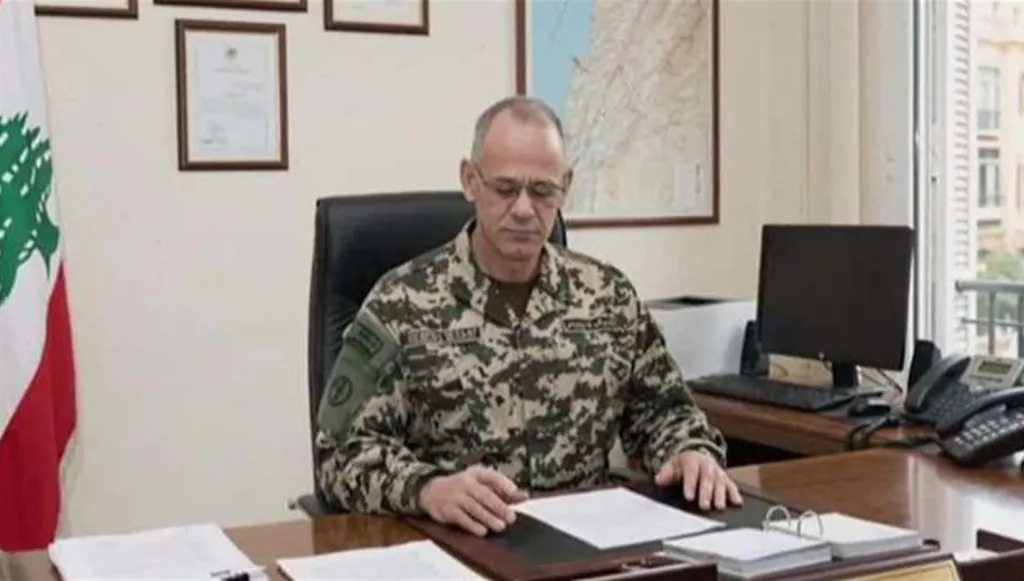تشابه المقدمات يقود إلى النتائج نفسها: إيران والاتحاد السوفياتي

ليست المعضلة الكبرى في التجارب الإيديولوجية الشمولية أنها أخطأت في بعض التفاصيل الإجرائية أو الخيارات الاقتصادية، بل إنها أغلقت باب المراجعة والتصحيح منذ اللحظة الأولى، وتعاملت مع أفكارها بوصفها حقائق نهائية لا تقبل الاختبار ولا المساءلة.
فالتجربة الماركسية في الحكم، كما عرفها القرن العشرون، لم تكن عاجزة عن بناء دولة حديثة بسبب نقص الموارد أو قلّة الكفايات، بل لأن تحويل النظرية إلى عقيدة حكم ألغى منذ البداية إمكان التصويب والتعلّم من الخطأ. حتى عندما تحوّرت مفاهيم كارل ماركس على يد لينين، ثم جرى تثبيتها بقسوة في عهد ستالين، لم يكن ذلك تطوراً طبيعياً في الفكر، بل بدا انتقالاً من نصّ مفتوح إلى يقين مغلق، ومن جدل فكريّ إلى سلطة لا تسمع إلا صوتها.
ماركس نفسه لم يضع دستوراً ولا نموذج دولة، بل قدّم تحليلاً تاريخياً للصراع الطبقي، وافترض نظرياً أن الدولة ستذوب في نهاية المطاف. لكن ما حدث في التجربة السوفياتية كان نقيض هذا الافتراض تماماً. الدولة لم تذُب، بل تضخّمت، والحزب لم يعد أداة تنظيم بل أصبح مرادفاً للوطن، والرأي لم يعد مجالاً للنقاش بل صار تهديداً أمنياً، مع أن لينين حاول تبرير ما سمّاه ديكتاتورية البروليتاريا بوصفها مرحلة انتقالية، إذ تحوّلت هذه المرحلة سريعاً إلى بنية دائمة لا تقبل التغيير، ولا تسمح بالمراجعة أو النقد الداخلي.
والواقع أن الأخطر من فشل السياسات الاقتصادية أو الإدارية في التجربة الماركسية لم يكن في النتائج وحدها، بل في استحالة تصحيح المسار. لم توجد مؤسّسات مستقلّة تراجع الأداء، ولا إعلام حرّ يحاسب السلطة، ولا حوار داخليّ حقيقي، حتى بين أبناء الفريق الواحد. أيّ اختلاف كان يُقرأ بوصفه انحرافاً إيديولوجياً، وأيّ نقد يُصنّف خيانة. هكذا تحوّلت الدولة إلى منظور واحد، وقول واحد، وقائد واحد، مهما تغيّرت الأسماء أو تبدلت الشعارات المعلنة.
هذا النمط يتكرّر، وإن بلغة مختلفة، في التجربة الإيرانية المعاصرة. فالنظام الإيراني قام منذ عام 1979 على نظرية حكم دينية سياسية أعادت إنتاج المنطق نفسه بلباس آخر. فبدل مفهوم الطبقة العاملة، ظهر مفهوم المستضعفين، وعوض الإمبريالية استُخدم مصطلح الاستكبار، ومحل الحزب الطليعي برزت مرجعية دينية عليا تحتكر تفسير النص والواقع معاً.
الاختلاف هنا لغوي ورمزي. لكن البنية الذهنية واحدة، وكذلك طريقة إدارة السلطة والمجتمع. في التجربة الإيرانية، كما في السوفياتية، لا مساحة حقيقية للمراجعة أو النقد الجوهري؛ فولاية الفقيه ليست مجرد موقع دستوري، بل حقيقة فوق النقاش. والمؤسسات، مهما تعدّدت أشكالها، تدور في فلك واحد، ولا تمتلك استقلالية أو آلية للتصويب. حتى التيارات المنتمية إلى النظام نفسه، حين تحاول النقد، تُعاد إلى حدود ضيقة لا تمسّ الجوهر. الحوار مسموح به ما دام شكلياً، والنقاش مقبول ما دام لا يقترب من مركز القرار.
في الماركسية الحاكمة كانت الشعارات مادية صلبة، تتحدث عن العدالة الاجتماعية والاقتصاد المنتج. وفي التجربة الإيرانية، كانت الشعارات عاطفية كهنوتية تستدعي المظلومية التاريخية والاصطفاء الديني. وفي الحالتين استُخدمت الشعارات بوصفها أدوات تعبئة، لا برامج قابلة للتقييم. وحين تفشل السياسات، لا يكون الفشل مدخلاً للمراجعة، بل ذريعة لمزيد من التشدّد والانغلاق.
الدولة الحديثة، كما وصلت إليها البشرية بعد تجارب طويلة، لا تقوم على العصمة، بل على الخطأ القابل للتصحيح. جوهر الدولة المعاصرة هو وجود آليات مراجعة دائمة، مثل برلمان فعلي، وقضاء مستقلّ، وإعلام حر، ومجتمع قادر على مساءلة السلطة. هذه العناصر غابت أو فُرغت من مضمونها في التجربتين، فتحول الخطأ الموقت إلى أزمة بنيوية، وتحولت السلطة من إدارة الشأن العام إلى إدارة الخوف. من هنا يمكن فهم الانتفاضات المتكررة في إيران خلال السنوات الأخيرة. فهي ليست احتجاجاً على قرار اقتصادي أو قانون بعينه، بل على نموذج حكم كامل. فشل اقتصادي يتجلى في التضخم وتآكل الطبقة الوسطى، وفشل إداري يتمثل في فساد، وفشل سياسي يقوم على الإكراه. هو المسار نفسه الذي سلكته الأنظمة الماركسية قبل انهيارها حين راهنت على القبضة الأمنية بدل الإصلاح.
التشابه الأعمق بين التجربتين لا يكمن في الشعارات، بل في منطق الحكم نفسه. ففي الحالتين هناك إيمان بأن المجتمع يجب أن يُعاد تشكيله وفق حقيقة مسبقة، سواء أكانت تاريخية مادية أم دينية غيبية. المواطن في هذا الإطار ليس شريكاً، بل هو موضوع للهندسة السياسية. ومع الزمن تتحول الدولة من إطار جامع إلى عبء ثقيل، ومن مصدر حماية إلى خصم دائم.
المدخلات والمخرجات في التجربتين متقاربة إلى حد لافت. ثمة إيديولوجيا تعتبر نفسها الحقيقة الوحيدة، وسلطة مركزية لا تُساءل، ومؤسسات شكلية، واقتصاد غير قادر على المنافسة أو الابتكار. والنتيجة واحدة: دولة تعيش على إدارة الغضب لا معالجته، وتبني شرعيتها على الخوف لا الرضا.
التاريخ لا يعيد نفسه حرفياً، لكنه يعيد دروسه بوضوح. فالدول لا تسقط لأنها بلا شعارات، بل لأنها بلا آليات مراجعة. وحين تُختزل الدولة في عقيدة، وتُختزل العقيدة في تفسير واحد، ويُختزل التفسير في رجل واحد، يصبح الانفجار مسألة وقت لا أكثر، مهما طال الصمت.
هنا تتجلى أهمية التعدّد والمرونة في أيّ تجربة حكم معاصرة. الدولة التي لا تسمع إلا نفسها تفقد قدرتها على البقاء. والشرعية التي لا تتجدّد تتحول مع الوقت إلى عبء ثقيل. أما القمع فلا يصنع استقراراً دائماً مهما طال أمده. فالمجتمعات الحيّة تبحث دائماً عن أفق أوسع. وهنا تتجلّى أهمية التعدد والمرونة في أيّ تجربة حكم معاصرة.












 تویتر
تویتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز




 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة