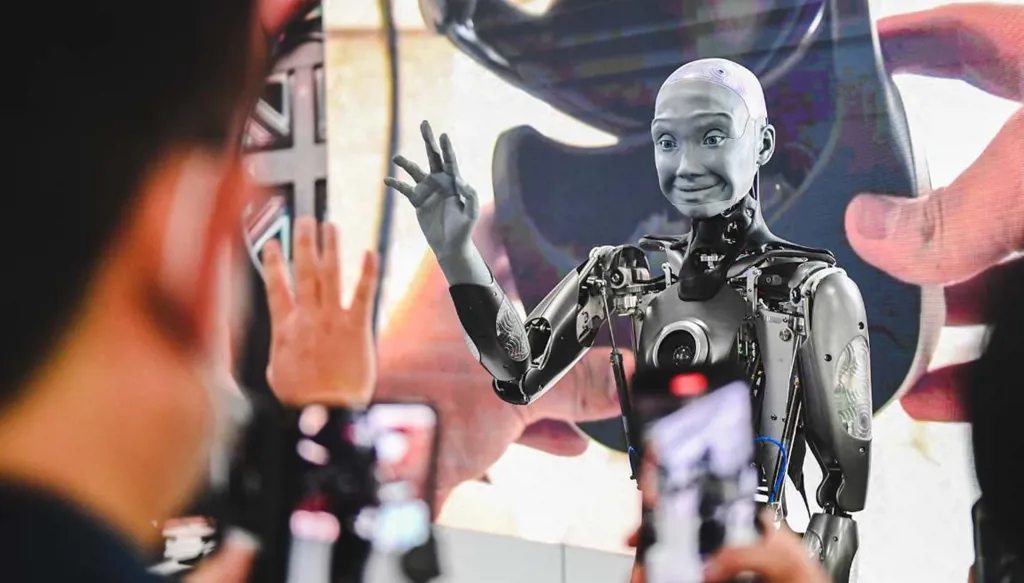نستعيد في ذكرى رحيل النائب والمفكر سمير فرنجية بعضاً من مقالاته المنشورة في "النهار".
هل ينجو ربيع لبنان المذبوح من مصيره المشؤوم؟
ثلاثة حوادث مهمة تشير إلى تغييرات في المنطقة ولبنان؛ أولها الاتفاق النووي مع إيران، ثانيها "الربيع" العراقي، وثالثها المفاوضات الجارية لتحديد مستقبل سوريا. فهل يستطيع لبنان أن يغتنم هذه الفرص الثلاث، ليحرّر ربيعه المذبوح من المصير المشؤوم؟
الحدث الأول يتعلق بالاتفاق حول النووي بين إيران والمجتمع الدولي، الذي ينهي حقبة تاريخية بدأت في العام 2003، تخللها تصعيد في أكثر من مكان؛ في لبنان مع حرب تموز (2006)، في غزة مع سيطرة "حماس" (2007)، في بيروت مع حوادث 7 أيار (2008)، وصولاً أخيراً الى اليمن.
شكّلت رسالة وزير خارجية إيران في جريدة "السفير" (3-8-2015) إشارة إلى رغبة في تغيير السلوك الإيراني تجاه العالم العربي، مع الحديث عن علاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول والدعوة للتشارك في معالجة أزمات المنطقة. لا يزال هذا التحول في بدايته وينبغي انتظار أفعال ملموسة للتأكد من الوجهة التي تسلكها إيران في المستقبل.
الحدث الثاني، هو هذا "الربيع" العراقي الذي لم يكن أحد يتوقع حدوثه، والذي تمثّل في تظاهرات شعبية تطالب بتحقيق إصلاح فعلي في إدارات الدولة، لإنهاء نظام المحاصصة.
الحدث الثالث يتمثل في المفاوضات الجارية على أكثر من صعيد وفي غير مكان لبتّ مستقبل النظام في سوريا وتحديد طبيعة المرحلة الانتقالية الواجب اعتمادها.
في لبنان، نشهد نهاية حقبة تاريخية طويلة بدأت في منتصف الستينات مع صعود الأحزاب والقوى الطائفية التي حلّت مكان التكتلات السياسية العابرة للطوائف والتي مارست عنفاً على مستويين: داخل كل طائفة لتعيين من يمثلها على صعيد الدولة، وما بين القوى الطائفية لتعيين حصة كل منها في الدولة.
أعاقت تلك الصراعات نموّ المجتمع، وأبقت البلد في حالة "حرب باردة"، كما أضعفت مناعة اللبنانيين حيال التطورات الجارية في المنطقة، فمهّدت، بذلك، الأرض اللبنانية لاستقبال الحرب "الساخنة" في العام 1975.
بدأ عصر "المقاومات"، من "المقاومة اللبنانية" إلى "المقاومة الوطنية" وصولاً إلى "المقاومة الاسلامية"، ودخلنا زمن "حروب الالغاء"، وآخرها تلك التي يخوضها "حزب الله" في سوريا.
الإشارة الأكثر تعبيراً عن نهاية هذا الزمن، أتت من التيار العوني الذي استخدم كل الشعارات الطائفية للإستنفار المسيحي، فجاء ببضعة مئات إلى ساحة كانت قبل سنوات قد جمعت مئات الألوف منهم، جنباً إلى جنب مع المسلمين.
نهاية هذه الحقبة التاريخية لا تعني نهاية الأزمة الوطنية. فلا يزال البعض أسير تصورات سياسية وإيديولوجية تزيّن له أنه يخوض معركة الحقّ الأخيرة ضدّ معسكر الباطل، ولن تنتهي هذه الحرب إلا بانتصاره الموعود. ولا يزال البعض الآخر مسكوناً بشهوة السلطة، في حين أن قوى أخرى لا تزال تنتظر ما قد يحصل في الخارج للتكيّف مع نتائجه، من دون المبادرة إلى مواجهة خطر انهيار الدولة ومؤسساتها. إن انهيار هذه الحقبة التاريخية لن يكون فعلياً الا إذا بدأ العمل على وضع الأسس لحقبة تاريخية جديدة.
تبدأ الخطوة الأساس في هذه المجال بإعادة الاعتبار الى التسوية التاريخية التي رسمها اتفاق الطائف والتي تتسع للجميع بعيداً من منطق الغالب والمغلوب، الذي استهوى، على مراحل، كل من استخدم العنف وسيلةً لتحقيق غايات سياسية.
هذه التسوية تحتاج الى عملية إعادة اعتبار، بعد التشويه الذي طالها، نتيجة تولي سلطة الوصاية السورية عملية وضع الاتفاق موضع التطبيق، ونتيجة اختزال الاتفاق بمنطق المحاصصة من قبل القوى الطائفية التي عملت على تعطيله بحجة أن التوافق يعطي الأقلية السياسية حقّ تعطيل خيارات الأكثرية.
اتفاق الطائف هو تسوية تاريخية لأنه يُجري مصالحة في داخل كل واحد منا بين انتماءاته المتعددة، فيُقرّ في آن واحد بحقّنا في التنوع وبحقّنا في المواطنة على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات.
هذه التسوية التاريخية هي حاجة لطيّ صفحة الماضي ومعالجة ما تسببت به تعبئة النفوس من فتن وصراعات طائفية ومذهبية في لبنان والعالم العربي الذي يشهد حرباً دينية تشبه إلى حدّ بعيد "حرب الثلاثين سنة" التي دمّرت المجتمعات الأوروبية من البلطيق إلى المتوسط، في مواجهات دامية ما بين الكاثوليك والبروتستانت.
هذه التسوية هي المدخل لإعادة الاعتبار إلى نموذج العيش اللبناني المشترك، الذي يكتسب اليوم أهمية مضاعفة في إزاء موجة العنف الطائفي التي تجتاح منطقتنا، والآخذة في الامتداد إلى أوروبا وأفريقيا. وذلك بتظهير فرادة التجربة اللبنانية في العالم أجمع، من حيث شراكة المسلمين والمسيحيين – بصفتيهم هاتين – في إدارة الدولة، وفرادة هذه التجربة في العالم الإسلامي بخاصة، من حيث شراكة السنَّة والشيعة – بصفتيهم هاتين – في إدارة الدولة.
هذه التسوية هي الشرط لإعادة بناء عيشنا المشترك بشروط الدولة، والكفّ عن اعتبار هذه الدولة حقلاً للصراع والتقاسم بين أحزاب طائفية. إن الدولة القائمة على هذه التسوية ينبغي أن تكون في الضرورة دولةً مدنية، حيث القانون – بوصفه تعبيراً عن إرادة عامة – يسري على الجميع دونما تمييز، وحيث العدالة مستقلةٌ تماماً عن السلطة التنفيذية، وحيث في إمكان المواطن الفرد أن يختار قانوناً مدنياً لأحواله الشخصية، وحيث لا تقع المرأة ضحية معايير تمييزية، وحيث لا تكون الإدارة العامة حقلاً للزبائنية على اختلاف أنواعها، وحيث مشاركة المواطن في الحياة العامة مكفولةٌ بقانون انتخابات حديث...
أخيراً، تفسح هذه التسوية في المجال أمام انهاء الانقسام العمودي القائم منذ سنوات واستبداله بفرز من طبيعة مختلفة. فرزٌ بين:
الذين استخلصوا دروس الحرب، أو الحروب، من مختلف الطوائف، وأدركوا أهمية الوصل والشراكة مع الآخر المختلف الذي – على اختلافه – يكوّننا مثلما نكوّنه، وهو شرطُ وجودنا كما نحن شرطُ وجوده في مشروع العيش معاً.
والذين، من مختلف الطوائف أيضاً، لم يغادروا كهوف عصبياتهم الطائفية والمذهبية، ولا يزالون يعتبرون الآخر المختلف مصدر تهديد لوجودهم.
على قاعدة هذا الفرز الجديد، ينبغي نسج علاقات شركة وتضامن عابرة للطوائف والمناطق، في ما بين الذين يرفضون العنف ويبدون استعداداً للنضال معاً ضد كل أنواع التطرّف.
¶¶¶
لكي ينجو ربيع لبنان المذبوح من مصيره المشؤوم، ينبغي طي صفحة الماضي، اليوم قبل الغد، والعمل على بناء دولة تتسع للجميع وتقدر على حماية الجميع.

نداء لحماية لبنان
لم يشهد المشرق العربي في تاريخه الحديث ما يشهده اليوم من عنف مجنون بات يهدد دولاً بالزوال. ولم يشهد لبنان من أخطار كالتي يواجهها اليوم من جراء الحروب الدائرة في المنطقة وتدفق اللاجئين اليه من سوريا والعراق، الذي كاد عددهم يوازي عدد اللبنانيين المقيمين في بلدهم.
في مواجهة هذا الزلزال، رأت قيادات مسيحية أن الوقت قد حان لتصحيح أخطاء تاريخية ارتكبت في حق البلاد والاتيان بعد طول انتظار برئيس "قوي" يعيد إلى المسيحيين حقوقهم المفقودة.
في العام 1988، رفضت هذه القيادات إجراء الانتخابات الرئاسية وجعلت من إنهاء الاحتلال السوري أولوية، فدخلت في حرب تحرير كادت أن تقضي على البلاد لولا تدخل العالم لوقف الحرب والتوصل الى تسوية الطائف. لكن هذه القيادات رفضت هذا الاتفاق بحجة أنه لا يتضمن انسحاباً سورياً فورياً من لبنان، وعمدت إلى استبدال حرب التحرير بـ"حرب إلغاء"، الأمر الذي أفسح في المجال لاحتلال سوري للبنان، دام، بمباركة دولية، مدة 15 سنة.
في العام 2005، وبعد خروج الجيش السوري من لبنان، انتقلت هذه القيادات المسيحية من ضفة الى أخرى، وعملت على صوغ "ورقة تفاهم" مع خصوم الأمس لنيل تأييدها في بحثها عن رئيس "قوي". وهي بهذا الانتقال فتحت الباب أمام عودة سوريا إلى لبنان، الأمر الذي دفع اللبنانيون ثمنه غالياً.
في العام 2015، أي بعد 27 سنة على بداية هذه "المأساة الرئاسية"، قررت هذه القيادات المسيحية أن تحسم الأمر، وأن تضع الجميع أمام مسؤولياته: رئيس "قوي" أو لا رئيس. فاشترطت على النواب الاقرار مسبقاً بمبدأ الرئيس "القوي" لكي يسمح لهم بعقد جلسة انتخاب. لم تتوفر هذه الموافقة المسبقة، فاضطرت هذه القيادات الى اختيار الفراغ الرئاسي.
ينم هذا الواقع عن انفصام خطير. فهناك مشهدان لم يعد من علاقة بينهما:
المشهد الأول يتلخص في الآتي: دولة ومؤسسات تواجه خطر الانهيار؛ مجتمع يعاني من انقسام مذهبي قد يهدد السلم الأهلي؛ حرب غير معلنة تدور رحاها على طول الحدود مع سوريا؛ اقتصاد على تراجع مع ازدياد متواصل لعدد اللاجئين.
أما المشهد الثاني فيتلخص في صراع على مركز رئاسة الجمهورية، مع ما يرافق ذلك من "أوراق تفاهم" بين الأحزاب المسيحية ومن مطالبة بتعديل الدستور لاستبدال الانتخاب باستفتاء شعبي على مرحلتين – المسيحيون يختارون والمسلمون يؤكدون خيارهم - وصولاً الى الدعوة إلى إلغاء اتفاق الطائف وتنظيم مؤتمر تأسيسي لوضع أسس "الجمهورية الثالثة".
عدنا اليوم الى العام 1988.
لم نتعلم شيئاً من تجربة كل تلك السنوات التي شهدت دوراً مسيحياً مميزاً أدى الى اطلاق انتفاضة كانت الأولى في العالم العربي ضد الأنظمة الديكتاتورية، تلك الانتفاضة التي – والكلام هنا للمجمع البطريركي الماروني - "فتحت الباب للخلاص الوطنيّ بتوحّد غالبيّة الشعب اللبنانيّ على نحوٍ غير مسبوق".
لم نتعلم شيئاً من تجربة العيش المشترك التي يمتاز بها لبنان، تلك التجربة التي تكتسب اليوم أهمية استثنائية بسبب فرادتها في العالم عموماً، من حيث شراكة المسيحيين والمسلمين في إدارة دولة واحدة، وفرادتها في العالم الإسلامي خصوصاً، من حيث شراكة السنَّة والشيعة في إدارة الدولة ذاتها.
لم نتعلم شيئاً من تجربة الكنيسة التي تخطت المنطق الطائفي الذي لا يزال يتمسك به "الأقوياء" في الطائفة وكانت، مع المجمع البطريركي الماروني 2006، من أوّل المنادين في هذا العالم العربي بإقامة الدولة المدنية، القائمة على "التوفيق بين المواطنية والتعددية" وعلى "التمييز الصريح، حتى حدود الفصل، بين الدين والدولة، بدلاً من اختزال الدين في السياسة، أو تأسيس السياسة على منطلقات دينية لها صفة المطلق".
في تاريخ لبنان المستقل، أتى الى سدة الرئاسة رئيس "ضعيف" وفق المفهوم المعتمد اليوم للقوة، هو اللواء فؤاد شهاب. فكان أن بنى هذا "الضعيف" دولة لا تزال مؤسساتها حتى اليوم تنظّم حياتنا الوطنية. واحترم هذا "الضعيف" دستور بلاده، فرفض تمديد ولايته.
المطلوب اليوم قليل من التواضع لنعيد بناء تجربة وطنية جديدة لا تقوم على التمييز بين "الاقوياء" و"الضعفاء"، بل على التمييز بين الذين استخلصوا دروس الحرب من مختلف الطوائف، وأدركوا أهمية الوصل والشراكة مع الآخر المختلف، وهم اليوم الأكثرية، وبين الذين، ومن مختلف الطوائف أيضاً، لم يغادروا كهوف عصبياتهم الطائفية والمذهبية، ولا يزالون يعتبرون الآخر المختلف مصدر تهديد لوجودهم، ينبغي العمل على إقصائه.
الوقت يدهمنا، والتطورات التي تشهدها المنطقة تتسارع، فعلينا طيّ صفحة الفراغ الرئاسي لكي نمكّن الدولة من القيام بدورها في حماية هذا الوطن، حماية "الضعفاء"، ولكن أيضاً "الأقوياء"، الذين باتوا اليوم في حال صعبة، من العراق وصولاً الى اليمن، مروراً بسوريا.

حــــــمــايـــــة الـكــــــيــان تـحــــــمـــــيــــهــم
"عــــــودة" المــســيــحـــيــيــن أحـــد الـشـــروط الأســــاســــيــة لإنــقـــــاذ لــبــــنــان
تطرح التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، من الخليج حتى البحر المتوسط، والتي تنعكس على الأوضاع في لبنان أسئلة من طبيعة وجودية على اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، الذين يتعرضون لحملة تخويف مبرمجة، الغاية منها تعطيل دورهم الكياني. وآخر ما تم ابتكاره في هذا المجال اقتراح حل يقضي بتعديل اتفاق الطائف لجهة استبدال المناصفة بالمثالثة، كتعويض لـ"حزب الله" على تخلّيه عن سلاحه، الأمر الذي يؤدي الى انهاء الوجود المسيحي الفاعل في لبنان.
يواجه المسيحيون في هذه المرحلة المصيرية سؤالا من طبيعية وجودية يتلخص في الآتي: هل هم أقلية يتوجب عليها الدفاع عن حضورها ووجودها الحر في مواجهة الأكثرية، أم هم جماعة ينبغي لها العمل مع الجماعات الأخرى على رسم مستقبل مشترك لها وللآخرين؟
في الحالة الأولى، من حق الأقلية الدفاع عن حقوقها الخاصة ومن حقها على الأكثرية أن تعترف لها بهذه الحقوق، لكنها لا تستطيع تخطي الحيز الخاص بها والمطالبة بدور لها مع الأكثرية في تحديد الخيارات العامة التي تعني الجميع.
اما في الحالة الثانية، فلا يوجد أقلية وأكثرية بل جماعات تمتلك كل منها خصوصيتها وتتشارك في ما بينها على قدم المساواة في رسم مستقبلها المشترك وتوفير الضمانات للجميع من دون تمييز.
في زمن الوصاية السورية جرت محاولة لتحويل المسيحيين الى أقلية ودفعهم الى تسليم أمرهم للسلطة السورية في مقابل "حمايتهم" من "خطر الهيمنة الاسلامية" عليهم. وقد تولى بعضٌ ممن تسلّموا مقاليد السلطة في ذلك الزمن مهمة اقناع المسيحيين بالتخلي عن دورهم التاريخي في الدفاع عن الكيان، في مقابل حصولهم على حماية توفرها سوريا. وذهب البعض الى حد التنظير لهذا الخيار من خلال الحديث عن "حلف الأقليات ضد الاكثرية".
سقط هذا المنطق مع صدور بيان المطارنة الموارنة الشهير في 20 أيلول 2000، وهو البيان الذي افتتح معركة استعادة استقلال لبنان وسيادته. وقد جاء في هذا البيان ما حرفيته: "لقد تحمل اللبنانيون، طوال ربع قرن الكثير، من اذلال وامتهان لم يتعودوه. وناموا على الضيم اياما وليالي، وصبروا على ما حل بهم من خراب ودمار، وارتضوا، على مضض، حرمانهم حقهم في تسيير امورهم، واعتبارهم قاصرين في حاجة دائمة الى وصاية (...) لقد خرجت اسرائيل من جنوب لبنان (...) أفلم يحن الوقت للجيش السوري ليعيد النظر في انتشاره تمهيدا لانسحابه نهائيا، عملا باتفاق الطائف؟".
في 20 أيلول 2000، حسم المسيحيون أمرهم، فرفضوا المنطق الأقلوي الذي حاولت الوصاية السورية فرضه عليهم ودخلوا في مواجهة صعبة مع النظام السوري الذي ركّز جهده على عزل الحالة المسيحية ومنعها من التواصل مع المسلمين كي لا تتحول الى حالة وطنية. لكنه فشل في ابقاء الفصل بين اللبنانيين ولم يستطع منع قيام معارضة لبنانية. فلم يبق أمامه من خيار سوى اعتماد سياسة القتل. فكان اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
إن الانجاز الذي ساهم المسيحيون في تحقيقه بعدما أعادوا تواصلهم مع المسلمين كان له الأثر الكبير في لبنان والمنطقة:
- فهم ساهموا في ولادة الاستقلال الثاني الذي يتميز عن الأول بأنه استقلال "شعبي" تجاوز النخب السياسية والقيادات الحزبية.
- وساهموا في إعادة لبنان الى خريطة العالم بعد غياب وتغييب داما طويلاً، فأصبحت القضية اللبنانية محوراً اساسياً في اهتمامات العالم.
- وساهموا في انهاء زمن الانظمة الاستبدادية التي شلّت تطور العالم العربي وأخرجته من التاريخ، وذلك من خلال إسقاطهم منظومة الهيمنة السورية على لبنان بالوسائل السلمية والديموقراطية بينما فجّر سقوط النظام العراقي بالوسائل العنفية حرباً دموية لا تزال مستمرة بعد أربعة أعوام على اندلاعها.
- وهم يساهمون اليوم في بلورة مفهوم جديد لنظام المصلحة العربية لا يتأسس هذه المرة على فكرة شمولية - ايديولوجيا "العروبة" في المفهوم البعثي -، بل على التعاون في القضايا المشتركة والتضامن حولها خارج منطق الإلغاء أو الاستتباع.
لكنه لم يتوافر للبنانيين لا الوقت ولا الوسائل الكافية لتثبيت هذه الانجازات. ففي غضون أيام قليلة أعقبت الرابع عشر من آذار 2005، شنَّت القيادة السورية حملة شرسة للعودة بالبلد الى ما كان عليه قبل انتفاضة الاستقلال: من اغتيالات ومحاولات اغتيال لقادة الحركة الاستقلالية وقادة الرأي، الى تفجيرات متنقلة استهدفت المدنيين، الى الاعتداءات على الجيش اللبناني والقوات الدولية، الى العمل على تعطيل المؤسسات.
واستهدفت هذه الحملة المسيحيين بصورة خاصة، فاهتزت ثقتهم بأنفسهم وبشركائهم نتيجة سياسة التخويف التي مورست في حقهم، ونتيجة أخطاء تمحورت في مجملها حول مسألتين أساسيتين:
- مسألة الانتخابات النيابية، من القانون حتى التحالفات، حيث لم تحسن حركة الرابع عشر من آذار شرح الملابسات التي رافقت هذه المسألة: من الخيار الذي فرض عليها بين القبول بقانون الـ 2000 أو تأجيل موعد الانتخابات، الى التحالف الرباعي الذي كانت غاية حركة 14 آذار منه الافساح في المجال أمام الحزبين الرئيسيين في الطائفة الشيعية للمشاركة في دولة ما بعد الوصاية، فيما استُغلت صورة التحالف الرباعي "المسلم" لتأليب الرأي العام المسيحي ودفعه الى الالتفاف الغرائزي حول زعامة مسيحية أحادية في مواجهة الزعامات الاسلامية.
- مسألة المشاركة السياسية التي بدت غير متوازنة، وخصوصاً بعد انفراط عقد "لقاء قرنة شهوان" قبيل الانتخابات النيابية، ما ساهم في ارساء انطباع لدى عدد من المسيحيين بأن القيادات المسيحية في 14 آذار ملحقة بالقيادات الاسلامية، الأمر الذي دفعهم الى البحث عن "زعيم" يستطيع الوقوف في وجه الزعماء الآخرين.
سيطر على المسيحيين نتيجة الحملة السورية التي استهدفتهم والأخطاء التي رافقت المسيرة الاستقلالية، شعور بالخوف على المصير والدور، فانكفأ البعض منهم، واندفع البعض الآخر في اتجاه زعامة زيّنت لهم أنها تستطيع، بحكم صلاتها بعواصم القرار في الخارج، أن تفرض توازناً في مواجهة القيادات الاسلامية الأخرى. فانتهى الأمر بمقايضة تقضي بالتخلي عن الدور الذي اضطلع به المسيحيون في معركة الاستقلال وقطع صلاتهم مع المجتمع الدولي في مقابل وعد بالحصول على "ضمانات" و"حقوق" بواسطة سوريا وايران والقوى المحلية التي واجهت الحركة الاستقلالية. هكذا عادت الأمور بالنسبة الى هذا الفريق المسيحي الى ما كانت عليه في زمن الوصاية عندما كانت القيادات المسيحية التابعة لسوريا تستخدم عامل الخوف لاقناع المسيحيين بالتخلي عن السيادة في مقابل "حمايتهم" من "خطر" المسلمين. اليوم، أتى من يجدد العرض ذاته عليهم لتأمين حمايتهم من "الخطر السني"، متجاهلا التحولات التي أحدثها الرابع عشر من آذار، والتي جعلت من شعار "لبنان أولا"، وهو شعار المسيحيين التاريخي، شعاراً اسلامياً بامتياز.
دفع هذا المنطق الأقلوي ذاك الفريق المسيحي الى الانتقال من موقع الى آخر: من مواجهة النظام السوري الى تبرئته من كل ما يحصل في لبنان من قتل وتفجير وتخريب، وذلك بذريعة أنه أصبح خارج لبنان بعد انسحاب جيشه في نيسان 2005؛ ومن دعم الشرعية الدولية الى مواجهتها واعتبارها سلطة وصاية على لبنان؛ ومن دعم الدولة في أن تكون صاحبة الحق الحصري في امتلاك القوة المسلحة الى دعم سلاح "حزب الله" في مواجهة الدولة؛
لقد كان لهذا الانتقال من موقع الى آخر نتائج كارثية أهمها:
- ابقاء الأزمة الوطنية مفتوحة من خلال تعطيل آليات التغيير الديموقراطي على مستوى المؤسسات الدستورية، ومساعدة النظام السوري على استمراره في التحكم بقرار رئاسة الجمهورية اللبنانية.
- العودة بالمسيحيين الى هواجس الذمّية بتخويفهم من الطائفة السنية، فيما كانت هذه الطائفة تعبّر، بقوة غير مسبوقة، عن التزامها لبنان، ودفعهم في الوقت ذاته الى الاحتماء بـ"حزب الله" الذي يجاهر بتحالفه الاستراتيجي مع النظامين السوري والايراني.
- وضع المسيحيين في مواجهة مع المجتمع الدولي والمصلحة العربية المشتركة، بجعلهم في دائرة الاستخدام الايراني لعدد من الأوراق في المنطقة من أجل إقرار دولي بدور ايران الأقليمي. هذا بالإضافة الى الترويج في البيئة المسيحية لخطاب يحث على كراهية الغرب والعرب والشرعية الدولية، الأمر الذي يطعن في السياق الثقافي التنويري للمسيحيين في لبنان والشرق.
لكن النتيجة الأخطر تمثلت في الاعتقاد الذي تولد لدى "حزب الله" بعد تحالفه مع هذا الفريق المسيحي بأنه أصبح يتمتع بـ"أكثرية" اسلامية -مسيحية تؤهله لإعادة الامور الى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من آذار 2005. وهذا ما دفعه في 12 تموز 2006 الى اختطاف جنديين اسرائيليين من خارج "الخط الأزرق"، فواجه اللبنانيون حرباً مدمِّرة لم يختاروها، ويتوجَّب عليهم دفع تكلفتها، كما وجدوا أنفسهم على خط مواجهة كونية بين "إسلام جهادي" تقوده ايران الساعية الى اعتراف بدورها الاقليمي، وبين قوى دولية تريد فرض "أجندتها" على المنطقة.
انتهت حرب تموز بإقفال الجبهة الجنوبية وفقاً لمقتضيات القرار الدولي 1701، فارتد "حزب الله" ومعه فريق من المسيحيين نحو الداخل وسار في خطة للانقلاب على السلطة من خلال ضرب المؤسسات الدستورية واحتلال وسط العاصمة، ومحاصرة السرايا الحكومية، وتعطيل عمل الوزارات والقيام بـ"انتفاضة الدواليب".
إن أخطر ما في هذا المنطق الأقلوي الذي برز بعد الرابع عشر من آذار 2005 هو أنه يدفع في اتجاه اخراج المسيحيين من الحاضر والمستقبل وتحويلهم الى أقلية محكومة بهموم ضيقة غير معنية بما يجري من حولها. ولعل الضجة التي أثارتها مسألة استبدال الجمعة العظيمة بـ"إثنين الباعوث" في توزيع أيام العطلة خير دليل على هذا الأمر. يبرز خطر التهميش هذا، وهو تهميش "ذاتي" غير مفروض كما كانت الحال في الحقبة السورية، في اسلوب مقاربة التحولات الرئيسية التي يشهدها لبنان والمنطقة والتي يتوقف على نتائجها مستقبل اللبنانيين ومستقبل المسيحيين في لبنان والشرق، فينظر أصحاب هذا المنطق الأقلوي الى الصراع الدائر في لبنان والمنطقة على أنه مجرد صراع مذهبي بين السنّة والشيعة من دون أن يدركوا أن المرحلة التي يشهدها العالم العربي هي مرحلة تحول تاريخية شبيهة في مضمونها بتلك التي عاشتها دول اوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين.
¶¶¶
هذا التهميش الناجم عن سياسة الخوف والتخويف التي تعرض لها المسيحيون بعد الرابع عشر من آذار 2005 ليس قدراً لا يمكن مواجهته. ففي زمن الوصاية السورية، جرت محاولات عدة لـ"احباط" المسيحيين واخراجهم من الحياة السياسية، لكن المسيحيين نجحوا في التصدي لها عندما حسموا أمرهم واتخذوا قرارهم بتحمل مسؤولياتهم الكيانية دفاعاً عن كل لبنان. فقدر المسيحيين هو الدفاع عن الكيان. وحمايتهم لا تأتي الا من حماية الكيان، وتحتاج استعادة الدور المسيحي في الدفاع عن الكيان الى شروط ثلاثة:
الشرط الأول هو الاقرار النهائي بأن المسيحيين "ليسوا أقليّة ترتبط بعلاقات جوار وتساكن مع الآخرين، وتبحث عن سبل لتنظيم تعايشها مع الأكثريّة والمحافظة على خصوصيّتها. إنّهم جماعة لها دور فاعل من خلال تواصلها وتفاعلها مع كلّ الجماعات لرسم مستقبل مشترك لها ولهم، يقوم على المبادئ التي تؤمّن للإنسان حريّته وتحفظ كرامته وتوفر له العيش الكريم" (المجمع البطريركي الماروني).
الشرط الثاني هو استعادة الموقع الذي يجسد هذا الدور المسيحي في الدفاع عن الكيان، وهو موقع رئاسة الجمهورية الذي لا تزال سوريا تصادره، والذي تحول، بسبب هذه المصادرة بالذات، من ضمان لحماية الكيان الى خطر على هذا الكيان. وتصطدم استعادة هذا الموقع بحملة مبرمجة تراوح أهدافها بين تعطيل الموقع وافراغه من مضمونه:
- التعطيل من خلال اعطاء الاقلية الحق في منع قيام مؤسسات الدولة، في حين أن الحقوق المعطاة الى الأقلية في دساتير العالم كلها تتعلق بتعطيل بعض قرارات الدولة، لا بتعطيل قيامها.
- الافراغ من خلال طرح فكرة "الرئيس التوافقي" الذي يقبل به الأطراف المتصارعون ولا يكون مع فريق ضد آخر. ماذا يعني التوافق في هذه الحال؟ وكيف يمكن "التوفيق"، على سبيل المثال، بين من يعمل على جعل لبنان قاعدة متقدمة لحلف خارجي وبين من يطالب بأن تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم؟ وهل المطلوب من الرئيس المقبل أن لا يكون صاحب مواقف لكي يكون "توافقياً"؟
إن التعطيل، مهما تباينت الآراء حول النصاب الدستوري، أمر مرفوض. أما التوافق الذي يتحدث عنه البعض، فهو غير الوفاق المطلوب. فالرئيس الجديد لن يكون "توافقياً، بل وفاقي قادراً على اجتراح تسويات نبيلة بين مصالح مشروعة متعارضة، لا أن يعمل، من منطلق التوافق، على البحث عن مساومات بين مشاريع فئوية متناقضة. فمهمة الرئيس الوفاقي هو أن يكون حكماً ومرجعاً ورمزاً للوحدة الوطنية، الأمر الذي يضع حداً للمقولة التي استخدمت لتبرير كل أشكال الوصايات الخارجية على لبنان، الا وهي غياب المرجعية الداخلية التي يمكن الاحتكام اليها لبتّ الخلافات وتالياً الحاجة الى وصاية خارجية تضبط الحياة السايسية لحماية السلم الأهلي.
الشرط الثالث والأهم، هو استعادة المسيحيين لجوهر الرسالة التي هي في أساس وجودهم وتمايزهم، الا وهي رسالة التواصل والانفتاح التي تتجسد في "العيش معاً"، "متساوين في حقوقنا والواجبات، ومختلفين في انتماءاتنا الثقافية والطائفية" (المجمع البطريركي الماروني). إن استعادة هذه الرسالة هي المدخل لإعادة التواصل بين المسيحيين والعالم، ذلك أن اهتمام العالم بلبنان اليوم لم يعد اهتماماً بلبنان القائم على "طائفة ممتازة"، كما كانت الحال في مراحل تاريخية سابقة، إنما هو اهتمام غير مسبوق بنموذج العيش المشترك الذي تزداد الحاجة اليه مع ارتفاع منسوب العنف والنبذ والإقصاء في معظم انحاء الشرق الأوسط.
إن قرار "العيش معاً" يتطلب أولاً الشجاعة:
- الشجاعة في الإقدام على "العيش معاً"، متجاوزين مخاوفنا الطائفية المتحدرة من الماضي، وغير باحثين عن "أمان زائف" يُغرينا به الانغلاق داخل "قبيلة" ما، أكانت قبيلة طائفية أم حزبية، تقليدية أم "حديثة"، موروثة أم اختيارية، محكومة لرمزية دينية أم محددة بلون أو راية أو شعار.
- الشجاعة في الإقدام على "العيش معاً"، من دون أن يشكّك أحدنا في الآخر، ومن دون اعتبار الفروق مع الآخر المختلف سبباً لتراتبية من أي نوع تسوّغ السيطرة عليه أو إقصاءه. فأن تكون مختلفاً عن الآخر، لهو أمرٌ لا ينطوي على أي حكم قيمي. إنه بكل بساطة تعبير عن حالة طبيعية وحقيقة مجتمعية.
- الشجاعة في الإقدام على "العيش معاً"، مدركين أن مستقبلنا المشترك لا يرتسم لمرة واحدة والى الأبد، بل يتطلب عناية دائمة وتسويات متجددة، ومدركين أيضاً أن هذا القدر من "اللايقين" الاجتماعي ليس حالة شاذة، وانما هو ملازم لكل علاقة اجتماعية.
وهذا القرار يتطلب أيضاً، وخصوصاً، ذكاءً وفطنة:
- فطنةً تجعلنا ندرك أن العلاقة مع "الآخر" المختلف ليست فقط ضرورة يُمليها علينا واقع العيش في مجتمع متنوّع، بل هي مصدر غنى لكل منا ولجميعنا. ذلك أن شخصيتنا إنما تتكوّن وتتشكّل من خلال علاقتها بالآخر الذي يضيف اليها أبعاداً جديدة. وهذه الإضافة تكون كبيرة وغنية بمقدار ما يكون الآخر متنوعاً.
- ذكاءً يجعلنا ندرك أن غنى مجتمعنا وأسلوب عيشنا لا يتأتّيان من مجرّد التجاور والمساكنة بين طوائف مختلفة، بل من "العيش معاً" الذي يربط ما بين الطوائف بأواصر المودة والاحترام، والذي يجعل من المجتمع اللبناني بيئة نموذجية للتفاعل الانساني. هذا في زمن بات موضوع "العيش معا"، ولا سيما في ظل المتغيرات الكبرى التي أحدثتها وتحدثها العولمة، يمثل تحدياً كبيراً على صعيد الانسانية جمعاء.
- فطنةً تجعلنا ندرك أن لبنان لا يستطيع التماثل مع أيٍّ من مكوّناته الطائفية. لكل طائفة خصائصها ومميزاتها، ولكن لبنان لا يختزل بواحدة منها، كما أنه لا يشكل حاصل جمع حسابي لتلك المكوّنات. إنه أسلوب عيش لعدد من الطوائف معاً، وهذا العيش معاً، أو العيش المشترك، هو جوهر وجود لبنان في هذا العالم، وسبب فرادته في منطقة تقوم دولها جميعاً على فكرة الانصهار والعصبية القومية.
هذه الشروط الثلاثة هي المدخل الى "عودة" المسيحيين الى حقيقتهم ودورهم. وهذه "العودة" هي شرط أساسي من شروط انقاذ لبنان ¶
المسيحيون، لبنان والعالم العربي
دعوة الى صوغ "تسوية تاريخية" تحمي لبنان والمنطقة
دمّر لبنان مرة أخرى نتيجة قرار لم يتخذه اللبنانيون.
فالاسباب التي سمحت لفريق سياسي أن ينوب عن اللبنانيين في تقرير مصير البلاد كثيرة ومتعددة. لكن من المؤكد ان ما حدث لم يكن ليحدث لو حافظ المسيحيون على فاعليتهم، تلك الفاعلية التي لعبت، منذ لحظة اعلان بيان المطارنة الموارنة الشهير في 20 ايلول 2000، دوراً حاسماً، من خلال تواصلها مع المسلمين، في استعادة سيادة لبنان واستقلاله.
فقد المسيحيون فاعليتهم عندما بدأت الانتفاضة تفقد زمام المبادرة نتيجة التردد وفقدان الرؤية ودخول بعض اطرافها في تسويات أشعرت البعض الآخر وكأنه تم التخلي عن الوحدة التي تجلت في 14 أذار. فاهتزت ثقة المسيحيين بأنفسهم، وسيطر عليهم شعور الخوف على المصير والدور، فاندفعوا في اتجاه من كان يعدهم بالاطمئنان وسلموه أمرهم. فاعتبر نفسه صاحب وكالة حصرية غير قابلة للعزل وجرهم الى موقع ليس هو موقعهم. فارتكبت أخطاء تمس بجوهر التوجهات المسيحية التاريخية، وذلك على مستويات أربعة:
1 - على مستوى الدولة: ربط البعض تأييده لها بالامساك بها بداعي اصلاحها، وحين تعذر الأمر، حوّل اعتراضه على الدولة تأييداً لمشاريع "اللادولة"، وصولاً الى إعادة الاعتبار الى الذين حوّلوا في مرحلة سابقة الدولة اللبنانية الى ولاية سورية.
2 - على مستوى المجتمع الدولي: دفع خيار "اللادولة" البعض الى مواجهة المجتمع الدولي والاعتراض على قراراته والاصطفاف في معسكر الدول الخارجة عن الشرعية الدولية، والتحّول الى مجرد قوة ملحقة بمشاريع لا قرار لها فيها، تدفع ثمناً في حال فشلها وثمناً أكبر في حال نجاحها.
3 - على مستوى الوحدة الداخلية: تجاهل البعض أهمية الحدث التاريخي الذي مثله دخول المسلمين بقوة في الدفاع عن استقلال لبنان في مواجهة سوريا، وهذا أمر لم يحدث من قبل، وتحوّل في المقابل عنصراً فاعلاً في تأجيج الصراعات المذهبية بين السنة والشيعة بدل أن يكون عامل تقارب وتوحيد.
4 - على مستوى اتفاق الطائف: طالب البعض بإعادة النظر في هذا الاتفاق من دون ادراك لخطورة العودة الى المنطق القديم، ذلك أن اتفاق الطائف وضع حداً للصراع بين الطوائف حول تقاسم السلطة، وألغى المعيار العددي الديموغرافي الذي هو في أساس هذا الصراع، معتبراً أن العيش المشترك المؤسس على المشاركة المتوازنة في السلطة هو خيار لا يحكمه منطق موازين القوى.
هذه الأخطاء الجسيمة نجمت عن طموحات واطماع وعقد، وتسبب باستمرارها غياب المراجعة والمساءلة والمحاسبة التي هي في أساس الديموقراطية التي نطالب بها على المستوى العام ونرفض ممارستها في بيئاتنا السياسية. هذه الأخطاء تعرض المسيحيين لخطر الخروج من السياسة، والخروج من السياسة يمهد عادة الطريق للخروج من التاريخ والجغرافيا. وهذا خطر يتهدد المسيحيين في لبنان ويتهدد ايضاً المسيحيين في الشرق العربي نظراً الى الترابط في المصير في ما بينهم.
تحتاج استعادة الدور المسيحي الى قرار مزدوج:
- قرار يقضي بالخروج من منطق استسلام انسان لآخر في تقرير مصيره، فيقوده الى حيث يريد دون مشاركة أو مساءلة. إن هذا المنطق هو منطق عشائري بامتياز يحوّل الانتماء الواعي الى تعصب أعمى، فيدمج القضية التي هي في أساس انتمائه ومن يرمز اليها، فيتحزب للرمز على حساب القضية.
- وآخر يقضي بالخروج من المنطق الأقلوي الذي يعطل القدرة على التفكير السليم ويرسم خطوط مواجهة مع الآخرين ويجعل الطموح محصوراً بالضمانات والحماية. والمجمع البطريركي الماروني الأخير كان واضحاً في هذا المجال عندما اعتبر أن الموارنة "ليسوا أقلية ترتبط بعلاقات جوار وتساكن مع الآخرين، وتبحث عن سبل تنظيم تعايشها مع الأكثرية والمحافظة على خصوصيتها"، بل "جماعة لها دور فاعل من خلال تواصلها وتفاعلها مع كل الجماعات في رسم مستقبل مشترك لها ولهم، يقوم على المبادئ التي تؤمّن للانسان حريته وتحفظ كرامته وتوفر له العيش الكريم".
هذا القرار المزدوج هو الذي يعيد الى المسيحيين فاعليتهم ويؤهلهم للمساهمة في صوغ "تسوية تاريخية" تحمي لبنان وتحمي المنطقة.
فنحن اليوم، لبنانيين وعرباً، رهائن صراع يدور على أرضنا. هذا الصراع هو صراع على دور كل من اسرائيل وايران في النظام الاقليمي الذي هو قيد التحديد بعد نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي. انتهى الفصل الأخير من هذا الصراع الذي كان لبنان مسرحه بفشل مزدوج: فشل اسرائيل التي عجزت للمرة الأولى عن الحسم العسكري، فاهتزت صورتها كذراع مسلحة للغرب في مواجهة الاسلام، وفشل ايران في الاستيلاء، عبر غزة ولبنان، على قضية العرب الأولى وهي قضية فلسطين، وتالياً تأهيل نفسها لقيادة العالم العربي والاسلامي في مواجهة الغرب.
أفسح هذا الفشل المزدوج في المجال لإمكان تجاوز مقولة "صراع الحضارات" التي يستخدمها الطرفان المتقابلان. وقد بدأ يظهر تحول في العالم الاسلامي بجناحه العربي والعالم الغربي بجناحه الاوروبي في اتجاه عودة التواصل بين العالمين والبحث عن صيغ تعايش وتعاون خارج منطق التصادم والإلغاء. وقد أعاد هذا التحّول الاعتبار الى تجربة لبنان والنظر اليها على أنها نموذج يمكن الاقتداء به لتجربة انسانية جديدة عنوانها: العيش معاً، متساوين ومختلفين.
والشرط اللبناني لهذا التحّول هو أن يقدم اللبنانيون على صوغ هذه "التسوية التاريخية" القائمة على المبادئ الآتية:
1 - رفض "ثقافة الموت" التي عممتها اسرائيل على المنطقة من خلال الفعل الذي تقوم به ورد الفعل الذي تستدرجه، وارساء "ثقافة حياة" تقوم على نقيض المنطق الذي يجعل الحق والحقيقة حكراً على رؤية معينة، فيعتبر الذات خيراً مطلقاً والآخر المختلف شراً مطلقاً.
2 - الدفاع عن هوية المنطقة العربية وحق ابنائها دون سواهم في تقرير مصيرها، وذلك عن طريق تصويب مفهوم العروبة الذي تعرض لتشويهات في العمق على يد أنظمة عسكرية استخدمته مطيّة لبلوغ السلطة، وايديولوجيا لتسويق كل صنوف القمع في بلدانها، والعودة بالعروبة الى مفهومها النبيل، باعتبارها رابطة ثقافية وحساسية مشتركة كونتا نظرة أهلها الى أنفسهم والى الكون. إن مثل هذا الجهد ضروري وملحّ لوقف التشنجات العقيمة التي يتخبّط فيها العالم العربي، تراجعاً أو هروباً الى الأمام، وتأمين تنمية بشرية شاملة.
3 - الضغط على المجتمع الدولي للخروج من سياسة "الكيل بمكيالين" – من تطبيق القرارت الدولية وصولاً الى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل – التي هي في أساس سوء التفاهم القائم تاريخياً بينه وبين العرب، والمساهمة الجادة في ايجاد تسوية عادلة للصراع العربي - الاسرائيلي التي هي المدخل الأساس لوقف دوامة العنف في المنطقة، والتحاور حول طبيعة النظام العالمي الجديد الذي يفتقر الى التوازن والعدالة، وبناء شركة فعلية مع أوروبا من أجل عودة "المتوسط" منطقة تعايش وتقارب بين شعوبه وثقافاته ذات الأصول العريقة والامتدادات الشاسعة.
4 - ترسيخ وتطوير صيغة العيش المشترك الذي هو في أساس العقد الاجتماعي الذي حدده اتفاق الطائف والذي يتأسس على الاعتراف بالآخر في تمايزه وفرادته دون السعي الى الغائه او استتباعه، أو فرض انصهار عليه يلغي خصوصيته أو توحد يختزل شخصيته ببعد واحد من أبعادها. والعيش المشترك يقوم على احترام الحياة في تنوعها وغناها، ب¥دون اخضاعها لتراتبية تفقدها غناها، أكانت هذه التراتبية ثقافية، أم اجتماعية أم عددية، فتفرز الناس أقليات وأكثريات، وترسم في ما بينهم خطوط تماس سرعان ما تؤدي الى التصارع والتصادم.
5 - بناء دولة قادرة على حماية العيش المشترك وتحصينه. والدولة القادرة هي الدولة المحررة من هيمنة الطوائف عليها، دولة مدنية مرتكزة، كما جاء في المجمع البطريركي، على "التمييز الصريح، حتى حدود الفصل، بين الدين والدولة"، وعلى احلال "الانسجام بين حق المواطن - الفرد في تقرير مصيره ورسم مستقبله، وحق الجماعات في الحضور على أساس خياراتها". فالدولة المدنية هي التي تضمن مساواة المواطنين أمام القانون، كما تضمن احترام التعدد الطائفي، وهي القادرة على صون الاستقلال بوضع حدّ للتدخلات الخارجية التي تستدعيها الصراعات الطائفية بصورة دورية.
إن صوغ هذه "التسوية التاريخية" أمر ملحّ، وهو مسؤولية الجميع دون استثناء. فالفرصة المتاحة لتبديل قواعد اللعبة ليست بطويلة. علينا ألا نضيعها.
العقلية الأقلّوية هي الخطر على مستقبلنا
حرّك الإرهاب الذي يمارسه متطرّفون أطلقوا على أنفسهم اسم "تنظيم دولة الاسلام في العراق والشام" مخاوف الكثيرين من اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، فباتت مسألة الحماية مسألة أساسية، دفعت البعض الى عقد مؤتمر في واشنطن لطرح هذه المسألة، وبحث سبل تأمين الحماية المطلوبة للمسيحيين، في حين أن المطلوب كان تأمين الحماية للإنسان في منطقتنا، أكان هذا الانسان ينتمي الى أقلية مسيحية تتعرض في العراق لإرهاب "تكفيري" أم ينتمي الى أكثرية إسلامية تتعرض في سوريا لإرهاب "بعثي".
في ظلّ التحولات الكبرى التي يشهدها العالم العربي، يجد المسيحيون أنفسهم أمام سؤال من طبيعة وجودية: هل هم أقلية بحاجة الى حماية دائمة من خطر الأكثرية عليها، أم هم جماعة يتشاركون مع الجماعات الأخرى مسؤولية إدارة شؤونهم المشتركة والدفاع بعضهم عن البعض الآخر؟
في العام 1920، تصرّف المسيحيون كجماعة لا كأقلية، فرفضوا فكرة "الوطن القومي المسيحي"، مطالبين بقيام "لبنان الكبير" الذي يضمّ إلى الجبل ذي الأغلبية المسيحية مناطق ذات أكثريات إسلامية.
وفي العام 1943، تصرّف المسيحيون كجماعة لا كأقلية، فرفضوا بقاء الانتداب وناضلوا من أجل الاستقلال الناجز.
بدأت الأمور تتغيّر مع تغير قواعد اللعبة السياسية والانتقال من كتل سياسية عابرة للطوائف، كالكتلة الدستورية والكتلة الوطنية، الى أحزاب عمدت الى اختزال الانسان بمكوّن واحد من مكوّناته، هو المكوّن الطائفي، معتمدةً من أجل ذلك سياسة التخويف من الآخر.
جاءت حوادث العام 1958 في سياق هذا التحول الأساسي الذي أفشل في ما بعد محاولة الرئيس فؤاد شهاب إعادة تأسيس العيش المشترك بشروط دولة أكثر عدالة وحداثة تستطيع حماية لبنان واللبنانيين، فدخلت البلاد في حرب استمرت 15 عاماً (1975-1990).
عندما تصدّت الكنيسة للمنطق الأقلّوي
عمدت الكنيسة الى وضع المنطق الأقلّوي جانباً وإفساح المجال إلى التوصل مع المسلمين الى اتفاق، هو اتفاق الطائف، لإنهاء الحرب ووضع العيش المشترك في أساس شرعية الدولة والربط بين فكرتَي المواطنة والتعدد للمرة الأولى في الشرق العربي.
فقد عبّر المجمع البطريركي الماروني (2006) عن موقف مميّز من اتفاق الطائف يتخطى منطق المحاصصة الذي استخدمه أصحاب النظريات الأقلّوية لتبرير رفضهم الاتفاق. فقد جاء في نصّ المجمع ما يأتي:
"ساهمت الكنيسة المارونية في بلورة الأسس والمفاهيم التي ارتكز عليها اتفاق الطائف (1989). ونظرت الكنيسة إلى هذا الاتفاق على أنّه مدخل لطيّ صفحة الصراعات الماضية بين مَن كان يطالب، باسم العدالة، بتحسين شروط مشاركته في الدولة، وبين مَن كان يسعى، باسم الحريّة، إلى حماية الكيان وتثبيت نهائيّته. ورأت الكنيسة كذلك أنّ هذا الاتفاق يثبّت أولويّة العيش المشترك على كلّ ما عداه، ويجعل منه أساسًا للشرعيّة" (الفقرة 28 من النص التاسع عشر). كما رأت أيضاً أن "مقدّمة اتفاق الطائف حسمت الجدال حول طبيعة العقد الاجتماعيّ بين اللبنانيين، فاعتبرت أنّ العيش المشترك هو في أساس هذا العقد، وأنّ لا شرعيّة لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" (الفقرة 29 من النصّ التاسع عشر)
هذا الإنجاز أفشله مَن كان في ذاك الزمن طامحاً الى السلطة، وذلك بحجة أنه لا يتضمّن موقفاً حازماً من الوجود السوري في لبنان، فدخل في "حرب إلغاء" بين المسيحيين أدّت الى وضع البلاد تحت سلطة النظام السوري الذي أعاد إحياء المنطق الأقلوي من خلال عرض نفسه مدافعاً عن "الحقوق" المسيحية في مواجهة "أطماع" المسلمين.
مرةً جديدة، تصدّت الكنيسة للمنطق الأقلّوي، فكانت في طليعة المبادرين، بعد الانقسام الأهلي الذي أحدثته الحرب، الى ترميم العيش المشترك الاسلامي – المسيحي في لبنان. وذلك من خلال جهد استثنائي، بدأ مع السينودس من أجل لبنان (1995) واستمر مع الإرشاد الرسولي (1997)، وذلك لـ"تنقية الذاكرة" ومغادرة "ثقافة الحرب" وإعادة الاعتبار الى معنى لبنان ورسالته.
وفي العام 2000، تصرّف المسيحيون كجماعة لا كأقلية، فطالبوا مع بيان المطارنة الموارنة في 20 أيلول 2000، بخروج الجيش السوري من لبنان، وأطلقوا مع "لقاء قرنة شهوان" الجهود لتوحيد الصفّ مع المسلمين، وذلك ايماناً منهم بأن التوافق مع المسلمين هو الشرط الأساس لاستعادة السيادة والاستقلال. وجاءت المصالحة التاريخية في الجبل إثر زيارة البطريرك الماروني (5 آب 2001) لتؤكد أهمية التلاقي الاسلامي - المسيحي.
وفي العام 2005، تصرّف المسيحيون كجماعة لا كأقلية، فلعبوا دوراَ أساسياً في انتفاضة الاستقلال. وقد جاء في نصّ المجمع البطريركي الماروني ما يأتي:
"فبعد أن كانت كلّ مجموعة تبحث عن ضمانات لها خارج الشريك الآخر، قام استقلال لبنان في العام 2005 على موقف مشترك مسيحيّ وإسلاميّ، يؤكّد حقّ اللبنانيّين في أن يكون لهم وطن حرّ ومستقلّ، وأن يعيشوا فيه مختلفين من حيث الانتماء الدينيّ، ومتساوين في مواطنيّتهم. واللبنانيّون مطالَبون باستخلاص دروس الحرب، والإدراك أنّ مصير كلّ واحد منهم مرتبط بمصير الآخر، وأنّ خلاص لبنان يكون لكلّ لبنان أو لا يكون، ويقوم بكلّ لبنان أو لا يقوم، ذلك أنّه ليس من حلّ لمجموعة دون أخرى، ولا لمجموعة على حساب أخرى" (المجمع البطريركي الماروني، الفقرة 33 من النصّ التاسع عشر)
غير أن الصراع على السلطة دفع بقيادات مسيحية شاركت في انتفاضة الاستقلال الى التراجع عن موقفها والعودة الى المنطق الأقلوي، بحجة "خطر سنّي" يستهدفها، متجاهلةً التحوّلات التي أحدثها الرابع عشر من آذار والتي جعلت من شعار "لبنان أولا"، وهو شعار المسيحيين التاريخي، شعاراً اسلامياً بامتياز. استخدمت هذه القيادات شعار "الخطر السنّي" لتبرير توقيعها "ورقة تفاهم" توفر لها دعماً في طموحها الى السلطة.
هذا الصراع الذي لا تحدّه ضوابط، هو الذي دفع قيادات مسيحية الى تأييد النظام السوري ضد شعبه والتنبؤ بانتصاره السريع، الأمر الذي جعلها، على نحوٍ ما، شريكة في الجريمة ضد الإنسانية التي تُرتكَب في سوريا.
أخيراً هذا الصراع، هو الذي أوصل البلاد الى فراغ دستوري في لحظة شديدة الخطورة، وأدى الى التضحية بالمركز المسيحي الأول في السلطة، وذلك من قبل من يدّعي الدفاع عن حقوق المسيحيين.
¶¶¶
بهذا الحلّ يخرج المسيحيون من الخطر
المسيحيون هم اليوم في خطر، لكن الخطر لا يأتي من الخارج بل من الداخل، وتحديداً من هذه العقلية الأقلوية القائمة على التخويف من أجل الإتيان بقائد ملهم يتولى خلاص الجماعة.
إن الخروج من هذا المنطق يبدأ بالإقرار، كما جاء في نصّ المجمع البطريركي الماروني، بأن المسيحيين "ليسوا أقليّة ترتبط بعلاقات جوار وتساكن مع الآخرين، وتبحث عن سبل تنظيم تعايشها مع الأكثريّة والمحافظة على خصوصيّتها. إنّهم جماعة لها دور فاعل من خلال تواصلها وتفاعلها مع كلّ الجماعات في رسم مستقبل مشترك لها ولهم، يقوم على المبادئ التي تؤمّن للإنسان حريّته وتحفظ كرامته وتوفّر له العيش الكريم. وقدر الموارنة وخيارهم هو أن يكونوا عامل تواصل في هذا الشرق بين مكوّناته المتعدّدة وبينه وبين العالم، وقوة دفع نحو المستقبل في مواجهة التخلّف".
وهو يتطلّب أيضاً الإقرار، كما جاء في رسالة بطاركة الشرق الكاثوليك الأولى، بـ"أن المسيحيّين في الشرق هم جزء لا ينفصل عن الهويّة الحضاريّة للمسلمين، كما أنّ المسلمين في الشرق هم جزء لا ينفصل عن الهويّة الحضاريّة للمسيحيين. ومن هذا المنطلق، فنحن مسؤولون بعضنا عن بعض أمام الله والتاريخ".
تأسيساً على ما تقدم، فإن المهمة الأساسية لمسيحيّي لبنان والعالم العربي هي اليوم في العمل على إعلاء شأن ثقافة السلام والعيش معاً، في مواجهة ثقافة العنف والإقصاء التي لا تزال تُلقي بثقلها على إنسان هذه المنطقة من العالم.
تقوم "ثقافة الحياة" على قرار حاسم، هو قرار "العيش معاً" متساوين في حقوقنا والواجبات، ومختلفين في انتماءاتنا الثقافية والطائفية، ومتضامنين في سعينا نحو مستقبل أفضل لجميعنا، مسيحيين ومسلمين.
هذا القرار يتطلّب أولاً الشجاعة:
الشجاعة في الإقدام على "العيش معاً"، متجاوزين مخاوفنا الطائفية المتحدرة من الماضي، وغير باحثين عن "أمان زائف" يُغرينا به الانغلاق داخل "قبيلة" ما، أكانت قبيلة طائفية أم حزبية، تقليدية أم "حديثة"، موروثة أم اختيارية، محكومة لرمزية دينية أم محددة بلون أو راية أو شعار.
الشجاعة في الإقدام على "العيش معاً"، من دون أن يشكّك أحدنا في الآخر، ومن دون اعتبار الفروق مع الآخر المختلف، سبباً لتراتبية من أيّ نوع تسوّغ السيطرة عليه أو إقصاءه. فأن تكون مختلفاً عن الآخر، هو أمرٌ لا ينطوي على أيّ حكم قيمي. إنه بكل بساطة تعبير عن حالة طبيعية وحقيقة مجتمعية.
الشجاعة في الإقدام على "العيش معاً"، مدركين أن مستقبلنا المشترك لا يرتسم لمرة واحدة والى الأبد، بل يتطلّب عناية دائمة وتسويات متجددة، ومدركين أيضاً أن هذا القدر من "اللايقين" الاجتماعي ليس حالة شاذة، وانما هو ملازم لكل علاقة اجتماعية.
هذا القرار يتطلّب أيضاً، وخصوصاً، ذكاءً وفطنة:
فطنةً تجعلنا ندرك أن العلاقة مع "الآخر" المختلف ليست فقط ضرورة يُمليها علينا واقع العيش في مجتمع متنوّع، بل هي مصدر غنى لكل منا ولجميعنا. ذلك أن شخصيتنا إنما تتكوّن وتتشكّل من خلال علاقتها بالآخر الذي يضيف اليها أبعاداً جديدة. وهذه الإضافة تكون كبيرة وغنية بمقدار ما يكون الآخر متنوعاً.
ذكاءً يجعلنا ندرك أن غنى مجتمعنا وأسلوب عيشنا لا يتأتّيان من مجرّد التجاور والمساكنة بين طوائف مختلفة، بل من "العيش معاً" الذي يربط ما بين الطوائف بأواصر المودة والاحترام، والذي يجعل من المجتمع اللبناني بيئة نموذجية للتفاعل الانساني. هذا في زمن بات موضوع "العيش معا"، ولا سيما في ظلّ المتغيّرات الكبرى التي أحدثتها وتحدثها العولمة، يمثّل تحدياً كبيراً على صعيد الانسانية جمعاء.
فطنةً تجعلنا ندرك أن لبنان لا يستطيع التماثل مع أيٍّ من مكوّناته الطائفية. لكل طائفة خصائصها ومميزاتها، ولكن لبنان لا يُختزَل بواحدة منها، كما أنه لا يشكل حاصل جمع حسابي لتلك المكوّنات. إنه أسلوب عيش عدد من الطوائف معاً. هذا العيش معاً، أو العيش المشترك، هو جوهر وجود لبنان في هذا العالم، وسبب فرادته في منطقة تقوم دولها جميعاً على فكرة الانصهار والعصبية القومية.
أصبحنا اليوم، بعد نصف قرن من الحروب المتواصلة، الحروب الساخنة منها والحروب الباردة، أمام استحقاق مصيري. فبقاؤنا وبقاء أولادنا في هذا البلد بات مرتبطاً بقدرتنا على إحلال السلام فيه.
فالسلام هو البديل من الحرب الأهلية السنّية- الشيعية التي تتهدّدنا جميعاً في لبنان والمنطقة.
والسلام هو شرط لحماية لبنان من كارثة اقتصادية تنتظره بسبب تداعيات الحرب السورية وتهجير مئات الألوف إلى لبنان.
والسلام هو شرط لتجديد دور لبنان في محيطه العربي في لحظة التحولات الكبرى.
¶¶¶
أشعر في هذه الأيام بشيء من المهانة عندما أرى البعض يتوسل، باسمي، حمايةً من هنا أو هناك. أقول لهذا البعض إن حمايتي، كحماية شريكي في هذا الوطن، تأتي من مكان واحد، تأتي من دولة أتشارك معه في بنائها وإدارتها. وأقول أيضاً لهذا البعض إنه من المعيب المطالبة بحماية المسحيين والاستمرار في الوقت نفسه بالسكوت عن مجازر متواصلة في حقّ المسلمين.
هذا الكلام قلته في الخلوة العاشرة لـ"لقاء سيدة الجبل" الذي انعقد في 31 آب 2014.
أرى أن الوقت قد حان لوضع حدّ لهذا المسار الانحداري الذي حوّلنا من جماعة لعبت دوراً أساسياً في قيام الكيان اللبناني وبناء دولته، الى أقلية يدفعها هاجس الخوف الى البحث عن حماية لها من خارج الدولة، وعلى حسابها.
لا نريد حمايةً من الغرب. نريد منه أن يشاركنا في معركتنا من أجل سلام لبنان وسلام منطقتنا، وأن يعمل من أجل ذلك على تصحيح أخطاء ارتكبها وأوصلت المنطقة الى ما هي عليه:
خطأ إبقاء الصراع العربي- الاسرائيلي من دون حلّ، الأمر الذي ولّد حروباً دورية ونزاعات دموية.
خطأ التحالف مع أنظمة الاستبداد في المنطقة زمناً طويلاً وعلى حساب شعوبها.
خطأ تدمير الدولة في العراق وإبقاء مواطنيها من دون حماية.
خطأ السكوت على جريمة ضد الانسانية تُرتكَب في سوريا.
لا نطلب من الغرب سوى تصحيح أخطائه. أما خلاصنا الفعلي والحقيقي فبيدنا معاً وجميعاً.










 تويتر
تويتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز



 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة