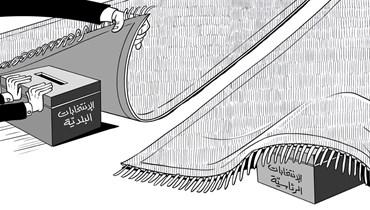لمَن تقرع أجراس البروباغندا؟ سيرة الدعاية السياسية سينمائياً
08-03-2022 | 21:01
المصدر: "النهار"
اضطلعت السينما بدور فعّال في الترويج والدعاية السياسية أثناء الحرب العالمية الأولى. دورٌ راح يتعزز، أكثر فأكثر، ضمن المؤسسات، بدءاً من الثلاثينات، ليصل إلى ذروته خلال الحرب العالمية الثانية. ما كان يمرّ سابقاً عبر الصحف، وجد، مع تطور تقنيات الاتصال والتواصل، منبراً جديداً له: الشاشة العريضة. الهدف دائماً: اقناع الشعب، والشعوب، عبر إقناع حفنة مشاهدين والوصول من خلالهم إلى الرأي العام، بضرورة شنّ الحروب، على هذا أو ذاك، حرصاً على المصلحة الوطنية العليا. البروباغندا في الشأن العسكري مثلاً أشكال وأنواع، ويختلف معناها واستعمالها بين طرف وآخر. هناك العمليات النفسية الموجهة للحلفاء، وهناك الحرب النفسية الموجهة للأعداء. في الديموقراطيات، يملك القادة المنتخبون من الشعب، الحقّ في إعلان الحرب على العدو، وليس عند الناس الا حقّ الاعتراض، لكن في معظم الأحوال عليهم ان يخضعوا لقرار السلطات. وكلّ الوسائل مبررة لاقناعهم بصوابية الخيار المتخذ.
السينما جُرَّت طوعاً أو غصباً عنها، إلى هذه الحملات التي تستهدف الرأي العام. من القيم التي روَّجت لها السينما خلال الحروب: الوفاء للوطن وصون شرفه وسمعته. والحجّة الأبدية: الخوف الذي يطلّ من خلف الحدود. واذا كانت هناك مبررات في عدد من الظروف، فهذا النهج لم يسلم من المبالغات والتفخيم. السينما قدّست مكانة الجندي، حامي السيادة وشرف الأمّة ومثال للتضحية في سبيلها. بيد انه في الكثير من الأحيان، وخلافاً لما يعتقده البعض حين يتعلق الأمر بالسينما الأميركية، كانت الأفلام التي تقرع أجراس البروباغندا، نتيجة مبادرات إنتاجية لا توصيات مباشرة ممن لديهم مصلحة فيها. كان المنتجون يقدّمون ما يطلبه المشاهدون. لا نكشف سراً اذا قلنا ان السوق هي التي تملك الكلمة الأخيرة حتى في الفيلم الدعائي. هي التي تملي في أحايين كثيرة موضوعاتها على كتّاب السيناريو، استجابة لمنطق العرض والطلب.

"الحصّة الليلية"، عن مجموعة عمّال في مصنع للأسلحة
في فرنسا، فيلم مثل "وجهٌ للحبّ" ساهم على نحو غير مباشر في ازدياد الطلبات للانضمام إلى الجيوش الكولونيالية. كان العمل من إنتاج "مركوري فيلمز"، شركة تنضوي تحت لواء الـ"أو ف أ" تمويل جوزف غوبلز. المنفعة التي عاد بها إلى الجيش، أسعدت كثيراً السلطات العسكرية في فرنسا آنذاك. البزة العسكرية في السينما كانت دائماً تثير مشاعر الفخر والاعتزاز، برغم العديد من المحاولات للعديد من السينمائيين المتنورين الذين أقدموا على معاكسة الموجات السائدة، لإزالة ظاهرة العسكرة، لكن بأدوات ولغة لا تبتعد كثيراً عن أدوات البروباغندا ولغتها. ينبغي التذكير بأن الكثير من الأفلام الدعائية تراهن على سذاجة الجمهور في تصديق كلّ شيء وأي شيء، خصوصاً في مراحل سابقة من التاريخ، حيث لم يكن تشكّل الوعي كما هو عليه اليوم، في عصر الفضاء المفتوح ودمقرطة الكلمة وتحول كلّ مواطن إلى صحافي هاو يشارك في صناعة الرأي العام. يجب الا ننسى أيضاً ان المعلومات يسهل إرسالها إلى عقل المتلقي عندما يكون مصير الوطن على كفّ عفريت، بحيث تزداد العواطف تخدراً.
في هذا الصدد، يقول المخرج الأوكراني سيرغي لوزنيتسا: “في بدايات السينما، وهنا أتكلم عن فترة العشرينات والثلاثينات، بدأ مخرجون أمثال أبراهام روم طرح أنماط مختلفة عمّا كان ينجزه أيزنشتاين. ظهر هذا البديل لأن طريقة أيزنشتاين جرى استخدامها للدعاية السياسة والإيديولوجية. كنّا نعلم أنه يعمل لصالح البروباغندا. "أكتوبر" على سبيل المثل عمل عظيم ولكن في الحين نفسه دعائي. هذا لا يمنع هذا، لأن هناك نوعية سينمائية لا يمكن انكارها. أجهل اذا كان أسلوبي يفيد لإنجاز أفلام دعائية. البروباغندا في حاجة إلى سرعة. كما تلاحظ المونتاج دائماً متوتر وعلى قدر من السرعة، لأن المخرج الذي ينجز الأفلام الدعائية لا يريدك ان تحظى بوقت للتفكير. علماً ان البروباغندا اليوم صارت أذكى بكثير ممّا كانت عليه في السابق”.

"انتصار الإرادة" لليني رييفنشتال، أشهر فيلم دعائي للنازية.
بحسب عالم النفس الألماني سيرج تشاخوتين، تسعون في المئة من المشاهدين يُمكن التحكم بعقولهم بنسبة كبيرة من السهولة، وفقط عشرة في المئة منهم يصمدون أمام تجربة الاستسلام للشعارات والوطنيات، طارحين الأسئلة على أنفسهم ومقيّمين ما يُقدَم لهم. هناك فيلمان نموذجيان في هذا المجال: "كلّ شيء هادئ على الجبهة الغربية" للويس مايلستون، من إنتاج “يونيفرسل"؛ و"صلبان من خشب" لرومان برنار، اللذان يتطرقان إلى التضحية والوطنية والشجاعة والواجب قبل أن نُزَجّ في تيمة تبدد الأوهام، الموضوع الذي رفعه إلى ذروته "الوهم الكبير" لجان رونوار عام ١٩٣٧. في هذا الفيلم من تمثيل جان غابان وبيار فرينيه وإريك فون ستروهايم، قال رونوار حقائق لم تكن السينما قد ألفتها بعد في ذلك الزمن: لا شرف في الموت. هناك الموت البارد والجامد ولا شيء آخر. بيد أنه، من السهل الملاحظة ان الجمهور لا يهتم الا جزئياً بالأفلام المناهضة للعسكر والتي تدين الحروب وتجاوزاتها، مفضّلاً عليها الملاحم وأفلام المغامرات التي تنتصر لبطولات الجنود. أغلب الظن ان الظمأ إلى غريزة التقاتل والتسلية التي تتيحها الأسلحة، أقوى من الاحتكام الى المنطق والعقل، عند شريحة واسعة من الناس.
كلّ الأنظمة، لا فقط التوتاليتارية منها، لجأت، في مرحلة من المراحل، إلى السينما البروباغندية. لينين سحرته قدرتها على تخاطب الجموع. "من بين كلّ الفنون، السينما هي الأهم بالنسبة لنا"، قال. كلّ دولة في حاجة إلى ان تطمئن شعبها، وتطمئن نفسها كذلك، على انها لا تزال الأقوى والأعظم، وانه لا ينبغي لأحد ان يخاف اذ دهم الخطر دياره. هذه الطمأنة لا تترك مكاناً للشكّ: الوطن سينتصر حتماً والمواطنون كلهم مشاركون في النصر، سواء ماتوا أو ظلوا أحياء. ولإقناع الناس بأن دولتهم هي الأقوى، كان هناك ما يُسمّى العروض العسكرية التي لم تخلُ البتة من الاغواء البصري. وبما ان العروض الحية لم تكن متاحة للجميع، كانت تُستعاد في بعض الصالات كمقدّمة للأفلام الجماهيرية الكبيرة.
في بعض دور العرض الألمانية، كانت هناك حصص للقطات مصوّرة تبعث العنفوان في صدور الشباب، وتعزز انتماءهم إلى النظام الجديد. أما في بريطانيا، فكان ما يُسمّى "النيوز ريل"، ينقل الحياة اليومية للجنود في أماكن عدة من نشاطهم الشخصي والعسكري. من هذه الأفلام: "بريد الليل" (١٩٣٦) الذي يسلّط الضوء على فضيلة العمل ليلاً. أفلام العمّال داخل المعامل أغوت الجمهور البريطاني، ممّا شجّع وزارة المعلومات على طلب إنجاز فيلم "الحصّة الليلية"، عن مجموعة عمّال في مصنع للأسلحة. طريقة أخرى لطمأنة الناس على ان لا مكروه سيصيبهم ما داموا يضعون إيمانهم في حكّامهم. وكيف ننسى "انتصار الإرادة" (١٩٣٥) لليني رييفنشتال، الآلة الدعائية المفضّلة لهتلر، الفيلم - التحفة الذي أظهر نفوذ الرايخ الثالث، واستحالة اطاحته. أعداد متجمهرة أمام الفوهرر تصفق للقائد الأعلى، نقلت المخرجة من خلالها للمُشاهد فكرة أن ألمانيا عادت إلى زمن العظمة التي كانت سُرقت منها. فيلم رييفنشتال الثاني "أولمبيا" (١٩٣٨)، كان تمجيدا للعرق الآري، استغلال دورة الألعاب الأولمبية للقول بأن الشعب الألماني هو الوارث الشرعي للثقافة الآرية ذات الأصول القديمة. هناك أيضاً الأفلام التي أُنجزت، والحديد كان لا يزال حامياً، أي كلّ تلك الوثائقيات التي توجهت إلى خطوط النار لالتقاط ما كان ينبغي التقاطه. أفلام وضعت الأصبع على التفوق التكنولوجي للفيرماخت. "معمودية النار" لهانس برتمان صوَّر تدمير بولونيا، وسحق الجيشين الفرنسي والبريطاني أظهر جلياً في "انتصار في الغرب" لسفاند نولدان، وهو الفيلم الذي جاء كردّ على "كلّ شيء هادئ على الجبهة الغربية"، الذي ندد بالحلّ العسكري.
أهم ما تجتمع حوله هذه الأفلام هو الحطّ من شأن العدو، تجريده من إنسانيته. هذا ما فعله الأميركيون باليابانيين بعد ١٩٤١. صوّروهم كحيوانات مفترسة. وهذا ما فعلته بعض الأفلام ذات الإيديولوجيات المنفرة التي شهدت خلطاً بين النازيين والألمان، أو تلك التي حمّلت اليهود مسؤولية كلّ مصائب الكون. من خلال تضخيم هنات العدو إلى درجة مضحكة أحياناً، وتداخل ناعم بين الاكذوبة والحقيقة، كانت الرسالة تجد طريقها إلى عقل المُشاهد، كما لو كان الأمر يتعلّق بإمرار رسالة عبر البريد. اليوم، مع تمكن الإنسان من التأكد من المعلومات عبر شاشته المحمولة في جيبه، من البديهي طرح سؤال مثل "لمَن تقرع أجراس البروباغندا؟”.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية