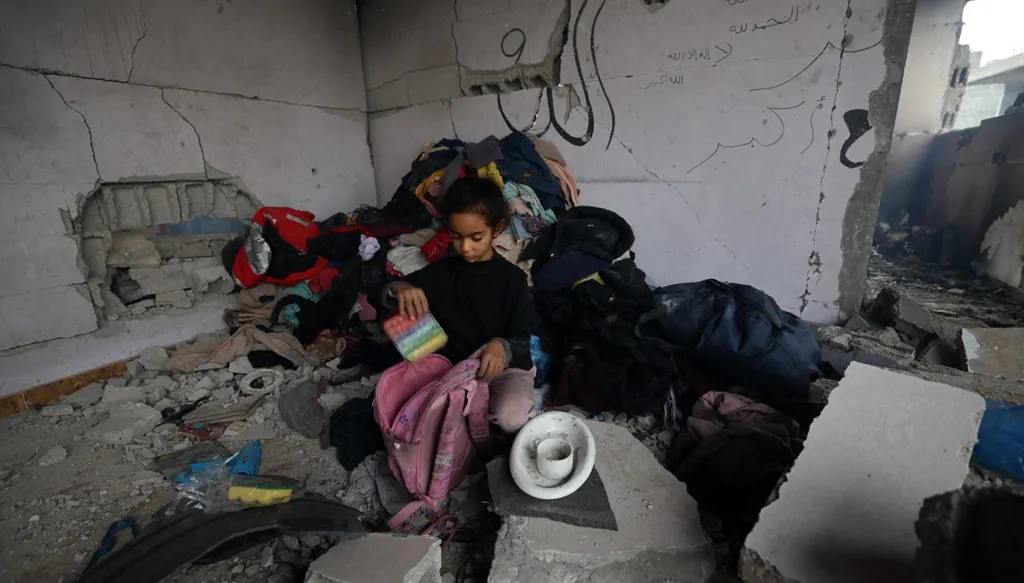القهوة عند العرب: فقهٌ وشعرٌ ونثرٌ وأمثال

القهوة من أعرق ما شرب الإنسان في تاريخه، نشأت في الحبشة (إثيوبيا حالياً) حيث ينبت البن البري في قرية صغيرة تُدعى "كفا"، وإليها يُعزى إليها اسم القهوة، وهذه رواية شائعة من روايات عديدة. طوّر العرب هذا المشروب وحوّلوه إلى ظاهرة ثقافية واجتماعية عالمية، فانتشرت من اليمن إلى البلاد العربية.
ومن الروايات التاريخية أن العلامة المفتي الصوفي جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد، المعروف بالذبحاني المذحجي اليماني، هو من أفضل على العرب بإدخال القهوة إلى مضاربهم في القرن الخامس عشر الميلادي. وكان حينها رئيساً للإفتاء في عدن، ولاحظ فوائد القهوة في أثناء رحلته إلى إثيوبيا، فأوصى بها طلابه وسيلةً للتغلب على النعاس ومساعدتهم على النشاط واليقظة، خصوصاً في أوقات الدراسة والعبادة.
من اليمن، نقل الحجاج القهوة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم امتدت إلى باقي المضارب. وحين بدأت العرب تحتسي هذا المشروب الجديد، المحضّر بطبخ دقيق البنّ على الجمر، لاحظت أنّه شريك الخمر في الإشباع، وحرمانه شاربه النّوم، فاتخذوا له اسم "القهوة". بقي الاسم في العرب أجيالاً وأجيال، عصوراً وعصور، حتى إذا دخلوا عصر الأتراك العثمانيين، تمدد اللفظ إلى التركية فصار "kahve".
فُتح أول محل لشرب القهوة في القسطنطينية (اسطنبول اليوم) في 1475. من الآستانة، حمل تجار البندقية هذا اللفظ إلى إيطاليا، فتحوّر إلى caffe. وذاع المشروب الحار الساحر في أنحاء القارة العجوز، فصار في فرنسا café، وفي بريطانيا العظمى coffee، وسمّاه الألمان Kaffee، وكتبه الأسبان والبرتغاليون café، كما الفرنسيون تماماً. وفُتح أول محل لشرب القهوة في فينيسيا ثم في إنكلترا عام 1652. أما في هولندا، فاختاروا له مصطلحاً إضافياً: Mocca... وموكا هذه مستوحاة من Port of Mokha، أي ميناء "المخاء" اليمني الذي كان يصدّر البن منه إلى العالم الجديد.
جدل فقهي
في القديم، أُطلقت العرب كلمة "قهوة" على الخمر، إذ كان "يُقهي"، فمن يشربه يفقد شهوته إلى الطّعام.
وفي "لسان العرب"، يقول ابن منظور: أقْهى عن الطّعام واقْتَهى أي ارتدَت شهوتُه عنه من غير مرض. وأقْهاه الشيءُ عن الطّعام كفّه عنه أو زَهَّدَه فيه. والقَهْوة الخمر سمّيت بذلك لأنّها تُقْهِي شاربها عن الطّعام. وحملت هذا الاسم في العصرين الأموي والعباسي. وذكرها ابن سينا في كتابه "القانون في الطب".
وأثارت القهوة جدلاً فقهياً واسعاً حول حلّيتها أو حرمتها. فحرّمتها جماعة من المشايخ مثل شهاب الدين العيناوي الشافعي وأحمد بن عبد الحق السنباطي، بينما عارضهم النجم القرني، وقال بتحليلها في كتابه "الكواكب السائرة بمناقب أعيان المئة العاشرة". ودافع عنها الشيخ أبو الحسن البكري المصري الشافعي قائلاً: "كيف تُدعى بالحرام وأنا أشرب منها؟".
استمر هذا الخلاف طويلاً، وأنتج إنتاجاً فقهياً وأدبياً من خلال الفتاوى والأشعار والمؤلفات التي واكبت ظهور القهوة.
شعراً ونثراً
أدت القهوة دوراً مهماً في الأدب العربي، فاستخدمها الكتاب رمزاً للتواصل الاجتماعي والترابط بين الأفراد. في أحيان كثيرة، كانت مرادفاً للضيافة والكرم، ما جعلها موضوعاً شائعاً في الشعر والنثر.
من بين الكتاب الأوائل الذين تعرضوا للقهوة الشيخ محمد بن سعيد الطبري والشيخ أحمد الكازروني. كما أشار الشيخ فخر الدين المكي الشافعي في رسالته "إثار" إلى جوانب ثقافية واجتماعية مرتبطة بالقهوة.
وجاءت القهوة لتحل محل ابنة الكرم في الشعر الجاهلي، بصفتها رمزاً للفتوة والفروسية. وجد الشعراء النبطيون في القهوة موضوعاً شعرياً ربطوه بنظم القصيدة وروايتها. فقال فيها أبو تمام الطائي:
"وقهوة كوكبها يزهرُ … يَسطَعُ مِنها المِسكُ والعَنبرُ
وردية يحثها شادنٌ … كأنّها مِنْ خَدهِ تعصرُ"
في الأدب المعاصر، قال الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش: "القهوة لا تُشرب على عجل، القهوة أختُ الوقت تُحتسى على مهل، القهوة صوت المذاق، صوت الرائحة، القهوة تأمّل وتغلغل في النّفس وفي الذّكريات".
وقال أيضاً: "أحنّ إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر فيّ الطفولة يوماً على صدر يوم وأعشق عمري لأني إذا مت، أخجل من دمع أمي!"، فغناها مارسيل خليفة، مانحاً لفظ القهوة تشديداً له معنى.
ثالوث اجتماعي عربي
في الثقافة العربية، تمثل القهوة ركناً في ثالوث اجتماعي: السيف والضيف والكيف. فالسيف إرث الرجولة والبطولة في الذود عن الحمى والشرف، والضيف ركن القيم الرفيعة لمجتمع الكرم والنخوة والسخاء، والكيف جلسة راحة وتباسط في مجلس العشيرة، والتي كانت المدرسة الحقيقية لتناقل التراث والقيم.
من الأمثال الشعبية الشائعة عن القهوة: "السادة للسادات والحلوة للستات، والقهوة يمين ولو كان أبو زيد (الهلالي) يسار". وفي المملكة العربية السعودية يقولون: "القهوة بالحب تنحسب"، أي أن القهوة ليست مجرد مشروب، بل هناك تجارب وعادات خاصة تزيد من جمال تناولها.
وثمة مثل آخر: "القهوة تجمع الأحبة"، وهذا يبرز أهميتها الاجتماعية والإنسانية في التواصل والتقرب بين الناس.
القهوة العربية حديثاً
في عام 2015، سجلت منظمة "اليونسكو" القهوة العربية في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، تلبية لطلب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة قطر مجتمعة، ما يعكس الأهمية الثقافية والتراثية للقهوة العربية على المستوى الإقليمي والدولي.
وتواجه القهوة العربية اليوم تحديات جديدة. ومتوقع بحلول عام 2050 أن يتأثر نحو 80% من إنتاج حبوب البن العربي بتغير المناخ، ما يدفع الى البحث عن بدائل مثل قهوة "روبوستا" الأكثر مقاومة للظروف المناخية القاسية.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نهضة جديدة في صناعة القهوة، لكونها أصبحت مركزاً رئيسياً في تجارة القهوة العالمية. ففي العام الماضي، زادت فروع مقاهي العلامات التجارية الشهيرة في المنطقة بنسبة 11%، واحتلت السعودية الصدارة بـ46% من هذه الفروع.
ساهم التقدم التكنولوجي في تغيير صناعة القهوة، بحيث زاد الاعتماد على الأتمتة في تحضير القهوة والمراقبة الحية للمحاصيل، كما باتت تقنية "البلوك تشين" لتتبع الحبوب أكثر انتشاراً.
طقوس تناقلتها الأجيال
- تتميز القهوة العربية بطقوس معقدة ودقيقة في التحضير والتقديم، تشبه القوانين. يبدأ التحضير باختيار حبوب البن وتحميصها قليلاً في مقلاة غير عميقة، ثم وضعها في هاون نحاسي ودقها بمدقة نحاسية. تُوضع القهوة المطحونة في الدلة النحاسية الكبيرة، ويُضاف إليها الماء والهيل والزعفران وأحياناً القرنفل أو الزنجبيل. بعد الغليان، تُسكب في دلة أصغر ثم تُقدم في أكواب صغيرة تُعرف بـ"الفنجان".
- يحمل المضيف "الدلة" بيده اليسرى وفناجين بيده اليمنى، ولا يقدمها باليسرى. في بعض المجتمعات البدوية يشرب المقهوي الفنجان الأول لنفسه للتدليل على حسن النية وطمأنة الضيوف.
- على المقهوي أن ينحني ليصبح الفنجان أدنى من صدر الضيف.وعند صبه القهوة ينزل خيطاً رفيعاً مع رفع الدلة من دون قطع الخيط.
- تُقدم القهوة أولاً للضيف الأهم أو الأكبر سناً، بحيث يُملأ ربع الكوب فقط.












 تویتر
تویتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز




 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة