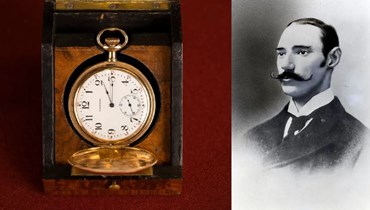الدينيّات اللبنانيّة: مسالكُ ضيّقة واختباراتٌ ملتبسة وتواطؤات مربكة
لمحته في زاوية من زوايا المكتبة الجامعيّة، فأسرعتُ إلى التخفّي والانحجاب رأفةً بي وبه، وفي حدسي أنّه سيفاتحني في أشدّ المسائل اللبنانيّة تعثّرًا وإرباكًا. فإذا به يناديني ملتمسًا أن أخاطبه على انفراد. حينئذ أدركتُ أنّ هذا الطالب الجامعيّ لن يهدأ له بال قبل أن يطّلع على جميع ما اختزنته تأمّلاتي في الواقع اللبنانيّ. ومن بعد أن أسرَّ إليّ أنّه قلقٌ على المعاثر التي تصيب الذات اللبنانيّة (المقالة الأولى) وحزينٌ لما استقرّ في قاع الوجدان اللبنانيّ من تناقضات خطيرة (المقالة الثانية)، سألني أن أكتب ثالثةً في الدينيّات اللبنانيّة علّه يدرك منها أصلَ التعثّر المربك. فتمنّعتُ في البداية وتردّدتُ تردّدًا عظيمًا ليقيني أنّ الدينيّات هي من أخطر المسائل اللبنانيّة على الإطلاق. غير أنّي أدركتُ أنّ اللبنانيّين يحقّ لهم أن يفوزوا بفهم أفضل لملابسات المسألة الدينيّة اللبنانيّة.
1- خصائص التديّن الساميّ المشرقيّ
لا شكّ في أنّ الأرض اللبنانيّة هي أرض ساميّة مشرقيّة عربيّة شهدت في جوارها وفي أجزاء منها ولادةَ الاختبارات التوحيديّة. فهي إذًا أرضٌ مفطورةٌ على التديّن العفويّ. وكلّ تأمّل في الدينيّات اللبنانيّة الراهنة ينبغي له أن يحرص على مراعاة هذه البنية التديّنيّة التكوينيّة الأصليّة. قد تكون هذه البنية ناشبةً في وجدان جميع الأمم التي اختبرت أطوارًا شتّى في نموّ وعيها. فاجتاز بعضُها الطورَ اللاهوتيّ، ومن ثمّ الطورَ الميتافيزيقيّ، إلى أن بلغ الطورَ الوضعيّ، بحسب ما رسمه لها الفيلسوف الفرنسيّ أوغست كونت. غير أنّ هذه الأطوار لا تختبرها الأممُ حكمًا على قانون التعاقب الإقصائيّ بحيث يُبطل كلُّ طور الطورَ السابق، بل قد تكتنفها الأطوارُ كلُّها في الزمن عينه والسياق عينه. وهذا الواقع الاكتنافيّ المتزامن هو الذي أعاينه في مجتمعات الأرض الساميّة المشرقيّة العربيّة، ومنها الأرض اللبنانيّة، ولئن ما فتئ الطورُ اللاهوتيُّ هو الطاغي الأعظم.
أمّا البنية التكوينيّة الثانية التي ينبغي مراعاتها في كلّ تناولٍ للدينيّات اللبنانيّة، فهي بنية التواطؤ المحكم بين الانتماء الدينيّ والانتساب العرقيّ أو القبيليّ. فالدين عند أهل المشرق العربيّ ناشبٌ في أصل الهويّة، بل قلْ هو الهويّة الأصليّة. وكلّ ما سواه يدور في فلكه. ذلك أنّ الإحساس بالارتباط العضويّ بالمشيئة الإلهيّة يخلق في الذات الساميّة المشرقيّة العربيّة إحساسًا فريدًا بالوجود يفوق جميع أصناف الإحساس الأخرى. ومن جرّاء مثل هذا الإحساس القويّ بالهويّة، عُزل الدينُ بالإكراه عن منقلبات التاريخ وتأثيراته، وتوطّدت أواصرُ ارتباطه بحاجة الجماعة إلى الهويّة المنيعة. وطالما أنّ الهويّة الذاتيّة، الفرديّة والجماعيّة، هي من أقدس الأقداس في تصوّر الوجدان الإنسانيّ، ولاسيّما العربيّ، فإنّ الدين اكتسب أيضًا سمةً في القداسة جاءت تضاعف من قدسيّته الأصليّة.
فالدين يكتسب قدسيّته من منابع شتّى. أوّلها سمة التعالي والسموّ والتجاوز المطلق التي يتّسم بها الكيانُ الإلهيّ، على نحو ما يختبره أهلُ الإيمان في العزّة الإلهيّة. وثانيها القدرة الجبّارة التي ينسبها الناسُ المؤمنون إلى هذا الكيان والتي تُرهب الإنسانَ على قدر ما تستهويه وتسحره. وثالثها انغراس الحاجة إلى الخلود والسعادة والمعنى في عمق أعماق الكائن الإنسانيّ، وهي حاجةٌ يعتقد الناسُ أنّ منبسطات التاريخ لا تحتوي على معالجة حاسمة لها. فلا بدّ من انفتاح علويٌّ يستقطب التوقَ الإنسانيّ الأبعد. وترتبط هذه المنابع بعضها ببعض بسببٍ من تصوّر التعالي الإلهيّ مزدانًا بأشدّ القوى على الإطلاق، وتصوّر القدرة الجبّارة في أبهى طاقاتها مقترنةً بالكيان الإلهيّ، وتصوّر الخلود والسعادة والمعنى مضمونةً ومكفولةً ومصونةً على أفضل الوجوه في حضن الاقتدار الإلهيّ.
وثمّة بنية تاريخيّة شبه ثابتة تكتنف البنيتَين الأولى والثانية، عنيتُ بها البنية الصراعيّة الناشبة في عمق الاختبار الساميّ المشرقيّ العربيّ حيث تصارعُ الأديان وتصارعُ الأنظومات اللاهوتيّة وتصارعُ الأيديولوجيّات هو على أشدّه منذ أقدم العصور حتّى اليوم. فالأديان التوحيديّة التي نشأت في هذه الأرض لا تُطيق التعدّد وتستكره التنوّع وتحرص الحرص كلَّه على توحيد الناس وصهرهم في بوتقة العبادات الواحدة والمعاملات الواحدة. وكلّ توحيد قاهرٌ من طبعه حتّى لو اتّصف بأسمى خصائل الرفق والوداعة والانفتاح الرصين والتحاور الهنيّ.
2. مصائر الإصلاح الدينيّ في الاجتماع اللبنانيّ
من هذه المعاينة ينبغي أن ينطلق كلّ جهد فكريّ يروم أن يتبصّر في واقع الدينيّات اللبنانيّة. وفي هذه البنية الثلاثيّة تنسلك كلُّ الاعتبارات التي يفوز بها المرءُ حين يحلّل هذا الواقع ويحصي مشاكله ويتحرّى عن انسداداته ويستشرف مآلاته. وممّا لا ريب فيه أنّ ما يسترعي الانتباه في بادئ الأمر إنّما هو هذه الغلبة القاهرة للإجماع التقليديّ على التوافق العقلانيّ في مسألة الدين في المجتمع اللبنانيّ. فاللبنانيّون، من بعد أن استشعروا خطر الوجود في خارج دائرة الهويّة الدينيّة، طفقوا يُخضعون كلَّ نقاش في الدينيّات لاعتبارات صون الهويّة التقليديّة الجماعيّة. كلُّ شيء مباح حين تراعي الجماعةُ أصولَ الحفاظ على الوديعة. وكلّ شيء محظور حين يصيب النقاشُ العقلانيّ الأصولَ القصيّة للتديّن الموروث. ومن ثمّ، فإنّ أفضل رسم لطبيعة التوتّر الناشب في المجتمع اللبنانيّ هو القولُ بصراع متفاقم بين الحرّيّة الفرديّة والهويّة الجماعيّة أو بين هذه الحرّيّة عينها والتقليد الجماعيّ أو بين الحرّيّة والأمانة أو بين الحرّيّة والمسؤوليّة.
وربَّ معترض يعترض على هذه الثنائيّة الصراعيّة التي أعاينها ناشبةً في وعي اللبنانيّين على تنوّع مذاهبهم. غير أنّ الاعتراض لا يستقيم حين يواجه المرءُ التشنّجَ الخطير الذي ينتاب المجتمعَ اللبنانيّ كلّما خرج أحدُهم ينادي بإصلاح أو بتجديد أو بتغيير. وقد تتنوّع مطالبُ الإصلاح والتجديد والتغيير وتتراوح بين الإنهاض الذاتيّ للدين الحقّ والابتكار الجريء لضروب أخرى من التدبّر العقلانيّ لقضايا الخلود والسعادة والمعنى. وبين الحدّ الأدنى المقبول والحدّ الأقصى المرفوض يتوسّط حدٌّ ثالثٌ يستوجب تدبيرًا صارمًا. ومثلما تتنوّع المطالبُ تتنوّع الردودُ الدينيّة الرسميّة. فإذا اقتصر المطلبُ الإصلاحيّ في حدّه الأدنى على تصويب طفيف أو تنقيح عابر أو تجميل سطحيّ سكتت المؤسّسةُ الدينيّة وأوحت برحابة الصدر والاحتضان الأبويّ. أمّا إذا أفضى المطلبُ الإصلاحيّ، في حدّه المتوسّط، إلى مساءلة نقديّة لمسلك المؤسّسة وللأعراف المتواترة وللتقاليد التفسيريّة المعتمدة، فإن المؤسّسةُ الدينيّة تستنفر وتسارع إلى التنديد والتأديب. أمّا إذا تجاوز المطلبُ الإصلاحيّ، في حدّه الأقصى، كلَّ الحدود ونادى باختبار آخر لحقائق الإيمان وتدبّر مختلف لمسائل العقيدة، فإن المؤسّسةُ الدينيّة تنتفض، وتهيّج الجماعةَ وتكفّر المبدعَ وترذله وتهدر حياتَه.
فلا عجب، والأمر على هذه الحال، أن يختار أغلبُ اللبنانيّين على تنوّع مذاهبهم الاكتفاءَ بالحدّ الأدنى، وممارسة التقيّة في الحدَّين المتوسّط والأقصى. ويقيني أنّ التقيّة لا ينفرد بها قومٌ من اللبنانيّين دون غيرهم، بل اللبنانيّون جميعهم سواءٌ في ذلك المسلك الاتّقائيّ. ذلك أنّ المناداة بالإصلاح في حدّه المتوسّط وفي حدّه الأقصى تزعزع السلطان الدينيّ في لبنان وتجلب الحكمَ على المنادين. فالمصلحون هم في عرف المجتمعات التقليديّة أهل البدعة والانشقاق. ولا سبيل إلى مهادنتهم أو مجاراتهم. بيد أنّ أهل المؤسّسة الدينيّة يتناسون أنّ مؤسّسي الأديان ومُلهميها وعظماءها كانوا كلُّهم من مصفّ المصلحين. فكيف يستقيم الإصلاحُ في الزمن المنصرم ولا يستقيم في الزمن الحاضر؟ ولمَ يكون التغييرُ في الزمن القديم زرعًا صالحًا متّصفًا بصفات الخلود ولا يكون التغييرُ في الزمن الراهن إنباتًا مفيدًا لتصوّراتٍ في الإيمان وإدراكاتٍ في العقيدة وتدبّرات في الالتزام الدينيّ تنهج لإنسان اليوم سبيلاً جديدًا في اختبار متطلّبات كيانه الداخليّ؟
3. الحاجة إلى الإيمان مرتبطةٌ بمشكلة تعريف الإنسان
لا ريب في أنّ الحديث عن الكيان الداخليّ للإنسان ضروريٌّ لفهم معاني الاختبار الدينيّ أو الإيمانيّ أو الروحيّ. وليس من سبيل آخر لإصلاح الدينيّات اللبنانيّة غير النظر في هذا الأصل الذي منه تنبثق كلُّ الاعتبارات، عنيت به البنية الأنتروبولوجيّة الأساسيّة التي منها يتكوّن الداخل الإنسانيّ. ولا يخفى على أحد، في هذا السياق، أنّ التركيبة التكوينيّة الإنسانيّة (أو ما يُدعى بالبنية الأنتروبولوجيّة) هي الأرضيّة التي تقوم عليها بناءاتُ الاختبار الدينيّ في جميع أبعادها العقائديّة والعباديّة والتنظيميّة. أعني بذلك أنّ الإنسان، حين تتّضح له هويّتُه الذاتيّة، يمكنه أن يدرك السبب الذي من أجله هو يؤمن أو لا يؤمن والكيفيّة التي عليها يختبر إيمانه منتظمًا في الأنظومة الدينيّة الأوسع.
غير أنّ مشكلة المشاكل تأتي من الاختلاف على تعيين هويّة الإنسان. فإذا قال قومٌ إنّ الإنسان مفطورٌ على تجاوز حدود العالم والتاريخ والكون، تهيّأ لهم أن ينظموا هذا الانفطار في البناء الدينيّ الأرحب حيث يتبيّن أنّ الإنسان يحتاج إلى قطب إلهيّ سامي الرفعة يحقّق له مثالَ التجاوز هذا. أمّا إذا انبرى قومٌ آخرون يقولون بتجاوز الإنسان لذاته في حدود العالم والتاريخ والكون، فإن الحاجة تنتفي إلى مثل هذا القطب الإلهيّ السامي الرفعة ويضطرّ الإنسان إلى الاكتفاء بحدود وجوده التاريخيّ المقترن بالحجم الزمنيّ للكون الهائل الاتّساع (ما يقارب 14 مليار سنة). وفي اعتقادي أنْ ما من أحد يمكنه أن يبتّ هذه المسألة طالما أنّ الإنسان ما انفكّ أحجيةَ الأحاجي وسرَّ الأسرار. فالعالم الأصغر السحيق الأعماق والعالم الأكبر الرهيب الاتّساع لا يزالان يستثيران في الوعي الإنسانيّ جميعَ ضروب التخيّل والابتكار. وما الاختبار الدينيّ سوى ضرب من ضروب التعاطي الرمزيّ مع محدوديّة الوجود الإنسانيّ.
والتنازع عينه ينطبق على التركيبة البيولوجيّة للخلايا الإنسانيّة، ولاسيّما الدماغيّة منها. فإذا اعتبر بعضُهم أنّ البنية الإنسانيّة تحتوي على جسد وروح (عقل) ونفس، وأنّ الجسد فانٍ والروح متحوّلةٌ والنفس خالدةٌ، كان له أن يفترض لخلود النفس موطنًا إلهيًّا يستضيفها، إلاّ إذا استضافها الكونُ الرحيب الذي منه انبثقت. أمّا إذا ظنّ بعضُهم الآخر أنّ الإنسان وحدةٌ كيانيّةٌ بيولوجيّةٌ تتفاعل في الداخل والخارج بحسب قوانين الحيويّة التي تضجّ بها خلاياه في أدقّ تشابك لها، فإنه يُسقط من حسبانه فرضيّةَ الاستضافة الإلهيّة للخلود ويكتفي بامتداد ذوبانيّ في الكون للوجود الإنسانيّ برمّته، فردًا وجماعةً، جيلاً بعد جيل، وجنسًا فوق جنس، واحتمالاً كيانيًّا على احتمال كيانيّ، ووعيًا مطّردًا في وعي مطّرد. وليس لنا أن نحرق أجساد اللبنانيّين الذي يقولون هذا القول لمجرّد أنّهم تصوّروا أمورًا لم يتصوّرها الآخرون.
4. الاختلاف الثقافيّ في فهم معاني الدين
وبناءً عليه، يمكن القول إنّ ما انتهجته البشريّةُ من سبُل دينيّة في العشرة آلاف سنة المنصرمة إنْ هو إلاّ اجتهادٌ رصينٌ محمودٌ للخروج بسبيل رمزيّ مقبول من مأزق المحدوديّة التاريخيّة. ولكلّ سبيل أنظومةٌ دينيّةٌ ترعاه وتصوّنه وتحرص على ديمومته. ولا يجوز المفاضلة بين السبُل الدينيّة إلاّ بالاستناد إلى بضعة من المعايير الناظمة للوجود الإنسانيّ برمّته. فإذا راعت الأديانُ كرامةَ الإنسان وحرّيّتَه وعزّزت المساواة المطلقة بين البشر وناصرت العدل والأخوّة والوداعة والتسالم والتحابّ، كان السبيلُ الذي تنتهجه للخروج من مأزق المحدوديّة سبيلاً مقبولاً.
بيد أنّ هذه القيَم التي يتحدّث عنها الناسُ في أديانهم (الكرامة، الحرّيّة، المساواة، الأخوّة، العدالة، الوداعة، التسالم، التحابّ) ليس لها في القواميس الثقافيّة المحلّيّة المدلولُ عينُه والمقتضى نفسُه. وغالبًا ما ينسى الناسُ أنّ معاني هذه القيَم تقترن بسبُل الاختبار التاريخيّ التي وسمتها بوسمها الثقافيّ الخاصّ. فتصوُّر كرامة الإنسان في الهند غير تصوُّر كرامة الإنسان في أفريقيا وغير تصوُّر كرامة الإنسان في أوروبّا، ولئن اعتقد أغلبُ الناس في الزمن الحاضر أنّ المعاني التي أجمعت عليها شرعةُ حقوق الإنسان هي المعاني التي يجب أن تلتزمها المجتمعاتُ الإنسانيّة في جميع أصقاع الأرض. إلاّ أنّ التباينات الثقافيّة تشير إلى غير ذلك.
وإذا ما أراد المرء أن يغوص غوصًا أعمق في نسبيّة هذه المعاني، تجرّأ فأعلن أنّ النصوص الدينيّة التأسيسيّة في جميع الأديان إنّما تستخدم هذه المفاهيم استخدامًا مرتبطًا بما استقرّ في وعي الجماعة الأصليّة المقتبلة من إدراك ثقافيّ نسبيّ لهذه المعاني. صحيحٌ أنّ هناك حقولاً دلاليّة مشتركة بين مختلف الأديان في فهمها لمثل هذه القيم، إلاّ أنّ الاختلاف ما انفكّ ناشبًا في التربة الأصليّة لنشأة هذه القيم. فإذا ادّعى أحدُهم أنّ قيمة الحرّيّة واحدةٌ في جميع الأديان والحضارات، فإنّ قولته هذه هي من باب التقريب الحسن النيّة. أمّا حقيقة الأمر، فهي أنّ للحرّيّة، على سبيل المثل، فهمًا خاصًّا في كلّ دين من الأديان التوحيديّة، وفهمًا خاصًّا في سائر الأديان الآسيويّة والأفريقيّة، وفهمًا خاصًّا في الأنظومات الثفافيّة العَلمانيّة الحديثة والمعاصرة. فلا يجوز أن يدّعي أهلُ الأديان أنّهم يحترمون قيمة الحرّيّة في الإنسان من غير أن يتبصّروا هم وسواهم في المضامين العمليّة والقانونيّة والإجرائيّة التي تستتليها مثلُ هذه القيمة. والأمر عينه يصحّ في سائر القيَم الأخرى.
لا غرابة، إذًا، أن يظنّ أغلبُ اللبنانيّين أنّ الدين، في أنظومته الثقافيّة التي استقرّ عليها في مطلع الألف الثالث، هو واقعٌ لصيقٌ بكيان الإنسان، فردًا وجماعةً، وأنّ الأديان تحترم القيَم التي تناصرها شرعةُ حقوق الإنسان، وأنّ التسالم والتحابّ ممكنان بين الأديان، ولاسيّما في لبنان، إنْ صفت النيّات وزهت الأخلاق وخلصت المساعي. والحال أنّ هذه الاعتبارات التي يضعها أغلب اللبنانيّين في موضع المسلَّمات القاطعة عادت لا تستوي على وجه موضوعيّ رصين. فاللبنانيّون، في القضيّة الأولى، ما اعتادوا قطّ البحث في الأصول القصيّة التي تنبني عليها اختباراتُهم الدينيّة. وعلى غرار وضعيّتهم الاستهلاكيّة الاتّباعيّة في الفكر والسياسة والاقتصاد، فإنّهم مستهلكون لما يأتيهم من مصادر السلطان الدينيّ المسيحيّ والإسلاميّ من خارج الاختبار اللبنانيّ الصرف. فالتفكّر في اللاهوت المسيحيّ وفي الكلام الإسلاميّ يقتصر على نقل خلاصات الفكر المسيحيّ العالميّ وخلاصات الفكر الإسلاميّ العالميّ، ما خلا بعض الحالات النادرة في الأوساط اللاهوتيّة المسيحيّة المعاصرة (إغناطيوس هزيم، جورج خضر، ميشال الحايك، يواكيم مبارك، بولس الخوري، غريغوار حدّاد) والحالات النادرة في الأوساط الإسلاميّة المعاصرة (موسى الصدر، محمّد مهدي شمس الدين، محمّد حسين فضل الله، محسن الأمين، محمود أيّوب، عبدالله العلايلي، صبحي الصالح، كمال جنبلاط).
ومع أنّ هؤلاء المفكّرين سعوا في صدق وتبصّر نيّر إلى انتهاج سبُل لبنانيّة من التفكّر الدينيّ الملائم لوضعيّات الاختبار الدينيّ اللبنانيّ، إلاّ أنّ مساعيهم ظلّت منضويةً تحت راية الانتظام الدينيّ الرسميّ، ما عدا قلّة منهم (غريغوار حدّاد، بولس الخوري، عبدالله العلايلي، كمال جنبلاط). ومن ثمّ، فإنّ الفكر الدينيّ الذي أنشأوه لا يجرؤ على مساءلة الأصول في كلّ اختبار دينيّ، ولا يجرؤ على استطلاع ضروب جديدة من التجاوز والارتقاء لا تُفضي بالإنسان إلى افتراض قطب التسامي الإلهيّ في خارج الرحابة الكونيّة. فكان فكرُهم الإصلاحيّ مقيَّدًا بالحدّ الأدنى، ونادرًا ما بلغ بهم إلى مشارف الحدّ المتوسّط. وخلاصة التفكّر الدينيّ اللبنانيّ في هذا السياق القولُ بأنّ الإيمان الحقيقيّ إمّا أن يكون إيمانًا بكيان إلهيّ يتجاوز الرحابة الكونيّة، وإمّا أن يكفّ عن الاتّصاف بصفة الإيمان الحقيقيّ
فينقلب اجتهادًا تأمّليًّا متحلّقًا حول محوريّة التاريخيّة الإنسانيّة.
5. شروط التعدّديّة الدينيّة البنّاءة: دوائر الرقيّ الثلاث
هذا في القضيّة الدينيّة اللبنانيّة الأولى. أمّا في القضيّة الدينيّة اللبنانيّة الثانية، ألا وهي مناصرة الأديان للقيَم الكونيّة التي تنادي بها شرعةُ حقوق الإنسان، فإنّ الفكر الدينيّ اللبنانيّ، على اختلاف واضح بين المقاربة المسيحيّة والمقاربة الإسلاميّة، ما فتئ يظنّ أنّ القيَم التي تنادي بها الأديان التوحيديّة هي أسبق وأسمى من القيَم التي تناصرها الشرعةُ الكونيّة. هي أسبقُ لأنّها منبثقةٌ من مضامين الوحي الإلهيّ الذي يرسم للإنسان طبيعته وجوهره وماهيّته. وهي أسمى لأنّها ترتقي بالإنسان إلى فوق ما ترتفع به قيَمُ الشرعة الوضعيّة. وفي هذا كلّه التباسٌ عظيمٌ ينبغي للّبنانيّين أن يدركوا مبلغ تأثيره السلبيّ. وما من سبيل لجلاء القضيّة إلاّ بالتمييز بين ثلاث دوائر من المثُل العليا التي تنشدها البشريّة أنّى ضربت في الأرض الفسيحة.
الدائرة الأولى هي دائرة القيَم الإنسانيّة التي يستخرجها الناسُ من ضرورات معيّتهم الإنسانيّة المحضة. عنيتُ بها قيم الحرّيّة والمساواة والعدل والأخوّة والتسالم والتوادع والتضامن. وهي قيَمٌ تقول بها الشرعة الكونيّة لحقوق الإنسان وتقول بها الأديان. غير أنّ قولة الأديان فيها تختلف بعض الاختلاف عن قولة الشرعة، كما سبق أن أوضحتُ ذلك. وقد يكون من أخطر مسؤوليّات المحافل الفكريّة الكونيّة أن تلتئم لتنظر في مقادير الاختلاف هذه.
الدائرة الثانية هي دائرة القيَم الروحيّة التي تنفرد بها الأديان وتنتصر لها من جرّاء ما انعقد في اختبارات أهل الصفاء الروحيّ من تطلّب رفيع لمقتضيات الوجود الإنسانيّ الرفيع. ومن هذه القيَم المدعوّة روحيّةً المحبّةُ الخالصة والاستضافةُ المجّانيّة والغفرانُ والتضحيةُ وإخلاءُ الذات في سبيل الآخرين. وممّا لا ريب فيه أنّ مثل هذه القيَم التي تقول بها الأديان نشأت من اختباراتٍ بشريّة محضة كاختبارات الأمومة الحاضنة والأبوّة الراعية والأخوّة المترئّفة. إلاّ أنّ الأديان تدّعي استلالها رأسًا من وديعة الكشف الإلهيّ. فلا ضير في ذلك ما دام الناسُ المؤمنون يُقبلون إلى هذه القيَم الرفيعة يختبرونها اختبارًا صادقًا بنّاءً. المطلب الموضوعيّ الوحيد في هذا كلّه أن يميّز الناس قيَم الشرعة من قيَم الرفعة الإنسانيّة هذه. فالشرعة لا يجوز لها أن تقول بالتغافر لأنّ هذه القيمة تتجاوز منطق العدالة القانونيّة. ولا يجوز أيضًا لأهل الأديان أن يستندوا إلى مثل هذه القيَم حتّى يدّعوا التفوّق على قيَم شرعة حقوق الإنسان الكونيّة ويدّعوا صحّة المصدر الإلهيّ ويدّعوا الاستعلاء على اختبارات الآخرين وحقائقهم. فهم، إنْ ادّعوا مثل هذا الادّعاء، وأغلب اللبنانيّين يسقطون في مثل هذه التجربة، خالفوا المضمون الحقيقيّ لمثل هذه القيم السامية.
أمّا الدائرة المثاليّة الثالثة، فهي دائرة الاختبارات الصوفيّة والتذوّقات اللاهوتيّة والتحسّسات الغيبيّة الخاصّة بكلّ أنظومة دينيّة على حدة. وهي دائرةٌ تنسلك في حلقة الاختبار الكيانيّ الجماليّ الصرف. وإلى هذه الدائرة تنتمي جميع القضايا الإيمانيّة والمقولات العقائديّة والاعتبارات اللاهوتيّة والكلاميّة التي تنطوي عليها الأنظومةُ الدينيّة في مقاربتها لسرّ الكيان الإلهيّ وتدبيره الخارق في الكون. ولا يخفى على أحد أنّ الإنسان في هذه الدائرة التذوّقيّة البحتة لا يجوز له الإثبات العقليّ أو النفي العقليّ. ولا يجوز له المفاضلة لأنّ الجماليّات ليست موضوعًا للتقويم العقليّ والحكم الموضوعيّ. ذلك أنّ حقائق الإيمان المسيحيّ، على سبيل المثل، تنبثق توًّا من اختبارات الجماعة المسيحيّة المؤمنة. وكذلك الأمر في سائر الأديان. والموقف الوحيد الرصين الذي ينبغي للمرء أن يقفه من هذه التذوّقات الصوفيّة اللاهوتيّة الغيبيّة هو موقف الاحترام وموقف التطلّب. فالإنسان لا بدّ له من أن يحترم ما أفرجت عنه الجماعاتُ المؤمنة من مختمر الآراء اللاهوتيّة في شأن الوجود الإلهيّ. ولا بدّ له أيضًا من أن يجعل هذه الجماعات المؤمنة تعتصم بأكبر قدر من الاحترام لمضامين الدائرة الأولى (شرعة حقوق الإنسان) ومضامين الدائرة الثانية (قيَم الرفعة الإنسانيّة). وحين يجمع أهلُ الأديان على احترام مقتضيات هاتين الدائرتين احترامًا رصينًا جادًّا ملتزمًا، فليؤمن من يشاء وليُبدع من يشاء وليُرجئ من يشاء.
6. الأسُس الثلاثة للتديّن السليم في لبنان
أمّا في القضيّة الدينيّة اللبنانيّة الثالثة، فإنّ اللبنانيّين يجب عليهم أن يدركوا أنّ استقامة الضمير وصفاء النيّات وصدق المساعي شروطٌ ضروريّةٌ للمعايشة اللبنانيّة، ولكنّها غير كافية لضمان استمرار المعيّة الإنسانيّة الحقّة في لبنان وتعزيز خصوبتها الفكريّة وتوطيد آثارها الطيّبة. فالمعايشة اللبنانيّة المبنيّة حصرًا على التقارب الدينيّ المسيحيّ الإسلاميّ لا تملك أن تنهض بالهيكل الوطنيّ الأرحب، بل يُعوزها سندٌ إصلاحيٌّ وطيدٌ. والسند هذا ينهض على ثلاثة أسُس. الأساس الأوّل التحوّل الدينيّ الفكريّ، والأساس الثاني الانعتاق من الخلفيّات المسلكيّة وموروثات الممارسات الطقوسيّة العتيقة المخالفة لقواعد احترام الحياة، والأساس الثالث التحرّر من مهالك التواطؤ المخزي مع السلطان السياسيّ الوصوليّ الانتفاعيّ. هي أسُسٌ إصلاحيّة تمكّن اللبنانيّين من الانتقال الهنيّ من طور التديّن المنغلق إلى طور التديّن المنفتح، ومن حالة المعايشة المتشنّجة إلى حالة المعايشة السعيدة، ومن وضعيّة العصبيّات العقيمة إلى وضعيّة الانتماءات المخصبة.
6. 1. الأساس الأوّل: التحوّل الفكريّ الدينيّ
في الأساس الأوّل ينبغي للّبنانيّين أن يُخضعوا عمارتهم الدينيّة لتفحّص نقديّ صريح جريء متطلّب. فالزمن العلميّ الكونيّ يخطو خطوات جبّارة في ميادين شتّى، منها فيزياء الذرّة ومبحث الخلايا والجينات وحقل الذكاء الاصطناعيّ والآلات الذكيّة شبه المستقلّة. وهذا كلّه يستوجب إعادة النظر الجدّيّ في المقولات التي قامت عليها الأنظوماتُ الدينيّة، على غرار ما حدث في سائر العلوم الإنسانيّة التي اضطرّت إلى مراجعة مسلّماتها ويقينيّاتها ومبادئها ومقولاتها وآليّاتها الفكريّة من بعد أن تجاوزتها العلومُ تجاوزًا مذهلاً. والأمر الأخطر هو أنّ الإنسان الذي اختبر التسامي الإلهيّ منذ بضعة آلاف من السنين هو غير الإنسان الذي يختبر اليوم معاني الوجود ورحابة الكون وقدرات الدماغ الهائلة. وليس ما يؤذي اللبنانيّين في معاصرتهم الفطنة للأسئلة الفلسفيّة العظمى التي اقتضتها طفراتُ العلوم المذهلة. وهم، ولئن عجزوا عن صياغة السؤال التجديديّ وابتكار الجواب الطليعيّ في النهوض بتصوّر آخر للدين وللإيمان وللغيبيّات، يستطيعون على أضعف الإيمان أن يواكبوا مواكبةً واعيةً ما تؤول إليه أبحاثُ الغرب المتطوّر في هذا المضمار. وقد يدركون، والحال هذه، أنّ أكثر المقولات التي يستخدمونها في التعبير عن إيمانهم عتقت وشاخت وكفّت عن الإفصاح عن حقيقة المسعى الإنسانيّ اللصيق بحقائق الوجود الكبرى. وليس يكفي القول بأنّ محدوديّة الإنسان في رحابة الكون المرعبة تقتضي وجودَ ناظم إلهيّ يدبّر كلّ شيء بحكمته الفائقة الوصف. فهذه العبارات أضحت اليوم في حاجة إلى صياغة جديدة للتحرّي عن معنى الكيان الإلهيّ المنفصل عن الكون، وعن معنى الحاجة الإنسانيّة إلى الخلود، وعن معنى المسؤوليّة التاريخيّة لأفعال الفرد والجماعة في تدبّر شؤون العالم والطبيعة والوجود والكون. وما إنْ يجرؤ مفكّرٌ لبنانيٌّ رصينٌ على تلمّس سبُل أخرى من التعبير عن الاختبار الإيمانيّ حتّى تعالجه المؤسّسةُ الدينيّةُ الطائفيّةُ بضربة قاتلة تزهق منه الروح وتجعله ينكفئ طريحَ اليأس والاستسلام. في حين أنّ الحداثة اللاهوتيّة الحقّة التي تليق بمقتضيات التفكير الموضوعيّ النقديّ الرصين ما انفكّت بعيدة المنال في أفق الاجتهادات الدينيّة اللبنانيّة والعربيّة الضيّقة.
6. 2. الأساس الثاني: الانعتاق من الخلفيّات المسلكيّة الدينيّة الملتبسة
وفي الأساس الثاني ينبغي للّبنانيّين أن يتبصّروا تبصّرًا ناقدًا في مسلكيّتهم الدينيّة الفرديّة والجماعيّة. فاللبنانيّون يسلكون في الحياة الاجتماعيّة من غير أن يدركوا الخلفيّات الدينيّة الموروثة الخفيّة التي تعمل في وعيهم الباطنيّ وتؤثّر تأثيرًا خطيرًا في بناء اقتناعاتهم وتصوّراتهم وأفكارهم وفي تعيين طبيعة أفعالهم وردودهم. من هذه الخلفيّات الربطُ المحكمُ بين المسلك الاجتماعيّ والاعتبارات العقائديّة الدينيّة. فالدينيّات هي التي تحكم المسلكيّات في الاجتماع اللبنانيّ. هذا في وجه عامّ. أمّا في الاستدلالات التفصيليّة، فإنّ اللبنانيّين، وهم في سوادهم خاضعون لعقليّة غيبيّة قدريّة استسلاميّة، يعتقدون أنّ الدهر لا يغيّر في أحكامه لأنّ ما يجري في منبسطات التاريخ هو من صنع القرار المكتوب في لوح المشيئة الإلهيّة الأزليّ. ويعتقدون أيضًا أنّ الطقوسيّات الدينيّة، إنْ هي حظيت بالرضى الإلهيّ، لها قدرةٌ سحريّةٌ على ضبط مسرى الحوادث، وأنّ العبادة الشعائريّة هي من أفعل ضروب الأمانة واكتساب الأجر. ومن الخلفيّات الدينيّة المربكة للاجتماع اللبنانيّ تسويغُ العلاقات الفوفيّة البطريركيّة الذكوريّة السلطويّة بإسنادها إلى المشيئة الإلهيّة. وتكثر في هذا المقام الأمثلةُ على ارتكاب المظالم على النساء والأطفال والفنّانين والمبدعين والمفكّرين باسم المشيئة الإلهيّة التي رسمت في فقه الأنظومة الدينيّة جميعَ الأحكام الضروريّة لبناء المجتمع السليم. إلاّ أنّ الأنظومة الدينيّة الفقهيّة هي نتاجٌ ثقافيٌّ نسبيُّ الانتماء. ولا يجوز فرضُ أحكامها على جميع الناس في جميع الأمكنة وفي جميع الأزمنة. وثمّة خلفيّاتٌ أخرى تُكره اللبنانيّين على التصرّف تصرّفَ الناس الخاضعين المستسلمين. وهي خلفيّاتٌ تستند في معظمها إلى تصوّر دينيّ موروث يقضي بإبقاء المسلكيّات الاجتماعيّة في أقصى منازعها الظلاميّة، وذلك كلُّه صونًا لما يفترضه المؤمنون من حكمة إلهيّة أرادت للناس أن يحيوا على هذه الشاكلة، ويتلاقوا على هذا المنوال، ويتعاقدوا على هذا الأساس، ويتفاعلوا على هذه الهيئة. ولكأنّ الفعل الإنسانيّ كلّه والتاريخ برمّته رهنُ المشيئة الإلهيّة القاهرة. بيد أنّ اللبنانيّين نسوا أنّ الإيمان الحقّ، بما هو توقٌ إلى السموّ الإنسانيّ الفكريّ والخلقيّ، لا يُبطل على وجه الإطلاق الحرّيّة الإنسانيّة، بل يستنهضها للاضطلاع الحكيم المسؤول بتدبّر المعيّة الإنسانيّة. ولا شكّ في أنّ مثل هذا التدبّر ينهج في كلّ زمن من الأزمنة سبيلاً جديدًا يعاصر المكتسبات المعرفيّة والمقتضيات المثاليّة الراهنة.
6. 3. الأساس الثالث: التحرّر من تواطؤ السياسيّات والدينيّات
أمّا الأساس الثالث والأخير فيقضي بإعتاق الاختبار الإيمانيّ الصرف من قيود السلطان السياسيّ. وليس بخفيٍّ على أحد أنّ الدينيّات هي الملعب المفضّل عند أهل السياسة في لبنان. فالسياسيّون يكرمون المؤسّسةَ الدينيّة ورجالاتها، وفي يقينهم أنّهم يهيمنون على وجدان المؤتمرين بأوامر المؤسّسة الدينيّة. والمؤسّسة الدينيّة تفرح باستدراج السياسيّين إلى صرحها، وفي يقينها أنّها تحصّن موقعها في الوعي اللبنانيّ وفي التركيبة اللبنانيّة. والحال أنّ الجميع يضحك على الجميع، إلاّ قلّة نادرة تعي خطورة التواطؤ ولكنّها لا تملك أن تفعل شيئًا. وتتفاقم خطورةُ الأمر حين يمنع مثلُ هذا التواطؤ اللبنانيّين من محاسبة رجال السياسة ورجال الدين. ذلك بأنّ التغازل الانتفاعيّ بين الطبقة السياسيّة والمؤسّسة الدينيّة يُفضي إلى توطيد منعة الاثنتين معًا بحيث يستحيل على المواطن اللبنانيّ الحرّ، إنْ قامت له قيامةٌ، أن يأمل بأيّ إصلاح منهما وفيهما. وقصارى القول في هذا التواطؤ أنّ الجميع يدرك عواقب تضعضع بنية الدولة اللبنانيّة وهشاشة المجتمع الدينيّ. وفي دهاء عظيم يعلم أهل السياسة أنّ الحسّ الدينيّ ناشبٌ في الصميم من الوعي اللبنانيّ وأنّ الطائفة هي الملاذ الأخير للّبنانيّين المشتّتين طوائفَ وقبائلَ وعشائرَ. فإذا بالسياسيّين يضربون على وتر المنعة الدينيّة والكرامة الطائفيّة حتّى يفوزوا بمبتغاهم. وأهل المؤسّسة الدينيّة ليسوا أقلّ دهاءً، إذ إنّهم يدركون مقام الزعيم السياسيّ في بنية الاجتماع اللبنانيّ، فإذا بهم يهادنون أهل السياسة، وبغيتهم أن يضبطوا وحدة الطائفة في بوتقة الزعامة السياسيّة الصاهرة.
وإنّي من الذين لا يرون فكاكًا من هذه الوضعيّة الملتوية إلاّ بتوعية اللبنانيّين وإشعارهم بمخاطر التواطؤ الدينيّ السياسيّ. ذلك بأنّ المجتمعات الراقية تختبر ضروبًا أخرى من السياسة الراقية ومن التديّن الواعي المنفتح. وقد يكون من أجدى السبُل إلى ذلك استعادة مقام العقل في الاجتماع اللبنانيّ. وليس أفعل في الوعي الإنسانيّ الفرديّ من التنشئة الصادقة على التمرّس العقليّ الموضوعيّ الناقد بوقائع الوجود والتاريخ. فالعقلانيّة الصادقة أضمن فوزًا بالسويّة الاجتماعيّة لأنّها تستنهض طاقات التفحّص الموضوعيّ والتحرّي العلميّ والتدقيق التقنيّ في تضاعيف الأفعال السياسيّة والدينيّة الملتبسة التي تتهدّد الاجتماع اللبنانيّ العطوب. ومن ثمّ، فإنّي أقترح على أهل الدين في لبنان أن يقبلوا بسلطة العقل العَلمانيّة المحايدة في نسبيّتها التاريخيّة. فالدين ينبغي له أن يستنير بسلطة العقل من غير أن يطلق عليها صفة المعصوميّة المطلقة. والشرط في ذلك أن يتيح العقلُ للاختبار الإيمانيّ أن ينشط في دائرة التذوّق الجماليّ للخير الأسمى من غير أن ينصّب نفسَه قاضيًا على هذا الحيّز الاختباريّ الأعمق في الكيان الإنسانيّ. فإذا استقام وازدهر مقامُ العقل في الاجتماع اللبنانيّ، كفَّ اللبنانيّون عن الخلط بين قطاع المدنيّات وقطاع الدينيّات، وسقطت التحالفات المميتة بين السلطان السياسيّ والسلطان الدينيّ.
7. الله سرّ الإنسان
حقيقة الحقائق في الدينيّات اللبنانيّة أنّ اللبنانيّين لا يفصحون عن حقيقة معتقداتهم لأنّهم يدركون أنْ ما من مكان أو إمكان حتّى الآن للمؤمنين المجدّدين الطليعيّين أو للمفكّرين الأحرار أو حتّى للملحدين المستنيرين. ولذلك ندر أن نشأت في لبنان حركةٌ دينيّةٌ إصلاحيّةٌ ذاتيّةٌ جريئةٌ، بل أتانا كلُّ جديد إبداعيّ من الخارج، فازدان المجتمع اللبنانيّ بالكنائس والفرق والبدع والشيع والجماعات والطرق والمحافل. وهذا كلُّه دليلُ تفوّر عشوائيّ لا مثيل له في التخبّط والتضارب والتنافر. وهيهات أن تنقلب لنا هذه الضُّمّةُ من الحرّيّات المتناحرة وهذه السبيكةُ من الطائفيّات المتصارعة موضعًا سنيًّا من مواضع التعدّديّة الكونيّة ما لم تنغرس كلّها في تربة العقلانيّة الموضوعيّة الناقدة المنفتحة المتطلّبة. ولذلك كانت حاجتنا في لبنان إلى تفكّر عقلانيّ جريء في الدين هي أشدّ ما تكون الحاجات الكيانيّة المصيريّة على وجه الإطلاق.
من تجلّيات هذا التفكّر العقلانيّ القولُ بأنّ الدينيّات اللبنانيّة تحتاج إلى ابتكار تصوّرٍ في الله يضعه في صميم الكيان الإنسانيّ بحيث يغدو الله هو سرّ الإنسان الأعمق. معنى هذا القول أنّ الله هو بُعد التطلّب المعرفيّ والخلقيّ الدائم في الوعي الإنسانيّ. ومعنى هذا القول أيضًا أنّ كلّ فعل أصيل صادق صالح نبيل راقٍ هو الموضع الأسنى لتجلّي الله في ثنايا الوجود التاريخيّ. على هذا الوجه أعاين ما تواتر إلينا من اختبارٍ لله في وعي السيّد المسيح وسيرته، أي في أفكاره وأقواله وأفعاله، وهو الصورةُ الناصعةُ لمثل هذا التجلّي، بالرغم من نسبيّة القرائن الثقافيّة التي تكتنف وجودَه التاريخيّ. وطالما أنّ الحضارات والمجتمعات ما انفكّت تلجأ إلى مقولة الله للتعبير عن أقصى ما يختبره الإنسانُ في عمق أعماق كيانه من توقٍ أثيل إلى التحقّق الذاتيّ والارتقاء الخلقيّ والأصالة الكيانيّ' الشاملة، فإنّ الله سيظلّ هو الأفق الأرحب الذي فيه تنسلك اجتهاداتُ الإنسان الساعي إلى فهم معنى وجوده في هذا الكون الرحيب. فإذا اقتنع الجميعُ بأنّ الله هو، في عمق مدلوله الرمزيّ، السرّ السحيق في الكينونة الإنسانيّة التاريخيّة، ازدهرت في الأديان اختباراتُها الصالحة وارتقت في المعتقدات الإيمانيّة مسالكُها المتنوّعة في الفهم الهنيّ المنفتح للحقيقة الإنسانيّة، وزهت في الالتزامات المسلكيّة المنبثقة من مقتضيات الانتماء الدينيّ الذاتيّ قيَمُ التصالح والتراحم والتسالم والتحابّ، وارتقت البشريّةُ كلُّها، على تنوّع استناراتها، إلى مقام أعلى من الصلاح والخير والجمال.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية