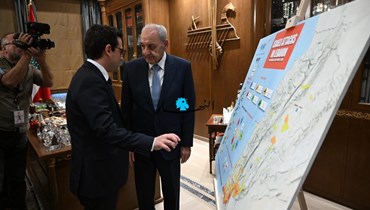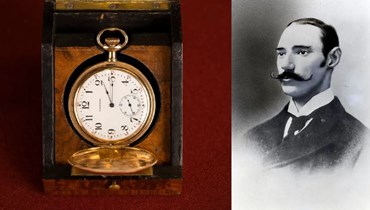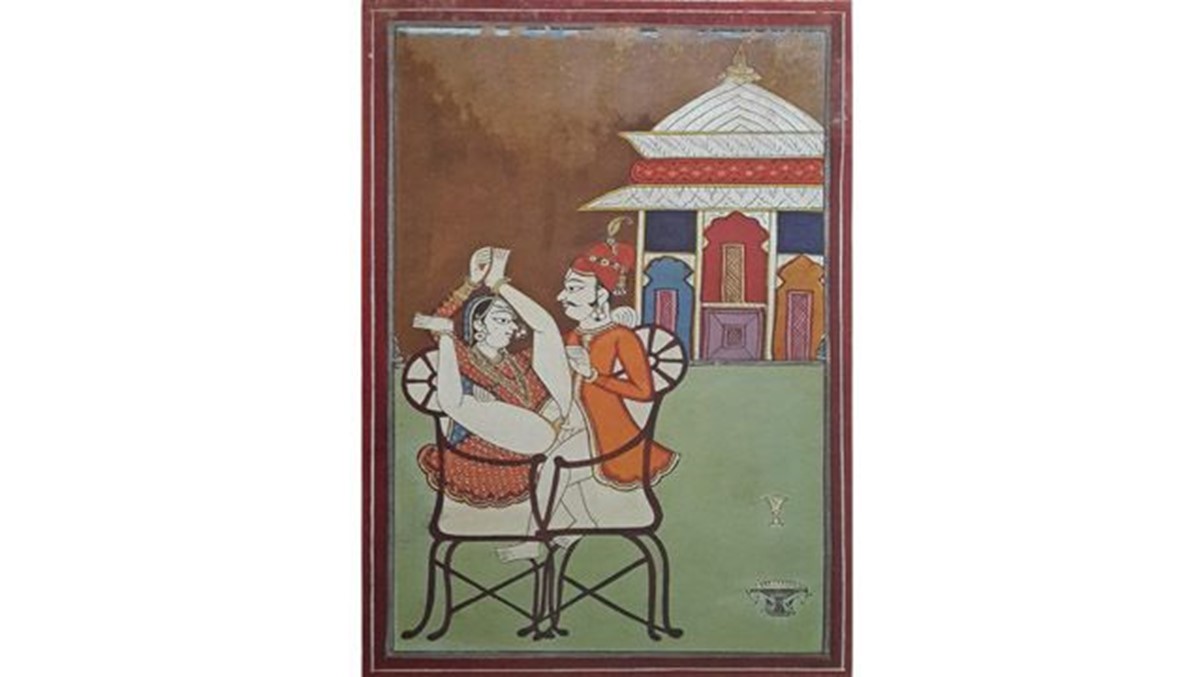على الكرسي الهزّاز في صالون بيتي في لوس أنجليس، أتأرجح، بعدما دخَّنَّا، سارة وأنا، سيجارتين من الحشيشة. بلادة حسّية وذهنية صافية تسري في جسمي ووعيي، فيما نتبادل عبارات، وأحيانا كلمات قليلة، تُباعد بينها مساحاتُ صمتٍ يتجمد الوقت فيها وأصداء الكلمات. أفكّر أن سارة نسخةٌ جديدة منقَّحة عن صديقتي القديمة، عذراء الشهداء، التي أخذ وجهها يصفرُّ ويصفرُّ قبل مدة من رحيلي عن بيروت، عندما أخذت تكسوه طبقةٌ رمادية دبقة، فرسمتُه، هكذا، على مساحة واسعة من لوحةٍ كبيرة أهديتها إياها، وكانت لوحتي البيروتية الأخيرة.
على مقعد في الصالون قبالتي، تواصل سارة تدخينها الشره، فتكاد تخنقني سحبُ الدخان. أتذكر أن عذراء الشهداء أخبرتني مرةً أن والدها المصاب بشلل نصفي أقعدَه في سني حياته الأخيرة، انتحر ذات صباح في غرفة نومه. مذ ذاك ارتسم مشهد انتحاره في مخيلتي: يضع في فمه فوهة مسدس، يطلق منه رصاصتين، يقع عن كرسيّه المتحرك، يرتطم رأسه بالأرض أمام ابنته، صديقتي الراوية، فتشاهدُ في أسفل رأسه ثقباً يخرج منه بخار خفيف يشبه السراب. من فمه يسيل دم ساخن على بلاط رخامي بارد صقيل يلمع بقوة غضب زوجته الهستيري الذي تصبّه عليه وعلى البلاط، كلما قامت بتنظيف البيت.
انتحر - روت عذراء الشهداء - خلاصاً من بؤس وضاعته وحياته المشلولة في كنف نقمة زوجته الساخطة الحرون، وأمِّها التي ما من مرة رأيتها إلا زاد يقيني بأن ابنتها، ولدت من امرأة عديمة الأنوثة، وتكاد تشبه جملاً أو دبّاً، عبثاً تجاهد وليدتُهُ، صديقتي، لاكتساب أنوثة تخلُّصها من إرث تلك الولادة. أنوثة كانت تشتهيها في فتيات ونساء متمدّنات تعرّفت إليهن في حياتها المدرسية والجامعية والحزبية والمهنية في بيروت، وكنتُ أنا شخصية أو مثالاً أساسياً لها، تشتهي اكتسابها وحيازتها في نفسها وجسمها وحركاتها. لكن تولّهها وتدلّهها المسعورين بتلك الأنوثة الجديدة، كانا مصدر نفورها من كل رجل يرغبها ويشتهيها رغبةً وشهوةً جسمانيتين حسِّيتين، أي غير عذريتين معذّبتين، تنطويان على استحالة تحققهما بوصول الرجل إلى جسمها الذي تنفر منه، وتتوق توقاً أليماً ومعذّباً لحيازة تلك الأنوثة الجديدة التي تشتهيها شهوة مستحيلة، جعلتْ وجهَها يصفرُّ ويصفرُّ، وجسمها يتعفّن بشهوته العذرية المتولِّهة بالشهداء. هذا ما تعتبره وتسمّيه حريتها أو تحرّرها من أمها، من إرثِ أمها وأبيها، القاسي القديم، الذي روت لي أخباره وحكاياته في أسلوب فولكلوري ساخر، تظن أنه يخلّصها من ذلك الإرث، ويمكّنها من تركه وراءها، فيما لم تكن سخريتها منه سوى تمرين مبتذل على استعادة نواته الصلبة الراسخة في شخصيتها ومخيلتها، والمتشبثة بحواسها ولغتها وأسلوبها ولهجتها في الكلام. أما الحرية والتحرر فما كانا شيئاً آخر غير عذريتها المعتفّنة التي وجدتْ لها مأوىً أو ميتماً في الحزب الشيوعي الذي ابتكر للهاربين التائهين الراغبين في التطهر من إرث أهلهم، طقوساً وشعائر رفاقية سمّاها الحزبُ النضالَ والتمرد، لتمويه نواة ذلك الإرث الصلبة ورغبات الرفاق المستحيلة في الخروج منها ومغادرتها.
أنا التي تعوَّدتُ في بيروت على كتمان اشمئزازي من تلك الطقوس والشعائر وسهراتها، غالباً ما كنت أطلقه قهقهاتٍ صاخبة في السهرات وفي اجتماعات خلية المثقفين الحزبية، فيعتبر الرفاق أن قهقهاتي تصدر عن أرمنيتي، نواتي الأرمنية التي كانوا يشتهونها شهوةً يسيل منها دبقٌ يشبه إصفرارَ العذرية ودبقها الرمادي على وجه صديقتي عذراء الشهداء.
* * *
فجأةً ينقطع استغراقي في هذا المونولوغ الصامت في ذاكرتي المتخيلة، إذ تناديني سارة باسمي، وتسألني إن كان أعجبتني الحشيشة، ثم تضيف ضاحكة: إنها نوعية ممتازة من جرود الهرمل في لبنان. أقول لها إنني أرغب في تدخين سيجارة أخرى، قبل أن أسألها عن أحوال أمها وأبيها، عن علاقتها بهما، ومشاعرها نحوهما، للتحقق مما تداعى في ذهني في نهاية المونولوغ الصامت: هذه الإنتحارية الناجية صنيعة طور جديد وطقوس جديدة من أطوار الحزب الشيوعي وطقوسه، أعقبا رحيلي عن بيروت.
تريدين سيجارة أخرى؟، تقول كأنها تكلّم نفسها أو شخصاً أخر سواي، فيما هي تقوم عن المقعد قبالتي، رافعةً يديها، متمايلةً هاتفة: تكرم عين الفدائييِّ، بالموت يزيدو تصحية. لكنها تتوقف فجأةً عن الهتاف، وفي نبرة متهكمة تتوجه إليَّ بالكلام قائلة: تسألينني عن أهلي، عن ماضيَّ؟! لقد ولّى زمنٌ كنتُ أعيد فيه البشر إلى أصلهم، إلى أهلهم، إلى مقابر طفولتهم، كي أعرفهم وأرسم تصورات عن شخصياتهم الراهنة، وعن أقدارهم ومصائرهم. هيا اهتفي معي لأولئك القابعين في مقابرهم هناك، في تلك البلاد، هيا اهتفي: يا غصن البارود مشنشل فدائييّ.
تصدمني هتافاتها هذه في اللغة العربية فيما نتكلم الانكليزية، فتستفيق في ذاكرتي المتخيلة مشاهد منسية من حياتي البيروتية، ثم أنتبه إلى أن ما سمّيتُه النواة الصلبة في مونولوغي الصامت عن عذراء الشهداء، سمّته سارة مقابر الطفولة في ردّها المتهكم على سؤالي عن أهلها. لكنني سمعتُ في ردّها باللغة الانكليزية أصداء نبرةٍ وموقف خطابيين متعاليين، كأنها تكلمت في لغة عربية فصحى كان يضحكني متكلموها في بيروت، وأسمع في الانتفاخ اللفظي لكلماتهم ضجيجاً يمتلئ بجثث كلمات محنَّطة.
تعود سارة الى الجلوس على المقعد قبالتي. أنتبه الى أنني، منذ جلوسنا الى طاولة العشاء في المطعم قبل أن أصطحبها الى بيتي، أردّد اسمها كلازمة كلما خاطبتها وتوجهتُ اليها بالكلام، ثم اختلط انتباهي هذا بأصداء فكرة قرأتها أمس في كتاب لوالتر بنيامين، فأقول لسارة: رجاءً ناوليني ذاك الكتاب الصغير عن المنضدة الى جانبك، يا سارة. آخذ الكتاب من يدها، اقلّب صفحاته قائلةً: اسمعي يا سارة، اسمعي هذه العبارات، فأسمع في صوتي، في أدائي كلماتي، نبرة حكميّة، شبيهة بالموقف الخطابي المتعالي في ما قالته قبل هنيهات. فجأةً تجاوبني: لا أحبّ القراءة، بل لا أجيدها، وتعذّبني. ذهني الصامت الشرود المستغرق في هلوساته البصرية، لا يقوى على القراءة. أنتِ اسمعي، أنا أقرأ - أقول لها محدّقة في صفحة من الكتاب في يدي، متأرجحة على كرسيَّ الهزّاز. بين لحظة وأخرى التفتُ اليها، وعلى هواي أحوِّر من الكتاب عبارات، فيما أقرأ: حين نردد اسم الشخص الذي نجالسه ونكلّمه، يا سارة، مرصعين بمشاعرنا، بأنفاسنا، بنبرة أصواتنا الرقيقة المتوسلة، حروف اسمه، راغبين أن يكون في لفظنا الحروف روحاً أو طيفاً لجسمه الماثل أمامنا، حينذاك نكون... هل تفهمين ما أقول يا سارة؟ هل تسمعين صوتي الآن؟
على المنضدة قربها تترك من يديها سيجارة الحشيشة المنشغلة بلفّها. في صمت تقوم عن المقعد، تقترب مني، تنحني عليَّ، تحتضنني، فأستقبل بشفتيّ ولساني لهفتها، تدفّق الشبق في قبلتها الطويلة. فيما هي تتراجع نحو المقعد، تثيرني حركتها العسراء، ويرتسم لوجهها في عينيّ طيف بعيد تضيئه ابتسامتها الكريستالية المائلة الى الطرف الأيمن من فمها. تنزع من قدميها حذاءها الرخيص ذا الكعب العالي. ضاحكةً أقول: كم رقيقة أنت، أقرب الى جسمك، الى وجهك، الى روحك وقلبي، بلا هذا النوع من الأحذية. لكنني ابتلعتُ أخيراً كلمة المبتذلة، وقلت بدلاً منها في نبرة متلهفة متوسلة: يا سارة. فتلتفت إليّ، تجلس على المقعد، تتناول عن المنضدة سيجارة من علبة تبغها الفرنسي، تشعلها، فأتابعُ أنا القراءة: بعد الإسم ولفظه تسحرنا التشوهات الصغيرة الظاهرة والخفيّة في جسم صاحب الإسم وحركاته. تقاطعني: لديَّ منها في جسمي وروحي أكثر مما تتخيّلين. صديقتي الوحيدة في بيروت، وهي شاعرة، قالت لي مرة إن كل من يحاول معاشرتي أكثر من ليلة عابرة، يكتشف أنه يتورط في جحيم. هل تصدّقين كل ما يقال يا سارة؟ هل تصدّقينها؟ ألاّ تظنّين أنها تبالغ قليلاً؟ - أسألها بصوت أسمعه نائياً، محايداً، منفصلاً عني، فيما أضع الكتاب على منضدة قربي. ثم أسمعها تقول: أصدّق نفسي. جرّبي، هل تجرّبين أن... وتتوقف فجأة عن الكلام.
بعد هنيهات من الصمت أسألها: ماذا أجرّب يا سارة؟، لكنني مثلها أتوقف عن ترجمة ما يدور في ذهني من أفكار الى كلمات. من حقيبتها الأخرى السوداء، تُخرج اللابتوب، تضعه في مكانها على المقعد، تسألني عن الرمز الذي يمكّنها من وصله بشبكة الأنترنت. تشغّله، تلتفت إليَّ قائلة: أحبّ أن أرقص، هل تحبّين الرقص؟ هل تسمحين لي بهذه الرقصة؟ أظل جالسة على كرسيَّ الذي أوقفته عن الاهتزاز، أسمع عزفاً يذكّرني بمطالع أغان غريبة كانت تُضجرني وتكئبني ألحانها وكلماتها الغثيانية كلما سمعتها في بيروت. تفردُ يديها، تمدّهما نحوي، تقترب مني، تتمايل في حركة متباطئة، تنقّل في هدوء متثاقل قدميها العاريتين على وبر السجادة الحرير أمامي في وسط الصالون. يدها تمسك يدي، تتمايل يدها الثانية في الهواء. أقف عن الكرسي، أنزع حذائي من قدميَّ، فيلامس باطنهما الوبر الحريري. يداها تحلُّ عقدة شعري المضفور، المتدلّي كذيل حصان من مؤخرة رأسي على ظهري. تُدخل أصابعها في خصله، تسرّحها، تبعثر بعضها على وجهي وعنقي وصدري. تغويني مداعباتها هذه، تُريني هيئتي كما لا أعرفها من قبل. أرفعُ يديَّ، كفّايَ تتمايلان في الهواء على إيقاع اللحن وصوت المغنية. سارتي تقترب مني، يتلاصق جسمانا، تضغط بأصابعها خاصرتيَّ، أغمضُ عينيَّ، فيغيب العالم من حولي، يمّحي، وتتلاشى في حواسي حدود جسمي. خصري يتعرَّق، ترتعش حلمتا ثدييَّ. وجه سارة يتأرجح في ضوء قمري في نفق، لهاثها يتدفق ساخناً الى أذنيَّ متقطعاً هامساً، فأسمع غمغمات، لهاث كلمات متقطعة، أصواتاً متخافتة، نبرات تتماوح بي، كأنني أعلو عن الأرض، أطير في سحب تخترق جسمي.
* * *
حين أفتح عينيَّ، أرى عينَي سارة تحدقان في وجهي، ثم تقول: ما سمعتِه، قصيدةٌ لصديقتي الشاعرة في بيروت. أهدتني إياها، وهي موجهة مني الى ابني الطفل المتوحد، هل أعجبتك القصيدة؟
أبتعد منها خطوتين، وفي نبرة هادئة مبطنة بسخرية خفيفة أقول: وأنا، أنا يا سارة، ألا ترفعينني معك؟ هل تتركينني وحدي على هذه الارض؟ أخاف عليك من الشعر يا سارة، من هي صديقتك الشاعرة هذه التي تسكنك؟ إنها أنت، أليسَ كذلك؟ لا تجاوب. تظلّ ترقص رقصتها المتمايلة البطيئة المتثاقلة. أعود الى الجلوس على الكرسيّ الهزاز. أنظر الى قدميها، أُبصر التشوّه الأول في جسمها: قدماها مسطحتان، مكتنزٌ باطنهما بزائدتين لحميتين في وسطهما تجعلانهما مسطحتين تماماً في ملامستهما الأرض.
أنا مَن طوال عمري أنفر من أمثال هذه الأقدام المسطحة، أشفق على أصحابها، أخاف منهم خوفي الهستيري من ذوي العاهات، أقعدني تشوّه قدميها على طرف السجادة الصغيرة أحدّق في حركتهما الهادئة الراقصة، مأخوذة برغبة في ملامسة تشوّههما بشفتيَّ، فيما أسمع من الأعلى صوت سارة تقول: لست بشاعرة. لي في بيروت صديقة مثل أختي التوأم، أو قرين لي يكتب الشعر من أجلي ويخاف منه عليَّ. أنا أحبّ الرسم والرقص، متى ترسمين وجهي؟ فأقول لها في نبرة حاسمة كنبرتها: إسمي ماريان يا سارة، أحبّ أن أسمعه بصوتك. هيا قولي: متى ترسمين وجهي يا ماريان؟
تظل تتمايل في صمت، فأتمدد قرب قدميها تاركةً فستاني الواسع الفضفاض ينحسر عن فخذيَّ حتى أسفل بطني، وأقول: هل تشعرين مثلي يا سارة بأننا منقطعتان غريبتان، كأن لا أحد سوانا في هذا العالم؟ بصوت يمتزج فيه الرجاء بالتوسل والسخط تقول: توقفي عن مناجاة اسمي، توقفي أرجوك. هذا جسمي هنا، خذيه، ماذا تريدين مني؟! ثم تبدأ تنزل عن خصرها بنطلون الجينز الضيق الملتصق قماشه الخشن القاسي بجلدها، فينكشف في عسر سروالها الداخلي الأسود السميك على خصرها وردفيها وثنيات فخذيها الخلفيتين والأماميتين. كيلوت قديم يذكّرني بشبابي الآفل، كأنني أبصره في مشهد سينمائي بالأسود والأبيض. بخفة متباطئة تُمِرِّ باطن قدمها اليسرى على فخذي، فأرتعشُ مُثارةً من أقاصي عريي في عزلات مراهقتي أيام كنت أقف أمام المرايا أرسمني في غرفتي ببيت أهلي في بيروت. لكنني من الأسفل، من حيث أتمدد على السجادة، أبصر وجه سارة طافحاً بابتسامة مائلة متجمدة هذه المرة، كنورٍ ألماسي ماجن في عينيها وعلى شفتيها. إنها تطوّح بي في متاهة أزمنة متشظية - أفكر - ولا تكفُّ عن مفاجأتي: سريعاً تسحب قدمها عن فخذي، تركض مغادِرةً الصالون إلى المطبخ.
* * *
من أين لها بهذه الخفّة الجسمانية الآن؟!، أتساءل. فمنذ لقائنا على الرصيف تحمل جسمها متثاقلة في كل لحظة وحركة، فيشدّها نحو الأسفل، إلى الأرض التي قالت قبل هنيهات إنها تتوق إلى الارتفاع عنها، مسحورة. بماذا؟ بالجمال الليلي لوجهها الغريب عن جسمها الذي يعيش حياته الأرضية اللزجة، منفصلاً عن وجهها، كأنها تجرّ جسمها خلفها، ثقيلاً، متشردّاً، مخموراً بالنوم النهاري الثقيل حتى الغروب، فتسلّمه إلى شهوات الليل، كي ترفعها الى السحاب في رحلة متخيَّلة عبر أساطير الأوّلين عن الخلق، وانتقال الكائنات من الطور المائي الى النباتي، فإلى طور الزواحف والطيور؟ لكن هروبها المذعور من أضواء النهار المسنَّنة يهوي بها إلى عتمة الليل، وشهوة الإفتراس العمياء كما في أوكار الضباع، وقيعان البحار التي حدّثتني في المطعم عن شغفها الليلي بعويل حيتانها الذي تسمعه في متاهات أرقها، مستوحدة قبل أن تتوضأ بحليب غلس الفجر، فتأخذها غفوة رمادية تبصر في مناماتها الكابوسية أنها أفعى مجنَّحة تطير من سفينة نوح الى قفر اليابسة ما بعد الطوفان.
ما الذي في لقيطتي المجهولة، في كلماتها، يبعث في مخيلتي هذه التهاويم الأسطورية؟ - أفكّر قبل أن أناديها: هيا يا سارة تعالي، تعالي لأرسم وجهك الآن.
* * *
تطلُّ من باب المطبخ، ثم تتقدم نحوي في خطىً متباطئة، حاملةً زجاجة نبيذ أبيض وكأسين فارغتين. تضع الكأسين على المنضدة وسط الصالون، تصبّ فيهما النبيذ، ترفع الزجاجة الندية الباردة، تحدّق فيها، تقترب مني، تحدّق في عينيَّ، تسكب بطيئاً بطيئاً قطرات من النبيذ. قبل وصول القطرات الى جلد فخذيَّ، يشتعل عريهما، تلقائياً تنفرجان، فتقعد سارة بينهما، وعن جلدهما تروح تلعق النبيذ بشفتيها ولسانها الساخن.
يا إلهي، يا للروعة يا إلهي، ارفعني الى تلك السحب، ارفعني - أتمتمُ مغمضةً عينيَّ، فيما يدا سارة تمسك أطراف كيلوتي على خصري، تجذبُهُ، أرفعُ ساقيَّ عالياً، فتحرّرني منه. لم أكن أتوقع أن يتوغل لسانُها في شعر عانتي، ولا أن يتدفق ماء أنوثتي، كأنما من أقاصي جسمي، فأتأوَّه، أئنُّ، ملتاعة، أكاد أصرخ مردّدة: سارة، سارة، سارة، ثم أسمع صوتها، فحيح صوتها، يلفظ اسمي في نبرة مترجيّة، أليمة، كأنها تضرُّعٌ نائح، فأرفع جذعي ورأسي، أحتضنُ بيديّ رأسها، أرفعُهُ من بين فخذيَّ، ألتهم بشفتيَّ ولساني شفتيها، لسانها، لعابها ممزوجاً بمائي، وبأصداء إسمي. يتعانق جسمانا، أهمس في أذنها أن تفكَّ أزرار فستاني عن صدري، أن تنزع حمّالة ثدييَّ، أن تدعني أبصر لسانها على حلمتي، فتنشر كلماتي الهامسة هذه شهوتي وميضاً بصرياً على جلدي. تمسك سارة أطراف بلوزتها السوداء على خصرها، بحركة هادئة ترفعها عن جذعها، تخرجها من رأسها، ترميها جانباً، فينكشف ثدياها، يرتفعان مع حركة ذراعيها، يهبطان متقلّصين، يستقران مكتنزين متصلّبين.
فكرة أنها بلا حمّالة صدر تحت ثيابها، تذكّرني برغبتي القديمة المنسيّة: أن أخرج من بيتي، فأمشي في الشارع بلا كيلوت، بلا حمّالة ثديين، تحت فستاني الصيفي الواسع الفضفاض.
* * *
غادرتني تلك الرغبة، أو ماتت، منذ رحيلي عن بيروت. ظللتُ أكتُمها وأؤجّلُها حتى شجّعني الرسام، عشيقي البيروتي الأخير، على أن أفعلها، فأخذتُ، كلما ذهبتُ للقائه في مرسمه، أرتدي فستاناً صيفياً أو معطفاً شتوياً، أسودين طويلين، عارية الجسم من أي قطعة ثياب تحتهما.
كان جسمي فتيّاً بعدُ، فيرتعشُ، على مقعد سيارة التاكسي الخلفي، بشبقٍ خيالي فاسق، حتى وصولي الى المرسم، وفيما الرسام يلتهمني واقفين وسط المرسم، قبل أن يتمدّد عارياً على سجادة على الأرض، فيلهبُ الشبق الفاسق جسمي المغطّى بالفستان أو بالمعطف، فيما هو يدخلُني، أُدخِله فيَّ، أقعدُ منتصبة على جسمه العاري تحتي. متمادية قوية عاصفة أبلغ نشوتي، كما لا أبلغها قط حينما أكون عارية من الثياب فوق أجسام رجالي.
كان يفتنني الجماع في صالون أو حجرة للجلوس يسكنهما غياب سكانهما المجهولين، أو الذين نعرفهم معرفة وثيقة أو عابرة، فتضاعف هذه الأماكن وأثاثاتها إثارتي، تفسّح مداها، تطلق شبقها في مخيّلتي ومسام جلدي، فأشعر بأنني خفيفة وخارج جسمي، غريبة عنه وعن رجالي، كأننا نلتقي في علانية تحرّرنا من الألفة الحميمة الضيّقة للقاءات المعتادة في غرف النوم على الأسرّة. كل شيء في تلك الأماكن يجعل طقس الجماع غريباً، يوسّع مساحته الغرائزية، يدفعه الى مجون فاحش غير متوقع: كثرة الأثاثات، حضورها إذ تستقبلنا كغريبين عنها. كلماتنا وحركاتنا المستريبة، وأصداؤها، ترتد إلينا كأنها تصدر عن شخصين آخرين سوانا. الموسيقى الليلية السوداء الغامضة، إذ تنشر في المكان وعلى أشيائه غلالات غير مرئية. الإضاءة الخفيضة الداكنة المنبعثة بلا انتظام من الزوايا وفي فسحات ظليلة. قطع ثيابنا المرمية على غير هدىً هنا وهناك، على مقعد أو كرسي أو طاولة، أو على الارض. عرينا الفوضوي غير المكتمل... وذاك الخمول الراكد في جسمينا الملقيين بإهمال في المكان الخطأ، منهكين صامتين.
هل لا تزال تغريني مثل هذه اللقاءات برجال اصطحبوني أو اصطحبتهم الى بيوت التقينا فيها لمرة أولى وأخيرة؟ بيوت أو غرف في فنادق بعيدة مجهولة تحضر لها في ذاكرتي المتخيلة صور مفاجئة منقطعة لا أقوى على إدراجها في مسار متصل لحياتي. هو عدم تكرار تلك اللقاءات الحميمية المنقطعة مع أولئك الرجال، ما حرّرني من أن يطالب أيٌّ منا الآخر في شيء، إذا التقيتُ مصادفة بأحدهم في مكان عمومي، أو في مناسبة عامة أو خاصة، فلا ينشأ بيننا سوى ذلك التواطؤ الخفي الخفيف بين شخصين جمعهما، قبل سنين، لقاء حميم عابر. غالباً ما كان لقاء المصادفة العلنية العابرة يطلق ضحكتي المقهقهة التي تشي بأنني أستمتع، بلا خشية ولا اضطراب، بخجلي الأنثوي المثير، وأختبر إن كان لا يزال مثيراً، من دون انطوائه على دعوة مني لتجديد اللقاء الحميم القديم الذي يدغدغ أنوثتي الحرة الفاسقة، بقاؤه وأمثاله من اللقاءات، أيقونات فريدة في متحف حياتي. أحياناً، في مداعبة متخابثة ماجنة، كنت أقول لبعض من أولئك الرجال، إنني أحب لقائي العلني العابر هذا بهم، أكثر مما أحببتُ تلك المجامعة الوحيدة العابرة.
* * *
ظلالُ مشهد قديم لأحدهم جالسا عارياً على كرسيٍّ وسط إنارة شحيحة شاحبة في ركن صالة للجلوس، تعبر في ذاكرتي المتخيلة، فيما أقول للقيطتي سارة في صالون بيتي، إنني للمرة الأولى في حياتي أجرّب الجماع مع امرأة، ثم أسألها: وأنتِ يا سارة، هل أنتِ سحاقية؟
بطيئاً بطيئاً تُمِرّ شفتيها على عنقي نزولاً الى صدري، تُخرج ثدييَّ من فتحة فستاني، ترفع رأسها، فأتمدَّد على السجادة، فيما تروح هي تروي: في بيروت تركتُ قرينتي الشاعرة، بعدما عشقتني وهجرت زوجها، فأخذتُ أصطحبها الى سهراتي الماجنة. في واحدة من تلك السهرات ذهبنا بعيداً في الكحول والحشيشة، حتى رأيتُنا عاريتين نرقص على أغنية "أنت عمري" لأم كلثوم، فيما الساهرون والساهرات مرتمون على المقاعد في الصالون الواسع، منطفئين حتى عيونهم المحدّقة فينا في جمود كجمود المرايا. في صفاءٍ لحن الأغنية، وكلماتها في ذلك السكون الموشى بما يشبه همهمات الإشراق السكرى بتلاوة كبار مشايخ تجويد القرآن عند الفجر: الله، الله، الله - في ذلك الصفاء وهمهماته، بلغت شاعرتي نشوتها رقصاً، وكان فجر سهرتنا موشكاً على البزوغ، فعانقتُها، ثم تمدّدنا على الأرض، هكذا، هكذا، كما أنتِ وأنا الآن يا ماريان، لكن بلا رقص ولا مرايا ولا فجر.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية