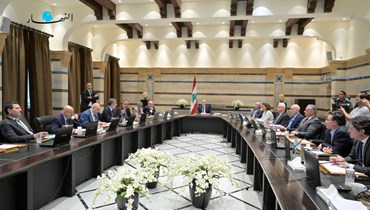"أصحاب ولا أعزّ"... 100 عام من صدمة الذكورة العربية بخلع المرأة قطعاً من لباسها!
إبراهيم توتونجي*
يصرخ إياد نصر في وجه منى زكي، بينما كثير من دفق الدماء يتجه صعوداً باتجاه دماغه المشوّش كثيراً تلك الليلة: "إنت لابسة أندروير (لباس داخلي).. الست اللي مش محترمة هي اللي بتمشي من غير أندروير".
تنفجر هذه الجملة ضمن "حفلة المفرقعات" النفسية التي آل إليها عشاء مجموعة الأصدقاء في الثلث الأخير من فيلم "أصحاب ولا أعز" (وسام سميرة. 2022)، وهو النسخة المعربة عن الفيلم الإيطالي "غرباء مثاليون" (باولو جينوفيزي. 2016). وهو أيضاً العمل السينمائي العربي الأول الذي يحمل علامة " نيتفليكس أوريجينال"، أي إنتاج مخصوص، للمنصّة العالمية الشهيرة لمشاهدة الأفلام وإنتاج بعضها.

كاتالوغ الرعب
وعلى لائحة "أول مرة" بوسعنا أن نضيف أنه الفيلم الأول الذي تظهر فيه ممثلة مصرية على الشاشة، تمايل جسدها للحظات، وتنحني قليلاً، لتلتقط بأطراف أصابعها قطعة سوداء من الدانتيل المخرّم تدسّها في الخفاء في حقيبة يدها. قطعة ضئيلة الحجم ولكنّ لها مفعولاً مهيّجاً يخرم أدمغة الذكورة في المجتمعات العربية التي ترزح أكثر فأكثر تحت سطوة الأبوية، وتتنازل، بوتيرة متسارعة، عن مكتسبات ضئيلة حصّلتها المرأة في حقبات معينة من تاريخها، أسهمت السينما بتدعيمها ونشرها. تلك السنوات القليلة بين منتصف الستينيات ومنتصف السبعينيات، قبل أن تبدأ رحلة العد العكسي، لعودة "المحظور" الى الالتصاق بطوطمه.
وحين نذكر الذكورة فالمعنى هنا ناجز ضمن كامل "كاتالوغ" التشوّهات النفسية الذي يرافقه: احتقار عميق لرغبات جسد المرأة ولروحها المحلّقة، توازياً. رهاب تفاصيل هذا الجسد، ومحاربتها، بدءاً من وظائفه ودوراته وسوائله، مروراً باحتمالية تقديره واحتضانه والاحتفاء والعناية به من قبل صاحبته، وصولاً الى الحرّية المطلقة لها بالتصرّف به، تبعاً لاشتهاءاتها لا تبعاً لـ"ملكية" الرجل له بحكم وصايته عليها.

لحظة خداع
جسد المرأة "ما غيره"، الذي يكمن في عمق كل الهجمات التي نالت من الفيلم مهما حملت عناوين مموّهة مثل: المثلية، والخمرة، والملوخية التي تؤكل مع النبيذ(!) هو الذي هزّ أدمغة الذكورة، وتحديداً المشهد الذي تجرّأت فيه الممثلة على الإيحاء بامتلاك إرادة التعرّي "التحتي".. في الخفاء عن زوجها.
الأنوثة على الشاشة تظهر قادرة على خداع الذكورة ورمي قنبلة في عقر صرحها من دون أن يرفّ لها جفن. وهذا جديد، نسبياً، وغير معتاد على الشاشة، وبالتأكيد سيكون غير مقبول ومستهجناً، ولن يتوانى نائب في البرلمان المصري عن المطالبة بمنع عرض الفيلم لحماية أخلاق الناس.
هو ذاته النائب الذي صرّح سابقاً بأن منظمات الشأن الإنساني هي "عصابات صهيونية هدّامة" وهو أيضاً النائب الذي يحاكم في برامج "توك شو" في وسائل إعلام تفتح له هواءها، هذا الفيلم تارة لأنه يظهر الفقر في مصر (ريش مثالاً. عمر الزهيري 2021) وذلك الفيلم تارة أخرى لأنه يغازل "الجماعات الإرهابية" (اشتباك. محمد دياب. 2016)، بل يسمح لنفسه بنصب محكمة التفتيش لمنتج مصري تقدّمي يقف وراء الأفلام الثلاثة تلك، وصودف أنه هو الشخص ذاته الذي يرأس "مهرجان القاهرة السينمائي" المنظم من جهات حكومية رسمية، وهو أيضاً نفس الشخص الذي يُكال له المديح للنقلة التي حققها للمهرجان.
لكن مسؤولاً يخدم صورة الدولة، التي تتبدّى زاهية عبر النقل التلفزيوني الحيّ للمهرجان، بنفس الإخلاص والوطنية اللذين يستخدمهما صنّاع برامج "نقل المومياوات" أو "طريق الكباش"، سيتحوّل، بين ليلة وضحاها الى "عار" وتجب محاسبته، متى ما مسّ الخطوط الحمراء، وشارك في إنتاج فيلم تسير إحدى بطلاته من دون سروالها الداخلي، سعيدة بلعبتها السرّية الافتراضية، مع رجل (ليس زوجها) يثيرها بأسئلته عبر محادثات "فايسبوك" عمّا تحت تنّورتها. ورغم أن "براءتها" تظهر في الفيلم ويتأكّد المشاهد من أنّ الأمر لا يعدو برمّته "لعبة افتراضية" لم تصل إلى حدّ لقاء الخيانة الحقيقية، ذلك لا يشفي غليل الزوج ولا الذكورة ولا المشاهدين الذين تنمّر بعضهم على زوج الممثلة، هذه المرة في الواقع لا الشاشة، أحمد حلمي، ونعتوه بأوصاف مخجل تردادها وطالبوه بـتطليقها!
في الفيلم تردّ زكي على نصّار: "دلوقت بس انتبهتلي. أنا بقالي سنين محرومة. اللي بتعتبرو جريمة هو الحاجة الوحيدة اللي بتخليني أحس إني ست وإني عايشة، مش ميتة معاك"، مستخدمة الذريعة التي تتلاءم مع كونها امرأة عربية، أكثر مع كونها امرأة وفقط (إذ إن فعلتها ردة فعل لاحتياج لا فعل إرادي لتحرّر). الزوج هو نفسه الذي ينتظر في العادة، صوراً جنسية محفّزة من صديقته ترسلها له عبر "الواتس آب" عند الساعة العاشرة ليلاً. وحين دسّت الزوجة سروالها في حقيبتها تحت العشاء لم ينتبه لها لأنه كان يتفقد هاتفه شرهاً.

لحظة تاريخية
لنعد الآن مئة سنة بالتمام والكمال. 1921. صحف القاهرة تهاجم امرأة مصرية أخرى، وإن بتأدّب يليق بذلك الزمن. النسوية والسياسية هدى شعرواي لا تزال تتلقى سهام النقد لأنها تجرأت على خلع قطعة مختلفة، أكبر حجماً وانسدالاً، ومرتبطة بالجزء العلوي من جسد المرأة، وسيرة التصاقها به عمرها مئات السنين: خمار الوجه.
تقول في مذكّراتها: "ورفعنا النقاب أنا وسكرتيرتي سيزا نبراوي وقرأنا الفاتحة ثمّ خطونا على سلّم الباخرة مكشوفتَي الوجه، وتلفّتنا لنرى تأثير الوجه الذي يبدو سافراً لأول مرة بين الجموع".
كانت تلك لحظة تاريخية متأثرة بالنهضة الحديثة للثقافة العربية تحت تأثير الانفتاح على أوروبا بالدرجة الأولى، والتي وئدت أيضاً سريعاً خلال العقدين التاليين وصولاً الى الأنظمة الشمولية في الستينيات التي احتوت مكتسبات الحركة التحررية النسائية وحاصرتها في مؤسسات رسمية ذكورية مترهّلة.
بين لحظة هدى ولحظة منى، وكلتاهما إشهار بخلع قطعة لباس لصيقة بجسد المرأة، مرّ مئة عام، حدث فيها الكثير في المصانع ومختبرات العلوم وتشريعات اللذة وشاشات السينما العالمية، والقليل، جداً، في مجتمعاتنا.

سيرة التغيّر والجمود
في قرن من الزمن، صنع السروال الداخلي سيرته، بتحوّل خاماته من القطن والكتان السهلي الغسل يدوياً، الى الحرير الدانتيل والليكرا، المناسبين لمكائن الغسّالات وللإنتاج الكمّي. وهو القرن ذاته الذي انتشر فيه مصطلح "الفتيشية" وحاول علماء النفس والمجتمع والأعصاب سبر أغوارها، وتصنيف أنواعها، التي لم تخلُ من "فتيشية" السروال الداخلي (مشاهد شاهدناها في فيلم مغربي- فرنسي جريء هو "الزين اللي فيك" (نبيل عيّوش. 2015)، وهو أيضاً القرن الذي أجرى فيه عالم ياباني تجاربه لتصوير دماغ شاب في الرابعة والعشرين من العمر تخصّص بسرقة سراويل النساء الداخلية (لم يمسّ سروايل أمّه ولا أخته) طوال 12 سنة وفي مناسبات عدّة، لتخلص دراسة العالم التي نشرت على "ديسكفر ماغازين"، مع صور أشعّة دماغ الشاب، إلى أن "فتيشية" السروال تجسّدت عبر انخفاض في تدفق الدماء الى دماغ الشاب (!)، بعكس ما جرى في دماغ نصّار في تلك اللقطة.
إنه القرن الذي ظهرت فيه صوفيا لورين في "الزواج على الطريقة الإيطالية" (فيتوريو دي سيكا. 1964) بلانجيري أسود شفاف طويل مع صدرية تتكوّم حول صدر ممتلئ يتموّه تحت زخرفة عقربية، ثمّ جين ميرو وبريجيت باردو في "فيفا ماريا" (لويس ماري. 1965) معاً في مشهد واحد مع لانجيري كشكش وحذاء جلدي طويل، وكاترين دو نوف "جميلة اليوم" (لويس بونيل. 1967) بشعر أشقر ولانجيري أبيض على ملاءة بيضاء، وصولاً الى نيكول كيدمان في "آيز وايد شوت" (ستانلي كبريك. 1999) بحرير شفاف يكشف تفاصيل الصدر. لكن الأقرب الى "دانتيل" منى زكي كان اختيار هالي بيري في "سورد فيش" (دمينيك سينا. 2001).
لقد حدثت أشياء كثيرة، في الواقع والسينما، قبل الوصول الى المشهد الذي هزّ الجماهير في فيلم "نتفليكس".
وفيما يعيش العلماء والمكتشفون ومطوّرو الأزياء والعناية الشخصية والمشرّعون لقوانين تحرّر المرأة روحاً وجسداً وفكراً، والمكتفون مع "فتيشياتهم" المنوّعة، كامل حيواتهم الاعتيادية السعيدة، تعيش شريحة ضخمة من شبابنا العربي الغارق في دوّامة العطالة والبؤس والاستلاب، على منصّات التواصل الاجتماعي لهدف واحد هذه الأيام: شتم منى زكي!
* كاتب وصحافي لبناني


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية