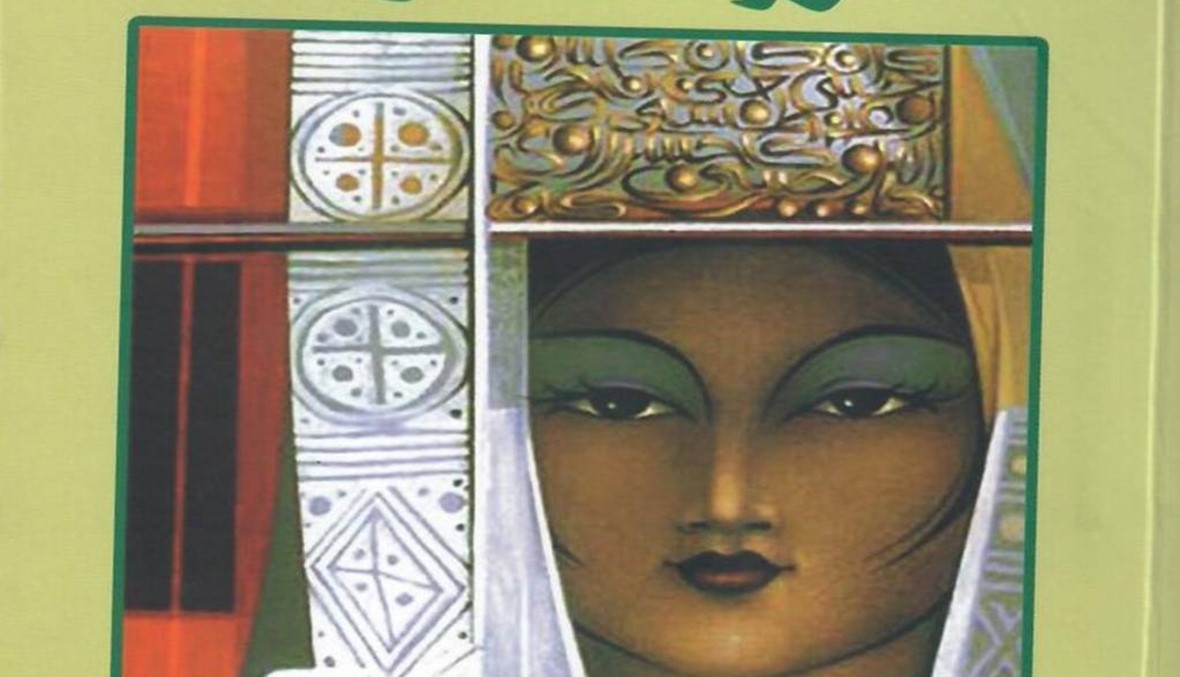من العراق إلى لبنان: "ممالكُ مسروقة الوقت"... كيف للشاعر أن يحفر القلق؟
كم من الوقت نحتاج حتى ننحتَ على شفةِ الغروبِ "سيّدةَ البحر" في "زمنٍ بلون الغياب".
أتّكئُ الآن على "غدٍ لا يُبارِحُ وجهي"... وأمامي تصدحُ "شهقةُ الزعفرانِ" كأنَّ صداها "انكسارُ المسافةِ" حين يبتلُّ الزمانُ حنينًا بعد "رحيل القصيدة" على جناحِ الشعر.
"وإذا النخلةُ جُرِحتْ"... ستبصِرُ فوقَ أزِقَّةِ الحرفِ "وطنًا على الرصيف"... و"منديلًا للمحطّةِ القادمة".
و"ثمّةَ أشياء للانتظار"، وثمّةَ مسافاتٌ واعترافاتٌ وصخبٌ وشتاتٌ وترحالٌ إلى المجهولِ بين المجرّدِ والمحسوس... بين السماء والأرض.
كلّها عناوين صارخة.. تتفلّتُ من أصابعِ "المايسترو" لتفرشَ جسدها وطنًا يؤوي غربةَ شاعره، وديارًا آمنةً من نزقِ السنين.
كيف للشاعر أن يحفر قلقه وأرقه على جبين القصيدة من دون أن يخدشَ خمارها؟ أنّى لعصاه أن تمتدَّ من تعبه المنحوت بيمينه حتى تستحيل شعرًا وسحرًا؟
عرفَ العراقُ الشعرَ بأبهى صوره على مدِّ الحرف... وعرف ألوانه وأشكاله وتقلّباته وأغراضه جميعها.. وظلَّ الجرح يغزل ألوان حداثته حتّى نحت أسماءً كبيرة حفظتها الذاكرة العربية وخلّدت نتاجها.
"بين النطقِ والصَّمتِ برزخٌ فيه قبرُ العقلِ وقبور الأشياء"، هذه فلسفةُ النِّفَّريِّ، وهذا فضاء الشاعر العراقيِّ نزار النّدّاوي الذي ضاقت به العبارة فأومأ الى المسكوتِ عنه في شعره، وأشار الى مهد القصيدة... فترك بذلك مساحاتِ تأويلٍ وارفةً وأرقًا لذيذًا في بال المتلقّي.
النداوي شاعرٌ مسكونٌ بالأصالة... متفجِّرٌ بالحداثة... تسرقه الصورة الى حيثُ منفاه الأوّل الذي لا مهربَ منه إلا إليه... والذي كلّما ازدادَ عتمةً طاب وجعه أكثر! وكأنّه يردِّدُ مقولة شمسِ التبريزي:
"تأكَّد بأنّي وإنْ رأيتُ النورَ في غيرك.. سأختارُ عتمتك!".
فيُقّدِّمُ هناكَ قرابينَ الحرف والنزفِ المقدّسيْن.. ويصبغُ بردة عشقِه بعتمةِ معشوقه:
"وماذا سوى أن أريدَكِ للتّيهِ
والوطنِ المشتهى
مارَسَتْهُ الرِّياحُ
فَنحنُ على ضفَّتيهِ عرايا
وماذا سوى وطنٍ
لم تذُقْ من يديْهِ القرى
غيرَ صيْفَيْنِ جوعًا
نصيحُ بهِ، أنْ تلطَّفْ بصبْرِكَ شيئًا
فحولَكَ كلُّ البلادِ بغايا!".
يجمعُ شتات الأرضِ... وغربة الروح والأضداد والتَّرحالَ والتَّرميزَ والوجع... ويرصفها عند بوّابة الفكرة من دونِ إذنٍ للعبور، إلى أن يفرض الشعر سطوته فتلحظ في مسيرة حرفه اصطخابَ المفردات التي تشير إلى كلّ هذا السفر اللانهائيّ "القطار"، "المحطات"، "الشبابيك"، "المسافات"، "الانتظار".
أمّا المرأة... فهي البلاد والمستقرُّ والحلمُ والمأمول... هي المستحيل والمرتجى... هي التي لم تشأ إرادةُ الحرفِ لها إلا أن تكونَ مرآةً لتمزّقهِ بين الأوطان.. وكأنّه يقول كما قال ابن العربيّ من قبل:
"كانت الأرحامُ أوطاننا.. فاغتربنا عنها بالولادة!".
يُتقِنُ رقصَ الدراويش... يرتدي جُبّةً فُصِّلت على مقاسِ خيالهِ وحده، ثمَّ يدور حول القصيدة دوران الناسك العارف، والذائب الذاهل في المقام المرجوّ... ولا يتوقّفُ حتّى تشهقَ الصورةُ بين يديه لِتَلِدَ الإيقاعَ بأبعاده الثلاثة (البعد التصويري والتركيبي والعروضي).
في ديوانه الثاني "ممالكُ مسروقةُ الوقت" أربعٌ وعشرونَ قصيدةً من بينها أربع عشرة قصيدة على وزنِ بحر المتقارب... تشعرُكَ سطوةُ هذا البحر بالرتابة المتعمّدة.. ولكنّها عند الشاعر النداوي تغدو خلّاقة، ظاهرها هادئٌ وباطنها متأججٌ ومشتعلٌ حدَّ الجنون.
هُويَّةُ الشاعر عابقةٌ في بُنِّ حرفه وتكايا قصائده... حتّى عشقهُ لبيروت وفيروز مفضوحٌ حدَّ الوله:
"ويا أنتِ
يا أهرقَ الهيلُ في حجرِها روحَهُ
لو سمحتِ
اسكُبي قطرةً منكِ في قهوتي
ثمَّ مرّي على وحشتي
مثلما صوت فيروز عند الصباح
وبيروتُ تفتحُ أزرارها لنهارٍ جديدٍ
وحلمٍ جديد".
تلك التفاصيل لا يخفيها الشاعر... لكنّه يُخفي "اللاوَطَنَ" الذي يعيشُ فيه... هو ذاك الجموح نحو لغةٍ لم تولد بعد، وشغفٍ لم ينطفئ بعد، ووطنٍ لم تلبسه السياسة زيَّ الهلاك!.
"ماذا أمقبرةٌ تُضاجِعُ حيّنا؟
كيفَ انكشفنا شرفةً سُفلى لأقدامِ الغزاةِ
وكيف أزنادُ البنادقِ سالمتْ أهدافها؟
*
أزجي السلام الى العراقِ
محمّلًا ما أودعت من سرّها فيه السماءْ
*
...وطني تركتُ التيه خلفي
يضحكونَ من انعتاقي نجمةً خجلى
وعيّرني الشتاتُ بسحنتي السمراءِ
قلتُ لهم شهادةَ موغلٍ في الضادِ
ما في الضادِ ثمّةَ ما يُريبْ؟!".
يحمل الديوان جرأةً في الأفكار والتعابير وخروجًا على المألوف أو السائد في بعض الآراء والمواقف حول الوطن والدين والمرأة والوجود والإنسان والأهواء.
كلّما أبحرنا عمقًا في قصائده، لاحظنا الشعريّة اللافتة في حرفه ولغته التي استطاع من خلالها أن ينتهج نهجًا يشبهه وحده. تراكيبه الخاصّة وفرادته في الحداثة والوصف طبعت على صدر القصيدة علامةً بارزة تتجلّى صورتها في غير موضع: "طبع اللوز"ـ "حسك الرعب"ـ "المحطات غرثى"ـ "أمجّ المدائن"ـ "جوع القطار"ـ "دخّنتَ أيّامك"ـ "مجهرها الجدليّ"ـ "الشبابيك المدلّهة"ـ "نافلة الويل".
قصيدة: "جُبَّةٌ واحدةٌ لا تكفي"
العنوانُ وحدهُ يُشكِّلُ الدوران الأوّل من الرقصة!
يُذكّرني بقولِ فريد الدين العطّار:
"لا تسلِّمْ نفسك للسّكر من جرعةٍ أو جرعتين؟ عليكَ الصحو وإن شربتَ كلّ دنان الحانة!"
نجترع الكأس الأولى ثمّ نسألُ أنفسنا: ما الحاجةُ الى جُبّةٍ أخرى؟ أوليس المطلقُ كلّه فيها كما ورد عند الحلاج؟
تأخذك العبارات الصوفية إلى عالمها الذي شكّل أحد أقوى الاتجاهات الشعرية منذ القرن السابع الهجري: القدح- الليل- القلب- أنا- أناك- الجبّة- التجلّي- العشق- القداسة- الصبر- الدهشة- الشطح- الماء- المعنى...
تبدأ القصيدة حيثُ يجتمع الكلّ في حضرة الذوبان المحض في مقام المراد.
"قلبي والحانةُ والقدحُ والليلُ وطبعٌ بي سَرِحُ
وأنا وأناكَ وتَسْرِقُني يا طبعَ اللوزِ وأُفتَضَحُ ".
اللطيفة البارزة هنا هي طبع اللوز المغناج الخجول، وهو اختيارٌ شاعريٌّ بامتيازٍ ولذيذٌ الى ما بعد الوصف، وتأويله عندي أنّ شجرة اللوز تُثمر مرّة في السنة في أوائل الربيع لمدّةٍ قصيرة، ولكنّها تتميّز بزهرها الأبيض وحبّها الأخضر الطريّ في البداية والذي سرعان ما يغيّر طبعه لتقسو قشرته فيما بعد، وكذلك يتميّز بطعمه الذي يتراوح بين الحلاوة والمرارة.
ولكنّ ذوبان الشاعر في مقدّسه يفضحه ويسرقه من "أناه" ليصبح كلّه ذائبًا في "أنا" المعشوق منغمسًا فيه تمام الانغماس... فيحلو عندها الافتضاح ويطيب عشقه بل ويربو الى حدّ امتلاءِ جُبّةِ الأورادِ بالعشق! وهنا تتجلّى لنا الإجابة عن السؤال الأوّل حول العنوان.
إنّ القلبَ لَيمتلئ عشقًا الى حدّ الفيضان... فلا جبّة بعد ذلك تكفي... والخوف عند التجلّي من أن تشفَّ فيفقد صاحبها السيطرة عليها وعلى نفسه!.
يسأل الشاعر مقدَّسَه الأغلى بكلِّ ما في الشعر من خجلٍ وحياءٍ بلغة استفهام عالية النغم، بليغة الأثر والسلاسة:
"وأخافُ تجلّى أنتَ بها وتشفُّ.. فماذا تقترحُ؟
قُدِّسْتَ وما حسدٌ لكنْ قد أسرفَ في التين البلحُ"
هذه المشاكسة اللغوية بين التين والبلح تشكّل أحد أوجه الحداثة والغرابة.
والكلّ يعرف أن البلح يحمل نواة غير أن التين ليس فيه نواة فيكون الغرق والإسراف فيه ألذّ وأجمل... وخصوصاً أن التين مشهور بحلاوته أكثر من البلح الذي لم ينضج بعد ليصبح رطبًا لذيذًا... وزد على ذلك أنّ كلاهما من الثمار المقدسة في القرآن وفي الشرق ودلالتهما عالية وغير متناهية.
يصفُ الشاعر صبره بالقديم الذي نزح أبناؤه بالقلب حتّى ما عاد يحتمل... ورغم محاولاته الكثيرة الا أنّه يستسلم للدهشة! ويستلم القلب دفّة القيادة والشعر فيحنّ لأرق الماضين الذين لم يبتلّوا بالماء رغم أنّهم عبروا برزخه!
لكنّ القلب يعود الى المعنى والسّرّ والمراد واللاوصول ليعرفَ أنّ الأشياء أكبر من أن تعرّف وتفسّر وتشرح وتدرك بالوصف والنطق.. وأعمق بكثير من أن تترجمها لغةٌ على الأرض، وكأنّه يعود من جديدٍ الى البرزخ العالق بين النطق والصمت والذي حدّثنا عنه النفريّ قبلًا.
على أوتار بحر المتدارك (سمي قديمًا الخبب أي صوت عدو الفرس) يحملنا الشاعر الى تجلّيات رقصته الساحرة مع الروي: الحاء وهو حرف مهموس وكأن صهوة الإيقاع تفرض عليه أن يهمس في أذن القصيدة قافيةً جارحة الأثر لتتبعها حروف الصفير قافزةً من مكانٍ الى مكان كالسين التي تكررت ثلاثًا في البيت الخامس "قدست- حسدٌ- أسرفَ".
لغةٌ سلسة كماء عذبٍ يعرفه الدراويش ويتقن فلسفته الحكماء ويسكر فيه العرّافون.
دورانٌ يتبعه ألف دوران، وخيطٌ رفيع نعبره على رؤوس شغفنا بين الصحو والسكر.
تسعة أبياتٍ من العزفِ الجميل والدوران الخالص لقصيدةٍ مغنّاةٍ وسمفونية مكتملة النوتات لشاعر متفرد بلغته وحداثته وتصوّفه.
أترك بين يديكم نصّ القصيدة:
قلبي والحانةُ والقدحُ والليلُ وطبعٌ بي سَرِحُ
وأنا وأناكَ وتَسْرِقُني يا طبعَ اللوزِ وأُفتَضَحُ
إمتلأت جبّةُ أورادي بالعشقِ وأخرى تجترحُ
وأخافُ تجلّى أنتَ بها وتشفُّ.. فماذا تقترحُ؟
قُدِّسْتَ وما حسدٌ لكنْ قد أسرفَ في التين البلحُ
سأحاولُ لكن لي قلبٌ أبناءُ الصبرِ به نزحوا
أفضى للدهشة أوحشَه أرقُ الماضين وقد شطحوا
يتساءلُ كيفَ وقد عبروا نبضَ الأنهار وما نضحوا
فارتدَّ الى المعنى فإذا الأشياءُ به لا تنشرحُ.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية