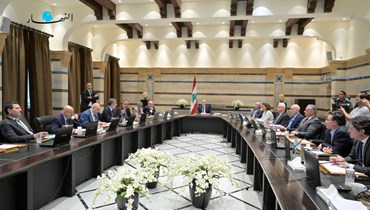سينما - غاريل يأخذنا الى الباحة الخلفية لسينماه: بصراحة لا أعرف أن أفعل غير الذي أفعله!
بعد نحو نصف قرن على انطلاقته السينمائية، لا يزال المخرج الفرنسي فيليب غاريل خارج التصنيف، بعيداً من الموضة، وفي منأى من الاتجاهات التي تحمل السينما الى ضفاف جديدة. فهذا المنحدر من سلالة المجددين في السينما الفرنسية، لا يزال يستعين بالأسود والأبيض، ولا يزال متمسكاً بالـ35 ملم ولا يزال يلحّ على الـ"سكوب" لتصوير أفلامه. أفلام موسومة بشخصية سردية تسعى دائماً الى محو الأحداث الدرامية الفجة لمصلحة الأشياء الصغيرة التي تلهي الأبطال. في "الغيرة"، جديده الذي عُرض في مسابقة "موسترا" البندقية (28 آب ــ 7 أيلول)، الحكاية حكاية حبّ، وانفصال وقهر وغيرة، بطلاها لوي غاريل وآنّا موغلاليس في طلة مستحدثة. أي، كلّ تلك الأشياء التي يعرف مخرج "لم أعد أسمع القيثارة"، كيف ينحتها في باريسه البوهيمية. في حوارنا معه، يأخذنا غاريل الى الباحة الخلفية لسينما تجري عكس التيار.
¶ تقول دائماً انه ليس غب امكانك ان تصنع غير الذي تصنعه...
- بصراحة، لا أعرف أن أفعل غير الذي أفعله. لا أتصور نفسي أُخرج فيلماً كوميدياً أو فيلماً هدفه الأوحد جعل الجماهير العريضة تزحف الى الصالات. كل ما اجيده هو أن أُرجع إلى السينما ما اخذته منها عندما كنتُ يافعاً. شأني شأن الكثيرين من صغار السن في تلك المرحلة، كانت السينما بالنسبة الينا المتنفس الوحيد. كنا متمسكين بها كما يتمسك الشخص الذي يغرق بخشبة الخلاص. نماذجي الكبار في السينما كانوا فرنسيين طبعاً، لكنهم كانوا ايضاً وخصوصاً ايطاليين. مقارنة بغيري، أنا قليل الارتباط بالسينما الأميركية وبصنّاعها الجهابذة. حتى متابعاتي لتلك السينما قليلة. أعتقد انه يستحيل عليّ اليوم أن أبلور طاقاتي خارج السينماتين الفرنسية والايطالية، لأن علاقتي بهما عبر الزمن كانت عميقة. أما لتصويري بالأسود والأبيض، ففي مرحلة سابقة كان صعباً جداً اتمام فيلم منزوع الألوان. اليوم، ارى ان هناك عودة إلى سينما بلا ألوان. ما يعني ان المراهنين على اللونين كانوا على حقّ، عندما ظلوا يتمسكون بهما طوال سنوات. هنري لانغلوا كان يقول: الأسود والأبيض لن يختفيا ابداً. وبما ان السينما ولدت باللونين، فعليها ان تحافظ على ما واكب نشأتها.
¶ أنت مقتنع ايضاً ان شريط الـ35 باقٍ الى الأبد...
- نعم. وربما يجدر بي الانتظار، مثلما انتظرنا مع الأسود والأبيض، كي يؤكد الزمن كلامي. طبعاً، لا مانع عندي أن يتم نسخ الفيلم على ملف رقمي، ليوزَّع ويُعرض رقمياً، لكن كفنان، لا أزال حريصاً على ان أصور بالـ35، مع ادراكي ان الرقمية عملي أكثر من الـ35، سواء في التصوير او العرض او التوزيع. عندما صورتُ في ايطاليا عام 2010، استخدمتُ كل آليات الانتاج وما بعد الانتاج الخاصة بالـ35، لأن هذه الآليات تساعد في أرشفة الأفلام. يجب أن نستوعب فكرة انه لا يمكن ترميم فيلم مصور بالديجيتال اذا ما اصابه مكروه، على عكس الفيلم المصور بالشريط السينمائي الذي يمكن ترميمه. الأميركيون بدأوا ينسخون كلّ شيء مصوَّر رقمياً، حتى مسلسلاتهم، على شريط 35، بهدف حفظه وإعادة ترميمه عند الحاجة. في استوديوات تشينيتشيتا، كل دورة العمل الخاصة بالـ35 لا تزال قائمة ومستمرة، وأنا لم أفعل الا اللجوء اليها عندما صورتُ فيها "صيف حارق". وعليه، فهمتُ ان الأرشفة لا يمكن ان تكون الا بالـ35، وهذا يعني اننا سنواصل إنتاج الشريط الخام، وسنحافظ على مختبرات التحميض وصون البروجكتورات. لا أقول هذا حباً بالإستفزاز، أو لأنني على الأرجح لن أجيد التصوير بغير الـ35. في طبيعة الحال، لا أغفل عن ان التقنيات الحديثة تساعد كثيراً الجيل الجديد لطرح افكاره ونظرته، من دون أن يكون عليه السعي خلف تأمين الموازنات الضخمة. أتكلم هنا عن الديجيتال المخصص للهواة الذي يمكن تحويله الى مادة ترتقي الى مستوى الإحتراف. كل هذا الذي يحصل الآن في مجال الثورة التقنية، يذكّرني بما حصل سابقاً عندما جرى الانتقال من السينما الصامتة الى الناطقة. فهناك مَن لم يستطع مواكبة التطور. لو ان الـ35 اختفى، لكنت أصبحت في مثل الوضع الذي كان فيه مخرجو الأفلام الصامتة الذين لم يستطيعوا القفز الى السينما الناطقة.
¶ ما تقوله يشير الى انك لستَ مخرجاً فحسب، بل مخرج الأفلام التي تجيد صنعها...
- بالتأكيد.
¶ بما انك تكلمت عن الاستفزاز، دعني أذكّرك بأنك من سلالة الاستفزازيين، وهذا واضح عندما تهاجم الصحافة التي لا تقف في صفّك، أو حتى عندما تختار حكايات ليست بالحكايات في شيء، حدّ انه يصعب على المرء أن يلخّص أحداث فيلم لفيليب غاريل.
- هذا كله لأنني لا أزال أشاهد الأفلام القديمة أكثر مما أشاهد الجديد. ثلاثة أرباع الأعمال التي أشاهدها هي من السينما القديمة. أقصد صالات باريس القديمة لمشاهدتها. هذا متاح في مدينتنا. إما أن أشاهد القديم للمرة الثانية وإما أن أكتشفه للمرة الاولى. ليس عندي تلفزيون في المنزل، ولم يكن عندي تلفزيون في أي يوم من الأيام؛ انا حريص على الاّ أضع أيّ صورة أمام عينيّ. اذا سألتني أيّ أفلام شاهدتُ هذه السنة من تلك التي صدرت حديثاً، فسأردّ عليك انه لم اشاهد منها الا نصف دزينة. شاهدتُ مثلاً "هولي موترز" لليوس كاراكس، "جيمي ب." لأرنو دبلشان، "كاميّ تعيد الصف" لنويمي لفوفسكي، "تابو" لميغال غوميز، ولا شكّ انني سأذهب لمشاهدة الفيلم الذي نال الجائزة الأولى في لوكارنو هذه السنة [توضيح من المحرر: يتكلم غاريل عن "حكاية موتي" للاسباني ألبرت سرّا]، لأنني كنت احببتُ فيلمه السابق. لا أشاهد كلّ الأفلام الجديدة، أولادي يشاهدونها، أما أنا فأكتفي بسماع ما يخبرونني عنها. ما يمنعني من ذلك (لهذا السبب ليس لديّ تلفزيون) انني عندما أشاهد فيلماً هابطاً، أبدأ بالإعتقاد ان السينما فنّ ساقط. أمّا عندما اراجع فيلماً قديماً لبرغمان، فأقول في سريّ ان السينما أعظم اختراع. لذلك، انتبه كثيراً الى ما اشاهده.
¶ الشخصية الرئيسية التي يضطلع بدورها في الفيلم إبنك لوي غاريل، ذات أحاسيس مرهفة، لكن الرغبة تأخذنا أكثر من مرة لندخل الشاشة ونقول للوي: "اذهب، عش أيامك، وامسك بزمام حياتك". يبدو لي انك تتناول هنا جيلاً كاملاً من مسلوبي الإرادة والقرار، بعدما صورت جيلك الذي كان محصناً بالنضال وعدم الاستسلام...
- كنا أربعة في كتابة سيناريو الفيلم، رجلين وسيدتين. أكثر من ثلثي الفيلم من توقيع السيدتين. لذلك ترى ان الشخصيات النسائية هي شخصيات حقيقة من لحم ودم، في حين ان مثيلاتها الرجالية، تمت معالجتها بالجهل الذي يمكن ان تستعين به المرأة عندما تنظر الى الرجل (هذا الجهل هو أيضا جهلنا نحن الرجال في كلامنا عن المرأة). لذا، في اعتقادي ان الضعف الذي عند لوي مصدره السخرية غير المقصودة التي بثّتها الكاتبتان، فارتأيت ان تبقى كما هي لأنني أجد الرجال الضعفاء أكثر استئثاراً بالفضول من الرجال الأقوياء. لا شيء في السينما يثير ازعاجي مثلما يثير ازعاجي الأبطال الخارقون.
¶ تعاملت مع ناس (ارليت لانغمان، يان ديديه، ويلي كارنت)، كان يتعاون وإياهم موريس بيالا...
- نعم، لا أخفي تأثري به. أنا في النهاية تلميذ بروسون تروفو وغودار. اتعامل واياهم كما يتعامل الرسام مع التشكيليين الكبار عندما يذهب الى المتحف. لا اقلّد، لكني أعاين ما اكتشفه قبلي العظماء. هذا حقي!
¶ لكن، كيف تكون الكتابة بثماني أيادي؟
- كان مهماً لي ان يكون السيناريو نتيجة مساهمة بين اطراف عديدين. بدأنا من مسوّدة ووصلنا الى مشاهد تخيّلها كلٌّ منا على حدة، ثم وضعناها معاً لنرى ما النتيجة التي سنخلص اليها. أما الرابط بينها، فهذا كان شأن الكاميرا التي اعادت صوغ الحكاية من جديد. احياناً، كان اثنان منّا يتخيلان المشهد ذاته، فنختار الأفضل. الحساسية النسائية تختلف كثيراً عن الحساسية الذكورية في كتابة المشهد، وكنت أبحث عن التضارب والاختلاف والتنوع في النظر الى العالم. خلال التصوير، حافظنا على ما كنا ألّفناه، لكن مع حرصنا على التحرر من الكثير من الأمور. هناك مواقف مرتجلة، ذلك ان السيناريو كان يتيح هذا الحيز من الحرية، لأنه لم يكن يتضمن بالضرورة حوارات. كانت تهمّني المواقف أكثر من الدراما والحوارات، وعندما نعمل على هذا النحو، نجد ان الممثلين يتحركون بحرية أكبر في دورهم خلال التقاط المشاهد.
¶ تنبع من الحبّ عندك أفكار سينمائية لا تكاد تنتهي. عندي احساس انه يمكنك ان تنجز الف فيلم عن الحبّ بتنويعات مختلفة...
- عندما اصوّر الحبّ، لا أستلهم فقط تقليدا عريقا في الأدب يعيد الاعتبار الى الرومنطيقية في حياتنا، انما أستند ايضاً الى التحليل النفسي الذي لم يقل كلمته الأخيرة بعد. الفصل لم يختتم. لهذا السبب، لا يزال في إمكاننا ان نتابع دراسة الاداء الغرامي والعاطفي. وهذا يحملنا الى ما قاله باربيرا في أن كل الأفلام في البندقية هذه السنة هي عن الأزمة الاقتصادية او العائلية، وهذا يجعلنا نستنتج مثلاً ان الضائقة المالية انعكست سلباً في العائلة وقيمها. لا أعرف اذا كان العثور على الحبّ والمحافظة عليه اسهل اليوم مما في السابق، لاننا لا نعرف كيف كان سابقاً. الشيء الوحيد الأكيد أن الحبّ في زمن الأزمة أفضل من الحبّ في زمن الحرب. اذا تذكّرنا ما عاشه الناس خلال الحربين العالميتين، اعتبر أنفسنا محظوظين. لذا، الأزمة ضررها اقل، مقارنةً بالحرب. أحاول أن أجعل كل الامور نسبية. ولدتُ بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا يعني انني لم اعشها، وهذا امتياز عظيم، ليس فقط للفنان الذي أنا بل ايضا للانسان الذي احاول ان أكونه. هنا نعود الى المقارنة بين الأجيال، لنقول مرة اخرى: "نعم، ما نعبره الآن صعب، ولكن حال أهلنا كانت اصعب، اذ كان عليهم أن يتحدوا الموت بشكل يومي".
¶ السينما التي جعلتك تكون ما أنت عليه اليوم، وأعني بها "الموجة الجديدة"، ماذا بقي منها اليوم؟
- هذه السينما منتشرة اليوم أكثر مما كانت منتشرة في وقتها. لنأخذ أفلام غودار مثالاً: في الستينات كانت ايراداتها ضعيفة جداً، باستثناء بعضها القليل. عندما كنتُ مراهقاً، كنتُ اذهب لمشاهدة أفلامه، وكان هناك دائماً عدد قليل من المشاهدين في الصالة. عندما نزل "ألفافيل"، أتذكر انه كان هناك ستة أشخاص في الصالة التي تعرضه. أفلامه لم تنل الإقبال الجماهيري. لكن، شيئاً فشيئاً، وبفضل بعض هواة "الموجة"، تم الإعتراف بغودار كواحد من أبرز الخلاّقين في القرن. يمكنني ان أؤكد ان قصة غودار هي قصة Fan club انتشرت انتشاراً غير معقول في العالم أجمع. عندما تسأل ماذا بقي، السؤال لا يُطرح على هذا النحو، لأن الاهم ان "الموجة" انتصرت على الزمن، وبعض أفلامها لا يزال يُعرض على التلفزيون بين الحين والآخر.
حرية!
حرية فيليب غاريل (1948) وشفافيته تتجسدان بداية في الاسود والابيض وتستمران مع الحوارات التي يستوعب غاريل عدم جدواها، وهي حوارات يمكن ان يتلذذ بها المرء بشكل افضل اذا كان يسمعها مباشرة باللغة الأصلية. لا خطاب في سينما غاريل، على الأقل هو يتباهى بأنه ليس عنده ما يعلنه ويصرح به ويكشفه. اذا كان هناك من خطاب، فهو يتجلى في اجتهاداته البصرية (التقاط مشاهد لويلي كارنت) وكادراته والروح التي تتلفظها سينماه. هناك تحريض على التفكير "بطريقة أخرى" والخروج عن الدروب السهلة ذات النتائج المضمونة. لكن برتوللوتشي وفريقه لم يجدوا فيه أهلاً لـ"الأسد الذهب"، ربما لأن الصداقة التي تربط الرجلين لعبت ضد مصلحة الفيلم، علماً ان غاريل سبق أن نال جائزة "الأسد الفضة" في دورة 2004 عن "العشاق غير المنتظمين". في الدورة الماضية، عارض غاريل كل نقد سلبي في شأنه، معتبراً كلّ من يهاجمه من سلالة الذين كانوا سابقاً رافضي أفلام تحولت اليوم محطات في تاريخ السينما. فهو، حسب ما يقول عن نفسه، ضحية "ما بعد بعد حداثيته" التي تجعله مخرجاً سابقاً لزمنه وضحية سوء فهم مستمرّ.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية