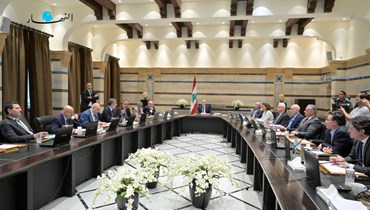في طريق مهجورةٍ أسير نحو مبنى قد يكون لمطار. امرأة أعرفها وتعرفني، لكنني لست متأكدة من وجودها الى جانبي، ولا من حملِ كلٍّ منا حقيبة سفر يتعبني ثقلها. كأنما في مكاني أمشي على قلق من تأخرنا عن موعد إقلاع طائرتنا الغامض. أشعر بوجود المرأة خلفي، بعيدةً، فيما أتسلق بصعوبة وخوفٍ سلّماً عمودياً ثابتاً ينتهي أعلاه بما قد يكون مدرّج ملعبٍ رياضيّ غير مرئي. يؤرّقني استبطاني فكرة أنّ المرأة في رعايتي، ومنظِّمةَ رحلتي ودليلي في مدينة تواطأنا، بلا كلام، على أن نعود اليها. فكرة العودة هي الحقيقة الأقوى حضوراً في هذه الرحلة الغامضة، لكنّ الأقوى منها هو يقيني بأنني ما من مرة عدتُ ولن أعود الى مكان غادرته، ولم تراودني قطُّ رغبةٌ في استعادة زمن أو وقت مضى وانطوى وصار ورائي. وها أنا، قبل إدراكي نهاية السلّم، أكاد أهوي، فأستيقظُ من نومي ومنامي في سريري.
خلف ستارة النافذة في غرفة نومي، شمسيٌّ طازج ضوء النهار، دافئ ولا حرارة فيه، كخفّة الراحة والوئام في حواسي وجسمي الممدّد على السرير. تؤنسني فكرة وجود امرأة في بيتي، ولا يقلقني غموض وجودها، ولا إن كانت غادرتْه أم لا تزال هنا، نائمةً أو صاحية. فكرةُ أنها كانت هنا ورحلتْ من دون أن تعلمني، تؤنسني أيضاً، ولا تثير أسفي. لا، لستُ ممن يحبُّ الأشخاصَ في حضورهم، كما في غيابهم. فما أحبّه في مَن يدخلون هم الى حياتي، وفي مَن أُدخِلهم أنا اليها، هو مقدرتي ومقدرتهم على التخلي، بلا جهد ولا ألم.
لكنني ها أنا أنهضُ من سريري بإرادة غريبة عن نهوضي المعتاد. الضوء النهاري في الغرفة خافتٌ، والى الجهة الأمامية العارية من جسمي، يصل مشرّباً برقّة قماش الستارة الشفاف المتهدِّل في انسداله أمام النافذة. تلك الإرادة تنبّهني الى أنّ جسمي ممتلئ بحضوري الذي تفيض منه أصداء رغبة في أن يستقبله أحدٌ ما. وهذه أيضا حال الوقت والبيت والأشياء حولي. برخاء حركةٍ لاإرادية من يدي، ألمُّ طرفَي الروب المدعوك، أضمُّ قماشةً على وسطي، متسائلة كيف استطعتُ النوم فيه! أخرج من غرفة نومي الى المطبخ، فأتناول من البرّاد زجاجة ماء أعبُّ منها جرعات طويلة. من مدخل جانبيّ بلا باب بين المطبخ وغرفة مرسمي الصغيرة في أقصى البيت، ألمحُ المرأة، سارة، نائمة على ذاك المقعد القديم الذي يتحول سريراً صغيراً، لا أتذكر أنّ أحداً نام عليه من سنين كثيرة. أدخل الى المرسم، أقف الى جانب سارة: جسمها مغطّىً كلّه بلحاف خفيف، إلّا رأسها الغارق في وسادة رخوة من تلك الكثيرة المتروكة مبعثرةً على الكنبة الكبيرة في الصالون. لا أكاد أسمع تنفُّسَها البطيء، قبل أن أخرج متجهةً الى الصالون، عابرةً الممرّ الضيق الذي يتوسط بيتي، لكنني أعرّج الى الحمّام في نهاية الممر، فأفرِغُ مثانتي، أتحسس ذلك الألم الخفيف اللذيذ، جرّاء انهمار البول، ويعقبه رخاءٌ ممتع بعد انتهاء انهماره.
على الكنبة الكبيرة في الصالون أتمدَّد، أرفع رجلَيَّ، أمدُّهما، وأُريح قدمَيَّ على ظهر الكنبة. من ستارة النافذة الكبيرة يصلني الضوء النهاري أقوى قليلاً مما في غرفة النوم، فأتحسّس دفأه الخفيف يتسلّل ناعساً الى جلد ساقيَّ الممتدّتين خارج فتحة الروب الأمامية. أحدّق في الضوء الخافت على جلدهما، فتبدوان لي طويلتين في استرخائهما. هل هما طويلتان حقاً ودائماً؟ أم أنهما تتراءيان لي هكذا الآن، استجابةً مني لتلك الفكرة الفانتاسمية القديمة التي قرأتُها في كتاب نسيتُ اسمه كما نسيتُ اسم مؤلفه الذي ذكر أن طول ساقَي المرأة وفخذَيها كان يضفي عليها سحراً يجعلها صعبة المنال؟ أنا نفسي أعلم يقيناً أنني لستُ ولم أكن صعبة المنال. لكن هل كان الآخرون ولا يزالون يرونني كذلك؟ في بعض من دوائر فناني بيروت وكتّابها وصحافييها، شاع أنني فاسقة، وأَستسهلُ ما أريد وأرغب، على ما قال الشاعر المتهكم ساخراً من انحطاطهم، ومن الصورة التي أشاعوها عني. لم أكن أعبأ بتلك الصورة، ولا سعيتُ في تغييرها أو تغيير سلوكي. ومذ رحلتُ عن بيروت لم أشعر قطُّ بأن أحداً يتذكرني، بل صرت منسيّةً تماماً كأني لم أكن.
الفكرة الفانتاسمية عن طول ساقيَّ المسترخيتَين على الكنبة تشعرني برغبة في أن تمرّر يدان غير يديَّ على جلدهما ملامساتٍ بطيئة مسكونةٍ بأصداء دعة الستارة الشفيفة المنسدلة أمام النافذة، قربي. قبل أن تلوح مني التفاتة الى أرض الصالون، وأرى ثيابي وثياب سارة مبعثرة مهملة على أرضه، أدرك أن رغبتي هذه والفكرة الفانتاسمية مصدرهما مخيلتي البصرية. كأنما لعينَين خفيتَين أو لعدسة كاميرا غير مرئية، تمدّدت على الكنبة مسترخية مستسلمة لمتعة أن يلامس الضوء النهاري جلدي.
من طيف مشهدي هذا، ينبجس مشهدٌ للمرأة التي كانت تجلس عاريةً ليتدرب على رسمها طلاب الرسم الشبان في معهد الفنون في بيروت، من دون طالباته. آنذاك - أتذكرُ كأنني أروي لشخص يجلس قربي - كنتُ قد علمتُ أن استثناء الطالبات من هذه الدروس التدريبية، حدث استجابةً لعرف محافظ مستجد فُرِضَ في المعهد فرضاً، وجرى تبريره وتقنيعه بمقولة أكاديمية وفنية: في تاريخ الفن التشكيلي كان العري، عري أجسام النساء في فن الرسم، شاغل الرسّامين الرجال، وصنيع شبقهم الفاسق ومخيلاتهم الماجنة. فكيف يُعقل، إذاً، أن تتدرب طالبات الرسم في معهد للفنون على رسم نساء عاريات، وما الفائدة من تدرُّبهنّ هذا؟ ثم ما الذي يحدث في قاعة المعهد التي يتدرب فيها معاً طلاّبه وطالباته على رسم امرأة تجلس لهم ولهنّ عاريةً، وتعرض عوراتها ومفاتنها لأبصار الشبّان الشبقة المفترسة، ولأبصار الفتيات المنكسرة الذليلة؟ أليست هذه حفلة مجون جماعي في وضح النهار؟، قال مرةً مدير المعهد.
لكن بعد مضيّ سنتين على تدريسي في المعهد، استُلحق إقصاء الطالبات عن حضور ساعات التدريب على رسوم العري، باتفاق إدارته مع المتنفذين من طلبته المتديّنين تديّناً جديداً، على أمرٍ أثار استهجاني وسخريتي: يجب أن تغطّي المرأة - الموديل جسمها العاري بنقابٍ أسود شفاف ينسدل فضفاضاً من رأسها حتى قدميها، أثناء جلوسها على كرسي صغير واطئ، ليرسمها الطلبة المتدرّبون المنتشرون أمام لوحاتهم في القاعة الواسعة.
بعد مدة قصيرة من انتظام الدروس على هذه الحال، تبيّن أن الطلبة المتديّنين يرسمون امرأة واقفة ترتدي التشادور الذي لا يسفر من جسم المرأة إلا عن كفّيها ووجهها المستدير، منتفخ الخدين بلونهما العاجي المحنّط. أما الطلبة الشيوعيون فرسموا المرأة - الموديل كما هي في جلستها تحت النقاب الأسود الشفاف. لكن أحدهم رسم نقابها بلون زهريّ مائيّ يشفُّ بوضوح عن عانتها، ووضع في فمها موزةً صفراء تخرجُ من ثقب في النقاب الزهري. نهار اكتمال اللوحة، وبعد قهقهات صاخبة أطلقها رفاقه الشيوعيون، نشب بينهم وبين المتديّنين عراكٌ انسللتُ في بدايته هاربة من القاعة، ثم غادرت المعهد.
في النهار التالي روى لي طالب شيوعي ما حدث بعد هروبي: استمر العراك في القاعة أكثر من ربع الساعة، وأدى الى تمزيق رسوم المتدربين كلها، قبل تحطيم المشاجب الخشبية التي تُثبَّتُ عليها، فاستعمل المتعاركون خشبها عصيّاً في تضاربهم الذي انتهى بفرار الشيوعيين من القاعة في الطبقة الثالثة الى الكافيتيريا تحت الأرض، تتبعهم صرخات المتدينين. أما المرأة - الموديل، فركضتْ عاريةً هلعة لترتدي ثيابها، حيث تعوَّدت أن تخلعها عنها وتتركها في حمّام جانبي قرب القاعة. لكن طالباً متديّناً تشبَّث بشعرها على مدخل الحمّام، وأخذ يجرُّها على الأرض وسط تدافع رفاقه وتسابقهم لركلها بأقدامهم. أخيراً سحبها المتشبّث بشعرها الى داخل الحمّام، وأغلق بابه عليها، فلم يُخرجها منه سوى مدير المعهد بعد وصول خبر العراك اليه، وحضوره الى القاعة مع جمع من الأساتذة والموظفين الإداريين، فأيقظوها من إغمائها وساعدوها في ارتداء ثيابها، ثم أوصلها أحد المدرّسين الشيوعيين في سيارته الى بيتها.
لم تنتهِ الحادثة عند هذا الحد. فبعد أيام قليلة اختُطف الطالب الذي قال الطلبة المتدينون في المعهد إنه أهان فاطمة الزهراء. وبعد أسبوع على اختطاف الطالب الشيوعي، عُثر عليه ليلاً مرمياً على شاطئ رملي مهجور في بيروت. كان عارياً تماماً، وحليق شعر الرأس تماماً، وكذلك شعر العانة، وعلى فروة رأسه الدامية محفورة آيات قرآنية: قل أعوذ بربّ الفلق. من شرّ ما خلق. تبَّت يدا أبي لهبٍ وتب. سيصلى ناراً ذات لهب. صدق الله العظيم.
■■■
لم أنتبه الى أن يد سارة تلامس إحدى ساقَيَّ بحركة ناعمة متباطئة، فيما هي تستمع اليَّ في شرود، إلّا بعدما أبعدتْ يدَها من ساقي، وأرجعت الى الخلف جذعها في جلوسها قربي جانبياً على حافة الكنبة. قالت إن شيوعيين يكبرونها سنّاً في قرية أهل والدها جنوب لبنان رووا لها حوادث تشبه ما أرويه، ولا تصدّق أنني أحفظ آيات من القرآن نقلاً عن شخص سمع غيره يقولها في شجار حصل قبل ثلاثين سنة في بيروت. في نبرة متعجّبة مستنكرة تسألني: كيف ومن أين لكِ أن تحفظيها وتتذكريها وتلفظي كلماتها وحروفها بكل الدقة والوضوح هذين؟ كأنّكِ لستِ أرمنية غريبة عن لغة الضّاد والقرآن!
أُخبرُها بأنني شغِفْتُ بأصوات مشايخ التجويد القرآني وأدائهم، وأسمّي لها عبد الباسط عبد الصمد، محمد صديق المنشاوي، مصطفى إسماعيل، أبو العنين شعيشع، ومحمد رفعت، ثم أسألها: أتعرفينهم، هل استمعتِ اليهم؟ وأروي لها أنني طوال أكثر من سنة سبقتْ رحيلي عن بيروت، داومتُ، مع صديقتي عذراء الشهداء، على السهر في بيوت أصدقاء لها كانوا ينتشون طرباً ووجداً في سهراتهم بأصوات مشايخ التجويد هؤلاء، فانتقلتْ اليَّ عدوى طريقة استماعهم وشغفهم بتلك الأصوات. كما أنني حملتُ في حقيبة سفري من بيروت الكثير من تسجيلاتهم، وظللتُ لسنتين أو ثلاث أدعو أصدقاء لي من جنسيات مختلفة، لنستمع اليهم في سهرات متباعدة، هنا في بيتي. لا، لا أصدق - تصرخ سارة، متفاجئة، ثم ترشقني قائلةً بنبرة شاتمة ضاحكة: كافرة، أرمنية كافرة، فإلى جهنم وبئس المصير. كم زجاجة من الويسكي كنتم تشربون في تلك السهرات الماجنة، مستمتعين بدوني بتلك الأصوات الإلهية الرخيمة تتلو آيات التهديد والوعيد بالويل والثبور؛ أيها الكافرون؟!
تقوم عن الكنبة بحركة سريعة ساخطة، فألمح على وجهها المبتسم أصداء حركتها المسرحية المرحة، وأنتبه الى أنها ترتدي ثوباً أسود بلا أكمام ينسدل فضفاضاً طويلاً، كقماش الستائر، على جسمها الممتلئ. من أين أتتْ بهذا الفستان؟ - أفكر - وأتذكر أنني منذ زمن بعيد تركتُه مع تسجيلات مشايخ التجويد في خزانة صغيرة في مرسمي، أضع فيها ثياباً وأشياء لم أعد أستعملها ونسيت وجودها وخرجتْ من حياتي: كالرسّام القبطي الذي هاجر أهله قديما من مصر، وتعرّفت اليه في باريس، بعد مدة من رحيلي عن لوس أنجلس، وإقامتي في بيتي هذا، فأهدى إليَّ هذا الثوب. كان يحب، كلما أمضى ليلةً عندي، أن أرتديه له، بعد مغادرة الساهرين. لكنه أخذ يرجوني كي أرتديه في حضورهم، فاستقبلتُهم به مرة، وانتهتْ سهرتنا تلك بأن تجامعنا امرأتين وثلاثة رجال، هنا في الصالون، حيث أنظرُ الى سارة ترقص الآن على أداء عبد الباسط عبد الصمد يتلو من اللابتوب الذي شغّلتْهُ على طاولة السفرة، آية: مرج البحرين يلتقيان، فبأي آلاء وبكما تكذّبان.
ما من مرة سمعتُ عبد الباسط ينشد هذه الآية، إلّا تخيلت نوراً قمرياً ينبثق من صوته كزبد موج هادئ بطيء يغمر قدميَّ دافئاً خفيفاً متلاشياً على شاطئ رملي في طرف صحراء مقفرة تتراءى لي من عبارة آلاء ربكما تكذبان. لا أفقه من معنى هذه العبارة سوى معنيي كلمتي ربكما وتكذبان، لكن مجرّدين منفصلين عن دلالتيهما اللتين أجهلهما في سياق العبارة التي ترد فيها الكلمتان. أنظر الى سارة تؤدي بجسمها ويديها حركات راقصة على أداء الآيات المتلاحقة: كلُّ من عليها فانٍ، ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يذكّرني رقصها بمشهد المرأة الارجنتينية التي ما من أحد سواها بادر الى الرقص ودعاني اليه في سهرات استماعنا الى منشدي القرآن، هنا في صالون بيتي. استجبتُ لها ورقصت معها مرتديةً الثوب الذي ترتديه سارة الآن. كنا ثملين تقريباً، والسهرة قد شارفت نهايتها حين بدأت الأرجنتينية ترقص، فتجدّدت سهرتنا، ورقصنا جميعاً، نحن المرأتين والرجال الثلاثة، كل على هواه، لكن في حركات بسيطة تجاري أداء صوت المنشد من آلة التسجيل، فظلّ صوته يتردّد في سمعي طوال وقت جماعنا على الكنبة والسجادة الصغيرة على أرض الصالون.
في سهرات بيروت، وهنا في فرساي، ما مرة فكّر أحد في معنى أي كلمة وعبارة يؤديها مشايخ التلاوات القرآنية. فما من مرة سأل أحدٌ أحداً من الساهرين والساهرات عن معنىً أو تفسير أو دلالة لهذه الكلمة أو تلك، ولا لأي من العبارات. هنا في فرساي، غالباً ما كنتُ أبادر الى إسماع مدعويَّ تلاوات المنشدين في الفصل الأخير من سهراتنا، بعد استماعنا الى أنواع من موسيقى الشعوب وأغانيها. بعضهم كان يستغرب أداء المنشدين المنفرد، ويدهشه تنوع طبقات الصوت وتجانسها، من دون أن يعلم ما يعلمه آخرون من أن ما نستمع اليه هو كلام الله في قرآن المسلمين. لكن من تكرّرت دعوتي إياهم، أخذوا يلحّون في طلب هذا المنشد أو ذاك من الذين استمعوا إليهم في سهرات سابقة. أما الأرجنتينية فكانت مدعوّتي للمرة الاولى حين بادرت الى الرقص، وقالت إنها للمرة الأولى تستمع الى ذلك النوع من الغناء. وحين غادرت بيتي في آخر الليل أهديت إليها عدداً من تسجيلات المنشدين، لكنني لم أعد أراها قط بعد ذلك.
الساهرون الكثيرون في بيوت أصدقاء عذراء الشهداء في بيروت، وحدهم من دون الساهرات القليلات دائماً، كانوا يطلقون نشوات وجدهم الطروب بأصوات المنشدين وأدائهم. كانت الأصوات تغمرهم وتلتهمهم، أو تملأهم وتأخذهم وتذيبهم ولهاً. وفي الفواصل الصامتة بين تلاوة الآيات، كانوا يطلقون صرخات ولههم وحركاته الصاخبة. دائماً كنت أتخيّل أن في ذوبانهم وجداً خلاصيّاً مريراً، ومنتشياً لذةً بتلك المرارة، متخيّلين أنهم يسبحون في فضاء تراثٍ سحيق القدم، غامض، متجمّد، ويعيدون إحياءه متوسلين أصوات المنشدين مجرّدةً مما تؤديه من معاني الكلمات والعبارات ودلالاتها. بعد وقت غير قليل من رحلات ذوبانهم، كانت الساهرات تُجارينَهم في استجابتهن الى ذلك الذوبان، لكن من مسافة وبلا وجد خلاصيّ منتشٍ بلذة المرارة المسكرة.
لا تزال سارة ترقص وسط الصالون. يذكّرني رقصُها بشعوري أنني كنتُ أجنبيةً بين أصدقاء عذراء الشهداء، وغريبةً عن نشواتهم، أستقبلُ أصواتَ المنشدين من دون اكتراث ببواعث انتشائهم ومصدره. في حضوري بينهم واستماعي معهم، لم يكن الصوتُ والأداء يلتهمانني. أستمتعُ بأنني منهم ولستُ مثلهم، وأتعرّف اليهم، مندهشةً من اندماجي في طقسهم، ومن أنني أتعرّف الى نفسي بينهم كما لم أعرفها من قبل. لكنني بعد عدد من سهراتي معهم انتبهتُ الى أنهم، هم أيضاً مثلي تقريباً، يقيمون فواصل بين نشواتهم، فيخرجون منها بين حين وآخر مندهشين مقهقهين من ذهابهم بعيداً فيها. بينهم للمرة الأولى في حياتي رحتُ أقعد على سجادة أو بساط أو فراش ممدودة على الأرض. وسرعان ما ألفتُ القعود المنخفض، هكذا، لصقَ الأرض، موقنةً أنّه من صلب الطقس الحميم المتقشف في غرفٍ داخلية خالية تقريباً من الأثاث، حيث يحيون سهراتهم البيتية التي تهيأ لي، أخيراً، أن تكرارها ينطوي على شيء من بلادتهم الحسية العقيمة.
كانوا في نهايات دراساتهم الجامعية، ومن شلل اليسار الجديد، أو غير التقليدي. وعلمتُ أنهم على خلافٍ وتنابذ عقائدي مقيمَين مع الحزب الشيوعي السوفياتي، منذ سنوات سبقت بداية الحرب في لبنان. أنا الأكبر منهم سناً بما بين خمسٍ وعشر من السنوات، والغريبة عن دائرة علاقاتهم وأجوائهم، راقني وأراحني أنني لم أنتبه مرة الى أن أيّا منهم أظهر لي رغبته الخاصة بي، أو حاول استمالتي إليه. عذراء الشهداء كانت على صلات متفاوتة بهم في حياتها الجامعية، قبل أن تنتسب الى الحزب الشيوعي وأتعرّف اليها. أصغرهم سناً كان يهواها هوىً عذرياً مزمناً، معذّباً ينطوي على حقد غامض عقيم، كتعلّقه المتيّم بها، وكغرامها بشهداء الحزب. لذا كانت تتردّد في أوقات متباعدة الى سهراتهم، مدفوعةً بشهوتها لأن تكون معذِّبة شخص ليس من الحزب، على ما قالت لي مرة، مضيفةً إنه يحيا غارقاً في حبّه إياها، كغرقه في شقاء جبنه عن تحقيق رغبته الهواميّة في أن يكون شهيداً.
كانت مترددة خائفة حين دعتني للمرة الأولى الى سهراتهم، فرجتني ألّا أخبر أحداً من الرفاق في خلية مثقفي حزبنا. عن قلة اكتراث معتاد مني، استجبتُ رجاءها، أنا من لم تكن بي رغبة أصلاً، بل أنفر من أن أكون صلةَ وصلٍ وناقلةَ أخبار بين الدوائر المتباعدة لحياتي وعلاقاتي.
علمتُ في سهرتنا الأولى أنهم انسلخوا عن حياتهم النضالية المتصلة بهوامش علاقاتٍ وأعمال حربية في منظمات فلسطينية مسلحة. وانتبهت الى إدراكهم غير الواعي بأنهم، لوداع أنفسهم وسنوات حياتهم تلك، يحيون سهرات الوجد البيتية. فأخذتُ أصرّ على عذراء الشهداء أن نذهب الى حيث يسهرون غالباً في بيت يقيم فيه متيّمُها مع أخته الكبرى المطلّقة، وحدهما، بعد رحيل والديهما الى قريتهم الجنوبية. القصيدة التي كتبها في تتيُّمِهِ بها، وقرأها لنا في إحدى السهرات، جعلتُ عنوانها إسماً آخر لصديقي: زهرة الإيديولوجيا. بهذا الإسم رحتُ أناديها كلما رغبتُ اليها أن نذهب الى سهراتهم، فتجيبُني أن السهرة الليلة عند خندق المواجهة، بعدما روت لي أن متيّمَها كان - كلما وقف على درج مدخل الجامعة خطيباً في جمعية عمومية طالبية - يستهلُّ كلمته في تحريض الطلاب على الإضراب والتظاهر، بالقول: نحن اليوم في خندق مواجهة مع الدولة.
أقطع شرودي المسترسل في استعادة مشاهد من تلك السهرات البيروتية، بأن أتلفت الى سارة قائلةً: أما ضجرتِ من الرقص، هكذا، إنني جائعة، ألا تحبّين أن نتناول طعام الغداء في مطعم باريسي: لحم وبطاطا ونبيذ، لكن بلا منغا. لا، لا، بلا بطاطا - تصرخ، فيما هي تلمُّ ثيابها عن أرض الصالون، وتركض نحو الممر، قائلةً: سريعاً أستحمّ، انتظريني، لا تتحركي؛ أحبّ مطاعم باريس.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية