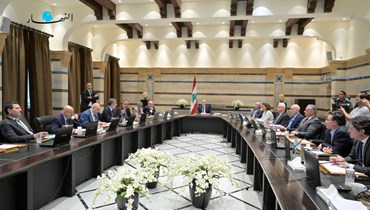غسّان صليبي
بين الردّ والردّ على الردّ، الصراع مستمرّ بين المشتبه فيهم والقاضي البيطار، الذي على ما يبدو لن يخضع ولن يرتدّ.
"الحقيقة" في انفجار المرفأ أصبحت معروفة بالنسبة إلى معظم الرأي العام اللبناني. ربّما لا يزال هناك نقص حول بعض التفاصيل أو غموض في بعضها الآخر، لكن معظم الرأي العام لم يعد يهتمّ بالتفاصيل طالما هو "يعرف" الأساس. لم تصبح "الحقيقة" معروفة لأنّ الرأي العام اطّلع على نتائج التحقيق، أو لأنّ القاضي البيطار سرّب النتائج للإعلام، بل ببساطة لأن "المريب كاد يقول خذوني"، مضيفاً بوقاحة، في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وعلى لسان وزير الثقافة، "تجرأوا وخذوني". المشتبه فيهم لم يتركوا بسلوكهم مجالاً لعدم الشكّ بهم.
لكن ماذا سنفعل بهذه "الحقيقة" إذا عرفناها؟ حتّى لو أكمل البيطار مهمّته وأصدر قراره الظنّي، ماذا عن مسار المحاكمة بعد التحقيق، وماذا عن مصيرها؟ حتّى لو أصدرت المحكمة حكمها بحسب القرار الظنّي، من سيتجرّأ وينفّذ قرارها، في وقت لم يتجرأ أحد من الوزراء المعنيين ومن القوى الأمنية على تنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرها البيطار. لا، ليست المشكلة في التحقيق المحلّي، وليس الحلّ في التحقيق الدولي، فلم يتجرأ أحد من المسؤولين على متابعة حكم المحكمة الدولية في قضية رفيق الحريري، ولا حتى هؤلاء المسؤولين الذي هم أولياء الدم. فهنا أيضاً ولمدّة خمس عشرة سنة كان كثيرون من بيننا يطالبون بـ"معرفة الحقيقة".
ألم نلاحظ أصلاً، وعند كلّ جريمة سياسية ترتكب في لبنان، أنّ الكلام يجري عن ضرورة "معرفة" الحقيقة، أكثر ممّا يكون هناك فعلاً تعويل على "معاقبة" المجرمين؟ لذلك أعتقد أنّ "معرفة الحقيقة" هي النتيجة القصوى التي يأمل أهالي ضحايا المرفأ الحصول عليها، حتى ولو ارفقوا ذلك بطلب المحاسبة ووقف التفلّت من العقاب.
أهالي الضحايا يطمحون للإعلان قضائياً عن هوية المجرمين، مع انّ الذي يستمع اليهم يفهم انّ هوية هؤلاء مفضوحة من خلال ملابسات الجريمة وما تبعها. إلّا أنّهم يحتاجون للإعلان القضائي لأن ذلك يجعلهم يتفوقون أخلاقياً على المجرمين، الذين يتفوقون عليهم اليوم بالقوة. التفوق أخلاقياً يشفي بعض غليل أهالي الضحايا الذين يشعرون بالقهر والظلم إلى جانب الحزن والأسى.
لذلك يعمل المشتبه فيهم على وقف التحقيق مهما كلّف الامر، ليس خوفاً من المحاكمة التي يعلم الجميع أنها لن تحصل، بل منعا للإعلان القضائي عن "الحقيقة" والشماتة الأخلاقية بالمجرمين التي ستتبع ذلك. ففي زحمة الخلافات السياسية وما يرافقها من كذب وتمويهات، يمكن لـ"الحقيقة" القضائية ان تلعب دوراً أخلاقياً فاعلاً، وربما سياسياً في وجه المتورطين. لا يمكن فهم التهديد العلني الئي وجّهه القيادي في "حزب الله"، وفيق صفا، للقاضي البيطار، إلا من هذا المنظور. كما لا يمكن تفسير ذهاب الثنائي الشيعي إلى حد تعطيل مجلس الوزراء حتى تنحية القاضي البيطار، إلا تفادياً لهذا المأزق الأخلاقي والسياسي.
"المنطق" الطائفي والديني الذي يحتكر "الحقيقة" المطلقة، لا يعترف بـ"الحقيقة" القضائية التي تستند إلى منهجية التحقيق والقرائن والإثبات ومرجعيتها القانون الجزائي. فيما الفكر الطائفي الديني يستند إلى الفكر الغيبي، وتُزَعزِعُ اساساتِه منهجيةُ التحقيق والقرائن والاثبات. كما أنه لا يعترف الا بمرجعية النص الديني والتأويلات التاريخية التي يفرضها الزعماء ورجال الدين. وعندما تصطدم "الحقيقة" القضائية بـ"الحقيقة" الطائفية والدينية المطلقة، تكون النتيجة مأسوية وتراجيدية كمأساة "عوائل" شهداء المرفأ الذين انشقّوا عن "عائلات" الضحايا، وعضّوا على جرحهم انصياعاً لزعماء طائفتهم، وطالبوا معهم بتنحي القاضي البيطار، بعد أن كانوا يثقون به ويؤيدونه. ها هي "الحقيقة" الطائفية والدينية المطلقة التي تدّعي حمايتك، تطالبك فجأة بالتنكّر لذاتك، كاشفة عن وظيفتها الاصلية.
"الحقيقة" القضائية مرفوضة اصلاً عندما يتعلق الأمر بالجرائم السياسية، في سياق صراع طائفي لا يعتبر الجريمة السياسية جريمة، بل وسيلة مشروعة، ومقدسة احياناً، لنصرة الطائفة وإلَهها. منذ الحرب اللبنانية حتى اليوم، كان الاغتيال السياسي العامل الأبرز في إحداث التحولات السياسية في البلاد. وربما لأنه يحدث في سياق صراعات طائفية، يُغفل المحللون الدور المفصلي للاغتيال السياسي في ما وصلت إليه الأوضاع في لبنان الحديث، مفضّلين الكلام عن "النظام الطائفي" كسبب "بنيوي" أعمق وابعد تأثيراً من عامل الاغتيالات السياسية، الذي يعتبرونه "ظرفياً". إذا تذكرنا أن كمال جنبلاط وبشير الجميل وموسى الصدر ورينه معوض ورفيق الحريري وغيرهم، وما كانوا يمثلون من مواقع وسياسات فاعلة في حقبات تاريخية معينة، قد جرى اغتيالهم أو تغييبهم، نفهم أن الاغتيال السياسي ليس عاملاً ظرفياً في رسم المسار السياسي في لبنان، كما أنه لم يكن لدوافع طائفية بل لأسباب جيو- سياسية واضحة. من هذا المنطلق، يتحوّل هذا العامل الظرفي، وبحكم التكرار التاريخي المنتظم، إلى ما يشبه العامل البنيوي الثابت وليس الظرفي. ربما لهذا السبب أصبح تعامل الرأي العام والمحللون معه كأنه جزء من السلوك السياسي العادي. وهو نوع من انكار لا واعٍ لـ"حقيقة" تاريخية مفادها ان تاريخنا يصنعه العنف، والمؤلم أكثر من ذلك ان هذا التاريخ يصنعنا.
لكن جريمة المرفأ ضحاياها من المواطنين العاديين وليس بينهم شخصية سياسية واحدة، وإن كان المتورطون فيها سياسيين، لذلك يصعب النظر إليها كجريمة سياسية مثل سابقاتها، وتبريرها بالتالي من خلال المنطق الطائفي الديني، الذي لا يعترف بالجريمة السياسية ضد الخصوم. ربما لهذا السبب، لجأ المشتبه فيهم ومَن وراءهم، إلى الزعم أن القضاء في هذه الحالة هو المسيّس، اي بتعبير أكثر وضوحاً، انه ضد طائفة المشتبه فيهم، إذ عندها يسهل عليهم التصدي له، مما يمهد لاحقا للوعي الجمعي الطائفي، أن يخلط بين الامور. وبدل أن يركّز اهتمامه على قضية الضحايا، يصبح همّه مصلحة الطائفة والخطر الذي يتهددها. وقد اكتمل المشهد مع تسلم القاضي حبيب مزهر الملف. فمقابل ضحايا ومتضررين معظمهم مسيحيون، ومشتبه فيهم معظمهم شيعة حتى الآن، وقاضٍ مسيحي ينظر في القضية، أصبح لدينا قاضٍ شيعي يعيد إلى القضية "توازنها الطائفي".
لا قيمة لـ"الحقيقة" القضائية الا في دولة القانون التي تعتمد الديموقراطية كآلية وحيدة لحل الصراعات السياسية، بعيداً من تدخل السلاح. عندما تصطدم العدالة، التي لا تترسخ إلا في دولة القانون، بغياب شروط تحقيقها، يمكن ان يشكل هذا عند المواطنين المظلومين، دافعاً إنسانياً وأخلاقياً قوياً للعمل على إرساء دولة القانون والديموقراطية. وهذا على ما اعتقد، ما بدأ يترسخ أكثر في وعي اللبنانيين بعد جريمة المرفأ، وإن لم تتمظهر مفاعيله بعد بشكل واسع.
لقد تغيرت نظرة اللبنانيين إلى سلاح "حزب الله": من سلاح مقاوم يحمي الوطن، إلى سلاح يُستخدم ضد الخصوم السياسيين، كما حصل في غزوة بيروت، إلى سلاح يدافع عن الأنظمة الاستبدادية خدمةً للهيمنة الإيرانية ونهجها المذهبي في المنطقة، كما حصل في سوريا.
هكذا أصبح السلاح المقاوم لإسرائيل، للأسف، رمزا للقمع وعدواً للديموقراطية. وقد تجلى ذلك أكثر ما تجلى، في مواجهة "حزب الله" للانتفاضة اللبنانية. ومع انفجار المرفأ وما نتج منه من ضحايا ومآسٍ وتدمير، واقتناع معظم الرأي العام ان لذلك علاقة على الارجح بسلاح "حزب الله" او بمواد متفجرة يستخدمها هو وحليفه النظام السوري، تحّول السلاح كسلاح، وحتى كذخيرة، إلى خطر وجودي للبنانيين عموماً، بعد أن كان قد بدأ مسيرته كحامٍ لهذا الوجود. وهذه هي "الحقيقة" السياسية المرة التي أفضت إليها جريمة المرفأ، والتي تتعدى مخاطرها تلك المتعلقة بـ"الحقيقة" القضائية. مما يفسر أن "حزب الله" قد جُنّ جنونه، وراح يهدد علناً بعد أن كان يهدد سرا.
لن نعرف ماذا نفعل بـ"الحقيقة" القضائية متى عرفناها، ولا ماذا نفعل بـ"الحقيقة" التاريخية عندما نعترف بها، إذا لم نعرف ماذا سنفعل بهذه "الحقيقة" السياسية، التي تتلخص في أن سلاح "حزب الله" أصبح خطراً على وجودنا على هذه البقعة من الأرض التي اسمها لبنان. مشكلة السلاح لا تقتصر على خطورة أهداف من يستخدمه. فبعد أن يكون السلاح أداة في يد صاحبه، يصبح هذا الاخير أداة في يد السلاح. فكما أن الأعزل يخاف من السلاح، فإن حامل السلاح يخاف من التخلي عنه. ألم يبرهن لنا انفجار المرفأ، أن السلاح "يتصرف" أحيانا باستقلالية عن صاحبه، فينفجر غصباً عن إرادته، مما يجعل صاحبه في موقع الدفاع بدل أن يكون كعادته في موقع الهجوم؟ السلاح "شيطان أخرس" حتى ولو كان بيد حزبٍ يقول انه يستخدمه تنفيذا لمشيئة الله.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية