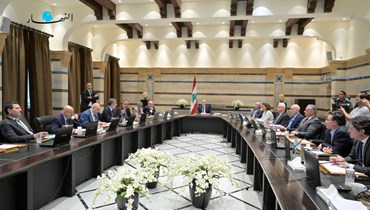"الدين في مستقبل البشريّة" لعيسى بيومي: هل من بوصلة تحمي من مستقبل غامض الملامح محفوف بالمخاطر؟
31-03-2023 | 11:15
المصدر: "النهار"
مارلين سعاده
من خلال عرضه لواقع حياة البشر على الأرض، يهدف كتاب "الدين في مستقبل البشريّة" للمهندس عيسى بيومي (صادر عن دار غراب للنشر والتوزيع، ط 1، 2022) للبحث عن الحقيقة المطلقة، في وقت تؤكّد لنا الوقائع التاريخيّة التي يعرضها في سياق الفصول، وبشكل قاطع، تخبّط البشر وضياعهم وبحثهم العشوائي عن حقيقة تناسب مصالحهم وليس الحقيقة المطلقة.
قد يكون في عرضه هذا ما لا يتلاءم مع مصالح من يُديرون هذا العالم، أكانوا رجال دين أم سياسة، ولكنّه يُظهر بشفافيّة الحقيقة المجرّدة التي تنقل لنا صورة واضحة عن واقعٍ عاشته وتعيشه البشريّة، قائمٍ على المصالح الشخصيّة، أكان للفرد أو للأمّة، بحيث يطغى خير مجتمع ما على ما عداه، ولو كان في ذلك تعدٍّ على الآخر وطعن في الأخلاق. وتصبح عندها الحقيقة الوحيدة المقبولة هي التي تضمن رخاء أمّة على حساب انهيار أمّة أخرى. وهذا ما يؤكّد استنسابيّة البشر للحقيقة، والأخلاق، والقيم، بحيث تفصّلها كلّ أمّة على قياسها، على حساب الحقيقة المطلقة التي لم يتوصّل إليها العالم إلى اليوم، ويبدو أنّه لن يتوصّل إليها يوماً، لأنّه ينطلق في بحثه عنها من أرضيّة متزعزعة، أو في اتّجاهات بعيدة كلّ البعد عن السبيل الحقيقي لإيجادها. وقد أظهر لنا الكاتب عيسى بيّومي بالشواهد والبراهين مدى انغماس العالم، وحتّى العلم الحديث، في التكنولوجيا، هذا الانغماس أو الانجرار أو التعلّق بالعلم والإصرار عليه بمعزل عن المسلّمات التي توصّلت إليها البشريّة وأشارت إليها الكتب السماويّة، ممّا ينبئ بالويلات ويهدّد مستقبل شعوب الأرض، إذ يشير إلى حتميّة فقدانهم السيطرة، والقضاء على وجودهم وأمانهم وسلامهم إذا لم يعيدوا النظر في كيفيّة البحث عن الحقيقة انطلاقاً من أسس مدعّمة بالأخلاق والصدق والخير العام.
إنّ ما يعرضه عيسى بيومي في كتابه "الدين في مستقبل الشعوب" إنّما يعكس ثقافته الواسعة، وخُلُقه، وإنسانيّته، وتجرّده، وموضوعيّته، وشغفه بالحقيقة، وإيمانه بالإنسان. حين أهداني الصديق الأستاذ حسن غراب هذا الكتاب مشيراً إلى أهمّيّته، هداني إلى سبيلٍ يروي ظمأ كلّ متعطّش إلى الحقيقة، إذ يجد فيه كلُّ مؤمن بالحقّ المطلق ما ينشده، وكلّ باحث عن حقيقة المجتمع البشريّ ما يبتغيه، وكلّ جاهل لواقع البشر وتاريخهم الفكريّ ما ينير فكره ليرى الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها كلُّ ذي عقل.
إنّه كتاب مكتنز بالأسئلة الجوهريّة حول واقع الإنسان ومصيره، والتي لا يبخل الكاتب في الإجابة عنها، وإن بشكل غير مباشر؛ فالوقائع التي يختارها من تاريخ المجتمع البشري، ويعرضها علينا، كفيلة بأن تؤكّد لنا النتائج، وتعطينا الأجوبة الشافية لعدد من الأسئلة الملحّة والمباشرة التي تضعنا أمام مفترق خطر، مما يحتّم علينا التفكير بجدّية وعمق قبل اتّخاذ القرار واختيار الطريق الذي سنسلكه وتسلكه الأجيال من بعدنا؛ علماً أنّه لا يُغفل حقيقة أنّ الدين، بمفهومه العامّ، يعزّز القيم؛ فالبشريّة، برأيه، بلا دين بمعناه المطلق المشتمل على القيم والأخلاق والمُثُل، والخاضع لحكم الضمير، تسير نحو الهلاك. لذا، نلمس في أسئلته تخوّفاً ممّا قد يؤول إليه مستقبل البشريّة إن نبذت الدين. من هذا المنطلق، يطرح سؤاله القلِق والتحذيري في آن - إذ يعتبر أنّ الدين لطالما كان في خدمة "مكوّن الإنسان الروحي" - فـ"هل سيبقى الدين مؤثّراً في حياة البشريّة ملبّياً لمكوّن الإنسان الروحي؟" (ص6). وهنا نلمس الخطر المداهم من ناحية فهمِ المؤتمَنين على نشر الدين رسالَتَه، وكيفيّة تطبيقِهم لها، وإشكاليّة تحديد المجتمعات الحديثة للقيم؛ فإن كانت "القيم الإنسانيّة تؤدّي دوراً هامّاً في هداية الضمير وتهذيب السلوك، فما علاقة الدين بالقيم التي تتبنّاها المجتمعات الحديثة؟" (ص 8).
ولأنّه يدرك أهمّيّة الوعي الإنساني الذي يعتبره "ملكة خاصّة تفرّد بها الإنسان بين كافّة الكائنات الحيّة على وجه الأرض" (ص 7)، يحاول من خلال هذا الكتاب، الوصول إلى كلّ من يشعر بمسؤوليّة نحو البشريّة، ممّن يعتبرهم القوى الأساسيّة المحرّكة للمجتمع، ويدعوهم ليقوموا بواجبهم في سبيل المحافظة على بقائها واستمرار تطوُّرها ورقيّها، مركّزاً على أهمّيّة القيم الإنسانيّة ودورها في هداية الضمير وتهذيب السلوك، ومشيراً إلى الطرق التي اعتمدها الإنسان للوصول إلى الحقيقة ألا وهي: الدين والفلسفة والفكر والعلم (ص 8- 9).
اعتمد الكاتب منذ الفصل الأوّل التسلسل التاريخي في عرضه لتطوّر فكر الإنسان عبر التاريخ، بدءاً من مرحلة عبادة آلهة ابتكرها خياله في العصر الحجري، لعدم مقدرته على فهم الكثير ممّا يحصل في الطبيعة حوله، وعجزه عن تحليل أسبابه، وصولاً إلى نشأة الحضارات ومعها الأساطير التي أظهرت الصراع القائم بين الخير والشر، وعكست "واقع حياتهم الذي عاشوه... ثمّ ترجمته حواسّهم ومشاعرهم إلى عبادة وطقوس وعقيدة تحكم حياتهم وموتهم الذي اعتبروه امتدادًا للحياة" (ص 16).
ثمّ جاءت بعدها الأديان السماويّة لتعلن عن وجود خالق واحد للكون غير مخلوق (ص 20)؛ وما لبث أن برز في مرحلة لاحقة العقل (مع طاليس، وإنكسمانس، وهرقليطس... وسواهم)، حين بدأ البحث عن معنى الأمور بتجرّد، بعيداً عن الأساطير والأديان... ثمّ ظهر "سقراط" في القرن الخامس ق. م. وبدأ "البحث عن الحقيقة في ذات الإنسان وليس في العالم الخارجي، فما على الإنسان إلّا أن يتأمّل ذاته ليدرك الحقيقة" (ص 22). وهكذا بدأ التجاذب الفكري بين الفلاسفة (سقراط، أفلاطون، أرسطو وسواهم)... إلى أن جاء الألماني فريدريش نيتشه (القرن 19) وأعلن موت الإله – العدميّة، فلم يعد معه من معنى أو هدف للحياة. وقد وافقه مارتن هايدغر في فلسفته الوجوديّة هذه؛ كما اعتبر آرثر شوبنهاور (القرن 20) أنّ الحياة شرّ مطلق وتنتهي بالعدم!
"ومن رحم الفلسفة نشأ العلم"، فأثبت "غاليليو غاليلي" (القرن 16) نظريّة عالم الفلك والرياضيّات "كوبرنيكوس" حول مركزيّة الشمس ودوران الأرض والكواكب حولها، مرتكزاً على العقل لتحديد أسس كلّ ما يواجهه الإنسان من أمور غامضة أو غير مألوفة (ص 24-25). وتتالت النظريّات المرتكزة على العلم مع نيوتن وأينشتاين (النظريّة النسبيّة ونظريّة الكم...)، ثمّ جاء عصر التنوير أو عصر العقل مع جان جاك روسو، آدم سميث، إمانويل كانط... مكرّساً مفهوم الحرّيّة الفرديّة؛ وتفاقم الكره لرجال الدين، إذ بهتت أو تلاشت صلة الناس بالسماء، واستبدلوها بالأخلاق والمثل كدعوة للخير والحكمة، مطالبين بالحقوق المدنيّة للفرد، من حرّيّة ومساواة ومواطنة. وأصبح العلم هو القوّة الهادية للبشر وليس الدين (ص 54- 55)، إلّا أن قوّة التكنولوجيا استفحلت في العصر الحديث وتمادت حتّى أخضعت لها مصير البشريّة إلى درجة التهديد بالفناء (التغيّر المناخي، التهديد بالحروب النوويّة والكيميائيّة والبيولوجيّة...) (ص 99).
انطلاقاً من هذا العرض الشامل لتاريخ تطوّر المجتمع البشري ونموّه، خصّص الكاتب بيّومي الفصل الثالث من كتابه "الدين في مستقبل البشريّة" ليتحدّث عن "الإنسان بين التطوّر والخلق"، في سعي منه لمعرفة مكمن الخلل في ما وصل إليه عالمنا من أزمات، وما يمكن أن يوصلنا إليه تطوّر العقل البشري من كوارث قد تقضي على البشريّة بأسرها، مشيراً إلى ضرورة تصويب المسار، وإعمال الفكر بطريقة صحيحة، ومتسائلًا عن "معنى الضمير إذا عجز الإنسان عن تمييز الصواب من الخطأ أو الصدق من الكذب أو الحق من الباطل... "لأنّ الإنسان بدون هذا الإدراك والوعي والمقدرة على التمييز لا يمكن أن نتوقّع منه أيَّ سلوك سوى سلوك الوحوش... (ص 112)، مشدّداً على أهمّيّة الأخلاق التي اعتبرها إحدى القوى الأربع المحرّكة للمجتمعات؛ ولكن، "لكي تكون هناك إرادة أخلاقيّة لا بدّ من أن يتّصف المريد بالوعي وحرّيّة الاختيار وهذا... لبّ الأخلاق، الذي يتمّيز به الإنسان عن سواه" (ص 113). وقد قام بتحديد أربعة مصادر أعطت الأخلاق مصداقيّتها: الدين والفلسفة والعادات والتقاليد والدساتير والقوانين الوضعيّة.
أمّا المحرّكات الثلاثة الأخرى للمجتمعات فحدّدها بالسياسة والاقتصاد وقوّة التكنولوجيا. والطريف في الأمر أنّه وضع السياسة في المرتبة الأولى. ولكنّ هذا الأمر لا يفاجئنا، فعالمنا محكوم بالدرجة الأولى بالسياسات القائمة التي تسيطر عليه وتتحكّم به، وتفتقر بشكل كبير للأخلاق. وقد يكون هذا النقص هو أساس معاناة البشريّة؛ فالسياسة تتحكّم بواقع البشريّة عبر العصور، وهي في زمننا تمسك بزمام الاقتصاد والتكنولوجيا، وتسيّرهما وفق مصالحها. وقد لاحظنا أنّ الكاتب شدّد على "قوّة التكنولوجيا"، وذلك لسرعة تطوّرها إلى حدّ وجود خطر عدم التمكّن من السيطرة عليها، مظهراً لنا عرضاً مثيراً لواقعها وما توصّلت إليه وما قد ينتج عنها من تبعات تخرج عن سيطرة الإنسان-مخترعها.
طرح الكاتب العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع، وهي أسئلة تعكس مخاوفه وتوقّعاته، منها: "إلى أيّ مدى ستغيِّر تكنولوجيا الذكاء الصناعي من واقع البشريّة؟ وهل سيبزغ معنى جديد للإنسانيّة مع تطوُّر الآلة الذكيّة؛ معنى يعيد تعريف الوعي والمعرفة والإرادة والتجربة الإنسانيّة برمّتها؟" (ص 154). إنّه يؤكّد أنّ "المخاطر التي تصاحب الذكاء الصناعي عديدة ويمكن أن تصبح كارثيّة على الجنس البشري وتسبِّب فناءه، وذلك ما لم توضع ضوابط أخلاقيّة صارمة تحكم تقدّمه المتسارع" (ص 155)، ليخلص إلى توقّع "مستقبل غامض الملامح محفوف بالمخاطر، وهذا ما لم تعثر البشريّة على بوصلة تهديها في الطريق الذي اندفعت فيه دون أن تتزوّد بحكمة آمنة" (ص 155).
لقد أشار بيّومي بشكل صريح إلى أنّ تأثير الأديان ينحسر كلّما ازداد البشر تقدُّماً (ص 156). لذا، فهو يدعو الشيوخ والقساوسة والكهنة إلى فهم طبيعة العصر والتصدّي لتحدّياته والتواصل مع الفاعلين فيه، فلعله يحدث "توافق بين مادّة الإنسان وروحه أو بين علمه ودينه" (ص 158)، مخصّصاً الفصول الثلاثة الأخيرة للحديث بشكل موسّع عن الدين والقيم الإنسانيّة، والدين والحقيقة، متسائلًا في النهاية إن كان من دور للدين في المستقبل!


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية