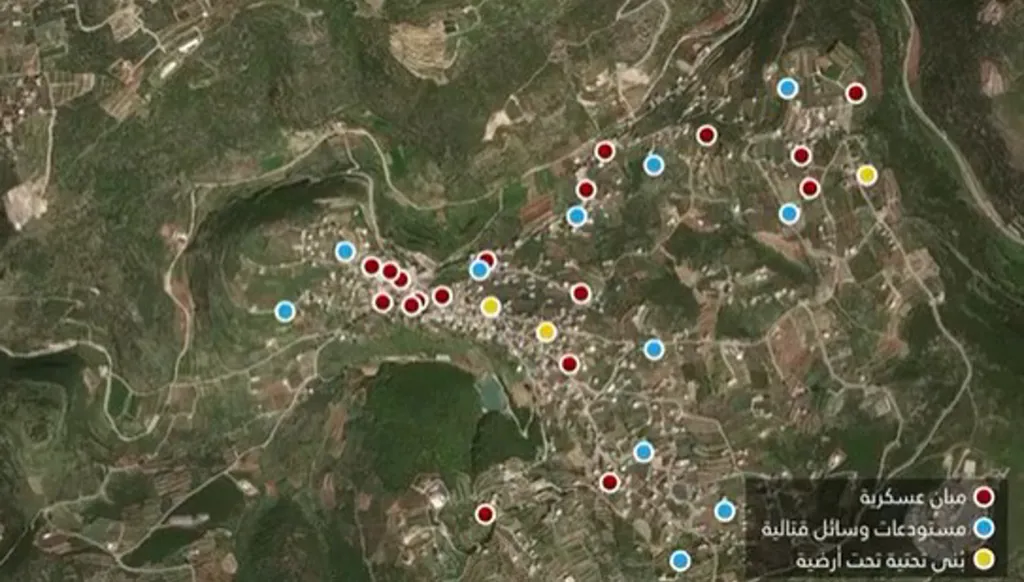يوسف بك كرم"يلتقي نظره بباب بيتنا"

ليليان يمين
كلما عدتُ إلى إهدن، كان بصري يسبقني إلى ساحة مار جرجس، إلى حيث يقف يوسف بك كرم على حصانه، شامخًا بوقفة الفارس الذي لم يترجل عن كرامته. بيتنا يقابل نظره مباشرة، كأن عينيه ثابتتان على عتبتنا، ترسمان لنا حدود الأمان.
في طفولتي كنت أخشاه ليلاً، كأن وقع حوافر حصانه يرنّ في العتمة، لكنني حين كبُرتُ، صرت أعشقه وأتأمل ملامحه، كأن في سكونه حركة لا يراها إلا القلب.
أمي ربطت حياتنا كلها بحضوره. إذا ضاع منها شيء، ناجته كمن يناجي وليًا أو قديسًا: "يا يوسف بيك، يرحم أهلك ورجالك". كانت ترسل اسمه معنا إلى الامتحانات كبركة، وحين سافر ابن أختي إلى أميركا، أرسلته معه كرفيق سفر لا يرهقه بُعد. حتى ابنتي الصغيرة تساءلت بدهشة: "كيف لكرم أن يقطع كل هذه المسافات؟ وكيف يمكنه أن يتابعنا جميعًا؟". فضحكنا، لكننا في أعماقنا صدّقنا صوت أمي وبأنّ روحه قادرة على ما تعجز عنه المسافات.
وسط الساحة
تمثال يوسف بك كرم،
للريح يشهر سيفه.
في أسفاري السياحية إلى أوروبا، صادفت تماثيل لفرسان يشبهونه في وقفتهم وهيبتهم. كنت أرتبك للحظة وأزيح نظري، كأنني أخون فارس إهدن إذا أطلت التأمل في سواه. حين راود بعضهم فكرة نقله من مكانه، شعرت وكأن السماء وقعت على رأسي؛ كيف يمكن أن يُنتزع وجه إهدن من قلبها؟ كيف لعينَي فارسها أن تغادرا موقعهما؟
غير أن الرجل الذي تراه أمي حاميًا لنا، كان هو نفسه غريبًا في منفاه. نُفي لأنه أحب الحرية، وحُرم من أرضه لأنه رفض الخضوع. حمل السيف دفاعًا عن أهله، وحلم بلبنان يليق بالكرامة، فجازته السلطنة بالظلم والإقصاء. عاش بعيدًا، ومات بعيدًا… لكنه عاد أخيرًا، عاد عود المنتصر، ليرتاح حيث أراد قلبه دومًا: بين أهله وفي حضن جباله.
أمام تمثاله، حيث يلتقي نظره بباب بيتنا، أُدرك أن رهبة الطفولة لم تكن إلا انعكاسًا لهالة رجلٍ لم ينكسر. يوسف بك كرم لم يبقَ تمثالًا من برونز، بل صار جارًا، فارسًا، وحارسًا يذكّرنا أن الحرية تُشترى دومًا بأغلى الأثمان.










 تويتر
تويتر
 فيسبوك
فيسبوك
 يوتيوب
يوتيوب
 انستغرام
انستغرام
 نبض
نبض
 ثريدز
ثريدز



 مسنجر
مسنجر
 واتساب
واتساب
 بريد إلكتروني
بريد إلكتروني
 الطباعة
الطباعة