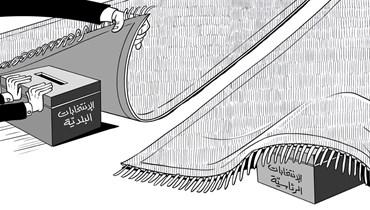كانّ ٧٢ - “مكتوب، حبّي: انترمزّو”: كشيش نحّات في جسد البنات
مجدداً، أضرم عبد اللطيف كشيش النار في كانّ (١٤ - ٢٥ الجاري). بعد ست سنوات من "حياة أديل" (نال عنه "السعفة")، يعود إلى المهرجان بـ"انترمزّو"، تتمة الجزء الأول من ملحمته "مكتوب، حبي"، التي شاهدناها في البندقية قبل نحو سنتين.
خرج السينمائي الفرنسي التونسي الأصل من صالة المونتاج ووصل إلى كانّ، ليقدّم فيلمه، كما عهدناه، بلا جنريكي البداية والنهاية. وضعنا مرةً أخرى أمام "ورك إن بروغرس" لم ينته العمل عليه بعد، لحظة سينمائية نعرف أين تبدأ لكننا نجهل أين تنتهي، من دون عنوان ولا أسماء الممثّلين وفريق التصوير. فقط مَشاهد سينما خالصة خرجت للتو من المصنع، سلّمنا اياها ومضى. صور متدفقة، بحالتها الأصلية، كانت قبل أيام بين أيادي الساحر، على رغم انها التُقطت قبل أكثر من ثلاث سنوات. من ثلاث ساعات وثمانٍ وأربعين دقيقة، اختصر كشيش فيلمه إلى ثلاث ساعات وثمانٍ وعشرين دقيقة. اقتطع من الفيلم مشاهد عدة، لكنه سيعيدها في أول فرصة، وفور انتهاء "دوشة" كانّ.
مع فيلمه هذا، يواصل كشيش مشروعه الراديكالي (الذي يزداد راديكاليةً)، في اقتناص لحظات من زمن ضاع وذهب أدراج الرياح لمَن عاشه، زمن لا نملك كلّ صوره وكلّ أحاسيسه في المخيلة الجمعية. الزمن المقصود هنا، هو منتصف التسعينات، أي قبل ربع قرن تماماً، يوم كان كشيش في الثلاثينات. زمن اللامبالاة والخفّة. زمن بلا توتر، بلا عنصرية، بلا أفكار مسبقة. كلّ شيء كان أكثر عفويةً قياساً باليوم. ألهذا الحدّ تغيرنا؟
يعود الفيلم بنا إلى مدينة سيت الساحلية الباهرة، حيث تلك الشلّة من الفتيان والبنات الرائعي الجمال، الذين تعرفنا إليهم في "مكتوب". كشيش يلتقط هذه العفوية في سلوكهم اليومي، المجال الذي لا يوجد له منافس لا في الأمس ولا اليوم. يتابع النحت في أجسادهم، وخصوصاً أجساد البنات، من أوفيلي وكاميليا وشارلوت فسيلين وغيرهن.
الجزء الأول من "مكتوب" كان يبدأ في آب ١٩٩٤، أما "انترمزّو" فينطلق في أيلول من العام نفسه، أي أيام الصيف الأخيرة التي تجعل الكلّ يرغب في الإفادة منها إلى أقصى حد. مشهد تمهيدي من نصف ساعة يدور على الشاطئ يلخّص بعض الشيء أحداث الجزء الأول، نتعرف خلاله إلى شخصية جديدة: مراهقة شقراء بعينين زرقاوين (ماري برنار) تمضي عطلتها في سيت. أنها وافدة جديدة إلى هذه البيئة. تحمل براءتها إلى عالم كشيش الذي يتكفّل الباقي. ما إن ينتهي هذا التمهيد، حتى يزج بنا الفيلم في المكان الذي لن نخرج منه إلا في الدقائق الخمس الأخيرة: ملهى ليلي، حيث الأزرق أكثر الألوان دفئاً.
طوال ثلاث ساعات، لن يكف الفيلم عن التجوّل في بضع أمتار مربعة. يشق طريقه بين أحاديث الشخصيات الجانبية وأجسادهم المتمايلة على إيقاع الموسيقى الصاخبة وتحت الفلاشات الملونة. يصوّرهم، يلحّعليهم ذهاباً وإياباً، حتى الهلاك، حتى الأنفاس الأخيرة أو ما قبلها بقليل، عائداً، في كمية لا تُحصى من المرات، إلى المواقع التي شكّلت نقطة انطلاقة كلّ حركة كاميرا. هذا التكرار بصفته إصراراً، تعنّتاً، تراكماً، أشبه بضربات متتالية على وتر واحد، يهدف منها كشيش إلى خلق صدى في نفوسنا كأننا في حالة مغناطيسية. فالتكرار هنا يخرج بحصيلة مختلفة في كلّ مرة. لا يوجد مشهد عند كشيش كآخر، مع أن كلّ المشاهد متشابهة.
التلسكوباج الذي كان يقدّمه الفيلم المرة الماضية، من شواطئ سيت إلى مزارعها عبوراً بحاناتها الليلية ومطاعمها، انتقل هذه المرة إلى المرقص. كلّ شيء يبدأ وينتهي (هل ينتهي فعلاً؟) في هذا المكان الذي كان ولا يزال "هاجساً تصويرياً" عند بعض السينمائيين، من مايكل مان إلى غاسبار نويه. حبّ وجنس وأحلام وعواطف وخيبات وغيرة وصداقات، هذا كله يتعانق ويتداخل وينصهر على إيقاع الموسيقى التي لا تصمت الا لتعود مجدداً. هناك الشباب الذين يحاولون استدراج الفتيات اليهن. وهناك الفتيات اللواتي يستسلمن. بين هذا وذاك... كشيش وما يفعله بهم!
في النهاية، ليس "انترمزّو" سوى فيلم عن الرغبة. رغبة تجد التجسيد الغرائزي الأبهى لها في الليل وحفيف الأجساد المعرقة بعضها على بعض وفي جنس فموي صريح داخل الحمّام. تتأخر كاميرا مدير التصوير ماركو غرازيابلينا على أجساد الشخصيات النسائية صعوداً وهبوطاً، مراراً وتكراراً، لمئات المرات، وخصوصاً لإلتقاط أرداف الفتيات الجميلة وأشكالهن المكوّرة، من دون أن يسقط في السوقية في أيّ لحظة من اللحظات.
في حين أن معظم السينمائيين يصوّرون ما له معنى وهدف، كشيش يتأخر على الشيء ويكرره تكرار المهووس، بغية إعطائه معنى، ولاستخراج ما لا يُمكن رؤيته بنظرة سريعة خاطفة. الحياة بكامل بهائها تسلّم نفسها على الشاشة، بحالتها الصافية.
كشيش يقدّم سينما مشبّعة بالتفاصيل، ولا يزال مخلصاً لأنماط العمل التي صنعته: التمهيد المستفيض، إطالة الزمن، البنية السردية، الحوارات، المناخ الذي يتشكّل ببطء. هذه كلها "خدع" كشيشية لبثّ الإحساس بالزمان والمكان.
"انترمزّو" تأكيد جديد ان كشيش سينمائي الرغبة والشهوة. طريقته في التعبير عنهما بعيدة سنوات ضوئية عن طريقة أي سينمائي آخر؛ فهو ينتقل من لحظة رقة إلى أخرى فيها الكثير من العنف. التجربة برمتها في "انترمزّو" قاسية للمُشاهد، إذ يأخده رهينة، حرفياً! ولكن، في المقابل، القول أنه لا يروي شيئاً، هو تحامل على السينما كلغة وجمالية واحساس.
الرغبة التي يصوّرها في حالاتها المتعددة: باطنية، مهذّبة، مكبوتة، كما حال أمين (شاهين بومدين)، بطلنا السلبي الذي يراقب من دون أن يمدّيده إلى المائدة (ألتغر أيغو المخرج). أو رغبة صريحة ومعلنة، كما حال باقي الشخصيات. أنه سينمائي الجسد كذلك، هذا الجسد الذي بات مجرد رؤيته والحديث عنه وتصويره موضوع اعتراض عند بعض الأغبياء في الغرب، وخصوصاً إذا كان مرتكب "الجريمة" ذكراً. أخيراً، يبقى كشيش سينمائي الزمن وكيفية استعادته وتجميده. وما محاولة إطالته للزمن سوى رغبة في البقاء فيه أطول فترة ممكنة. كأنه يمسك بالليل ولا يريده أن يمضي.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية