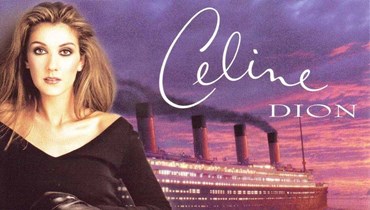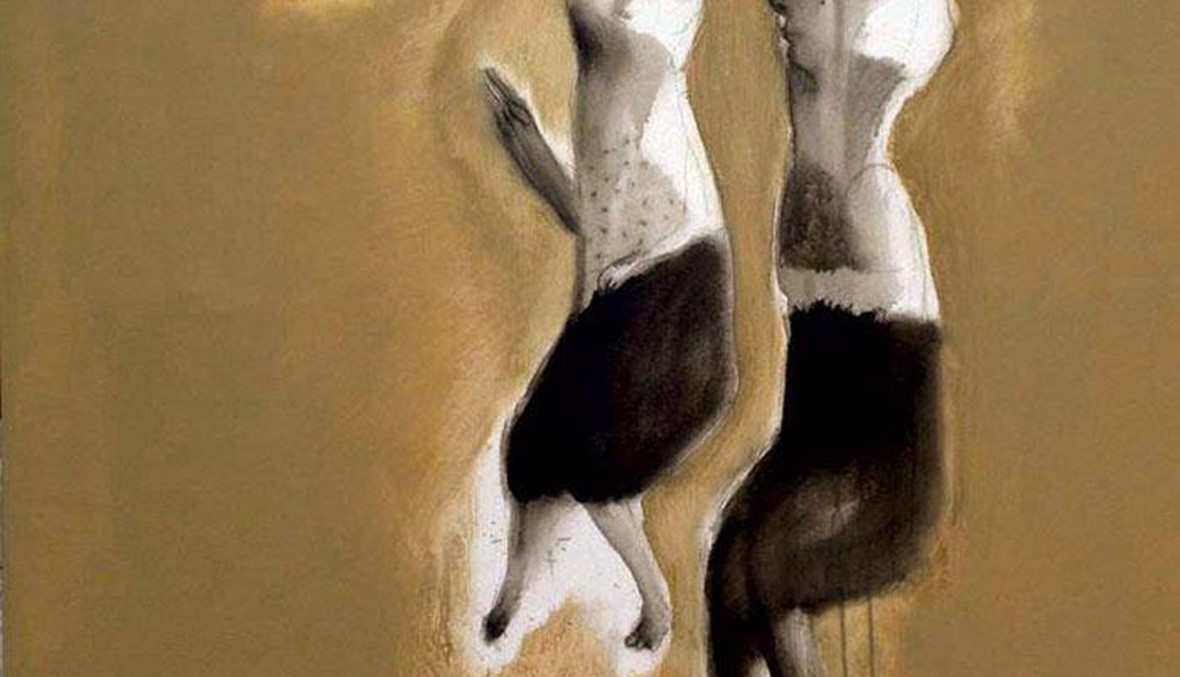يتعالى أزيزُ الشاحنات أمام "دار الشَّعْب" التي تحوّلت، منذ سنةٍ، إلى مصنعٍ للملابس الجاهزة، بعد أن فوّتت فيها وزارة #الثقافة. سارعت شركةٌ فرنسية إلى اشتراء الـمحلّ. سَوَّته بالأرض. ثمَّ شيَّدت مكانَه مصنعًا ضخمًا بطبقات ثلاث. تُعرف هذه المصانع، في بَلدتي، بِاسم: "معامل 72"، نسبةً إلى قانون يسمحُ للشركات الفرنسية باستغلال اليد العاملة المحلية، بشرط بيع المنتوج في #فرنسا. كلَّ صباح، يصطفُّ رتلٌ من الشاحنات، تملأ الحارَة هديرًا، ويَملأها العُمّال بكراتين الثياب الجاهزة.
مُقعدًا بنسبة ستِّين بالمئة من العَجز، تمرُّ أيامي بائسةً. منذ افتتاح المصنع، صرتُ أراقب مرور الشاحنات، الواحدة تلوَ الأخرى. وأقضّي بقية يومي في استعادة أصوات بلدتي، أتابع همسَ أهلها وصخَبهم. هوايتي الوحيدة استعادةُ الأصوات. قدمتُ إلى دُنيا الضوضاء صبيحة 20 آذار 1956. كان أوّل صوتٍ سمعته، حين انحدرتُ من رحم أمي الهادئ،أهازيجَ القرية وزغاريدَ نسائها، فَرْحةً "بعيد الاستقلال" الذي أُعلِنَ عنه يومَها. كانت الفِرقة النحاسيّة تجوب الشوارع صادحةً بالأغاني الوطنية. تَعزِف مطالِعَها ثم تَمرُّ لِغَيرها بسرعةٍ ونَشازٍ. لحظتها، أطلقتُ صَرختي الأولى فامتزجت بضجة الخارج. ومن ذلك الحين، نَشأت لديَّ حاسّة سمعٍ فائقة، تلتقط الأصوات المحيطة وتَختزنها. مع مرور السنوات، صِرتُ كلي ذاكرةً صوتيةً، بمثابة "قرصٍ صَلب" يتضمن آلاف التسجيلات. تُرتِّب ذاكرتي تلك الموادَّ في كراتينَ، ثم تستعيدها بحسب الذكرى. اليوم فاضَت كرتونة الأصوات التي تَناهَت مما كان "دارَ الشَّعْب"، قبل أن يتحول إلى "مَعمل 72". وها حركة الشاحنات لا تتوقف أمامها ولا يَهدأ أزيزُها.
بُنيت الدارُ بعيْد أشهرٍ من الاستقلال بفضل توجيهات "زعيم الأمة" لتكون مقرًّا للتظاهرات الثقافية. لـما بلغتُ السادسة من عمري، شجَّعتني أمي على ارتيادها للمشاركة في أنشطة "الكَشَّافة". اغترَّت المسكينة بما تسمعه هناك من الأغاني الحماسيّة بإشراف "القائد" الذي كان يَضع نظَّارات سوداء تُخفي وراءها عَوَرًا قبيحًا. كان يداعب "الأشبال" ويُلاطفهم. ويقضي معهم أوقات الظهيرة. أحيانًا، كان يأخذ معه أحد "الأشبال" إلى غرفةٍ صغيرة مظلمة، تقع أسفلَ الدار، فيَتحَسّس جسده الطريَّ. احتفظت ذاكرتي بتأوَّهات "القائد"، يُطلقها كأنّه ذئبٌ جريح...
سمعتُ نفس هذه التأوهات حين صرتُ، بعد سنواتٍ قليلة، أرتاد قاعةَ العَرض التي تضُمّها هذه "الدار". مساء كلِّ سبتٍ، يُعرض شريطٌ سينمائي طويل، عبر آلة ضخمة قديمة. يأتي شباب البلدة للمشاهدة والصياح والتصفيق و... تقبيل الشاشة الحائطية. كنتُ أنسلُّ وسط الجُموع وتَصفيرهم نحو الكراسي الخلفية للقاعة. أتجنب صيحاتِ التشجيع أو الشماتة، كلما تواجَه أبطال الفيلم أو تبادلوا اللكمات والطلقات. وما أن تبدو فتاةٌ، على الشاشة الكبرى، حتى يَهجم الشبّان عليها فائرين، يُشبعونها لثمًا وتقبيلاً. تعلو منهم زفراتُ الشّبق. هؤلاء أنفسهم كانوا يعودون في الغد، عشيةَ الأحد، لمتابعة مباريات كرة القدم بين الفِرق الوطنيّة الفتيّة. هتافٌ وسبابٌ وأهازيج تنطلق في كلّ اتجاهٍ، كلما ولَجت الكرة المذعورة شِباك أحد الفريقيْن المتنافسيْن.
عندما يحمى وطيسُ المقابلة، كنت أفرّ إلى المشربة أتأمل لافِتَيْن معلقتيْن: "مَن أثبتَ أنَّه في خِصَامٍ مع زوجته، فَله تخفيض في المشروبات بنسبة عشرين بالمئة"، هذا ما كُتب على الأولى. على الثانية: "غدًا، المشروبات بِالـمَجَّان بمناسبة عيد ميلاد حُسين دارِ الشعب". كلاهما نُسِخ بخط أنيق وحِبْر فاحم. عُلّقت اللافِتَتَان على واجهة المشربة التيتقع في مدخل الدَّار. وراء الكُنْتوار، يقف حُسين، مُنظِّف الدّار وحارسها، يبيع مشروباتِه ويقهقه بصوتٍ عالٍ. ماتَأناس كثيرون دون أن يعرفوا تاريخ ميلاده، ولا شهدوا حفلةَ توزيع المشروبات بالمجان. من طرافته، جعلَ "غدا" مُطلقةً من كل قيدٍ...
ومن دون قيدٍ ولا حَجْرٍ، كنت أذهب إلى "الدار". الوقت الوحيد الذي يمنعنا فيهحُسيْن من الدخول، وقد صرنا مُراهقين مشاغبين، كان أثناء زيارة "المسؤولين" الذين يَفدون من العاصمة ليعقدوا اجتماعاتِهم الحزبيَّة. تُنصَب لهم كراسٍ فَخمة، في فَناء الدار، وأمامها طاولاتٌ عليها مِزهريات. فيملَؤون الساحة بخطاباتهم ويضجُّ الحاضرون بالتصفيق والهتاف:"يحيا الزعيم! يحيا الزعيم!". من موادِّ تلكَ الجَلبَة، تشكَّلت لديَّ كراهية صادقة للمسؤولين الذين أُمنع بسببهم من دخول دار (ي). وللتعبير عن هذه الكراهية، صرت أقضي أوقاتًا طويلة في "مكتبة الشباب"، التي تؤويها "الدار" أيضًا في قاعة كبرى. يأتيها التلامذة، وخصوصًا في سنة البكالوريا، للمراجعة وإعداد "العروض". غالبًا ما تتحول قاعتها إلى ملتقى أحبابٍ ومعارضين. دارت أولى نقاشاتي السياسية بين خزائن كُتبها. نتظاهر بالبحث بين الرُفوف، ثم نُوَشوش حول علاقات الدولة المريبة بالـمُستَعمِر متسائلين: "هل انتهى الاستعمار حقًّا؟" نتناقش خلال ساعات الظهيرة تحت مروحة آلية. لا يزال صريرُها يملأ مسامعي، كأنه ترتيل.
في شهر رمضان، تعلو تلاوة القرآن من مكتب مدير الدار. أمر الحزب الحاكمُ مديري دُورِ الثقافة بتنظيم مسابقاتٍ في "حفظ القرآن الكريم". توجيهٌ ماكر لِسحب البساط من تحت "الإخوان" الذين ينافسون الدولة في احتكار الدِّين. تجمَّع الأولاد، وكنت بينهم، لتلاوة ما حفظناه في المدرسة. كان المدير وقتها شيوعيًّا مُلحدًا. وكان يتابع قراءَتَنا، منزعجًا، من المصحف. حتى قِصار السور ضاعت من ذاكرته المثقلة بخُطب ماركس وتعاليمه. تَصلَّب "الماضي الرَّجعي" كثَلجٍ يغطي شوارع موسكو الباردة، حيثُ درَس في بداية الثمانينات.
في أمسيات الشتاء الباردة، تَفوحُ بحارتي روائحُ الحمص والفول الذي يُحضّره حُسين. وأكثر ما يشتدُّ تدافعنا حين يَضعُ البهارات على البيض المسلوق. في عزِّ البرْد، يَعضُّ الجوع بطونَنا، نحن الشبابَ العاطل. فنُسارع إلى دار الشعب لشراء البيض المزيّن بذرّات الفلفل الأسْوَد والملح. يكثر اللغط والهَرَج، ولا يكون نصيب الواحد منّا سوى نصف بيضةٍ. ويقتصر "النشاط الثقافي" على لقاءاتٍ ماجنة حول القهوة والفول. تتوالى ضحكاتنا ساخرةً من فلانة وفلانة. تدور "نقاشاتنا" عن نساء البلدة وقِصصهن مع الأزواج والخِلان. "الله الله!" عبارة كانت تَرِد بانتظام إشارةً إلى أنَّ فلانة التحقت بسلك "الشريفات". وهذه أيضًا، على لسانِنا العابث، كناية عمَّن "ضاع شَرفها". كنت أستمع إلى تلك القصص وأتخيل تأوهاتِهنَّ...
فقد التقطتُ بعضَها صدفةً في القاعة السُّفْلية لدار الشعب، وكانت مخصصة للنشاط المَسرحي. أسَّست ثلةٌ من اليافعين، من الجِنسيْن، فرقةً مسرحية وكنت عُضوًا فيها. بمِثاليةٍ صادقة، سعينا إلى تحرير عقلية الشعب من "الظلامية" وتحقيق الاستقلال الفعلي. على خَشبة المسرح، أنبري: "كيف أثبِتُ أنني في خصام مع زوجتي؟".يجيبُني زميلي بمَكْر: "تأتي بشهادة عَجْزٍ يتجاوز الستِّين في المئة دليلاً على أنها عَنَّفتكَ! تَزيد نسبة التَخفيضات بحسب نسبة العجز!". من وحي تلك اللافتَة، اقتبسنا حوارات مَسرحيتنا الأولى. كأنها تنبؤٌ بما صار إليه حالي اليوم، بعدما أقْعَدتني جلسةُ تَعذيب وحشية في أقبية هذه الدار نفسها. أُضيف بلهجة واثقة: "لكنِّي لستُ في خصام مع زوجتي. بل مع أسعار الزيت والقمح والسكر التي لا يَتوقف ارتفاعها جرّاء سياسَة "التعاضد". فَرَّطَ الناس في أراضيهم وأملاكهم بسبب الحَا...". وهذه كناية صريحة عن الحزبِ الحاكِم الذي أمر بتعذيبي لأنني تأثّرتُ بتعاليم ماركس.
كانت للحزب الحاكم، في دار الشعب، اجتماعاتٌ سرّية، تعقدها ليلاً "لجنة التنسيق"، (أي:الوشاية). يأتي رجال السلطة فيتداولون بينهم أسماء المعارضين لسياسات الدولة، أكانوا إسلاميين، ماركسيين أم شيوعيين. يبدو أنّ اسمي قد دار على ألْسنتهم. الحزب الواحد لا يقبل الشريكَ ولا المعارض. يُوظّف جميع الهيئات لتمجيده والهُتاف له. ومن الهتافات ما كان أهازيج ترتفع في المناسبات "الوطنية" فتسيح في فناء دار الشعب. تطلقها أفواج الكشّافة والفرق الموسيقيّة والنحاسيّة وحتى مجموعات الإنشاد الديني، حيثُ يُجبرهم الحزبُ على الحضور للعَزف والغناء والمديح. أصواتٌ تلهج بحمد "زعيم الأمة" الذي جاء بالاستقلال في 20 آذار 1956...
أصواتٌ لا ينقطع طنينُها في أذنيَّ، وأنا أراقب أرتالَ الشاحنات تبتلع كراتينَ الثياب التي خِيطت بعرقَ بنات بلدتي لتباع في فرنسا. تردُ إشارة صوتية من هاتفي الجوّال. أرسل لي "رفيقٌ" قديم معايدةً في ذكرى ميلادي، فيها صورةُ "مصنع الدخان"، الذي يعود إلى مدينة نانسي الفرنسيّة في القرن التاسع عشر، وقد تحوّل إلى "ميدياتيك"، مكتبة سمعية-بصرية شاملة. ها قد ملأتها الكتبُ والأفلام والاسطوانات. اختلط أزيز الأرتال بذكرى صيحاتي تحتَ التعذيب. كيف سأثبتُ لحُسين دار الشَّعب أنني ما تَخاصمتُ مع زَوجتي ولكن مع الحا...
اقرأ للكاتب أيضاً: رواية مُفككة: تُتاجرُ بآلام العرب


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية