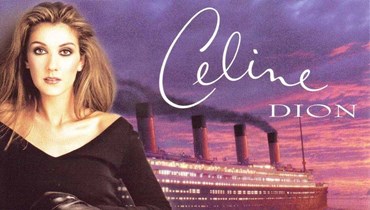على عَجلٍ، أتممتُ دَرْسي في مادَّة التاريخ. غادرتُ الفصلَ بارتباكٍ. ما عرضتُ على التلامذة خلاصَةَ الدرس ولا اقترحتُ عليهم نصوصًا للتوسُّع. دهمني الوقتُ. عندي درسٌ خصوصيّ في الضواحي الشمالية لمدينة #باريس. عليَّ أن أسرعَ السير وإلا تأخّرتُ على تلميذي. أبوه يدفع لي عشرين أورو عن كل حصة. يَوَدّهُ أن يتألّق في هذه المادة، لا سيما في معرفة "ممالك" القرن التاسع عشر. زحمةُ السيارات في شوارع "الحاضرة" لا ترَحم، مثل الضّرائب. أنا مضطرٌّ إلى العمل ساعاتٍ عدة حتى أواجهَ ضغط الغلاء وكثرة "الإتاوات"، كما أفضِّل تسميتَها. وهي أشدُّ على العُزاب، أمثالي، منها على الـمُتزوّجين.
ما إن فتحتُ حقيبتي الجلديّة حتى فُوجِئتُ بغياب مُفكِّرَتي السوداء. عاودت التفتيش عنها بين الكتب والأوراق ولكن دونَ جَدوى. أنَسيتُها في قاعة الدرس؟ في خروجي السريع ذاك، لا شكَّ أنني تركتها على الطاولة. مفكرتي عبارةٌ عن دفترٍ كثيفٍ، أهدانيه صديقٌ يعمل في "مصلحة قُدامى الـمحاربين". لكنني حِدت بها عن وظيفتها الأساسية ووَسَّعتُ معناها، كما هو شأني مع سائر الكلمات والأشياء المحيطة بي. لذلك سمّيتها "الديوان". وصرت أدوِّن فيها بعضَ المواعيد، وجلُّها لا ألتزم به. إما أنساها دون قصدٍ أو يعتذر عنها الأصدقاء في آخر دقيقةٍ. وقد أضع فيها قائمة الأغراض اليومية التي عليَّ شراؤُها. أحيانًا، أكتب فيها فقراتٍ أتسلى بها في طريق العودة إلى البيت، في ضواحي باريس الجنوبية. وقد أنقل على صفحاتها نصوصًا تُعجبني من طرائف القرن الماضي. في آخر الدفتر، سطّرتُ باللون الأحمر أسماءَ ملوك تونس في العصر الحُسيْني. أنا مشدودٌ إلى هذه الحقبة بقوةٍ. تَسكنُني أحداثُها رغمًا عنّي. فأصفها في"الديوان"، كما يَصُفُّ المؤرخ المحترفٍ جُذاذاتِه.
عنَّ لي أن أهاتفَ إدارة المعهد. رنَّ الهاتف طويلاً ولا جوابَ. هذا ما كنت أتَوقَّعُه. هم لا يجيبون إلا نادرًا. لا أدري لمَاذا يَضعون رقمَهم على موقعهم الالكتروني ولِمَاذا يُحددون أوقات "الدوام" ما داموا لا يلتزمون بها. المدير يمينيّ التوجُّهِ. كلُّ ابتساماتِه صفراء. أحسُّ أنه لا يطيقُني: تونسيٌّ يدرِّس التاريخ بمعهدٍ فرنسيّ؟ هناك "إنّ"، شيءٌ لم يستطع استساغته ولا يقدر على البوح به.

ثم خطر لي أنَّ ياسمين، تلميذتي، مَسؤولة الفصل، يمكنها أن تذهبَ نيابةً عني لتتفقد القاعة. عندي رقم هاتفها. في أول السنة، طلبتُه منها لإعلامها في حالة تأخُّري أو غيابي. أرسلتُ إليها رسالة نصيّة. أجابتني بنبَرة فلسفية: "نِسيان"مُفكِّرة" ! هذا من لطائف التضاد. اطْمَئِنَّ. سأفعل ذلكَ بعدَ غدٍ". "بعد غدٍ؟"، مَن الذي يضمن لي أنّ ديواني لن يضيعَ؟ ولن يأخذه أحدٌ ليُشبع فضوله، أو ليذيعَ أسرارَهُ، رغم تفاهتها، على الشبكات الاجتماعية؟ في باريس، تُصنَع الفضيحة بلا شيء.
ياسمين فتاة جريئة، نِصفها تونسي والآخر فرنسي. لا أدري أيُّهما عليها غَلبَ؟ المهم، فيها جانبٌ هجينٌ لا أتبيّنُه. طالما بحثت لديها عن ثمرات اللقاء، في جسدها وفي قلبها وفي كلماتها، بين بلد مستعمِر وآخر مُستَعمَرٍ سابقٍ. لا أدري كيف تعيش آثار هذه الهُجنة حين تَختلي بنفسها وتمشط شعرها الـمُجعَّد الذي يناقض بَشرتَها البيضاء. تُقبل على مادتي (التاريخ) بِنَهمٍ قَلِقٍ، مَشوبٍ بالازدراء والشكّ. تُظهِر أمام بعض الوقائع الاستعمارية صَلفًا. وقد تُداريه. تعتبر بعض الأحداث فضيحةً. تَرى أنَّ فرنسا أدّت رسالةً حضارية في تونس منذ قرنيْن. ولكنَّ "الجمهورية" خُذِلت وقتها بسبب استبداد البايات وتصلب علماء "الزيتونة"...
البحث عن ديواني آخرُ همومها. لو كنتُ مَحلَّها، والتمسَ مني أستاذي خدمةً، لنَفّذتها توًّا. ربما هذا هو فارق ما بين تربيتي في القرية وما تلقته هي في مدارس باريس ومعاهده. سلَّمتُ أمري لله. ولكنني تطيَّرتُ من نسيان "الديوان" وراحت بي التأويلات بعيدًا. أنا رجلٌ يغلب عليَّ التطيُّر، رغم حصولي على "أستاذية" في علم التاريخ. أرسلت رسالةً إلى تلميذي لألغيَ الدَّرسَ الخصوصي. هَزَمَتْ الخرافةُ حاجتي للعشرين أورو. "الله غالبٌ"، كما يقول والدايَ كلما حَزَبَهما أمرٌ جليل.
في الغد، وبُعيد الظهر، أرسلت لي ياسمين رسالةً نصية جديدة: "مُفكِّرتُكَ معي!" ورَسَمَتْ، بعد جُملتها المقتضَبة تلك، علامةَ النصر والسرور. سُرِرتُ بديواني. ولكنْ ما فهمت نَصرها وعلامَتَه. على مَن كان ولـِمَن؟ بعدهُنيهة، رسالة ثانية: "لكنْ لا يمكنني تسليمك إياها، لا اليوم ولا غدًا لأنني سأسافر إلى تونس صباحًا". إذن، سأظلّ أيامًا أخرى بلا ديواني.
من مَحاسن الصدف أو من مساوئِها، أنَّ الأسبوع الموالي يوافق العُطلة الفصليّة في المعهد. وكنت قد عزمتُ على السفر إلى تونس أيضا لرؤية والديَّ الهَرِمَيْن. سأغتنم الفرصة، وسأجلبُ شيئًا من زيت الزيتون من بلدتي. هو من العناصر القليلة التي تَشدُّني إليها. وفيها أحنّ إلى فَطائر "سي محمود" اللذيذة، بروائحها الذكية التي تنعش الأنوفَ في صباحات الشتاء القارسة. مادلين بروست عربيّة. "ياسمين. لو سمحتِ، هل يمكن أن نلتقيَ في "الحاضرة" وتُسلِّميني المفكرة؟". علَّمتهم، منذ أيامٍ قليلة، أنّ كلمة "حاضرة" تعني "العاصمة"، بلغة القرن التاسع عشر. "حسنًا، أستاذ، نلتقي في "الحاضرة" وأسلِّمك مُفكرتكَ هناك". شعرتُ أنَّ القَدَر يَحيك لي أحبولة من أحابيله. وهذا أيضا من تهيُّؤاتي البائسة كلما خاطبتني تلميذةٌ.
في الحقيقة، لا داعيَ لهذه التأويلات ولا لهذا التكلّف. لا شيء ثميناً بالمفكرة السوداء. مجرد موعدَيْن أرجِّح أنهما سيُلغَيان. ورسمٌ بمبلغ دَيْن على رقبتي، أعجز عن تسديده منذ سنة. وهو مرقومٌ في باطني يُحرجني كلما رأيت زميلي الدائن. في البداية، كنتُ أختلق له قصصًا. طبعًا لا تنطلي عليه. وما لبثَ أنّ خَطَرَت له فكرة شيطانية: أكتب له نصوصًا تاريخية، ينشرها في جريدة أسبوعية بإمضائه هو بعد أن يُغيِّرَها تغييرًا طفيفًا، ثم يرسلها. الاتفاق نافذٌ منذ شهور. أحرِّر له مادته ونطرح، من مجموع الديّْن، عشرين يورو لكل واحدة منها. كلما كتبتُ المبلغ المتبقيَ، تذكرت ما حلَّ بالإيالة التونسية حين استدان مُلوكُها ملايينَ الفرنكات من فرنسا لتشييد قُصورهم. كان كاتب أسرارهم يقيِّدها في دفاتر المملكة بِأسًى.
كانت هذه الديون بذرةَ "الحماية الفرنسية". "ليس مهمًا ياسمين. لا تزعجي نفسكِ! يمكنني أن أنتظرَ لما بعد العطلة. فعلاً، يصعبُ الالتقاء في شوارع #تونس وأحيائها". أجبتها بنفاقٍ وقلبي يتطلع لرَدِّها. لا أطيق الحركةَ بلا ديواني. مثل العريان أنا دونه. فهو يُخفف عليَّ عبثَ النظر إلى وجوه الناس في القطارات المكتظة. أضع فيه فقراتٍ تتملكني لشهور. ومما أحنُّ إلى قراءته مقطع تاريخي نَسخته فيه من إحدى المراجع. يصف أحمد باي أثناء زيارته لباريس سنة 1847. استَجمعت قوايَ وكتبت: "ياسمين، هل يمكن أن تنقلي لي المقطعَ الواقع في الصفحة الخامسة؟ ولو بالتدريج. فيه بضعة أسطرٍ، أحتاجها في إعداد درسي المقبل". كانت كذبةً بيضاء.
بعد يوم من الانتظار: "تفضل المقطعَ الأول: "مَرَّ أبي يومًا بالشارع المعروف بشان-زليزي، فأشار لي: "هنا مُلتقى الجِنِّ". قلتُ له: "كاد أن يوافقَ الاسمُ المسمّى". قال: "ما أشوقني للحصول على لونٍ من العدالة. أشتَمُّ رائحة الرَّيْب وراء كواليسها". قلتُ له ملاعبًة وأنا أتنَفّس هواءَ الحَرب وأرنو لسطوتها: "لا يحق لك ذلكَ، في هذه الجادة، تُوَزَّع الحرية ممزوجة بالمال والسِّلاح".
لا صلة لهذا النص الذي نَسَخَتْه بنص المؤرخ، عدا بعض العبارات. لماذا تصرَّفت ياسمين في مَتنه وحوَّرَته بهذا الشكل؟ لماذا اختلقت قصةً مخالفة للأصل؟ داء التحوير يطال التاريخ وأسماءه. لعلني أتوهم هذه السطور أو لعلها بضعة أخطاء إملائية؟ هل تريدُ أن تكتب قصتي بقلمها؟ هذا من استعمار الحكايات. كان جدُّها للأم قد استولى على أراضٍ وزياتين بالساحل التونسي.
قررت أن أنصاع لِلُعبتها وأستجيبَ لغوايتها. كتبتُ: "مَررت يومًا بمسالك الجنة. فتَنَني حَرفان، حاء وراء، حين التقيا وضمَّ بعضهما إلى بعضٍ في جادات الحواضِر ومضائق التاريخ. هما من ثِمار الثورة. سأتنفس هواءَ الحرية وأرد من مائها في أرضك الباريسية. يحق لي، كأي رجلٍ من الناس، الرقص بين الكلمة اللذيذة والإتاوة المفروضة. ولأجل الحرفين متعانقَيْن، لا بد أن نلتقي في بلدتي أيضًا، ستدركين ما في الزيت من الأسرار. قبل قرنٍ، جاء جَدُّك الباريسي لديارنا طِلابًا له".
وبعد ساعةٍ، بعثت لي هذا مقطعًا جديدًا: "تفضل النص الأصلي الذي كَتَبه مؤرخك. "مَرَّ الباي يومًا بالشارع المعروف بالشان زلزي ومعناه: "ممشى الجنة"، فقلت له: "وافَقَ الاسمُ المسمّى"، فقال لي: "ما أشوقني للدخول من باب عليوة، وأشتم رائحة الزيت من حانوت الفطايري داخله". فقلت له مداعبًا وأنا أتنفس هواءَ الحرية وأرد من مائها وقدماي بأرضها "يحق لك ذلك، لأنك إن دخلت من هذا الباب تفعل ما تشاء، أما الآن فأنت رجلٌ من الناس".
في رسالة موالية، أضافت: "من الآن، فصاعدًا، سأتغيَّب عن دروس التاريخ. سَجِّلني غائبة. لن أبالي. سَأشتغل على مادة المالية والمحاسبة. هي أجدى لي من رَيْب الذاكرة. تَخذُلني عناصر الماضي. إما أرسل لكَ مفكرتكَ عَبر البريد السريع مقابلَ شيك، أو أنشر محتوياتها على شبكة التواصل. التاريخ لا يَرحم".


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية