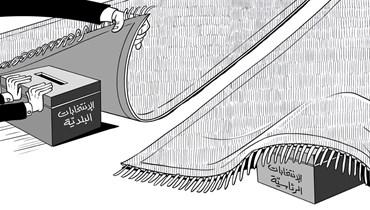ندوة كلية اللغات في الجامعة اليسوعية حول رواية أنطوان الدويهي... كتّاب ورحّالة يحاورون في "آخر الأراضي"
في تحيّة لعمل أنطوان الدويهي الأخير، نظّمت كلية اللغات في الجامعة اليسوعية في بيروت طاولة مستديرة بعنوان "كتّاب ورحّالة يحاورون في رواية "آخر الأراضي"، للإضاءة على العلاقة بين الرواية والسفر في أدب الدويهي. اللقاء، الذي تمّ في "قاعة جوزيف زعرور"، في 19 كانون الأول الجاري، أدارته عميدة كلية اللغات جينا أبو فاضل سعد، وشارك فيه ثلاثة كتّاب - رحّالة ، سمير عطا الله ومحمد علي فرحات وشوقي الريّس، td حضور حشد من الجامعيين والمثقفين وأهل الاختصاص.
في افتتاحها اللقاء، ذكرت العميدة جينا ابو فاضل سعد : "عرفتُ الإنسانَ من أنطوان الدويهي قبل أن أعرف الروائيّ فيه، على غير ما هو مألوف. فنحن غالباً ما نُعجب بأدب أحدهم فنتمنّى لو نلقاه ولكننا في الآن نفسه نخشى هذا اللقاء. فماذا لو خاب الظنُّ منّا ولم تُطابق صورةُ الإنسان تلك التي ارتسمت له في مخيّلتنا من خلال ما قرأنا له؟ لقد أثبت الفيلسوف الفرنسي بول ريكور تلك الخشية لما قال: "حينما يصادف أن نلتقي بمؤلّف فنحادثه عن كتاب وضعه، ينتابنا شعور بأنّ تلك العلاقة الفريدة التي بنيناها مع المؤلّف في مؤلّفاته ومن خلالها قد انقلبت رأساً على عقب". أمّا أنا فقد تسنّى لي أن أتلمّس النفس البشرية في أنطوان الدويهي أولاًّ، ما دفعني إلى قراءته. ولماّ قرأته، أحببت أن ألتقي به من جديد وكم سرّني أن أجد الإنسان والمؤلّف متطابقين صدقاً وشفافيّةً وألقاً. فشكراً لك يا أنطوان لأنّك لا تخيّب ظنّ قرّائك!
تُحادث أنطوان الدويهي فتلفتك طيبةٌ في نفسه، وأناقةٌ في تصرّفه وعذوبةٌ في كلامه ورهافةٌ في حسّه وصفاءٌ في سريرته وخفرٌ في حركته. وتقرأه فتطرب لانسياب جمله تترقرق على بديع التنميق والتطريز وتنبهر بألق مشاعره ونقائها، تتدفّق من عمق أعماقه لتفيض حبراً فضياً لامعاً يكاد يخطُف منك البصرَ بل تراك تنخطف وإياه لتوقّع خطى نفسك على خطى ما يعتمل في دخيلته، وما أغنى ما يعتمل فيها. يجرّك معه في رحلاته اللامتناهية، التي لا تعرف هدأةً ولا قراراً. رجل الارتحال هو، لا يرسو في زمان أو مكان ولا ينتمي إلى لحظةٍ أو بقعةٍ أو أنّه ينتمي إلى لحظات العمر كلّها ماضياً وحاضراً ومستقبلاً وإلى بقاع الأرض كلّها من أدناها إلى أقصاها. فكلّما أتت ريشته على ذكر برهةٍ، استعادها بهنيهاتها، هنةً هنة. وكلّما عرّج قلمه على بقعةٍ، استذكرها بأمكنتها، شبراً شبراً. فهو يأبى أن تجرفَه دوامةُ الوقت المتسارعة. يستوقفها متيقّظَ النفس، متوقّد الذاكرة، متنبّه الحسّ. فعلاقته بالزمان والمكان ليست بالعلاقة السطحية، العابرة، الخاوية، بل هي علاقةٌ وثيقةٌ، حميمة، تضرب جذورها في سحيق أعماقه. فيروح يسبر خفايا تلك الأعماق وخباياها، بما فيها من نور وظلمة، من وعي ولاوعي، من واقع وحلم. فأراضيه لا تقاس بالأمتار والأميال فحسب بل بعصف الأفكار، وجموح المشاعر وتلألؤ الذكريات وضبابية الأحلام. إنها أراضيه الداخلية المتفاعلة مع الأراضي الخارجية، يطاردها كالمحموم حتّى تخومها، حتّى أواخرها. يدفعه في سبر الأغوار هذا فضولٌ لا حدّ له لأن يفهم أسرارَ الحياة والموت وتحرّكُه مشاعرُ ولا أسمى، هي مشاعرُ الحبّ.
وأنطوان الدويهي لا يكتب إلاّ ليفهم، فعدم الفهم، على حدّ ما يقول، "يقلقه ويقضّ مضجعه ويثير فيه عذابات مبرّحة". تلك حال الأدباء الكبار. وعلّنا إذا قرأنا ما فهموه، فهمنا نحن ما في عوالمنا الذاتية وما في وراء عوالمنا الأرضية".
سمير عطا الله
استهلّ سمير عطا لله مداخلات الطاولة المستديرة قائلاً: "كنت كلما أصدر أنطوان الدويهي عملاً، أكرّر عليه سؤالاً نسيت أنني طرحته مع صدور العمل السابق: ألا تشعر أن مناخك الأدبي شبيه بمناخات ألبر كامو؟ وكان، برغم كل نبله، يكرّر النفي في شيء من العتب والتأنيب على الذاكرة. إذاً، من يشبه هذا السرد الذي هو في خفّة الأثير وكثافة الحقيقة؟ في خفر المخيّلة الزهراء وسطوة الوقائع؟ لعله في النهاية، شبيه صاحبه، ولا حاجة إلى مقارنات، ولا إلى شواهد، لكي تقنع نفسك، في هذه الرحلة في عالم الدويهي، عبر مقاهي السان ميشال، وقطار سولاك، وضفاف تلك البحيرة جليسة الطيور، كأنك قد شاهدت تلك الروعة من قبل. لكثرة ما مشاعره رقيقة، وقلمه خافق، يخيّل إليك دوماً أنك ترى في شفافية أنطوان الدويهي، لوحات كثيرة ومشهداً واحداً. تلك خدعة الفن وهو يحاول الذوبان في الصدق. ولا مقام للسرد يتغيّر. فثمة قضية واحدة، وإيقاع وحيد، من فصل إلى فصل، ومن كتاب إلى كتاب، هو الوقوف إلى جانب مظلومي العبث وضحايا الوهن البشري المتساقطين امام جدار القدر.
لكن إذا تأمّلت جيداً في سطور "آخر الأراضي" وفصولها، سوف يغويك، مرة أخرى، سحر المقارنات. فسلمى فرح الحديثة، هي سلمى كرامة في "الأجنحة المتكسّرة". خاتمة محزنة ومبكية منذ اللمحة الأولى، ولن تزعج المرأة الطيّبة أحداً بشيء من التضرّع لما أحيطت به من أدغال القدر. استسلمت ومضت. هذه لعبة أخرى من أسلوب الدويهي، الذي هو مرّةً صفاصفة كثيفة تغني لك، ومرّة صفصافة عرّتها الريح والوحدة، فأدركتْ أنه ليس عندها سوى الحزن والأسى، لكنك أنبل من أن ترمي إليها قطعةً من الشفقة. حقها عليك أن تشاركها العزّة في العبث.
مثل كل عمل سابق له ، "آخر الأراضي" رحلة في النفس المرهفة. أنقل منها : "هذا النهر الداخلي المنساب على الدوام، بطيئاً، خافتاً، رهيفاً، مفعماً بالأسرار، واصلاً الذات بكل ما في الكون من عوالم". أو: "ألقى بوح كلارا المفاجئ حصاة كبيرة في بحيرة ذاتي". أو أيضاً: "وما زلتُ أسير فيها حتى اليوم، وحيداً في أروقة نفسي"...
كأنما أنطوان الدويهي يحرص على التعريف، تكراراً، بنفسه: الرواقية والتأمل. وتدور بك معه الأسفار والأمصار. لكن رحلتك الكبرى هي دائماً في اتجاه الداخل كالمتصوّفين. أو كالشعراء. أو كالرواة. أو كمزيجهم الخصب الحزين...
يشبه سرد أنطوان الدويهي رحلة في القطار إلى سولاك. معه ترافق المتعبين والمرهقين والرجل النحيل العنق، الذي لا يكفّ عن تأمّل الصبية في المقعد المقابل. لكنه يترجّل قبلها عندما يذكّره فتى إلى جانبه، انها "المحطّة الأخيرة".
هكذا تبدأ الرحلة إلى "آخر الأراضي". الشعر في الرواية، والرواية في الألق، والسرد فصلٌ من فصول أهل إهدن وسولاك".

محمد علي فرحات
في مداخلة محمد علي فرحات ما يأتي: "في تصوّره حياة ما بعد موته، التي يسمّيها "الحياة الأرضية الأخرى"، يذكر الراوي: "يصل بي الأمر إلى رغبة حيازة بيت، أو ثلاثة بيوت، في ثلاثة أو أربعة أمكنة، جدّ متباعدة، أحبها على نحو خاص، تكون هي أمكنة إقامتي. بيت على كتف وادي قزحيا، وشقة صغيرة مطلة على نهر السين، وبيت في بلدة الميناء القديمة تمكن منه رؤية البحر عند شاطئ النخلتين، وآخر في سان مالو داخل الأسوار قبالة المحيط، وأنا أعرف تماماً موقع هذه البيوت. يكون تنقّلي بينها بخفة لا توصف، تشبه خفة الأرواح، أو أنوجد فيها في آن واحد، إذ تكون لي نعمة الإقامة في أمكنة عدة في وقت واحد".
يذهب راوي "آخر الأراضي" إلى إقامات متعددة ومؤتلفة استجابة لتكوينه الإنساني وتبلور ثقافته واتساعها، وتجاوزاً للحنين إلى المكان الأول الذي نجد تعبيراته في شعر كثير وفي سرد روائي يقوم على حيرة الروح بين الأمكنة. هذا لا يمنع الراوي من سرد قبسات من تراجيديا الهجرة اللبنانية تعبّر عنها حكايات أقارب وأصدقاء. ولا تذهب الرواية إلى التبشير بكوسموبوليتية ولا إلى تقليل شأن الانتماء إلى الأرض الأم، ففيها انسيابات شعرية تمجّد هذا الانتماء وتضعه في خلفية وجدان الراوي أينما توجّه، كما أن الرواية لا تنفي عوامل الافتراق بين الشرق والغرب، لكنها في شبكة الحكايات التي تكوّنها تعبّر عن القلق في مرحلة تجاوز خيمة المكان الواحد التي تحجب سماء البشر وأفق البعيد المؤدي إلى اكتشاف الآخر ومعه اكتشاف الذات في صيغتها الجديدة والمتجدّدة. بل إن روح الراوي لا تكتفي ببيوت ثلاثة أو أربعة متباعدة، فتلك مطلب الجسد المعجزة بحضوره المتعدّد وهناءته المستجيبة لعشق التنوع، إنها تطلب ملجأ يقيها التجارب المفتوحة على احتمالات الشر والدنس، ويقترح الراوي ملاجئ مختلفة ككاتدرائية قديمة في مدينة صناعية أو صومعة مهجورة أو بيتاً حجرياً منسياً، أو محترف رسام أو متحفاً لآثار نادرة.
"آخر الأراضي" رواية السفر، جسداً ووجداناً، وهي أيضاً رواية سفر الروح في الهاجس الذي يحكمها، أعني الموت بأشكاله وتحولاته. ويكون السفر طلباً لاكتشاف الذات أو اكتمالها ما يجعله مقترناً بالحب الدافع إلى رحلة الراوي في القطار وفي غير القطار، بحثاً عن أخت روحه كلارا التي يجدها أخيراً في آخر الأراضي وفي صيغة الموت- الاختفاء. لقد تعبت كلارا ليس من مرضها إنما من جهدها لإخفائه، ويمكن أن نخاطبها بالقول: تبكين في السرّ. بعد منتصف الليل. تمرضين داخل جدران أربعة. وعند الإعلان تعلنين نهضة الجسد. والأجراس تسمعينها أجراس عيد.
كلٌّ يبحث عمّن أضاعه ليكتمل. لا يستطيع الإنسان العيش وحيداً. ويعرض علينا الراوي أن الإنسان لن يستطيع العيش في مكان واحد. في خيمة. لذلك يذهب إلى اكتماله في الحب والسفر.
"آخر الأراضي" رواية الطريق والمشّاء اللذين يتمظهران في الكتابة. وهي حفر في الإنسان الفرد فلا ملائكة على الأرض، إذ يكتشف أحد العابرين في الرواية أنه ينطوي على شرّ. يخاف من نفسه ويذهب إلى عزلة وإلى ما يشبه انتحاراً. ليس من مطهر أو أن هاجس النقاء أعماه عن رؤية مطهر ما لينقذ نفسه الأصلية. هي رواية السفر في أمكنة الجمال شرقاً وغرباً، الطبيعة والعمارة، وقلما نرى حشوداً في تلك الأمكنة، كأنّ ضوءاً كاشفاً يركز على الراوي وعلى أفراد معدودين يَذْكُرُهم، وما سوى ذلك ظلمة حالكة. ولكن، يكفي منظر جميل واحد ليختصر جمال العالم، ويكفي إنسان واحد لنعرف من خلاله أحوال البشر. أين أنت يا أبا العلاء قائلاً: "أتزعم أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالمُ الأكبرُ"؟ أمكنة وأزمنة تحضر وتغيب على مساحة السّرد. وليس من خطية في السياق. إنها شبكة حكايات تجد خطّها أخيراً في وجدان القارئ. رواية تشبه نفسها، كلاسيكية في مناخاتها لا في بنائها الذي أراده الكاتب مفتوحاً على الذات القلقة ولكن المنطلقة بلا حدود. رواية السفر في الحياة وملامسة الموت في كل حركة، وهي تعرض إنسان عالمنا الجديد الذي يتخوّف من مصيره فيستعين بالحب والذكريات والتركيز على أشياء الجمال.
ولأننا هذه الأيام في لبنان لا بد من الاستدراك: نرى يومياً عاديّةَ الموت في المجازر العبثية، غياب الإنسان بما هو إنسان، الموت وهو يتهيأ ثم يتحقق. ونسأل: هل بقيت دول أوروبا، ومعها لبنان الذي يقاربها في التعدُّدية، أمكنة إشعاع وجذب، أم أن الخوف يدعوها إلى الانكفاء ورفض الآخر لأنه آخر؟ هل بقي الشرق طامحاً إلى إشعاع الروح بعيداً من مستنقعات الخرافة، وهل بقي مصرّاً على نهضاته يستعيدها بعد كل فشل وخراب؟ أم أن الشرق سائر إلى عدوانية مطلقة ينقطع عن العالم من حيث يكرهه ويعتبره عدواً؟
أسئلة خشنة نقحمها في مقام الرواية المتعالي".
شوقي الريّس
اختتم شوقي الريّس مداخلات الطاولة المستديرة بما يأتي: "في كتابه "كائنات من نسج الخيال" يحدّثنا خورخي لويس بورخيس عن طائر أسطوري لدى الشعوب الأرومية في أميركا اللاتينية، مزيته أنه يبني عشه عكس سائر الطيور ويطير ناظراً إلى الوراء، كأنّه لا يكترث إلى أين هو ذاهب، بل من أين جاء. أنطوان الدويهي، عندي، هو هذا الطائر، المحلّق دوماً، ناظراً إلى الوراء، مسافراً إلى الداخل، إلى الأعماق الأثيرة لديه، إلى الأماكن الأخّاذة، والمهدّدة في جمالها وجوهرها، في البلد الذي لم يعد للجمال فيه مناخ ولا مواسم. كتاباته ليست سوى ذريعة لهذا السفر. يتساقط فيه على نفسه كأزاميل النحّاتين. كمن يحاول الاغتسال من إثم لم يقترفه، او التطهّر من خطيئة لم يرتكبها.
لا أظن أن اختياره سكبَ هذا الحوار حول روايته، في عالم الترحال والسفر، بعد ان سبق له واختار الموسيقى والرسم إطاراً لحوار آخر، إلا ترسيخاً لمعتقد مفاده أن الهدف من الكتابة – الهدف الأسمى – كما الموسيقى والرسم، والسفر، ليس الوصول إلى مكان معين، بل هو نظرة جديدة إلى الناس ، والأشياء، والعالم. لا أعتقد أن ثمة فعلاً يشبه الكتابة، لا بل يتماهى معها، مثل السفر. السفر ليس من أجل الوصول، بل من أجل السفر،. من أجل أن نصل متأخرين. أو من أجل ان لا نصل أبداً. هذا التقاطع الرهيف بين الكلمات والطرقات، نشتهي أن لا ينتهي. نخاف أن ينتهي هذا الذي يسمّيه أنطوان الدويهي "العالم الداخلي... العالم الحقيقي الوحيد"، ويقول إن "الحياة الداخلية هي الكون برمّته، وعندما تنطفئ الحياة الداخلية، ينطفئ الكون".
والسفر إلى الداخل، حيث المطارح تبقى ماثلة بعمق في فسحة الذات، هو أقرب ما يكون من كتابات أنطوان الدويهي، التي تكشف لنا عن حقول فسيحة في أعماقنا، لم نكن نعرفها. وإذ ندخل إليها، نكتشف مزيداً من مجهولاتنا وتتعدّل دروبنا – هذا في الأقل ما يحصل معي – ونزداد فهماً لهذا المنفى المتحرِّك، الغامض والفسيح الذي نعيش فيه، والذي نظلّ، نحن، فضاءه أنّى توجّهنا. آنذاك تتكشّف لنا اسئلة، أعمق ما فيها أنها تبقى بلا أجوبة. ونكتشف ان هناك غموضاً يتعذر جلاؤه، وسوف تكون الحياة نفسها متعذرة إذا جلوناها بشكل كامل. ثم نكتشف أن الغموض نفسه سفرٌ، وأنه هواءٌ آخر نتنشّق، لكي تصبح إقامتنا على هذه الأرض أكثر متعة، وأكثر جاذبية.
منذ ان ألفتُ كتابات أنطوان الدويهي، وأتيح لي أن أطلّ على بعض دخائله الكثيفة الصافية، صرت أقارب أدبه تماماً كرحلة موعودة: أبدا القراءة بلهفة وقلق، وأنتهي بحسرة وكآبة لذيذة، وتوق إلى العودة مع صديق، مع حبيب، مع كل الناس.
كالمسافر أنطوان عندما يكتب، يقيم في كل الأمكنة، ولا يقيم في أي مكان. المكان عنده أصلٌ مسكونٌ بهاجس الترحّل، كالجذر المسكون بالفرع. إنه انشقاقٌ يحمله الانسان في ذاته: بين كينونته وصيرورته. كأن الترحل أفق الأصل، كأنه، لذلك، ماهيته. ونحن، حين نلغي الترحّل، نلغي غنى العالم، أي أسراره ومجهولاته التي ليس أقدر من الكتابة على كشفها واختزانها. هكذا نترحّل لكي نكتشف العالم، مقامنا فيه، إقامتنا.
والكتابة مكانٌ لهذا الترحّل، لهذا الكشف المعرفي. إنها السفر الذي يكتشف السرّ فيما يبقيه طي الخفاء. إنها الجسد مترحّلاً. طبيعة ثانية، أو كأنها الطبيعة وقد تحوّلت أبجدية. الطبيعة التي يشعر أنطوان بعذاباتها وآلامها، كما يشعر بعذابات الناس وآلامهم. ولا يملك غير الكلمة ضمادةً لهذه العذابات والآلام.
من أجمل ومضات فيديريكو غارثيا لوركا، وأشدّها كثافة، ما يقوله عند التهيّب للكتابة، كما لو انه على سفر أخّاذ وعسير: "سوف لن نصل. لكننا ذاهبون!". السفر، الكتابة، لكي نعيش الحياة اليومية للآخرين كما لو كانت حدثاً استثنائيّاً، يشبهنا ولا يشبهنا. نتذرّع به، ونتقمّص عالماً آخر. نحلم له، ننشده ونتوق إلى العيش فيه، عن ادراك أو غير إدراك...
وها هو أنطوان الدويهي يتساءل في "آخر الأراضي": "كيف عندما ينوجد الانسان في مكان آخر، ناءٍ، يمكن ان يصبح إنساناً آخر، يبدأ حياة أخرى، لا علاقة لها بحياته ؟". هكذا تجري الكتابة في نهر اللغة والعالم، كمثل سفينة تعانق اللجة فيما تحتضن الضفاف. كأنها المكان مهاجراً داخل المكان".
أنطوان الدويهي
بعد فتح باب النقاش امام الحضور، علّق أنطوان الدويهي بالآتي: "يطرحون عليّ أحياناً هذا السؤال: "لمن تكتب؟". أنا لا أكتب لأحد تحديداً. حين أكتب، لا أفكّر قط بالقارئ، أي قارئ، ولا بأي جمهور. لا علاقة لي بهذا الأمر. لكنني أسَرُّ حين ألتقي من وصلت إليه هذه الكتابة، ومن تفاعل عميقاً معها، مثلما هي الحال اليوم أمام هذه المداخلات الأربع المؤثرة، التي كان لها وقعها في نفسي.
لا أعتقد ان كتابتي يمكن أن تصل إلى الجميع. الكثير من القراء يفتش عن كتابات تحمل إليه متعة ما، غالباً ما تكون سريعة الزوال، او إثارة عابرة، أو يفتش عن كتابة تحمل إليه معرفة، تاريخية، أو سوسيولوجية، أو سياسية، أو حتى فلسفية، أو حول أحداث مأسوية شهيرة، تثير حشريته، او غير ذلك... أنا خارج رواية الموضوعات وأدب الموضوعات، المتنقلين على الدوام من موضوع لآخر، لا علاقة بالضرورة بينها، يجهد الكاتب في جمع المعلومات والوثائق عنها قبل معالجتها. أنا لا أقوم بأدنى توثيق. لا علاقة لعوالمي الأدبية بالموضوعات والتوثيق. عوالمي الأدبية مستمدّة من الغوص في الحياة الداخلية، حتى الأعماق، وحتى أبعد الأبعاد، حيث الذاكرة، التي هي شمس الروح، وحيث أغوار اللاوعي، وحيث الحالات، والهواجس، والمشاعر، والنزعات، والأشواق، والأحلام، والرؤى... مستندي الوحيد هو تلك "اليوميات الداخلية"، التي أدوّن فيها كل ذلك، منذ سن الخامسة عشرة حتى اليوم، والتي هي المعين السري الوحيد لكتابتي. وحسناً فعل شوقي الريّس حين أشار إلى ما أذكره عن الحياة الداخلية بأنها "الحياة الحقيقية الوحيدة"، وبأنها "الكون برمّته"، وبأنه "حين تنطفئ الحياة الداخلية، ينطفئ الكون". فما أنا إلا شاهد، أشهد لذلك. "ما أنا إلا شاهد، أشهد لما أنا فيه".
لذلك أعتقد أن ثمة "نخبة" تصل إليها عوالمي الأدبية. ليست هي نخبة اجتماعية، أو فكرية، او ثقافية. كلا. هي نخبة الموصولين بهذا الشيء السري الذي هو "الشيء الأدبي"، بالمعنى الجمالي والسحري للكلمة. هو رابط عميق مقيم في فئة معينة من النفوس، التي تملكه بطبيعتها. أمر يصعب تفسيره. وهو غير مرتبط بالضرورة بالثقافة، ولا حتى بالأدب. إذ، في الحقيقة، هناك العديد من المثقفين والأدباء، لا علاقة لهم بـ"الشيء الأدبي". يمضون حيواتهم من دون أن يدركوا ذلك. مثلما هناك العديد من رجال الدين، الذين لا علاقة لهم قط ب "الشيء الروحي". كما هناك العديد من الناس "العاديين"، إذا جاز التعبير، الموصولين ب"الشيء الأدبي".
ثم، ثمة امر آخر أود الاشارة إليه. يسألون الراوي في "آخر الأراضي": "لماذا تكتب؟". يجيب: "لأن دعوة الكتابة هي دعوتي"، ثم يضيف: "ولأنها هي ردّي الوحيد على الموت".
كيف تكون الكتابة رداً على الموت؟ ربما لأنها تحفظ المكتوب، خارج طوفان النسيان والاندثار، فيبقى حيّاً في الذاكرة البشرية لأزمنة طويلة، او لأزمنة لا تنتهي.
لكن هناك غير ذلك في الردّ على الموت. هذه الحياة الداخلية الذاتية، الفريدة، الشاسعة، في وعيها ولا وعيها، هذا الكون الداخلي برمته، بأمكنته وأزمنته وأشخاصه التي لا حصر لها، وبحالاته ومشاعره وهواجسه وأشواقه...كيف ينطفئ، وفي أي عدم يتبدد، إذا تعرّض الجسد لرصاصة صغيرة بائسة، أو صدمة عمياء على طريق فرعي، او غير ذلك من التوافه، ممّا يميته في لحظة؟ الكتابة هي لحفظ كنوز الحياة الداخلية، الحياة الحقيقية الوحيدة، في منأى من "هذه الفضيحة الكونية التي هي هشاشة الجسد البشري"، وهذه "الفضيحة الكونية التي هي الموت". وما تحفظه الكتابة ليس هو كل الحياة الداخلية قط، بل جزء بسيط منها. هو جزء بسيط لا اكثر من تلك اللحظات المتوهجة، من تلك الكنوز اللامرئية، الموعودة بالعدم الداهم.
ثم هناك أمرٌ أخير في موضوع الكتابة ردّاً على الموت. إنها الرغبة الهائلة في التواصل مع كل ما هو حيّ، على امتداد العالم. إنه لأمر بالغ المأسوية ان يكون الشعور الطاغي الذي يجتاحنا في هذه اللحظة، في تلك اللحظة، لا تشعر به البشرية جمعاء. أذكر في "كتاب الحالة"، قبل خمسة وعشرين عاماً، ما معناه:
"ما هذا الوجود غير الموصول بكل ما هو موجود؟
ما يحيا يحيا من دوننا
ونحيا من دون ما يحيا".


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية