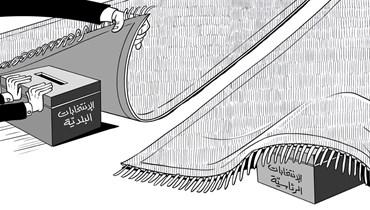"تعرّفت إلى جان في العام ١٩٧٨. كنت بدأتُ أدرس #السينما بأميركا في عز الحرب. التقيتُه خلال العطلة الصيفية، كان لنا أصدقاء مشتركون يعملون في السينما نصحوني بالتعرّف إليه. تفاجأتُ أنه يدعى جان شمعون ويعمل في مؤسسة السينما الفلسطينية! كان يصعب ربط اسم كهذا بالسينما الفلسطينية. اعتبرتُ الواحد نقيض الآخر. وعندما التقيته، تبيّن لي أنّه نقيض اسمه حتى: شاربان، لهجة بقاعية…(ضحك). اللقاء الأول لا يزال مطبوعاً في رأسي. كان يعرض أفلاماً على شراشف في الأحياء الفقيرة لناس لم يروا فيلماً في حياتهم. يهوى خوض نقاشات طويلة. كان جان شخصية منطلقة وصوتاً جهورياً وطريقة خاصة في الترحيب بالآخر، يختلف عن كلّ الذين أعرفهم. عندما علم أنّني أدرس في أميركا، قال: “ايه، روحي كملي وارجعي”. وهذا ما حصل. في أواخر العام ١٩٨١، عدتُ، فالتقينا على مشروع له وأغراني بإعطائي عليه ثلاثة آلاف ليرة لبنانية. مبلغ لم أتقاضاه يوماً (ضحك).
عندما اجتاحت إسرائيل بيروت في العام ١٩٨٢، كانت في تصرّفنا ٩٠ بكرة لأفلام ١٦ ملم. كنا اشتريناها من فرنسا لتصوير فيلم وثائقي. وكانت في تصرفنا كاميرا من مؤسسة السينما الفلسطينية. أنجزنا فيلمين، الثاني لم نكمّله. كان جان يظهر في الفيلم، يتجوّل بين الناس ويتحدّث معهم بعفوية. الفيلم الذي حقّقناه، "بيروت تحت الأنقاض”، وثّق تجربة حصار بيروت، وفي الوقت عينه كنّا نصوّر مَشاهد غرائيبة قريبة من أجواء “بعدنا طيبين” (برنامجه الإذاعي) التي بقيت في حالة “راشز”، وهي الآن موجودة في لندن. في العام ١٩٨٣، بعد مجزرة صبرا وشاتيلا، كان الوضع صعباً، فانتقلنا إلى فرنسا، حيث لجان فيها معارف وعلاقات وصداقات، كونه درس هناك. منتجنا “تحت الأنقاض” هناك. الآف الناس كانوا يُخطَفون في بيروت. عشنا في فرنسا سنوات، ولكن كنا نزور لبنان. ثم أنجزنا “جيل الحرب”، لحساب الـ”بي بي سي”، شاهده الملايين وقتها وفتح لنا آفاقاً جديدة. باتتأفلامنا تُبث على محطات غربية يشاهدها جمهور عريض. عزّز هذا علاقتنا بالـ"بي بي سي" فأنتجت لنا أفلاماً عدة. قرّرنا الانتقال إلى لندن. حتى اننا عشنا في أميركا لفترة، ومنتجنا فيها. صعبَ علينا العيش خارج لبنان. أفلامنا هنا. كان عندما يقع أمر ما، يهرب الناس من بيروت ونحن نعود اليها. ثمة أشياء كثيرة شدّنا إلى هذا المكان. في استطاعتي إنجاز أفلام في أي مكان من العالم، ولكن ليس لي فيه موضوعات. أشعر نفسي معنية بما يحصل هنا. ألمس جدوى ما أفعله.

تطوّرت العلاقة تدريجاً. لبناء علاقة عاطفية، يفترض وجود شيء يجمع الطرفين. أفكار، أهداف، مشروع حياة.. كانت لدينا أشياء مشتركة وأحلامشبيهة. أحببنا بعضنا البعض، ولكن عن اقتناع. لم يكن حباً غير مدعوم باقتناع. جاء الحب في أسوأ مرحلة: ١٩٨٢. أتذكر أننا كنّا نصوّر الدمار في دار للعجزة بالقرب من مخيم صبرا. في هذا المأوى، بعضهم كان يعانيخللاً عقلياً، واللافت أنّ الحرب أعادتهم إلى حالهم الطبيعية، إذ كانوا ينظرون إلى ما يجري من حولهم في اعتباره جنوناً، رغم أنّهم كانوا متّهمين بالجنون. في الخارج، كان حقل ألغام: إسرائيل تجرّب أسلحة تستخدمها للمرة الأولى، وبينها قنابل عنقودية. كنا نناقش شيئاً يخصّ السينما، مع العلم أنّه كان في استطاعتنا الدوس على لغم في أي لحظة… هكذا بدأ الحبّ. كان يقول لي دائماً أنّه لديه ثلاثة شروط للارتباط بفتاة: أن تكون جميلة ومناضلة وذكية. وبنظره، توافرت الشروط الثلاثة فيّ (ضحك). أنا أيضاً كان يهمني توافر هذه الشروط في الشخص الذي سأحبّه، ولكن ليس بهذا الترتيب. فعليه أن يكون أولاً مناضلاً وثانياً ذكياً وثالثاً جميلاً. لا يسعني الارتباط بشخص ليس على الأقل مناضلاً ولا يتمتّع بذكاء. الجمال شيء إضافي. أتحدّث عن النضال بالمعنى الإنساني، يعني أن يكون للمرء قضية. لا أقصد الالتحاق بالأحزاب، الأمر الذي لم يفعله جان في حياته، علماً أنّمعظم الأحزاب تشدّنا نحوها. كانوا يتّهمونه بأنه شيوعي، وهذا غير صحيح. جان كان مؤمناً بالجوهر، لا بالشكل. كان يحترم المؤمنين ولكن لم يكن مؤمناً ممارساً الطقوس. إنّه علماني. تزوّجنا زواجاً مدنياً في فرنسا. فكلّ منّا ينتمي إلى ديانة مختلفة. أهلي عارضوا في البداية. ولكن تقبّلوا الأمر عندما تعرّفوا إليه. جان ينبذ الطائفية ويرتاح إلى البسطاء من الناس.. وكان الآخرون يحبّونه لعفويته وطيبته. لم نختلف يوماً على مسألة دينية طوال سنوات عيشنا معاً.. ربينا ابنتينا على العلمانية. كان شعاره: "خير الناس أنفعهم للناس". هذه كانت ديانته. بيته في الصنايع خلال الحرب كان يقع في مبنى بيروتي قديم، ضمن منطقة أوت مهاجرين نزحوا من النبعة والكارانتينا والجنوب، منطقة أطياف متنوعة. كان جان بمثابة مختار هذا الحي، كلما اختلف اثنان يصالحهما. أحياناً، تتجادل النساء على المياه، فترتفع أصواتهنّ بعد منتصف الليل، فكان يتدخّل.

أحبّه الناس. صوّرنا في الجنوب ومكثنا في البيوت. الآن، بعد مرور ٣٠ عاماً، علمتُ بأنهم أقاموا مجلس عزاء في قرية شحور، كأن الفقيد فقيدهم. أثناء التصوير، عندما يدهم الجيش الإسرائيلي المنازل، كان يرافق الشباب المقاومين إلى نهر الليطاني. لم يحمل السلاح في حياته. في صغره، اصطاد عصفوراً، فتعرّض لصدمة ولم يلمس بعدها قطعة سلاح واحدة.
أنجزنا أربعة أفلام إخراج مشترك. بقية الأفلام فيها عمل مشترك، ولكن ليس إخراجاً متشركاً. أفلامنا معاً كإخراج نُفّذت بطاقم صغير، أتولى الكاميرا وهو الصوت، ثم أتسلّم المونتاج. عملنا بمبدأ التكامل لا الاختلاف. شغلنا الاسلوب، فسعينا إلى لغة جديدة مع كلّ فيلم. بخاصة في "زهرة القندول"،حيث حاولنا إنجاز دوكو دراما، بعيداً من التقليدية.
لفينا بلداناً كثيرة، قمنا بعدد من الجولات في أميركا وأوروبا والدول العربية. لم نكن نترافق في السفر دائماً، خصوصاً عندما رزقنا بأطفال. لدينا طن من الحكايات: في إحدى المرات، كنّا نناقش "زهرة القندول" مع الجمهور الأميركي في جامعة جورجتاون. غالباً، يكون الجمهور الغربي متعاطفاً مع القضية التي نطرحها، وأحياناً يكون في الصالة أحد الصهاينة الذي يحاول التذاكي، فجان كان ينفعل بسرعة، وكونه فرونكوفونياً، انكليزيته لم تكن تسعفه. وفي الحقيقة، كنت أفرح بوجود بعض المشاكسين كي يحتدم النقاش. التعاطف المتواصل ممل. يومها في جورجتاون، كان بين الجمهور شابة صهيونية تنتقد عدم إظهارنا وجهة النظر الإسرائيلية أو شيء من هذا القبيل. فطلب مني جان بغضب شديد القول لها إنّ إسرائيل هي العدو المصيري. لم أكن أعرف كيف أترجم عبارة “العدو المصيري” في أميركا وباللغة الإنكليزية! فظلّ يصرّ، إلى أن جاء الردّ من الجمهور نفسه!

خلال الاجتياحات والضربات الكبيرة، يزداد تعلق الإنسان بالحياة، وتكتسب الأشياء معنى أكبر. الحبّ، الحاجة إلى الفرح… كلّ شيء يتضاعف. تخفّ المسائل السطحية. تجربة الاجتياح الإسرائيلي كانت من أصعب التجارب التي عشناها، خصوصاً أنّني كنت أخوض تجربتي السينمائية الأولى. كانت حرباً شاملة على مدار الساعة، بحراً وجواً وبراً. احتار الناس إلى أين يذهبون، فالمباني راحت تُدك على رؤوس قاطنيها، ونحن صوّرنا أموراً مماثلة في أكثر من مناسبة. كنّا نصعد إلى أسطح المباني لنصوّر الغارات. أتذكّر مرة أنّنا صعدنا ١٤ طبقة برفقة ناطور المبنى، وكان لا يكف عن الكلام بالرغم من حاجتي لتسجيل صوت الطيران الذي يحلق فوق رؤوسنا. فأشرتُ له كي يصمت، الأمر الذي أرعبه. كانت هناك فكرة راسخة هي أنّ الطيران الإسرائيلي في إمكانه استطلاع كلّ شيء على الأرض، حتى علبة السجائر. نظر الرجل في السماء، وسألني: “بيسمعونا؟”. هذه من الأشياء التي لا أنساها. جان جازف كثيراً، وهذه من الأشياء التي أزعجني. لا يتردّد فيالدخول إلى أرض المعركة. ينبغي أن تكون المجازفة في السينما مدروسة. عشنا مَشاهد سوريالية، حدث أحدها في شارع الحمراء أثناء الاجتياح. كنّا نشتري قنديل غاز بسبب انقطاع التيّار الكهربائي. فجأة، تساقط علينا الرصاص من كلّ صوب. سيّارة مسرعة آتية من أول الحمراء، ومَن في داخلها "يمشّطون" الشارع من أوله إلى آخره بالرشاشات. جان رماني أرضاً، شعرتُ كأنني في فيلم وسترن. هذا مشهد لا يفارقني. كانت لجان سرعة بديهة ساعدته في إنقاذي يومها.

تعرّضنا للكثير من الأشياء المماثلة من المسلّحين. مرات، كنّا نتعرض لإطلاق نار. أكثر مرة تعرّضنا فيها لمغامرات كانت يوم صوّرنا "بيروت - جيل الحرب" على خط التماس. صوّرناه لحساب محطة "بي بي سي" البريطانية في العام ١٩٨٨. كان البلد يمرّ بظروف صعبة جداً. الأحزاب الطائفية بدأت تتسلّم، وانطلقت المعارك الداخلية. لم يكن ثمة شيء واضح، المتاريس في كلّ مكان. في هذا الفيلم، دخلنا أجواء المقاتلين الشباب؛ هؤلاء الذين يمكن تسميتهم بجيل الحرب. شاهدنا أشياء لم أرها في حياتي. حزنّا وتأثّرنا مع إدراكنا أنّ حاملي السلاح هم ضحايا قبل أي شيء آخر. صحيح أنّهم أطلقوا النار على بعضهم البعض، ولكن ثمة رابطاً بينهم. الطرفان جمعهما الفقر. تبدّى هذا جلياً في خطّ التماس بين الشيّاح وعين الرمانة.. كنا نجالسهم ونسمع أحاديثهم. يعرف أحدهم الآخر بالاسم.

جان يمثّل لي هذه الشريحة من الناس الذين اندثروا. باتوا يتساقطون واحداً تلو الآخر. إنّه من جيل الستينات، من الذين فعلوا شيئاً ما للثقافة في لبنان.. بعضهم لا يزال حياً. أجدهم بمثابة معالم وطنية. جان يعبّر عن أحلام جيل لم تتحقّق. ولكن هذه الأحلام كانت مهمة آنذاك. أنا أصغر منه سناً، ولكن يسعدني أنّنا عشنا هذه الأحلام وإن لم تجد طريقها إلى الواقع. بينما الجيل الجديد لم يُفسح له حتى المجال ليحلم أحلاماً كبيرة. باتت أحلامه شخصية لا تتعلّق بوطن أو قضية. الأفلام التي أنجزناها تحفظ ذاكرة الحرب، ذاكرة تغيب حتى عن الكتب. جان من الذين صانوا الذاكرة.
لم يتعرّض لليأس. لم يُصب بالإحباط على الصعيد الشخصي. كان سخطه على السياسة كبيراً. لم تتغير مواقفه البتّة. حتى أنا لم أتغيّر. ظلّ على اقتناعاته. لا أؤمن بالاصطفافات.. الناس "بتروح بتجي"… نحن كنّا واضحان في ما يتعلق بالشؤون الكبيرة. ثمة أمور أساسية لا تحتمل اللعب. في المقابل، صرنا أكثر انفتاحاً مع مرور الزمن، وبتنا نسمع الآخر. جان أكثر جذرية مني، ولكن طريف حتى في حزمه، كونه واضحاً ولا يلعب. اصطدم بالناس، وحاولتُ ترطيب الجو، رغم انحيازي لرأيه. يختلف أسلوبي عن أسلوبه. كان صاحب عنفوان، ينفعل بسرعة، "ينرفز". العصبية جزء من شخصيته، ولعلها سبب من أسباب مرضه.
ثمة موضوعات كنّا الأوائل في طرحها، كقضية المخطوفين أو موضوع البيئة الذي يؤثر في حياة الإنسان. هذه أمور تهمّ الجميع، ولا تطال فريقاً دون الآخر.

بدأ المرض يفتك به شيئاً فشيئاً. إلى درجة أنّه يصعب استذكار اللحظة التي أصيب به. ظهرت العوارض الأولى من نحو عشر سنوات، ولكن بقي على نشاطه بشكل عادي. أنجز فيلمين في تلك الفترة، "حنين الغودول" العام ٢٠٠٧ و"مصابيح الذاكرة" العام ٢٠٠٩. في البداية، كان تأثير المرض خفيفاً، ولكن راح يزداد مع مرور الزمن. كان نوعاً من الألزهايمر. أسباب عدة تؤدي إلى إصابة الإنسان به، أحدها الضغط.. اللافت أنّه راح ينسى الذكريات الحديثة، وظلّ يحتفظ بالقديم. لم يدرك وضعه الصحي، وهذه رحمة.
ذاكرته العاطفية كانت قوية. لا أعرف إذا استوعب "٣٠٠٠ ليلة" عندما شاهده، ولكن كان يعي كلّ شيء آخر.. يعرفني ويعرف ابنتينا. العلاقة الحميمية ظلت قائمة حتى اللحظة الأخيرة. بقي متماسكاً ومبتسماً. كنت أشعر معه أنّ الحبّ والحنان أهم شيئين، وجان كان محباً إلى النهاية. ولكنه فقد ذاكرته السينمائية؛ غابت عن باله كلّ الأفلام التي أنجزها. مع أنّالرغبة لم تفارقه. في كلّ مرة كنت أقول له أنّني ذاهبة للتصوير، أراه متحمساً. كان ينتعش. طوال سنوات نشاطه، راكم مشاريع لم تُنجز. أحدها عن الموسيقى العربية. أراد انجاز هذا الفيلم حتى قبل أن نتعارف. إحدى رغباته أيضاً إعادة تجربة الفيلم الروائي. كنا بدأنا كذلك العمل على فكرة استرجاع أفلامنا الوثائقية القديمة لإعادة اكتشاف الشخصيات في ضوء الحاضر، علماً أنّه أنجز فيلمين على هذا المنوال، أحدها "مصابيح الذاكرة"(آخر عمل له)، عن تجربة وداد حلواني والمخطوفين. أشعر أنّ عنوان الفيلم هذا كان يحمل دلالة.
مرضه أصعب علينا من صعوبته عليه. إنّها معاناة الناس المحيطين بالمريض. في البداية، راح أحياناً ينسى التفاصيل اليومية، ولكن يتذكّر الماضي. ثم، دخل في مرحلة لم يعد قادراً فيها على العمل. ولكن كان متماسكاً وحنوناً، كأنه يعود إلى ذاته الحقيقية، إلى جوهره، إلى الطفل الذي كانه. أقصد بالطفل، ذاك الصفاء! كان شيئاً جميلاً، لأن أسلوب مواجهة المرض يختلف بين إنسان وآخر. جان عاد إلى طبيعته الأصيلة، وهذا ما بقي منه، وما جعلني صامدة. حتى آخر لحظة، كان مبتسماً. رحل بهدوء تام. لم يتألم جسدياً. شعر أنّ ثمة شيئاً يتغيّر فيه ولكن لم يعانِ عذاباً واضحاً. تعذّبنا ونحن نراه يتلاشى أمامنا، ويتغيّر. عشتُ حداداً امتد عشر سنوات. كأنني أفقده كلّ يوم. كان بمثابة وداعاً يومياً. بقي حبنا المتبادل، لا بل ازداد قوة. كذلك بالنسبة لابنتينا. في الفترة الأولى، عاشتا الصدمة. لم نتقبل الحقيقة، ورفضنا الحديث عنها. ولكن مع الوقت أزعنّا، وصرنا نقدّر كلّ لحظة نعيشها معه.
تابع الأخبار باستمرار، تفاعل مع المستجدات السياسية وشتم (ضحك). ردات فعل كهذه أفرحتني أحياناً. بدا حقيقياً في هاتيك اللحظة. أخبار البلد وانقسامات السياسة الداخلية والسخافات كانت تزعجه، تضايقه وتضايقني. يجب القول أنّه لطالما اكبب على القضايا الكبيرة. وهذا ما جمعنا. قضية الإنسان وقضية فلسطين في صدارة اهتمامه. هذه مسائل استحقّت الحزن. وظلّ على حماسته حتى النهاية. لم يتبدّل ولم يستسلم. بقى الجوهر ونسى التفاصيل. أشعر أنّ هناك شيئاً رمزياً في مسألة نسيانه. كأنه امتلأ وجاء النسيان ليخفف عنه.
أسعده أن يزوره الآخرون. يفرح عندما يأتي سامي حواط إلى بيتنا ليعزف ويغني. ذاكرته السمعية لم تزُل. الموسيقى لا تغيب بسرعة من الذاكرة؛ ثمة أشياء تصمد أكثر من أشياء أخرى. حتى مَشاهد أفلام احتفظ بها.. كنا نسمع الكثير من الموسيقى. ثمة أبيات شعر أو ألحان أو مشاهد أفلام معيّنة كانت تعني له الكثير، ويتفاعل معها. من خلال بعض المَشاهد، استعاد شيئاً من الذاكرة. بعض الأصدقاء المقرّبين كانوا أوفياء له. ظلوا يزورونه. منهم نقولا دانيال الذي زرع له أرزة في الباروك. نوع من مبادرة رمزية. كان جان وقتها لا يزال قادراً على الاستمتاع. في الجناز، طلبتُ إلى نقولا دانيال إلقاء كلمة، وتمنيتُ أن يتحدّث عن الأزرة التي زرعها لجان. فقال إنّها ترمز لأصالة لبنانية معينة، أصالة باتت مفقودة في أيامنا هذه، أو لعلها فقدت منذ زمن بعيد.

كثر لم يكونوا قادرين على رؤيته. لم يشاؤوا رؤيته متغيراً. أرادوا الحفاظ على صورته السليمة في مخيلتهم. وهؤلاء الأكثرية. أتفهّم خيارهم. إنّهم محبون له. في النهاية، غير مهم إن جاؤوا أم لا… عندما كان حياً، كنت أحلم به. أرى كوابيس تنتكس فيها حاله الصحية وإلى ما هنالك. والآن بعد رحيله، صرت أحلم به وهو يضحك ويمازح. يحصل هذا للمرة الأولى. حلمتُ به يومياً، ولكن بعد موته تغيّرت طبيعة الحلم.
صورتُ "٣٠٠٠ ليلة" العام ٢٠١٤. كان جان حينها في أسوأ حالاته. تصوير الفيلم جعلني أتماسك. بدا انجازه ضرورياً للبقاء صامدة من أجل جان وابنتَي. أخرجني الفيلم من الحالة التي كنت فيها، فعانيتُ ضغطاً إضافياً.. وصلتُ إلى مرحلة شعرتُ فيها أنّني أنزلق. بالإضافة إلى حالة جان النفسية التي ضغطت عليّ، رافقني الضغط الذي يفرضه إنجاز الفيلم. لم يكن هو في حالة تسمح لي استشارته وأنا أصوّر، ولكن كلّ هذه السنوات التي عشناها معاً جعلت أحدنا ينصهر في الآخر، إلى درجة أنّني أتكلّم عليهكأنه لا يزال حياً. لا زلت أستعمل صيغة "نحن". أعرف رأيه في أمور عدّة. اكتسبنا الكثير من بعضنا البعض. تجاربنا تداخلت.. رغم الاختلاف في مقاربة العمل، كان أحدنا يُكمل الآخر. جسّدنا مشروعاً مشتركاً، يتعايش فيه الإنساني والعائلي والسينمائي. لذلك كنت أستشعر بوجوده خلال التصوير.. شعور لعلّه ازداد الآن. أشعره في داخلي".


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية