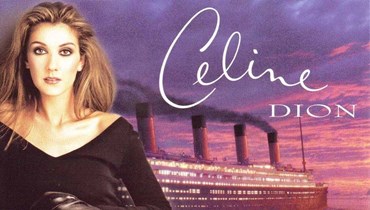إنّها صبيحة السبت في العشرين من شباط. من بين كلّ "أمكنة كلارا"، التي أجهد في الابتعاد عنها، لم أستطع التخلّي عن بلدة سولاك، في عالمها البحري النائي، التي آخذ القطار إليها ذهاباً وإياباً، نهاية كل أسبوع، منذ يوم الاختفاء، وها أنا متّجهٌ إليها اليوم أيضاً. شيءٌ ما لا يُقاوَم يجذبني إلى هناك، كما ذكرتُ من قبل. مع أن عشرات الرحلات لم تُظهِر لي ضوءاً ما، مهما خَفتَ، وعلى الرغم من ليل مضطرب آخر، دهمتني فيه الأحلام المضنية نفسها. استيقظتُ باكراً، مُرهقاً، وسلكتُ الطريق تحت المطر، أنا ومظلتي، إلى "محطّة الغرب".
زخّة مطر شديدة ضربتْ بلوّر النافذة، أنقذتني من قسوة ذاك الحلم. كنتُ على وشك الاختناق حين جاءني الغيث. كنتُ في ما يشبه مبنى مطبعة كبيراً، يضمّ طبقات داخلية فسيحة، وقاعات جدّ واسعة هي أيضاً، عالية السقوف وفارغة. كنتُ أريد الخروج منه. تذكّرت أني خرجتُ، في المرّة السابقة، عبر دربٍ شديدة الضيق والارتفاع، تلفّ بالكامل إحدى قاعاته الخالية، البالغة الاتساع، أفضت بي، نزولاً على درج حديدي، إلى قاعة أخرى تحتها، شبيهة تماماً بها، كان عليَّ اجتياز دربها الضيقة، الشاهقة، التي تلفّها بالكامل هي ايضاً. كان خروجي كثير الصعوبة، إذ إنّي أخافُ الفراغ.
لكن، هذه المرةّ، حاولتُ الخروج بالطريقة عينها، فلم أستطع. لم يكن في مقدوري التقدّم، ولو خطوات، على الدرب الضامرة، التي أضحت أكثر ضيقاً، وقد زال الدرابزون من حولها، وأصبحت أشبه بالحرف الإسمنتي الطويل، المنحدر، الملتفّ على نفسه على ارتفاع بالغ داخل القاعة. هممتُ بالسير فوقها، لكنّي عدتُ أدراجي سريعاً إلى الوراء، إذ كدتُ أن أصابَ بالدوار وأسقط من هذا العلوّ المخيف، أرضاً.
كان لا بدّ أن أخرج من المبنى. صادفتُ في حيرتي صبيّتين، لا أعرفهما، دخلتا القاعة، من بابٍ انفتح فجأةً، شبيه بباب المصعد. سألتهما بلهفة كيف لي مغادرة المبنى. دلّتاني في الآن نفسه، مشيرتين بيديهما: "من هنا!". ذهبتُ في ذاك الاتّجاه، حيث وجدتُ بضعة شبّان، لا أعرفهم، يسلكونه هم أيضاً. لكنّه، في نهاية الأمر، لم يفضِ بنا إلى الخارج، بل قادنا إلى مكان مكشوف، يتوجّب القفز منه إلى تحت، فوق ما يشبه المربّعات الإسمنتية. تريّثتُ في القفز، ونصحتُ الشبّان بأن يجدوا لهم مواقع أكثر انخفاضاً للقفز منها. لكن سرعان ما راحوا يقفزون، واحد عن يساري، وآخر عن يميني، وحذا حذوهم الباقون. وبقيتُ أنا، وحدي، عالقاً فوق، لا أجرؤ على مجاراتهم.
لكن، فجأةً، أخذتِ الأمورُ منحىً مأسوياً. بدلاً من خروج الشبان من المبنى، رأيتُ أحد الذين قفزوا عن يساري، وهو يغرق في ما يشبه مستنقع الوحل، الذي لم يكن مرئيّاً من قبل، إذ بدا أرضاً بالغة الصلابة. راح يغرق في الوحول وهو يصرخ مستغيثاً وملوّحاً بيديه. ورحتُ أصرخُ بالرجال، من حيث أنا، بأن يسرعوا إلى نجدته. أتوا إليه من كلّ الجهات. حاول أحدهم انتشاله بيده، وخلتُ أن الأمرَ قد نجح. لكن ما لبث، بعد قليل، أن وقع الاثنان في المستنقع. وجاء الآخرون لنجدتهما، فوقعوا مثلهما، وصار الرجال كلهم ممسكين بعضهم ببعض، وهم يغرقون في الوحول، ويصرخون في هلعٍ عظيم.
كنتُ أتوق، بكل ما أوتيت من قوّة، لإنقاذهم. لكنّي لم أستطع القفز من المكان العالي الذي أنا فيه. كنت على يقين بأنّي سأتحطّم شرَّ تحطيم. هممـتُ مراراً بالقفز، لكنّي بقيت أراوح مكاني، وأنا في حالٍ رهيبة، حين أيقظتني زخّة المطر. على الرغم من استفاقتي، لم أستوعب أني في حلمٍ حقاً، بل في الواقع، وكان شيءٌ قويُّ، غريب، يشدّني إلى ذاك المبنى، ويدفعني دفعاً نحو الرجال الغرقى الذين تركتهم. وأنا لم أخرج تماماً منه الآن أيضاً، وأنا ألج بوابة "محطّة الغرب".
يتقدّم بي القطار، وهو كالعادة شبه فارغ في فصول الصقيع، إلى سولاك البعيدة. لا أدري لماذا حضرتني عبارة "تُمطِرُ على زهرِ البرتقال"، وهي من العبارات التي تردُ فكري، هي نفسها، بصورة عفوية، بين حينٍ وآخر، من دون سبب، كلازمة للحن خفي لا أعيه. تذكّرني بعبارة "وعلى ثيابي اقترعوا"، التي كان يقولها والدي أحياناً بلا سبب. هل هو لحن الشوق إلى أريج زهر البرتقال في أراضي طفولتي، المتوارية ما وراء البحار، الذي يملأ الأرجاء كل عام، بدقة الساعة الكونيّة التي لا تُخطئ، بعد شهرٍ واحد فقط من الآن مع حلول العشرين من آذار، الذي يحمل في ثناياه، أكثر من أي شيء، روح الطبيعة ومجمع أسرارها؟ لا أدري. لكنّي عرفتُ أشياء عن جنائن البرتقال وعن البحر، خلال رحلتي الأخيرة إلى هناك، أعجبُ من نفسي كيف لم أعِها من قبل، ومن زمان.
حين ننتقل من موريا، بلدة الشتاء، بلدتي، إلى مدينة الفيحاء البحرية القريبة، المتحلّقة حول قلعة صنجيل، غالباً ما نمرّ في حيّ تلّ آغا، على مرتفع قبالة البحر، وقد أضحى مع الوقت مدينة في ذاته. تقع هذه الأمكنة الثلاثة على مجاري الينابيع والأنهر المنحدرة من جبل لبنان، التي تتحد، بعد موريا، في مسار واحد. ثمة كارثة معمارية كبرى حلّت على هذه الأنحاء مع ظهور مواد البناء الجديدة، والتكاثر السكاني، وتوالي الفتن والحروب، وضعف الدولة، وضياع الذوق الشعبي، والتهافت على "الرفاهية"، وخصوصاً، وهنا تكمن المأساة، توافر المال في هذه البلاد، قبل وقت طويل من توافر ثقافة البناء والمشهد، التي لم تصل إليها بعد، ولا مؤشّر لزمن وصولها. لكن الأرهب من هذه الفاجعة المعمارية هو عدم وعيها. دمار وتشويه هائلان، لا يشعر ولا يدري بهما أحد. كانت مدينة الفيحاء، الفينيقة الأصول، على مدى مئات السنين، عاصمة إمارات وولايات صليبية ومملوكية وعثمانية متوالية. كانت تحيط بها، جهة البحر، بساتين ليمون شاسعة، تفوح منها مطلع الربيع، على نحوٍ كثيف، ساحر، رائحة زهر البرتقال، التي أعطت المدينة اسمها. لكن فجأةً، أخيراً، خلال سنين قليلة فقط، تعرّضت البساتين للإبادة الشاملة، على مدى النظر، لتحلّ جحافل الأبنية مكانها، بحيث لم يعد في الفيحاء شجرة برتقال واحدة. بلا ترددّ ولا حسرة، كأنّها لم تكن. أمّا تل آغا، الذي كان يُعرَف بـ"جبل الزيتون"، فأبيد زيتونه عن بكرة أبيه، من دون أن يأبه أحد. أمّا لجهة موريا، فمصير حقول البرتقال والزيتون كان أفضل حالاً، على الرغم من التشوّه العمراني الكبير الذي حلَّ هنا أيضاً. ولا يعود الفضل لأهل موريا قط، بل للجغرافيا. كان برتقال الفيحاء يمتدّ على سهلٍ منبسط، على مستوى أرض المدينة، صالحٍ للبناء. أما تلّ آغا فكان توسّعه العشوائيّ السريع، محكوماً بالقضاء على زيتونه، المتداخل مع بيوته. لكنَّ لموريا شأناً آخر. هي مقيمة على تلّة فسيحة، شبه جزيرة مزنّرة بالأنهر، تطوّقها بساتين البرتقال الممتدّة حول مجاري المياه، في أمكنة منخفضة ورطبة، غير ملائمة للبناء. أما زيتونها فيمتدّ معظمه في السهول، خارجها، بعيداً عن مواقع السكن.
أمّا ما اكتشفته في رحلتي الأخيرة، فليس هذه الكارثة، التي أدركها من زمان، بل ظاهرة أخرى، كم استغربتُ عدم وعيي لها من قبل. تجوّلتُ في انحاء تل آغا، وشاهدتُ البحر. بين آلاف العمائر المتراكمة عشوائيّاً، السادّة الأفق من كلّ صوب، كانت ثمّة فتحات ومطلات ضيّقة، يظهر منها البحر. كانت رؤية زرقة اليمّ من فوق، هي آخر ما بقي من "جبل الزيتون" القديم، بعد إبادته، وهي بارقة الجمال الوحيدة في تلّ آغا. لا شيء تحلو مشاهدته في هذا الحيّ- المدينة المتراكم، إلا البحر. مع ذلك، امتلكني شعور طاغٍ بأن الناس، هنا، ترى كل شيء، إلا البحر، وتعي كلّ تفاصيل نهارها وليلها، وأشيائها ومشاغلها، إلا المشهد الأزرق. تدرك الجماعة كل شيء، إلا جوهرتها الوحيدة الباقية، فهي خارج وعيها. ولو زال البحر على حين غفلة، بسحر ساحر، من هنا، لما أبه له أحد.
ومثلما جلتُ في تل آغا، مشيتُ طويلاً حول بساتين البرتقال التي تزنّر موريا، بلدة الشتاء، وخجلتُ من نفسي كيف لم أفعل ذلك ولا مرّة، منذ صباي الأوّل. جنائن كثيفة، شاسعة، متلألئة الثمار، حافلة بجوقات العصافير، تتوالى بعيداً وعميقاً، بلا انقطاع، على ضفاف الأنهر الثلاثة وعلى وقع خريرها، رشعين الآتي من أسفل الجبل، وجوعيت وقاديشا، النابعين من أعاليه. لا أعتقد أن بلدة أخرى في المشرق تملك مثل هذه الغوطة الفريدة. ولا شك في أنّ برتقال موريا هو كنزها البديع، وأثمن وأبهى ما فيها. مع ذلك، لا يراودني شكّ أيضاً في أن شعب موريا لا يرى هذه البساتين، ولا يدري بها، ولا يعيها قطّ. وأنّ أي مقهى، أو متجر، أو محلّ لباس، في موريا، مقيم في وعي ناسها، أكثر بما لا يُقَاس من غوطة بساتينها. أعظم ما في موريا هو خارج وعيها. وهنا أيضاً، لو غابت جنائن البرتقال بسحر ساحر، لما تركتْ أثراً يُذكَر في وجدان البشر.
ما أدركتُه في رحلتي الأخيرة، أن مكمن العلّة في موريا، كما في تل آغا، الذي تنبثق منه كل مشاكلهما، أن الأولى لا تعي بساتين البرتقال، والثانية لا تعي البحر. إن استمرار الفتن والحروب في هذه الأنحاء، وتفاقم الأزمات المعقَّدة، المؤلمة، إنما يعود، في الدرجة الأولى، إلى هذا السبب الجوهري عينه، الذي أخجل من نفسي، يا للغرابة، كيف لم أكن أعيه ، أنا أيضاً. مثل موريا وتل آغا، سائر البلدات والمدن. وإذا لم يعد البحر، وبساتين البرتقال، وسهول الزيتون، وغابات الصنوبر، والتلال، والسفوح، وتلج عميقاً وعي هذه الأنحاء، فلن تعرف الخلاص يوماً.
*فصل من رواية لأنطوان الدّويهي، تصدر قريباً عن "الدار العربية للعلوم- ناشرون"، و"دار المراد"، بيروت.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية