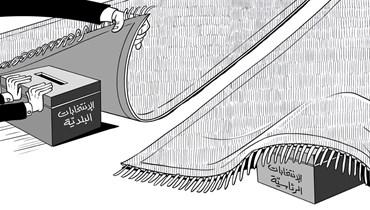رائد أنضوني عن اصطياده للأشباح: في السينما كل شيء ممكن
مشاهدة "اصطياد أشباح" لرائد أنضوني تجربة بسيكولوجية تفرض استسلاماً واعياً وكاملاً للمخرج وخطته الجهنمية التي تنطوي على كمية من العنف اللفظي والنفسي والجسدي الباهر. إنه نزولٌ إلى جحيم الانغلاق، ليس من دون دغدغة أحاسيس واستفزاز غرائز. من داخل الديكور الكلوستروفوبي الذي يشيّده فريق الفيلم، يتلاعب أنضوني بالخيوط والنفسيات التي تتخبط بين استذكار الماضي وإعادة خلق الحاضر في لعبة انعكاسات ومرايا. لا يرفّ للمخرج جفنٌ. إنه، في الحين نفسه، المهيمِن والمهيمَن عليه. عملية شدّ حبال خفيّة تظهر على امتداد الفيلم بينه وبين الشخصيات، ثم بين النصّ الممسوك والارتجال، بين أسطرة الشيء وتشييء الاسطورة، بين الرغبة في القفز فوق الأسوار والحاجة إلى البقاء داخلها. اللبس كثير، المشقّات في إيجاد الطريق إلى الحياة السوية، البعيدة من الاضطرابات، أكثر فأكثر. عبر تصوير شلّة من الرجال الذين اعتقلتهم إسرائيل لإستجوابهم في مراكزها، تتبدّل أشياء كثيرة، فيهم وفينا. تسقط مسلّمات معمول بها، تتحرر القلوب المليانة، وتمتد الألسنة إلى مناطق محظورة. عبر إلغاء موفّق للفواصل بين ما ينتمي إلى الحقيقة وما يُمكن تصنيفه في خانة الصياغة الإبداعية، يقحمنا الفيلم في تجربة نفسية قاسية، تُعتبر امتداداً لعمل أنضوني البديع "صداع". إلا ان العلّة تبقى في علاقة الشخصيات بالفيلم، التي هي في طبيعتها أسمى من أي علاقة قد تنشأ بيننا وبينه. علاقتنا بتجربتهم لا يمكن أن ترتقي إلى علاقتهم بها. لأن إعادة خلق تجربة تحمل في داخلها محاولة للتخلّص منها، أو أقله تقبّلها وتجاوزها، نتوصّل من خلالها إلى أن ندرك ما معنى العبارة التي تأتي على لسان أحدهم: "يللي جواتك، يا بتهزمه يا بيهزمك". بعد مهرجان برلين السينمائي، حيث نال جائزة أفضل وثائقي، كانت للفيلم محطّة في تظاهرة "أيام بيروت السينمائية"، تسنت لـ"النهار" خلالها محاورة أنضوني للمرة الثانية.

في برلين أثناء تسلّمه الجائزة.
* هذا أول عرض للفيلم في بلد "عربي" بعد عرض رام الله. شعرتُ أن هذا الأمر يعنيك...
- أعتقد نعم. كلّ جمهور يتفاعل مع الفيلم بطريقة "مختلفة". الفلسطينيون "أحلى شي": فظيعة كمية المشاعر التي تخرج منهم، سواء أكانت حزناً أم فرحاً. خصوصية العرض في فلسطين هي أن معظم المشاهدين كانوا معتقلين سابقين، ولهذا السبب لديهم قراءة "مختلفة"، أمامهم أوتوستراد مفتوح يوصلهم إلى الفيلم (...). بالنسبة إلى عرض بيروت، بيني وبين هذه المدينة طاقة إيجابية، في اعتقادي أن أساسها جيني. #سوريا ولبنان وفلسطين منطقة واحدة في النهاية. علمتُ أخيراً ان الإنسان لا يرث فقط عبر الجينات المظهر الخارجي بل أيضاً الذاكرة. الجينات تحمل ذاكرة بعيدة. هنا في بيروت ألمس طاقة هي طاقتي الحقيقية. بالإضافة إلى أهمية "أيام بيروت السينمائية"، هنا ثمة جمهور وتفاعل ونقاشات وروح طيبة. كلّني آمل أن تعود بيروت منصة لمشروع ثقافي عربي، لأنه لم تبق لنا عاصمة تنهض بمشروعنا العربي: بغداد دُمًّرت، الشام تعاني، أما القاهرة فهي في وضع يُرثى له.
* أفاجأك حصولك على الجائزة في برلين؟
- بعد العرض الثاني، لم يعد الأمر يفاجئني. بدأتُ ألمس ما يحصل حول الفيلم. كنت أشعر بشيء كبير يحدث. عادةً في برلين، عشرات الأفلام الوثائقية تُعرض، وليس سهلاً أن تحقق رواجاً بفيلمك. لكن مذ بدأت الضجة حول الفيلم، شعرتُ بها. من الأصداء التي وصلتني، أدركتُ انه ممكن.
* لفتني رأي سلبي بالفيلم نُشر في "فرايتي"، يتّهمك بإنجاز فيلم يفتقر إلى المناقبية. حاولتُ خلال مشاهدتي ان أرى ما المشكلة فلم أجدها!
- كاتب المقال تحامل عليّ شخصياً. كنت أتمنى مقاربة تحليلية للفيلم، وهذه وظيفة الناقد. هناك هجوم شخصي ضدي، وحجته الوحيدة انني جعلتُ الممثل يتبوّل على نفسه، مع أن ابنتي التي في الثامنة كانت على يقين أننا استخدمنا الشاي للإدعاء أنه بول. وإذا دققتَ، فسترى الأنبوب في طرف الكادر. في النهاية، هذا مشهد روائي. ثم، إذا كان حنوناً إلى هذه الدرجة، فكيف يستطيع أن يتجاهل كلّ الواقع الذي نعيشه، لينتقد 20 معتقلاً سابقين يبنون سجناً من كرتون. هذا السجن كلّه من كرتون وخشب، إذا ركلته برجلك، ينهار! هناك واقع في منطقتنا العربية لا يمكن تجاهله. 7000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية. حواجز، ذلّ، قهر، وعنف يومي.
في كلّ المقابلات، شرحتُ أني حظيتُ بإشراف طبيب نفسي؛ معتقل سابق كان موجوداً طوال فترة التصوير ويعمل مع الفريق في أعمال البناء، وكان مديره الدكتور فتحي فليفل (الطبيب النفسي في "صداع"). كان يأتي إلى موقع التصوير مرةً كلّ يومين كي أستشيره ونتناقش معاً. هو الذي نصحني مثلاً أنه يجب اعطاء المشاركين في الفيلم حقّ الانسحاب، والكلّ كان يملك حقّ الانسحاب، حتى الممثل الرئيسي، وهناك شخص انسحب. من جانبي، وحرصاً على عدم إلحاق الضرر بأحد، اتخذتُ كلّ الاحتياطات اللازمة، مع اقتناعي بأنك إذا أردتَ تقديم فنّ جيد، فلا يمكنك ان تظل تسبح في البركة نفسها. عليك المغامرة. وهذا الفيلم كله مغامرة.

رمزي مقدسي في "اصطياد أشباح".
* أيعني أن الفيلم كان يمكن ألا يصل إلى أي شيء؟
- بالتأكيد. كان يمكن ان "أدخل في الحيط" في أي لحظة. من الأساس، لم يصدّق أحدٌ اللغة السينمائية التي أردتُ اعتمادها، وهي لغة تترجّح بين الوثائقي والروائي. كانت مغامرة "بنت كلب". اقتصر التحدي على كيفية وضع مشهد روائي بعد مشهد وثائقي، على أن يتقبله الجمهور من دون مساءلة. كان أمراً صعباً وخطراً.
* هذا الارتباك الذي نشعر به عزّز تفاعلنا مع الفيلم.
- بالطبع. يعلّمك الفيلم منذ البداية ألا تبحث عن السردية السهلة، إنما ان تمشي مع الطاقة والإحساس. هذا فيلم يتابَع بالإحساس أكثر منه بالبحث عن المعاني المباشرة. في الأخير، هو لا يتكلّم عن أي شيء. إنه تجميع لقصص صغيرة، لا شيء أكثر من هذا. لا يوجد خطاب.
* أجد أنك حوّلتَ وضعاً استثنائياً (الاعتقال) إلى شيء عادي، مجرداً إياه من جبروته. والعادي مخيف لأنه يقرّبنا منه، فيدهمنا الإحساس بأنه قد يكون مصيرنا أيضاً.
- سأقول لك ما الصعب في هذا الفيلم. لماذا انضغط الكلّ خلال مرحلة التصوير بمن فيهم أنا؟ في الحقيقة، يطوّر الإنسان بشكل لاواعٍ نظام حماية. وهذا النظام له علاقة بإغلاق مشاعر معينة. لأجل المرور بمثل هذه التجربة، يطوّر المرء هذا النظام. البني آدم ناجٍ كبير. عندما بنينا السجن، كنا، كمعتقلين سابقين، نفتقد هذا النظام. تركناه خلفنا في السجن. فجأةً، بدأ السجن يُبنى، ونحن غير محميين. كيف يُمكن محمد عطا الذي اعتُقِل أقل مرة 78 يوماً، وهو اسطورة في فلسطين، ان يبكي أربع مرات خلال التصوير؟ لهذا السبب، كان حقّ الانسحاب مضموناً. كذلك حقّ الغياب؛ فلا عقد يفرض على الشخص الحضور يومياً. إنها دائرة عليها أن تكتمل. الحاجة إلى التعبير مفيدة وتعيد الإنسان إلى الحياة. الفيلم باشر هذه العملية، ولكن لا أعرف إلى أي مدى ستكمّل الشخصيات في هذا الإتجاه. عرضُ الفيلم في رام الله أحيا أشياء جميلة جداً. مساعد المخرح وديع حنني الذي كان معي في باريس وتراه يقول في الفيلم إنني "مهووس سيطرة"، يعيش اليوم ولادة جديدة مع وقع العروض. لا يمكنك ان تتخيل التجرية التي يعيشها، ليتك تتكلم معه.
* ندخل في الفيلم مباشرةً. لا يوجد أيّ سياق تاريخي ولا شرح عن ظروف الاعتقال وكلّ هذه التفاصيل...
- صوّرتُ كلّ هذه التفاصيل، لكني لم أستخدمها. هذا الفيلم ليس هو الذي أردته. صوّرتُ هذه التفاصيل كضمان في حال اخفاقي، فكان ليكون لديّ على الأقل فيلم ثان أعطيه لـ"آرتي" (ضحك). أجريتُ لقاءات عن مراكز التحقيق وكلّ هذه الأشياء، لكنها في الأخير موثّقة في كلّ مراكز حقوق الإنسان، ولا أحتاج إلى توثيقها مجدداً.
* هل مرّ الفيلم بمراحل عدة قبل الوصول إلى هذا الشكل؟
نعم. كان فيلماً روائياً في البداية. حبي للوثائقي أنقذني. عندما ترى شخصاً كمحمد عطا، الذي كنت أريد تصوير قصته، تتساءل: "أي ممثل سيأتيك بهذا الاحساس؟". يكفي صمته وكيف يتنفس. لا يمكن لممثل ان يأتي بهذا الاحساس. هذا ما دفعني إلى ابتكار هذا الفورما.
* أين صوّرتَ الفيلم وكم استغرق من وقت؟
- صوّرنا في مبنى برام الله تابع للبلدية. كان المكان عبارة عن مرأب سيارات من 600 متر مربّع. صوّرنا 30 يوماً على مدار شهرين. انتهيتُ بـ 120 ساعة من الـ"راشز". دائماً أصوّر هذه الكمية. استغرق المونتاج نحو 6 أشهر. الحلو انه استغرق وقتاً طويلاً بسبب بطء العمل، ولكن منذ البنية الأولى كان كلّ شيء راكباً. تطلّب الاشتغال على التحريك بعض الوقت، كذلك العمل على تصميم الصوت وميكساجه. كلّ هذا أنجزناه في سنة ونصف السنة، بعد الانتهاء من التصوير.
* كيف عشتَ المونتاج؟
* كانت مسألة بالغة الصعوبة. توتّرتُ من شدة خوفي على الفيلم. عشتُ مجدداً كلّ مرحلة التصوير، تماهيتُ مع تجارب الشخصيات من خلال المونتاج. الفيلم كان صعباً: وحدة مكان، شخصيات متعددة، بين الروائي والوثائقي، ويتضمن مشاهد تحريك. كأنني لملمتُ كلّ تعقيدات #السينما لأضعها في فيلم واحد.
* أتذكّر أنك أخبرتني عن استخدامك في "صداع" لمدير تصوير لا يتكلّم العربية. وها إنك تكرر التجربة هنا. في المناسبة، هل هو نفسه؟
- لا. لكنه وحش مثله.
* هل بتَّ تتقصّد الإستعانة بمدير تصوير لا يجيد العربية؟
- نعم. إذا كنت تصنع فيلماً يستند إلى المعلومات، فلا بدّ من شخص يتحدّث العربية. أما في حالة هذا الفيلم، فعليك الإتيان بشخص لا يتكلّم لغتنا أو بشخص عربي يمتلك اللغة لكن "رأسه على رأسي". باختصار، أحتاجُ إلى أحد لا تغريه الكليشهات. شهدتُ الكثير من هذا النوع من الحكي خلال التصوير. لم أستخدم منه شيئاً. المصوّر عندي لم يكن فاهماً، كان يتعقّب المشاعر، وهو يضع في أذنيه سمّاعات تلتقط كلّ ما تلتقطه الميكروفونات. حساسيته للصوت كانت شاملة. في المشهد الذي وضعتُ فيه يدي على وجه رمزي مقدسي بعد شجار بينه وبين محمد عطا، أتعرف ماذا فعل المصوّر؟ كانت يدي على وجه رمزي، فتركنا وذهب بكاميراه في اتجاهٍ آخر (خارج الغرفة). كانت حركة فظيعة ولكن فيها مغامرة. لو لم يعثر على شيء في الخارج، لكان خرّب المشهد. وهو مشهد إلى هذه الدرجة خاص. هو كمصوّر شعر بأنه لا يمكن ترك الشخص الذي خرج. أظن كان يسمع أنفاسه.
* هذا لأنك فسحتَ له المجال ليتحرّك بحرية ويُبدع؟
- إما أنك تثق به أو لا تستطيع العمل وإياه. في البداية، شاهدتُ فيلماً كان اشتغل عليه فأحببته. يدعى كاميّ كاتينيون، سويسري الجنسية. طريقة العمل المثلى ان تترك له المساحة، ولكن عليك ان تجد اللحظة المناسبة لتتكلّم معه (...).
* هل تجد أن ثمة المزيد من التقبّل اليوم في الغرب للأفلام التي تدين إسرائيل؟
- بصراحة، كلّ الناس قالوا لي إنها مفاجأة غريبة من برلين، وبرلين بالذات. بصراحة، لا أعرف. المسألة ليست مسألة جائزة فحسب. في النهاية، اعتليتُ خشبة المسرح وسُمح لي بأن أقول ما أشاء، وهذا عندي أهم من الجائزة. أظن ان العمل الجيد لا أحد يستطيع أن يقف في وجهه، وسيجد طريقه إلى الرأي العام.
* لكونك تعيش في باريس منذ 8 سنوات، ألا تنوي إنجاز الأفلام فيها، أم ان موضوعك في #فلسطين وسيظل فيها؟
- فكّرتُ أكثر من مرة، ولكني لا أزال أشعر بالخوف. ربما يجدر بي إمساك مفاتيح المجتمع الفرنسي، وهذا غير متوافر حالياً. القصّة ليست باللغة. لا أزال أشعر بمسافة تفصلني عن هذا المجتمع.

في بيروت لعرض الفيلم.
"الواقع العربي أقبح بكثير مما نراه في الفيلم"
في نقاش مع الجمهور، بعد عرض "اصطياد أشباح" مساء الخميس الفائت في "متروبوليس"، تكلّم رائد أنضوني بعفوية وحبّ وصراحة عن معاني فيلمه الخفية وتفاصيل اشتغاله عليه، بدءاً من الصنف (دوكودراما) الذي ينتمي إليه وصولاً إلى السعادة التي يشعر بها مع تأكد عرض فيلمه في الأمم المتحدة (نيويورك) الشهر المقبل. قال: "عندما ترى سجيناً فلسطينياً يضطلع بدور محقق إسرائيلي، فأنت ترى طبقتين أو أكثر. بعين ترى الروائي وبعين ترى الوثائقي، وهنا بدأ يحصل الاختلاط. منذ تلك اللحظة، لم يعد يفرق معي. بعض المشاهد بدأناها روائية، وانتهت وثائقية، كذلك مشهد التحرّش الجنسي. عندما سلّمتُ نفسي ليعتقلوني، كان الأمر مزحة ولكن انتهى بالجدّ. الفيلم هو الذي خلط الأوراق، أنا لم أضع سوى اللغة السينمائية. في السينما، كلّ شيء ممكن إذا وجدتَ اللغة الصحيحة".
المراحل التي مرّ بها أنضوني خلال التصوير انعكست على الفيلم. في البداية، هناك ترقّب يتطوّر إلى تعبير عن الضغط فغضب وعنف. ثم ساد نوع من سخرية عالية، وفي آخر اسبوعين، شعر المخرج كأنه في الجنة، لم يعد يرغب في مغادرة التصوير. "صرنا نحس أننا عائلة واحدة داخل السجن. تكوّن شيء حميمي جداً. تبدد الغضب والعنف والتوتو، لتظهر الوردة التي داخل كلّ إنسان. للأسف، تغلب السوداوية علينا مع اكتشافنا في النهاية ان ابنة محمد عطا كانت سجينة، والأطفال الذين جاؤوا لزيارة موقع التصوير طرحوا علامة إستفهام كبيرة حول مستقبلهم".
روى أنضوني البالغ من العمر خمسين عاماً، أنه على أثر انسحاب الإحتلال الإسرائيلي من داخل المدن الفلسطينية قبل 20 سنة مع بداية إتفاق أوسلو، أول شيء فعله الفلسطينيون (وهو من هؤلاء)، هو التدفّق إلى الأماكن التي اعتُقلوا فيها، كي يروها من جديد. وفق اعتقاده، هذه حاجة كلّ شخص مرّ في تروما معينة، يتوق إلى عيش حالته السابقة من دون ان يكون سجيناً. "بالنسبة إلينا جميعاً، هذا مكان شبح. عشرات الآلاف اعتُقلوا في سجن المسكوبية، ولكن لا أحد شاهده لأن رأس المعتقل يبقى مغطى. في بداية التصوير، كان هناك ترقّب من جانب الذين شاركوا فيه، ولكن مباشرةً في الاسبوع الثاني صاروا يناقشون ويتخانقون على تفاصيل التفاصيل. مشروعي صار في وقت سريع مشروعهم. ما كان مجرد شغل أمسى حاجة".
أعدّ أنضوني تمثيل مشهد اعتقاله في اللحظة التي كان الكلّ فيها تحت الضغط. يقرّ بأنه لو لم يخرج بهذه الفكرة، لكانوا سيعتقلونه فعلاً. الكلّ انضغط، فسلّمهم نفسه! بعدها، تغيّر الفيلم جذرياً. وصل الجميع إلى أعلى مستوى من التعبير عن العنف، ثم ساد الارتياح. في نهاية الاسبوعين الأخيرين، بات هناك فيلمٌ آخر.
عن "أبطال" الفيلم، يقول أنضوني: "هؤلاء خرجوا من السجن، إنهم ناجون. أدرك منذ اليوم الأول للتصوير، انني لا أتعامل مع ضحايا. لم أرَ في أيٍّ منهم ضحية، لأنني أنا نفسي لستُ ضحية. لو نظرتُ إليهم كضحايا، لما أنجزتُ فيلماً كهذا. جزء كبير منهم شارك في الفيلم بدافع وطني من نوع "لا نريد أن نخرس". كنت أميناً على هذا، مع ان الفيلم ليس عن هذا. في عرض رام الله، جاء نحو 500 شخص، وتفاعلوا مع الفيلم بشدّة، وبعد العرض وقفوا أمام القاعة لساعة ونصف الساعة، لا يريدون المغادرة. لم نُجرِ نقاشاً، ولكن كان هناك شلال من الحكايات عن السجون".
ارتأى أنضوني ان يلجأ إلى صيغة سينمائية كهذه، لأن "الواقع الذي نعيشه في العالم العربي أقبح بكثير مما نراه في الفيلم". انتهى اللقاء بتأكيده المتكرر ان السجون الحقيقية أقبح من صورتها في السينما، وكذلك المنطقة العربية برمتها. "أظن اننا نحتاج إلى صورة أقسى، لعلنا نخرج مما نحن فيه، ونفهم من أين يأتي السلوك السائد في بيئتنا. لم نلد والأشياء بألف خير، كلّ هذا يعيش في داخلنا، ومستمر منذ مئات السنين. دور السينما هو ترجمة الإحساس إلى مرئي مسموع. السبب الأساسي الذي دفعني إلى إنجاز فيلم قاسٍ هو عدم قدرتي على التحمّل. لم يعد جائزاً إضافة الماكياج على واقعنا والقول ان كل شيء تمام: نحن مبهدلون والله العظيم!".


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية