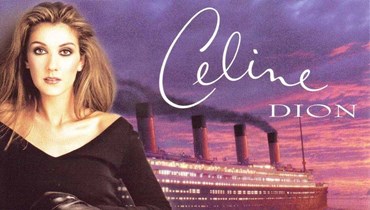سينما - مهرجان البندقية ردّ الاعتبار إلى لاف دياز بإسناد "الأسد" إلى تحفته "المرأة التي غادرت" عودة موفقة لأمير كوستوريتسا بعد 8 سنوات غياب وكونتشالوفسكي يفكك العقيدة النازية
لاف دياز: كثر لم يكونوا قد سمعوا بهذا الاسم قط في مطلع هذه السنة عندما فاز في الـ"برليناله" بجائزة ألفرد باور ("دب فضة")، عن فيلمه "أنشوده اللغز الحزين" ذي الساعات الثماني. فالمخرج الفيليبيني عمل منذ سنوات في بلاده بإمكانات بسيطة ومحدودة، قبل أن تستميله المهرجانات الدولية، كانّ أولاً ثم لوكارنو فبرلين، والآن البندقية، حيث نال مساء السبت الماضي في ختام مهرجان البندقية (31 آب - 10 أيلول) "الأسد الذهب" عن تحفته "المرأة التي غادرت"، وهي ملحمة سياسية واجتماعية أخلاقية مدتها 224 دقيقة، مصوَّرة بالأسود والأبيض وتدرجاتهما.
فيلم باهر من الجنريك إلى الجنريك، نشعر فيه بروحية المكان ووطأة الزمن، حيث كلّ وحدة تصويرية تنطوي على كم هائل من السينما الكبيرة. لاف دياز يأتينا متأبّطاً درساً مزدوجاً في السينما والإنسانية! الأول عن كيفية صناعة فيلم ببساطة نموذجية خارج كلّ التوقعات الفنية والاقتصادية والسياسية، والثاني يتجسّد في خطاب يرفض الانزلاق إلى أحضان العنف والشر. ليس لدى الشخصية التي يقترحها دياز ما تخسره، مع ذلك فالإذعان للعنف لحلّ مشكلتها وإعادة الاعتبار إلى نفسها، لن يكون أول خياراتها، بل سيبتعد عنها هذا الاحتمال كلما اقتربت منه. هذا هو الخطاب الذي يسمو به الفيلم، وهو خطاب إنساني ملحّ، وخصوصاً في زمننا هذا. وهو يؤكد لنا قبل أيّ شيء آخر، أنه ليس ثمة موضوع قديم أو جديد، بل نظرة قديمة ونظرة جديدة.
بسيطة الحكاية التي يستند إليها "المرأة التي غادرت"، حدّ أنّه أمكن اختزالها في فيلم من ساعة ونصف الساعة، لكن دياز ليس من أنصار السينما المنتشرة بكثرة والهادفة إلى منح المُشاهد معلومات بأشكال عصرية ولغة بصرية مغرية. فهو، عندما يقرر التصوير ويضع كاميراه في هذا المكان دقائق طويلة، إنما يبحث عن أسلوبية معيّنة ويلقي وجهة نظر ذات شأن على الواقع الفيليبيني، محاولاً محاصرته مكانياً وزمنياً. وهذا ما يحصل تحديداً عندما يُمسك بحكاية هوراسيا (كارو سانتوس)، مدرّسة خمسينية أمضت سنواتها الثلاثين الأخيرة في معتقل بسبب جريمة لم ترتكبها، وعندما تخرج إلى الحرية، تصمّم على الانتقام من الرجل الثري الذي كانت على علاقة به وتسبّب بسجنها بعدما اتُهمت بجريمة قتل. عبر حكايتها، يقحمنا دياز في الواقع الاجتماعي للفيليبين. نرافقها من مكان الى آخر، لنتعرف إلى شخصيات ثانوية وعلى تلك اللوحة الخلفية التي تسند خطاب الفيلم السياسي المضمر. فالحوادث تبدأ العام 1997، وفق النشرة الإخبارية التي تُذاع في الراديو، وما نسمعه خلالها عن عودة هونغ كونغ الى الصين بعد 156 سنة من الاستعمار البريطاني، يعكس هواجس دياز عن الكولونيالية في بلاده وآثارها النفسية والاجتماعية التي ألقت بظلالها على أفلامه الماضية. شخصية هوراسيا هنا شاهدة على الفقر والفساد والجهل والإهمال الذي تعانيه البلاد على مرأى الله ومسمعه (دياز استوحى من قصة قصيرة لتولستوي اسمها "الله يرى الحقيقة لكنه يتمهّل"). فالفيليبين، أقله البقعة التي يصوّرها، بيئة متديّنة يُستخدم فيها الدين أحياناً كغطاء لانتهاكات فاضحة، فحتى المجرمون والشياطين يحجزون لهم مكاناً كلّ أحد في الكنيسة/ الجنة للتكفير عن ذنوبهم.
في جو كهذا، تعود هوراسيا في محاولة لتجميع كل ما تفتت في حياتها التي ذهبت أدراج الرياح، وبناء الخير من حولها، عبر قراءة قصص لأطفال مشرّدين ومساعدة آخرين مالياً. تلتقي طريقها بطريق شخصيات غرائبية هي في الحقيقة صلة الفيلم بالواقع المستجد الذي تغيّر كثيراً خلال وجودها داخل السجن، إلى درجة أنّها أصبحت غريبة في أرضها، لا تجد نفسها في شيء، بل ميتة مع وقف التنفيذ. وكم مؤثر انبعاثها بعد ثلاثة عقود لترى أنّ زوجها غادر هذا العالم وابنتها راحت لتعيش في مكان آخر، وابنها اختفى وقد يكون مخطوفاً في مانيلا.
هوراسيا شخصية متغيّرة تجسّد ضمير المخرج نفسه، تكاد تصبح بلا وجه، لا تعرفها وهي خارجة من داخل عتمة الليل واضعةً قبعتها على رأسها لتلتقي في شكل متكرر حيناً ببائع بيض وحيناً بعاملة جنس متحوّلة أو تلك الفتاة المخبولة التي تأخدها الى زيارة كنيسة يقصدها الشخص الذي تريد الانتقام منه، في واحد من أظرف المَشاهد. معظم حوادث الفيلم ليلية، وغالباً لا نرى تفاصيل الوجوه أمام الشاشة بدقّة، بيد أنّ التكرار الذي يقترحه نصّ دياز هنا يُذكّر ببعض أفلام جيم جارموش. مدهش أن نرى ولادة الأمل من بيئة مسدودة الأفق، وأنّ ثنائية الانتقام/ العفو ليست أبسط إشكالية على سطح الأرض، والسلام مع الذات قد لا يتحقق أبداً. أجمل ما في دياز وأفلامه هو أنه يُبقي الكثير من الإنسانية عند شخصياته وهو يضعها في مواقف قاسية وحرجة ومعضلات أخلاقية لا تُحسَد عليها.
¶¶¶
لا أحد يصوّر الحيوانات كما يفعل أمير كوستوريتسا. مذ غاب المعلم الصربي عن السينما الروائية لتسع سنوات خلت، ونحن لم نشاهد فيلماً يحتفي بالحيوان بهذا القدر. فالدجاج والحمير والخراف والزواحف والدببة، جزء لا يتجزأ من قبيلته السينمائية التي يعيد إحياءها هنا في جديده "على طريق الحليب" (مسابقة)، المقتبس من ثلاث قصص حقيقية الذي استغرق إنجازه نحو أربع سنوات. لا أحد يوظّف الحيوان بهذا الشكل الظريف كما يفعل هو. باختصار، لن تتسنّى يومياً مشاهدة فيلم يتحوّل فيه الخروف انتحارياً بحزام ناسف أو أفعى تتذوّق الحليب. مخرج "أندرغراوند" صاحب مخيّلة خصبة تحمله إلى البعيد جداً. العلّة الوحيدة أنّ الإبداع عنده انفجر في مرحلة مبكرة جداً من حياته (كان في الحادية والثلاثين عندما فاز بـ"السعفة" عن "أبي في رحلة عمل" 1985)، فلا تتذمّروا إن بدا ما ينجزه الآن أقل إثارة للإبهار مما مضى.
أتفرّج على هذا كلّه من مقعدي في الصالة الكبيرة في "موسترا" البندقية، حيث سبق أن نال كوستوريتسا جائزتين مذ شارك فيها قبل 35 عاماً. ثمة ما شاخ في هذا الديكور، وأشياء أصابها العتق، بدءاً من نظرتنا إلى هذا النوع الباروكي من السينما، وصولاً إلى كوستوريتسا نفسه الذي يأتي هنا بفيلم ديناميكي يحمل بعض الإرهاق، خصوصاً في الجزء الأول. هذه مناسبة أيضاً لنلحظ كم تحوّلت النكتة المجانية والطرافة السخية التي كانت تكفي في ذاتها إلى عنصر هادف درامياً، وصولاً إلى حال الأسى التي لا رجوع عنها، وهي ستضرب ختام الفيلم.
أياً يكن، يقدّم كوستوريتسا فيلماً يشبهه ويشبه عوالمه التي اعتدنا عليها؛ نوع من الواقعية السحرية في أبهى تجلياتها. إنه كالسمكة، يحتاج إلى البقاء في المياه. نحن الذين عشقنا أفلامه حتى "قطّ أسود، قطّ أبيض" (1998)، وإلى حدّ ما "الحياة معجزة" (2004)، نجد في "على طريق الحليب"، كلّ مكونات سينما كوستوريتسا وتفاصيلها، من الموسيقى إلى الشخصيات الثانوية فالـ"بورلسك"، وتلك التيمات الكونية المنبثقة من المحلية. ثمة أيضاً الشريط الصوتي الغني جداً: صوت المروحيات والطيران والقنابل والحيوانات. ترافق هذا كله موسيقى تصويرية صاخبة من تأليف ستريبور كوستوريتسا، ابن المخرج الذي يخلف غوران بريغوفيتش بعد انتهاء العمل بينهما بسبب إشكال.
هذه المرة الأولى يمثّل فيها كوستوريتسا في فيلم من إخراجه، وهو يتدبّر أمره جيداً قبالة الكاميرا وخلفها. سبق أن مثّل في أفلام لسينمائيين آخرين، ولم يسبق له الوقوف أمام كاميراه باستثناء فيلم قصير أنجزه قبل عامين ضمن عمل جماعي عن الأديان، "كلمات مع الله"، بناءً على فكرة لغييرمو أرياغا. الدور الذي يضطلع به هنا بسيط جداً: رجل يدعى كوستا يوفر الحليب للمقاتلين على الجبهة من خلال نقله إليهم بالمستوعبات. نراه يتنقّل على ظهر حماره من قريته إلى أرض المعركة، متحدياً القنابل والرصاص. حياة الريف العجائبية ينقلها كوستوريتسا بسخرية مُرّة، ليتكوّن تدريجاً أمامنا عالم متكامل من هواجسه وعقده وزلاته التصويرية.
الحوادث تجري خلال حرب البلقان، لا تفاصيل حربية، فهي ليست سوى خلفية تُمسك الوقائع وذريعة ليُمرّر كوستوريتسا بعض مواقفه السياسية التي لا وزن لها ولا تستحق التوقّف عندها من فرط هزالتها. الفيلم ليس عن الحرب بل عمّا بعدها، "فمعظم المآسي تبدأ عندما تنتهي الحرب"، قال كوستوريتسا في المؤتمر الصحافي. روعة الطبيعة والمساحات الخضراء لا تحجب، يا للأسف، النار والحديد. في هذا الديكور، تتبلور علاقة كيمياء بورلسكية على طريقة كوستوريتسا بين صديقنا الذي ينقل الحليب ولاجئة صربية إيطالية تهرب من ماضيها ومن جنرال بريطاني يطاردها. هذه اللاجئة تضطلع بدورها مونيكا بيللوتشي، ويعود الفضل إلى المخرج في بعض "الشرشحة" المحببة التي يُلحقها بالممثلة الايطالية عبر جعلها تركض خلفه بمستوعب حليب أو تنام بين قطيع من الخراف أو تخيط له أذنه المصابة التي طارت من مكانها. في المقابل، يجعلها تغني وتبكي؛ فعلان لم يسبق لها تأديتهما في حياتها المهنية.
نحن إزاء صورة مختلفة لبيللوتشي، فهي المرأة رمز الأمومة والحنان، وليست مصدر رغبة عابرة. وهي أحياناً امرأة لعوب خارجة لتوّها من سينما الأربعينات. العنف والسخط يجاوران الغنائية والرقة كما العادة، بيد أنّ النصف الثاني من الفيلم هو الذي يحلّق عالياً في فضاء السينما. المغامرة التي ستحملنا إلى أعماق البريّة، في رحلة مدهشة عبر الأنهر والحقول والشلالات، تؤمّن قسطاً كبيراً من المردود المعنوي الذي ينتظره المُشاهد من فيلم لكوستوريتسا، وتبرهن عن قدرته التي لم تهمد في صناعة لقطات عصيّة على التقليد. هذا الجزء من الفيلم يأتي بعد انتهاء الحرب ومطاردة عصابة الجنرال - الذي كان على علاقة باللاجئة - بغية قتلها. تتوالى المواقف والحلول السوريالية على طريقة كوستوريتسا، وصولاً إلى النهاية التي تقحم الفيلم في مزاج مختلف تماماً، فيه شيء من السينما التراجيكوميديا على الطريقة الإيطالية. بعد 35 سنة على ولادتها، لا تزال سينما كوستوريتسا تصوّر الحروب والصراعات لتشهد على عبثيتها، وتوفر حلولاً غالباً ما تكون أصعب من المشكلة نفسها. يعتقد كوستوريتسا أنّ الفراشة التي تحوم فوق رؤوس العسكر أقوى منهم، ولهذا السبب نحبها!
¶¶¶
بالأسود والأبيض وبحجم صورة مربّعة على غرار بعض أفلام الأربعينات، قدّم الروسي أندره كونتشالوفسكي فيلماً كبيراً عن الحرب والمآسي ومعسكرات الاعتقال والعقيدة النازية، في لحظة مهيبة حملت معها مخزوناً من الإنسانية. كنّا ذكرنا أنّ الـ"موسترا" هذه السنة، وكما بات دارجاً في السنوات الأخيرة، ملتقى لغات، وها إنّ مخرجاً آخر هو كونتشالوفسكي يصوّر بغير لغته الأم، أي بالفرنسية والألمانية وبعض الروسية. فالكلّ يتحدّث بلغته في جديده "جنة"، حرصاً على الصدقية السينمائية والحقيقة التاريخية التي بقي مخرج "عشاق ماريا" أقرب ما يمكن إليها.
يروي "جنة" (فاز بجائزة أفضل مخرج) كيف التقت أقدار ثلاث شخصيات خلال الحرب الثانية: أولغا (جوليا فيسوتسكايا) روسية من عائلة نبلاء انخرطت في المقاومة الفرنسية؛ وجول (فيليب دوكين)، متعاون فرنسي مع النازيين؛ وهلموت، ضابط نازي رفيع المستوى يتحدّر من عائلة أريستوقراطية.
تبدأ الحكاية العام 1942 مع القبض على أولغا وسجنها بتهمة إيواء أطفال يهود في مسكنها، خشية أن يرسلهم النازيون إلى المعتقل، وتنتهي في المعتقل مع أولغا أيضاً. لكنّ الفارق شاسع ما بين لقائنا الأول بها ولقائنا الأخير. في فرنسا، يستدرجها المتعاون جول فتعرض عليه خدمة جنسية، إلا أنّ المقاومة الفرنسية تغتاله قبل أن يحين موعد "التفاهم" بينهما. الحوادث المتلاحقة توصل أولغا إلى معسكر الاعتقال حيث تلتقي بالضابط هلموت الذي احتكّ بها ذات مرة. الضابط هذا مخلص أشد أنواع الإخلاص للمشروع النازي الذي يرى فيه تجسيداً للفردوس على الأرض. في حين بدأت النازية تلفظ أنفاسها الأخيرة، تُسند لهلموت مهمة جديدة هي كشف الفساد في المعتقلات. وعندما يكتشف وجود أولغا في المعتقل، يتقرّب منها مجدداً في محاولة لتهريبها... ولكن، أيتغلّب الحبّ على العقيدة؟
بدايةً، يجب التشديد أنّ هذا ليس فيلماً آخر عن الهولوكوست. صحيح أنّ ثمة تفاصيل عنها في آخر الفصول، لكن الفيلم يوظّفها في إطار خطابه الشامل الذي يطال طرحاً عالمياً. في المؤتمر الصحافي، أعلن كونتشالوفسكي أنه أراد الانفصال عن موضوع المحرقة ليتحدّث عن الطبيعة البشرية والشرّ اللذين ينتميان إلى كلّ الأزمنة وليسا حكراً على ما جرى لليهود. وما أفضل طريقة للانفصال عن الشيء سوى الاقتراب منه أكثر؟
مفاجأة الفيلم هي في النحو الذي يرسم فيه السيناريو صورة النازي هلموت، وهي صورة قد يجدها البعض إشكالية، كونها حمّالة أوجه. اعتدنا في السينما (حتى الذكية منها)، صورة نمطية باهتة للنازي، لم تسقط مع مرور الزمن، ولم تختلف كثيراً بين فيلم وآخر. فالنازي مثلاً يتم التعبير عن بذور الشرّ لديه عبر إظهاره شخصاً غير رحوم مع الحيوانات، يُسيء معاملة قطّ، إلخ. الحكاية هنا مختلفة تماماً. فهلموت شاب رقيق، مرهف الحسّ، يستمع إلى برامس ويقرأ تولستوي، يبعث برسائل إلى فتاة التقى بها فهتف قلبه لها. هلموت ليس الوحش المنتظر، إلا أنّ الأفكار النازية نخرت عظامه. وهي أفكار يعترف لاحقاً بزيفها وعارها. عبر تبني هذه المقاربة، يأتي كونتشالوفسكي بفكرة مهمة أنّ الشر يتحقّق أحياناً من أجل بلوغ الخير، أي أنّ فاعل الشر يعتقد أنه يقوم بعمل إيجابي للإنسانية، ثم عند الحشرة يقول إنه ليس عليه أن يبرّر خياراته.
مُشاهدة "جنة" تجربة قاسية تتطوّر لتكون رقيقة في أحايين كثيرة. ثمة إخراج صارم يولي الاهتمام للتعبير الوجهي، وتقطيع مكثف وحركات كاميرا مدروسة وميل خفيف قد يزعج البعض للميلودراما. إلا أنّ كلّ شيء منضبط نصّاً وتمثيلاً وتصويراً، لدرجة أنّ كونتشالوفسكي يسمح لنفسه بالهروب إلى خارج دائرة العنف في مَشاهد نوستالجية باهرة، بهدف توليد صورة شعرية تكتفي بذاتها، كتلك اللقطة في آخر الفيلم، حيث نرى هلموت في مكتبه يدخّن سيجاره وينفخ في الهواء، فيما العالم ينهار في الخارج. من اللحظات المثقلة درامياً التي يكسرها الصمت والعزلة والحيرة والضياع، يستمّد الفيلم روعته السينمائية. "جنة" بعنوانه اللمّاح، فيلم ينزلنا في الجحيم والبؤس واليأس، حيث مصير واحد في انتظار الجميع سواء أكانوا صانعي حياة أم صانعي مأساة أم بين بين. إنها ورطة الحياة، وورطة العيش في زمن الأفكار القاتلة. ولا فكاك منها إلا بالموت.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية