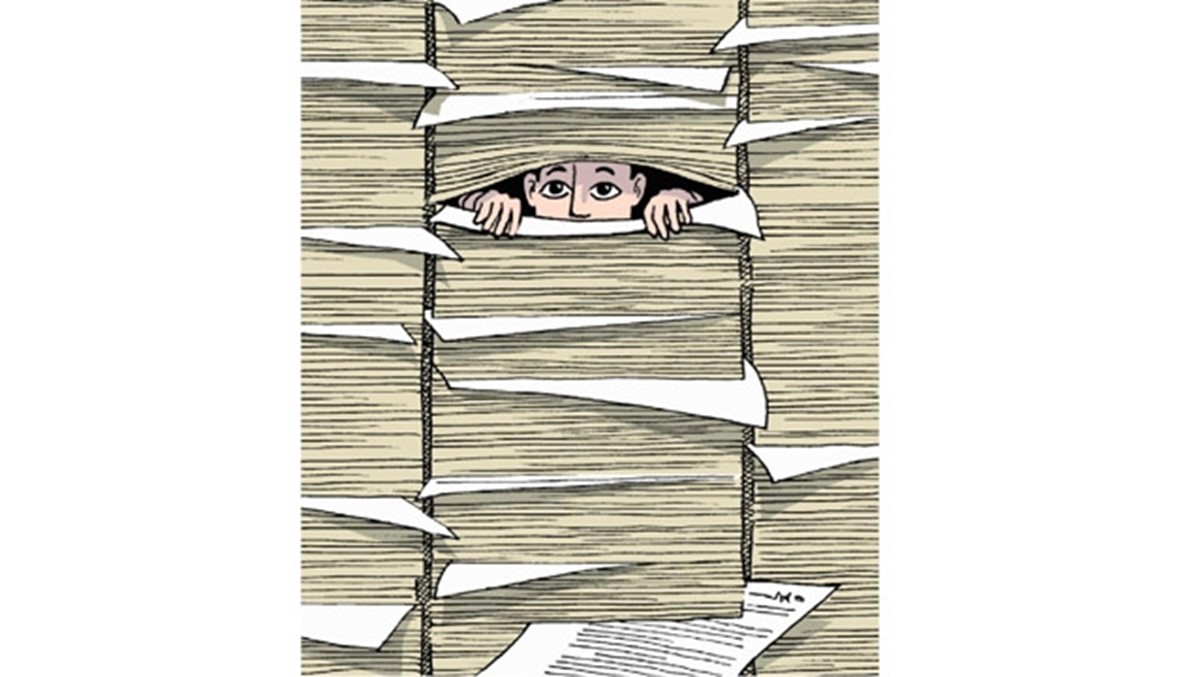حين قدّمتُ الورقة إلى السيدة البدينة كي تختمها، وتعطيها رقماً، وتسجل تفاصيلها في سجل بقياس متر مربع، أدركتُ حكمة التعب، وهيبة أن أكون مواطناً في دولة.
قداسة الورق مسألة تحتمل الخيال، فالسيدة البدينة، التي لم تقطع حديثها مع رفيق غرفتها، تعرف كل الأوراق، وتحدس الجمال في الخطوط، وتعيش متعة التوسل في عرائض تسيح منها الأمنيات. إنه جمال أن تكون شيئاً غير الذي تظنّ، فنحن في الحقيقة محض أوراق، وهذا ليس تذمّراً من الروتين، لكنه تفخيم للطاعة.
كانت الساعة تشير إلى العاشرة، وكنت في دائرة مهيبة تعود إلى وزارة التعليم العالي، تبدو من الخارج كقلعة، ومن الداخل كفندق درجة ثانية. أكثر ما يدهش هنا هو الحنان النسائي. الصدمة الأولى لي كانت أنهن لا يعرفن أين تذهب الأوراق. الإجابة عن الأسئلة تخلّف فيهن رعشة تشبه رعشة الحب. كنت في مهمة من أجل ابن خالي الذي كان يدرس في ليبيا وعاد إلى العراق كي يكمل تعليمه في بلده. بالطبع ليست هذه هي مشكلتي، فما إن رأيتُ إضبارتي تتضخم في يدي بشكل مخيف حتى تلبّسني قلق الأوراق. إذا كانت تحتوي على 150 ورقة فكيف هي الحال مع المئات من العائدين إلى الوطن، أو الخارجين منه؟
كنا أكثر من عشرين مواطناً، نحمل الأضابير نفسها، ونتجمع عند مكتب موظفة هزيلة البنية لكنها جميلة الأنف والشفتين، قيل لنا إنها المسؤولة عن ليبيا. الموظفة الهزيلة كانت تتحرك ببطء، وبعد اختباء قصير في دورة المياه، عادت تطلب منا المزيد من الأوراق المستنسخة. خرجنا كلنا واسترددنا هواتفنا النقالة، وعلب سجائرنا من موظف الاستعلامات، وذهبنا إلى شاب يجلس مع أجهزة استنساخه بين كتل عملاقة من الكونكريت عند مدخل البناية. كنت الأول من بين جماعتي المواطنين.
سألتُ الشاب المنهمك بالاستنساخ:
- أبو الشباب... هل تعرف ماذا يفعلون بكل هذه الأوراق بعد ان ينجزوا طلباتنا؟
نظر الشاب إليّ بتمعن وقال:
- يحتفظون بها في الأرشيف.
لم يقنعني، ويبدو انه أخذ يفكر في الأمر بينما هو يستنسخ أوراقي. وبعد أن تحاسبنا، رفع رأسه وقال:
- أعتقد أنهم يحرقونها.
فكرة الحرق خطرت ببالي أنا أيضاً، لكن السؤال متى يفعلون هذا وأين؟
عاد رجل الاستعلامات إلى تفتيشي، وتجريدي من الهاتف، وسجائري.
سألتُه بينما أنا أنشر ذراعي مثل المسيح على الصليب:
- هل تحرقون أوراق أضابيرنا بعد أن تنجزوها؟
نظر إليَّ بعينين غاضبتين وقال:
- نحن لا نفعل هذا مطلقاً. من قال لك هذا يكذب، ويمكنك أن تسأل المدير العام.
فكرتُ في كلام الموظف العنيف، وأنا في المصعد، وتذكرتُ أنه قرأ هويتي ويعرف أنني صحافي.
وجدتُ أن المواطنين قد تضاعفوا، ومسؤولة ليبيا كانت تتكلم بانفعال قابل للتطور. حاولتُ أن أكون مرئياً، وان أضع ابتسامة مفعمة بالمعاني على وجهي، لكن مسؤولة ليبيا فقدت تركيزها فجأةً، وقالت إنها تشعر بالاختناق، وإن أنفاسنا تصيبها بالدوخة. قام احد الموظفين بإخراجنا إلى الممر وهو يتأفف. قلت له إنني كنت الأول قبل أن تطلب مسؤولة ليبيا أن نستنسخ مجموعة من الأوراق. أوقفني الموظف عند الباب وسمعته يقول لمسؤولة ليبيا إن رائحتنا كريهة، ويبدو أننا لم نستحم منذ مدة. كنت أضع عطر "فهرنهايت" لذلك لم أهتم لكلامه.
لحظات وخرجت مسؤولة ليبيا. لم أتحرك. احتكّت بي، فهمستُ في إذنها:
- إلى أين؟
اعتقد أن عطري فعل فعله، فقالت وهي تضيق عينيها:
- دقائق وأعود.
تابعتُها بنظراتي، فسألني الذي خلفي إن كانت مسؤولة ليبيا ستتأخر. طلبتُ منه أن يحافظ على الطابور إلى حين عودتي.
سرت في الاتجاه الذي ذهبت فيه مسؤولة ليبيا، وأنا أنظر إلى المكاتب يميناً ويساراً، بحثاً عنها. سألتُ موظفاً قزماً، فنصحني أن أفتش في المطبخ. وبينما أنا أتوغل عميقاً في ممرات ملتوية، وجدتُني أتوقف عند غرفة مفتوحة الباب حيث لاحت أكوام الاضابير وهي مرزومة بارتفاعات مختلفة، وتملأ فراغاً عارياً من الأثاث. دخلتُ إلى الغرفة بخطوات بطيئة، فسمعتُ غصة غامضة تشبه لغة الفئران. نظرتُ يساراً، فاذا بمسؤولة ليبيا تجلس على ستول وهي تمسك بسندويش طويل واللقمة محشورة بفمها. ابتسمتُ لها، فاحمرّ وجهها وكبر أنفها.
سألتها:
- أهنا تضعون أضابير المواطنين؟ ماذا تفعلون بها بعد ذلك؟ هل تحرقونها؟
أعتقد أنها فشلت في البلع، وقد انتهزتُ هذا، وسألتّها مجدداً:
-ـ هل تبيعونها لمعامل الورق؟
نجحت مسؤولة ليبيا أخيراً في دفع لقمتها، وقالت:
- هذه أضابير الموظفين. إنهم يجهزون مكاناً لحفظها.
- وماذا عن أضابيرنا نحن، هل تحرقونها؟
تجمدت في مكانها والسندويش في يدها كأنها طفلة في روضة. أعتقد أنها كانت تفكر، وهذا يعني أنها غبية.
سألتني:
- لماذا أنت مهتم بالأضابير؟
قلت لها:
- إنه فضول مهني.
لم تصدّقني، وهذا دليل آخر على أنها غبية.
قلت لها:
- أستحلفك بروح القذافي أن تسرعي. نحن ننتظر منذ الصباح.
قالت:
- دقائق وأعود.
أعطيتُها إضبارتي وقلت لها إنني سأنزل للتدخين، وأريد أن أراها على مكتبها حين أعود وقد أنجزت أوراقي لأنني الأول حسب ترتيب الطابور. هزّت رأسها علامة الموافقة. سألتها ماذا تأكل فقالت انه جبن "كرافت" وعرضت عليَّ سندويشها، فشكرتها قائلاً إنني أحب هذه النوعية من الجبن، وأحترم من يأكلها، فابتسمت وعاد أنفها إلى حجمه الطبيعي.
في الاستعلامات أخذت هاتفي وعلبة سجائري. الموظف الذي يفتش الناس رماني بنظرة فيها شك. خرجت إلى الفضاء، ورحت أدخن، وأنا أعلم أن الموظف يراقبني عن بعد. دخنت سيجارة أخرى، ورحت أتفحص المبنى. لا بد من وجود محرقة ما، أو حاوية نفايات ورقية. الاحتمالات كانت كثيرة، والفكرة الأولى تلحّ على جمجمتي بطريقة عجيبة. من المؤكد أن هذه الدائرة بعمر الدولة، ولديها طريقة في التخلص من الأوراق. أنا لا أفهم دوائر الدولة، وأجدها عجيبة ومعقدة. حمدتُ ربي لأنني لم أخلق موظفاً.
وجدتُني أدور حول البناية. كانت نظيفة تماماً، وبلا محرقة، ولا حتى حاوية نفايات. عدت إلى الاستعلامات وخضعت مجدداً للتفتيش. الموظف سألني بصوت متشنج:
- هل تأكدت يا أستاذ من أننا لا نحرق الأضابير؟
قلت له وأنا أقلّد شكل الصليب:
- لا تفهمني غلطاً. أنا فقط أريد أن أعرف أين تذهب الأوراق.
- لماذا تريد أن تعرف هذا؟
همستُ له:
- إذا سمحت لي أن أدخل علبة سجائري معي إلى المبنى فسأخبرك.
فكر قليلاً وقال:
- شرط أن تعدني ألاّ تدخن.
- هل أنت جاد؟
- طبعا أخي.
لم نتفق. توقف المصعد بي عند الطابق الثاني ودخل رجل سمين بشارب كث. تفحصني من الأسفل إلى الأعلى وما إن انغلق علينا الباب حتى سألني:
- لماذا تريد حرق الأضابير؟
- من قال لك إنني أريد هذا. أنا فقط كنت أتساءل أين تذهب الأوراق؟
- وما دخلك أنت؟
انفتح الباب، فوجدت المواطنين يتجمهرون أمام أبواب المصاعد. الرجل السمين قبض على ساعدي وجرّني للخروج من الزحام. أمسك بي الرجل الثاني الذي طلبتُ منه أن يحافظ على الطابور، وسألني بعصبية:
- لماذا فعلتَ هذا؟
وقبل ان أتمكن من الرد ظهرت مسؤولة ليبيا، وأشارت إليَّ بسبابتها، وقالت:
- هذا هو الذي يريد حرق الدائرة.
ضاقت أنفاسي، وبالكاد استطعت القول:
- يا جماعة دعوني أفهِمَكم.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية