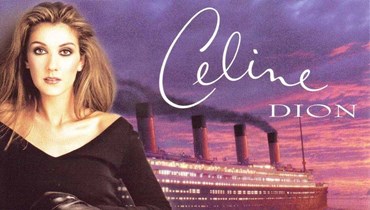تحت الضوء - المهرجانات "تفقّس" وبعلبك التي تحتفي بعيدها الستّين هاجسُها الحياة والخلق والتألق
يحفل الصيف اللبناني بأوجاع كثيرة، بعضها متصل بالقيظ الشديد واستحالة مداواته بالكهرباء المتوافرة، مضموماً على أزمة السير، واستفحال الفقر والبطالة والفساد، وبعضها الآخر شديد الصلة بالمأزق السياسي والاجتماعي المتعدد الفصول والمعبَّر عنه رمزياً بمنع تشغيل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها مؤسسة رئاسة الجمهورية. لكن هذا الصيف نفسه يحفل بمهرجانات الفن والفرح والحياة على أنواعها، وهي على مراتب ومنازل ومستويات، تحلّق حيناً فتصل إلى الغيوم والنجوم وتتكئ على القمر اللذيذ، فتعزّي وتؤاسي وتعوّض، لتنزل أحياناً إلى القعر فتلاقي الحثالات "الوطنية" من كل جنس ونوع.
لكن لهذا الصيف ولمهرجاناته ميزة خاصة جداً، فهو مناسبةٌ لتكريم بعلبك التي تحتفل بمرور ستّين صيفاً على بدء المهرجانات. كان ذلك متزامناً مع الزمن الجميل، زمن تفتّح الحداثات وتبلورها في الحياة أولاً، في المجتمع، وتالياً، وبالترابط، في الأدب والفنّ والعقل والروح والجسد. لن يجرّني حنينٌ ساذجٌ إلى ذلك الزمن، ولا إلى الفكر الذي لامس آنذاك قيام مفهوم الدولة، لا من قريب ولا من بعيد. سأكتفي بالقول إنه كان "زمن الشعر"، بما يعنيه ذلك من دلالات تتعدى كتابة الشعر بذاته، لتشمل "زمن الحياة". يعزّ عليَّ أن أتحدث عن "زمن الشعر"، فلا أرى "زمناً"، بل أرى إلى الشعر فحسب، شريداً، يتيماً، تائهاً، بلا ديارٍ، وبلا مسكن.
مرّت أهوالٌ وحوادث وحروبٌ خلال الستّين عاماً المنصرمة، لكن بعلبك بقيت، كما أدراجها، فسحةً نوعيةً للتألق والمتعة والخلق، وفضاءً متجدداً للتعبير بالجسد والكلمة والموسيقى والغناء والصوت. يصعب جداً تلخيص ذلك كلّه، أو إعطاؤه تحديداً، من دون الرجوع إلى التجارب المتراكمة، محلياً وعربياً وعالمياً، تلك التي عُرِضت هناك، على الأدراج، وتحت سماءٍ مكرّسةٍ للخيال والكبرياء. ينبغي أن تكون ثمة عودة تحليلية وتفكيكية إلى مسمّيات تلك التجارب، وأنواعها، وخصائصها، لاستجلاء كوامن معطياتها ومكوّناتها. يمكن بشيء من الأريحية، على شيء قليل من التحفظ، وبدون تعميم، التحدث عن كون تلك التجارب علامات فارقة في تاريخ الاحتفال الصيفي اللبناني، شابتها بين حين وآخر اختياراتٌ لم تكن جميعها على سويةٍ متكافئة. كأحوال النبع المتفجر الذي ماؤه الزلال النقي يحمل معه الحصى والأعشاب والطفيليات. ذلك كان مرتبطاً طبعاً بالظروف الموضوعية الشائكة، وبتغيّر المعايير، وباختلاف الرؤى، كما بمشقات المحافظة على الوتر المعياري المشدود، الذي قد يتملص في لحظة خاطفة، فنحلّ عن عناصر توتره، ليحتاج دائماً وأبداً إلى إعادة تزييت، وشدّ مفاصل، لتركيز خياراته.
لم تبخل علينا بعلبك يوماً بالقيمة. ظلّت على الدوام تضفر قامة مهرجاناتها بالمهابة النوعية. لا يستطيع أحدنا أن يتشدّد فيقسو، ويظلم، ويكون "ملكياً أكثر من الملك"، ليحمّلها أكثر من طاقاتها وإمكاناتها، التي اضطرتها أحياناً إلى الاستمرار بشقّ الأنفاس، ومقاومة "الترييف" والقتل والاستبداد والانحطاط، ببعض التبسيط الشعبوي العابر، لكنْ من دون أن تصبح أسيرة هذا التبسيط، أو أن تدين له بالولاء. لن أدخل في التفاصيل، لأن المناسبة ليست أهلاً لها، ولا غاية المقال تبتغي ذلك، لكني أحبّ أن أشهد، معتبراً أن بعلبك الرمزية والفنية حاجة مطلقة في الزمن اللبناني المتراجع نوعاً، تحت وطأة الانهيارات في معايير التربية الفنية، وفي شروطها، وسلّم قيمها، كما في تعبيراتها وتجسيداتها.
ما أقوله عن بعلبك، أقوله بقوة، عن بيت الدين ومهرجاناتها، التي باتت هي الأخرى، بحكم الخبرة والنوعية والمقارنة والتحفيز، حاجة فنية لبنانية مطلقة. فلينتبه المعنيون بمسألة المهرجانات، إلى أنه لا يعنيني في شيء، الانتقاص العشوائي أو المقصود من نوعية أيّ استحقاقٍ فني ومهرجاني. ثمة نوعيات محترمة في الكثير من الخيارات، هنا وهناك، في الاستعراضات الصيفية المتعددة، من الشمال إلى جبل لبنان إلى الجنوب. تحية إلى النوعيات، التي توسّع فضاء القيمة، وتغلّب المعنى، وشكله المصطفى، على الصخب الاحتفالي الشعبوي "البيّيع". وإذا كنتُ لا أسمّي مهرجانات أخرى، قد يكون في عدم تسميتها إجحاف في قيمتها وحقّها، فذلك تجنّباً للانزلاق غير العارف، أو تفادياً للمجاملة. على هذا الأساس، أنادي بالصوت العالي: فلنحتفِ بالفرح الفني مع المحتفين به، أينما كان، وبما ملكت الأيمان. لن أقول كيفما كان، لكنْ يجب أن نفرح. لأن الفرح مسؤوليتنا، وحقّنا. لقد سُرِقنا، وتعرّضنا للبيع في أسواق النخاسة، وفي المزادات العلنية الرخيصة، على أيدي "أهلنا" والقيّمين علينا قبل الآخرين. الانتهاز صار مهنة الكثيرين منا، والصناعة التايونية "درجة ترسو" أصبحت الشغل الشاغل للكثر من ممتهني الفرح السريع والفنّ السريع والربح السريع. كم يصعب على المرء أن يرى فرحه الفنّي يُسرَق منه، فلا يبقى سوى الفتات الذي يُرمى للحثالات. هل صار شعبنا حثالةً ذوقية وفنية؟! أرجو أن لا يكون الأمر على هذه السوية. في هذا المجال، ولأجل هذا السبب بالذات، ينبغي لنا أن نتشدد في خياراتنا الفنية المفرحة، وأن "نعدّ العشرة" قبل أن نصفّق، ونوافق، ونمدح، وندبّج المقالات، لئلاّ تلتحق معاقلنا الرصينة بالرخص والابتذال السائدين.
يعنيني في شكل خاص، أن ""أتلذّذ" وأنا أشهّر بالانهيارات، حيث يختلط الحابل بالنابل اختلاطاً مهيناً، إلى حدّ يشعر المرء المنسجم مع نفسه، والمتشدد حيال المعايير، بأن الانهيار في مفهوم الدولة ومؤسساتها، لا بدّ أن يكون مترافقاً في بعض الأوقات، في هذا الوقت المتطاول والمستديم بالذات، مع "لزوم" الانهيار في مفهوم الفن على أنواعه، من معايير الصوت، إلى معايير الموسيقى، فإلى معايير الرقص والمسرح والجسد والكلمة، والاستعراض عموماً، حيث جحافل البشاعة والانحطاط والتساهل والتراخي تغزو المواقع الفنية الحصينة، فتجعلها مطيةً سهلة للصعود والترقي. يترافق ذلك كلّه مع الكثير من الاجتراء الإعلامي والإعلاني، الذي يسهّل نوعاً من التعهّر المعيب في المستوى، بحيث يتدجّن كل شيء، أقصد المعيار، فيصير شبيهاً بفقدان المناعة القيمية، وبتلوّثات الهواء الذي نتنشّقه، والماء الذي نشربه، والطعام الذي نأكله، والدواء الذي نداوي به الأمراض غير القابلة للتداوي.
ينتشر "الفرح" الاستعراضي الصيفي انتشاراً مخدِّراً، كسولاً، شبه مسطّح، بل شبه تافه، فيأخذ بجماعات الناس، ويدغدغ حاجتهم إلى "الهرب" من الأوجاع الوجودية واليومية، التي تنخر حياتهم وتعصف بطموحاتهم وأحلامهم. وهو "الفرح" الاستعراضي نفسه الذي لا يكتفي بمواسم الصيف ومهرجاناتها بل يتخذ من محطات الإذاعة والتلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي بؤراً على مدار السنة والأيام لتعميم الانهيار الهستيري "المفرح". لبنان كلّه، بات، أو يكاد، مشهداً هستيرياً مريعاً للانهيار، ليس في مجالس أمراء السياسة وثقافة السياسة ومسارحها فحسب، بل في "سياسة" كل شيء. يجب التعميم هنا، لأن لا احترام لقانون، ولا لمعيار، إلاّ فردياً. الجماعات هي الجماعات، والسياسات هي السياسات. من شأن ذلك أن ينعكس على فنون هذه الجماعات وعلى "سياسات" تلك الفنون. لا أرى في ذلك إلاّ خطراً يحدق بـ"المعنى". يذكّرني هذا بما آل إليه فردوس الطبيعة اللبنانية على أيدي القتلة والوحوش والمنتهزين وأرباب الربح السريع، الذين دمّروا البيئة الجمالية بالبشاعات والمقالع والكسارات والعمران العشوائي المخيف. ألا يجب أن يذكرني هذا، بما آل إليه مستوى التعليم، الجامعي وغير الجامعي، حيث فرّخت جامعات كثيرة، ينوء عددها بالمنطقة العربية، فكيف لا ينوء بلبنان. هل تكون غالبية الجامعات المناطقية والطائفية المنتشرة في الأرجاء شبيهةً من حيث القيمة والمستوى بغالبية المهرجانات الصيفية والإذاعات والتلفزيونات ومواقع التواصل المقسّمة تقسيماً جغرافياً و"دينياً" وهوائياً؟ ألا يجب أن يذكّرني هذا أيضاً، بحفلات توقيع الكتب المنتشرة كالفطر بل كالأمراض المعدية، في معارض الكتب المركزية والمناطقية والدينية، حتى بات المرء يشعر بـ"الخجل" من جرّاء تفكيره في الإقدام على توقيع كتاب، أو تنظيم أمسية، أو إجراء مقابلة. هذا المشهد المخزي، جزء من مشهد البلاد، الفولكلوري، الاستعراضي، الانهياري، العمومي، في السياسة وفي المجتمع. وهذا ما يجب عدم التغاضي عن التشهير به. يا عيب الشؤم!
لكنْ، مهلاً. فنحن في حاجةٍ ماسّة إلى الفرح، من أيّ نوعٍ ومستوى. أعرف ذلك معرفةً عميقة وجوهرية. اليأس عميم، والوجع عميم. الناس يريدون خشبة وهمٍ خلاصي، ودواءً للنسيان. هم يريدون تضميد اليأس والوجع بكل الطرائق الممكنة. بالتخدير القاتل، لِمَ لا! أكاد أقول إن من حقّهم أن يفعلوا ذلك، لأنهم فقدوا البوصلة، وباتوا في تيهٍ عميم. هل يحقّ لقادة الرأي، أن يفقدوا هم أيضاً البوصلة؟ هل يحقّ لبعض القيّمين على المهرجانات والاستعراضات، وإن عابرة وموسمية، ومحلوية، أن يعمّموا البشاعة والانحطاط، شكلاً ومضموناً؟ إذا كان الفرح ضرورة مطلقة، فللضرورة هذه مستويات ومعايير، يجب ألاّ تتخطى الحد الأدنى، لكي لا يفقد القائمون على المهرجانات مفاتيحها المهيبة. تحية إلى بعلبك. وإلى سواها. ولا تعميم!


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية