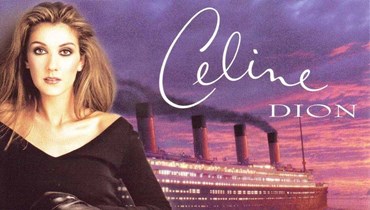تحت الضوء - مهرجان مدينة سيت الفرنسية يصدح بالشعر من المتوسط إلى المتوسط
يرفرف ظلّ الشّاعر بول فاليري (1871-1945) على مهرجان "أصوات حيّة من المتوسط إلى المتوسط" (Festival voix vives de mediterrannée en mediterrannée) الذي يجري سنويّاً في مدينة سيت الفرنسيّة. ويتوافق هذا المهرجان بنسخته الجديدة الثامنة عشرة 2015 (18 لغة، 100 شاعر، 35 بلداً) مع مرور سبعين سنة على وفاة الشاعر الفرنسيّ الكبير، إبن هذه المدينة بالتحديد. في المناسبة نفسها، تحتفل المدينة بمرور سبعين سنة أيضاً على إطلاق التسمية الرسميّة لمدفن سان شارل بالمقبرة البحريّة (cimetière marin)، تيمّناً بقصيدة الشاعر الشهيرة التي تحمل التسمية نفسها للمدفن اليوم، حيث تقبع مقبرته التي يرتاح فيها تحت "هذا السقف المستكين حيث تتمشّى اليمامات بين المقابر وحفيف الشربين".
صحيح أنّ سيت مدينة الصيّادين والبحّارة، كونها تربض من كلّ جوانبها على مرفأ متوسّطي شاسع منفتح على بلدان كثيرة- ويعود فضل نشأتها تاريخيّاً إلى الإيطاليّين، ما يجعلها أشبه بجزيرة هانئة عائمة، غير أنّها مدينة الفنّانين والرسّامين والشعراء والمسرحيين والمغنّين والمصوّرين الذين يقصدونها سنويّاً، ويستلهمون جمالاتها تحت شمسها السحريّة التي تلهب المخيّلة. يكفيها أنّها، في انحدارها من جبلها سان مون كلير إلى مرفئها المحتشد بحركة البواخر والطيور البحريّة، أنجبت شاعراً عالياً كبول فاليري، ومغنّياً طريفاً كجورج براسنز، وممثّلاً درامياً كجان فيلار.
أخذت هذه المدينة على عاتقها، بالتعاون مع أهلها وسلطاتها المحليّة، وبدعم الكثير من المؤسسات الفرنسية الخاصة والرسمية، إقامة مهرجان شعريّ سنويّ يستمرّ تسعة أيّام متتالية (من 24 تمّوز حتّى 1 آب)، وبات يُعتبر اليوم من أبرز المهرجانات الشعريّة ليس في أوروبا فحسب، بل في العالم أيضاً، حيث يقصدها في تلك الفترة نحو 50 ألفاً من السياح، في حين أنّها مدينة جنوبيّة صغيرة لا يتعدّى عدد سكّانها 44 ألف نسمة.
مثل كلّ سنة، وبالتوازي مع مهرجانات شعريّة أخرى مماثلة تُقام بُعيد هذا المهرجان، في شهر أيلول تحديداً، في كلّ من تونس (سيدي بو سعيد)، وإيطاليا (جنوى)، واسبانيا (توليدو)، تعكس المدينة، بمهرجانها الشعريّ الإستثنائيّ هذا، صدى الأصوات المشاركة (ألبانيا، الجزائر، المملكة العربيّة السعودية، الأرجنتين، بلجيكا، فرنسا، البوسنة - الهرسك، تشيلي، قبرص، اليونان، كولومبيا، كرواتيا، مصر، اسبانيا، إيطاليا، هايتي، العراق، إيران، لبنان، فلسطين، إسرائيل، الأردن، كوسوفو، ليبيا، مقدونيا، مالطا، المغرب، المكسيك، مونتينيغرو، البرتغال، كيبيك، صربيا، سوريا، تونس، تركيا...). الهدف من هذا المهرجان إسماع أصوات الشعراء أينما كان: في الشوارع، والأماكن العامّة، والحدائق، والميناء، والبحر، ودعوة الناس والتأثير فيهم عبر جعلهم على تواصل يوميّ، حيّ وحارّ، مع الشعر المعاصر اليوم. هذا المهرجان المعروف عالميّاً، والفريد من نوعه من حيث تنظيمه، واحترافيّته، وجماليّة إطاراته، وديناميّة لقاءاته، وفي ظلّ الظروف الراهنة الصعبة التي تمرّ بها بلدان المتوسّط، يفتح الحدود، واقعيّاً وخياليّاً، للشعر والموسيقى، ولجمهور كبير من مختلف الجنسيّات والأعمار. وهو، من خلال الشعر، يستدعي حضارات المتوسّط الأصيلة، وثقافاته الغنيّة، وأديانه، وأساطيره، كاشفاً ومستكشفاً وسائل تعبيره الحديثة. حيث تكتسب الكلمة عبره قوّتها، لتصبح معبراً أو جسراً بين مختلف الثقافات، بصوت قويّ وجهور، في عالم بات، يوماً بعد يوم، يطبق أذنيه، أو يكاد، على سماع أصوات الحقائق الإنسانيّة الوجدانيّة. منذ 18 سنة وهذا المهرجان يخلق فسحة للشعر، وللكلمة الشعرية الصادقة، الحيّة، المباشرة، المنفتحة على الجميع بتساؤلاتها وقلقها الوجوديّ. فوق أرض الانفتاح تلك، والاكتشاف، والتبادل، في عالم ينزع اليوم إلى انشغالاته المادّية، لا يزال هذا المهرجان يؤمن بالشعر والشعراء، ويفسح مجالاً تعبيريّاً بهدف تغذية الإيمان بالجمال والإنسانيّة من جديد، وتالياً الأمل بجعل العالم أفضل. لذا يعمل المهرجان، بمدعوّيه ومنظّميه وجمهوره، على اتخاذ الشعر فضاء إستثنائيّاً للقاء والتبادل والتقاسم، في وجه الإنقسامات والتقسيمات والتمزّقات.
شخصيّاً، سنحت لي فرصة المشاركة هذه السنة كشاعر في المهرجان، مع ثلاثة شعراء لبنانيّين آخرين (أدونيس، صلاح ستيتيّة، وبول شاوول). ومن حسن حظّي أنّ المصادفة كانت إلى جانبي عندما وصلتُ إلى سيت ليلاً، من بيروت - باريس - مونبلييه، إذ أبلغتني سيّدة تدعى بياتريس، من الأعضاء المنظّمين، أنّ البعض من أهالي المدينة، خصوصاً الميسورين والمثقّفين منهم، يهوون استضافة شعراء وشاعرات في منازلهم الجميلة، وقد وقع الاختيار عليّ - إلى جانب شاعرة بوسنيّة - لأحلّ ضيفاً عند أحدهم، فأوصلني السائق إلى هناك في ساعة متأخّرة من تلك الليلة. غي وماريان، من آل ستولز، يقيمان في حيّ فخم، في فيلا مكوّنة من ثلاث طبقات، في محاذاة المقبرة البحريّة. فيلا رائعة الجمال، مشغولة بذوق رفيع وبساطة مدهشة، ومحاطة بشبه غابة من الأشجار المتنوّعة والنباتات المختلفة، يتوسّطها حوض سباحة، والبحر على مرمى حجر منها. أشبه بجنّة صغيرة مخفيّة وهانئة. الرجل الحيويّ، والمرأة الأنيقة، لهما ابنة وحيدة تعيش في باريس، وقد بلغا سنّ التقاعد، فانسحبا مرتاحين إلى هواياتهما في أرض الراحة في سيت صيفاً. عمل غي في مجال التأمين، وهو يتابع تجميع الملصقات الفنّية والمجلاّت التصويريّة، خصوصاً كلّ ما له علاقة بشخصيّة تان تان. أمّا ماريان، التي درست في موسكو، وعملت طويلاً في مجال الترجمة التقنيّة في العديد من الشركات، فترتاح اليوم في مرسمها الزجاجيّ المطلّ على البحر، ترسم وتنحت بالحجر والفخّار.
كلّ يوم، ومن دارتهما الشافية للجسد والرّوح، اعتدتُ أن أحمل حقيبتي الصغيرة التي أضع فيها أشعاري المنتقاة للقراءة، وأنطلق في المدينة. أسوح تحت شمسها سيراً على الأقدام، كغالبيّة سكّانها. أدور في أحيائها الشعبيّة النظيفة، المرصوفة أحجارها بانتظام، الملوّنة الشبابيك والأبواب. نزلات، وطلعات، وأدراج، ومنبسطات، وحدائق، وزوايا مختارة بعناية لإلقاء الشعر. مظلاّت بيضاء صغيرة، كراسٍ بحريّة طويلة، رجال ونساء بالشورت. تماثيل فنيّة لأشخاص مصنوعة خصّيصاً للمهرجان، تمثل جامدة بين الناس، في الشوارع والزوايا، وعلى شرفات البيوت، تنصت إلى كلّ شيء ولا تتفوّه بكلمة. شمس المتوسّط الباهرة، وشقفات من السماء والبحر منفرجة من بين الجدران الطويلة المستطيلة. شعر، وموسيقى، ورقص، ومسرح، وبيرة، ليل نهار، إلى أن تتعب المدينة فتنزل وتنام آخر الليل في مرفئها. وأنا، بعد تجوالي المستمرّ فيها، لا أجد نفسي إلاّ وقد نزلت معها إلى المرفأ. تربطني الطيور البحريّة المترنّحة فوقي وإلى جانبيّ طوال النهار بأحد مناقيرها أو أرجلها، وتشدّني نزولاً إلى تحت. إلى رائحة البحر، وألوان الزوارق، وأخبار الصيّادين، ونكات البحّارة، ووداعة المحلاّت الصغيرة المترامية على طول الميناء. تسعة نهارات وتسع ليالٍ. أجول، وأقرأ أمام باحة منزل، في الحديقة، تحت درج الكنيسة، في الساحة العامّة، فوق متن زورق شراعيّ، على رأس جبل يطلّ على المدينة كلّها. أقرأ، وأسمع شعراء آخرين، من بلدان مختلفة ذات لغات وأمزجة متنوّعة. أقرأ، وأسمع، وأشرب، وأرقص، وأطير فرحاً، إلى أن أغطّ آخر النهار، مع الطيور المستكينة وشبكات الصيّادين المنهكة، في البحر المحمّل مغامرات الذاهبين والقادمين، منها وإليها.
بصراحة، جذبني عدد لا يُستهان به من شعراء، وموسيقيّين، وقارئين وقارئات بالفرنسيّة، لكن الذين انحفروا في ذاكرتي اثنان: شاعر أرجنتينيّ سبعينيّ، يرتدي سترة كاكيّة عسكريّة وبنطال جينز، يتساءل في مطلع إحدى قصائده إذا كان العصفور يغنّي لأحد كي يطربه أم يغنّي لنفسه كي يطرب نفسه فقط!؟ وشاعرة اسبانيّة أشبه بساحرة قصيرة القامة ذات تجربة شعريّة شخصيّة، بشعة، وبشاعتها انعكست جمالاً على مواضيعها، تتحدّث في أحد نصوصها عن صورة فوتوغرافيّة عائليّة يقف فيها أبوها في الصفّ الأماميّ بنظرات قاسية وشاربين مفتولين حادّين، ووراءه يختفي جميع أفراد العائلة في ما يشبه العتمة المطبقة، منهارين لكن مربوطين بخيط رتيلاء تقبع في زاوية الغرفة حيث يقفون. بالطبع، إلى جانب الشعراء، جذبني غي وماريان، بشخصيّتيهما الغنيّتين، وطباعهما المحبّة للحياة، وثقافتهما، وتواضعهما، وبساطتهما. فكان عليّ، في آخر نهار لي في سيت"، أن أهدي إليهما شيئاً أردّ به الجميل لهما. ماذا؟ لديهما كلّ شيء تقريباً. ثمّ كانت هذه القصيدة: "من بيت غي وماريان،/ البحر بمتناول يدكَ/ أزرق كسماء ملساء / مفتوح كصفحة دفتر تكتب عليها الشمس عند المغيب سطرها الأرجوانيّ الأخير،/ إلى أن يأتي بعدها على مهل القمر/ مصباحاً تعلّقه يدُ الليل في غرفة السهر.../ ومن حولكَ كيفما استدرت،/ حديقة تلفّكَ كخصر امرأة مترنّحة/ ترمي في أذنيك همسات ووشوشات خضراء، تحسبها الطيور والسناجب أحياناً كسرات خبز/ فتأتي لتقتات منها على مرأى من عيني قلبك./ هكذا، وأنت هائم في كلّ تلك الجمالات،/ ليس عليك سوى أن تقف على درج طويل من الكلمات،/ تشكر الضوء والظلّ معاً،/ وتتذكّر عندما ترحل مع رعشة الصباح الأولى،/ أنّ لك على الضفّة الأخرى من الدفتر الأزرق/ أهلاً آخرين مزروعين في أرض الحبّ الخصبة".


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية