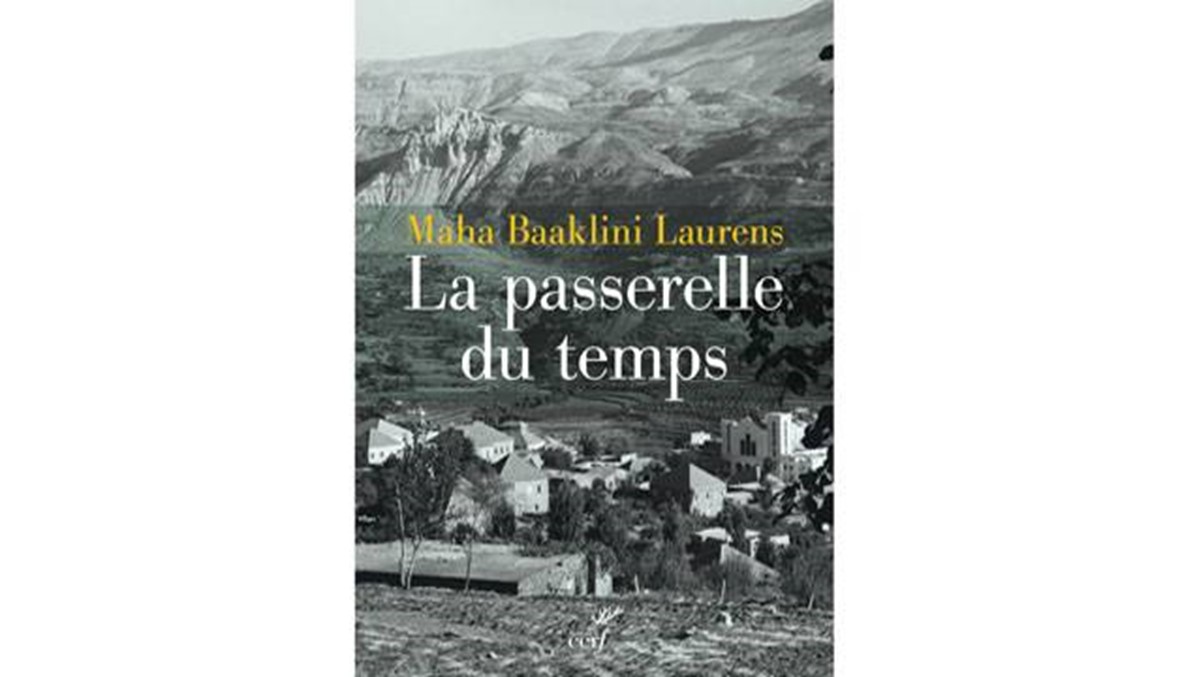مها بعقليني لورنس: من وقت القرية إلى وقت الحرب
أوّل ما يشعر به القارئ حين يغادر التمتّع بقراءة كتاب مهى بعقليني لورنس، "معبر الوقت" (La Passerelle du Temps)، الصادر لدى "منشورات سيرف" الباريسية (Editions du Cerf, Paris) إلى التأمّل في مصدر هذه المتعة ودواعيها، هو الحيرة في اختيار نوع من أنواع التأليف أو فنّ من فنون الكتابة ينسب هذا الكتاب إليه. هو الكتاب الأوّل لصاحبته مها بعقليني لورنس: لم تصدر قبله سوى ترجمة لرواية من روايات نجيب محفوظ ومقالات متفرّقة. لكنه، على قول المأثور الفرنسي، "ضربة مجرّب" جاءت "ضربة معلّم"! ولا تمنع الحيرة المشار إليها ذهاب الخاطر إلى إدراج المؤلّفة في كوكبة من كتّاب الرواية اللبنانيين الذي اعتمدوا الفرنسية لغةً أولى لهم وفيهم معاصرون لنا هم أمثال أمين معلوف وجيرار خوري وألكسندر نجّار وشريف مجدلاني وجورج قرم ولكن يسعنا أن نقع على أوائل للتقليد الذي يمثّلونه في أعمال لسابقين من أمثال فرج الله حايك مثلاً وقد نشر معظم ما نشر بين أواخر الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان وعشايا حرب لبنان المديدة...
لا نقصد بالرواية أيّ نوع من الروايات. فثمّة أسماء غير هذه كان يتعيّن علينا ذكرها لو قصدنا النوع الروائي بعمومه. إنما نقصد الرواية المكرّسة لحقبة من حقب المجتمع اللبناني الحديث أو المعاصر، تتمثّلها في أحداثٍ وشخوص، وهذا فضلاً عن اتّخاذها الفرنسية مركباً بكلّ ما ينطوي عليه ذلك من خصائص في ثقافة النص الروائي ومخيّلته وأسلوبه. ولا تستغرق الرواية اللبنانيةُ المدار كلَّ أعمال الواحد من هؤلاء ولا جلّها. بل إن بعضهم (قرم مثلاً) لم يطرق الفنّ الروائي كلّه إلا طرقاً عارضاً صارفاً جلّ جهده التأليفي إلى فن آخر أو إلى أكثر من فنّ واحد: إلى التاريخ مثلاً. أما مها لورنس، المستقرّة في باريس من أعوامٍ كثيرة والمتّخذة العلاج النفسي حرفةً لها، فإن "معبر الوقت" الذي أصدرته قبل أشهر هو، على ما سبقت الإشارة إليه، كتابها الأوّل.
لقد ذكرنا النزوع العفوي إلى إدراج هذه المؤلّفة في فئةٍ بعينها من الروائيين. ولكن لا ينبغي لهذا النزوع أن يمنع من السؤال: هل هذا الكتاب رواية؟ نتّخذ محاولة الإجابة عن هذا السؤال مدخلاً إلى التعريف بالكتاب: بمضمونه وبنيته وبأهمّ أوصافه ومزاياه.
أوّل ما يمنع الجزم الفوري بمناسبة صفة الرواية لـ"معبر الوقت" حضور المؤلّفة الفعلي في وقائع روايتها وذكرها أو وصفها حوادث كانت شريكة فيها إلى هذا الحدّ أو ذاك. من شأن ذلك، مبدئيّاً، أن يجنح بالكتاب نحو السيرة الذاتية... لولا أن واقع الكتاب يغاير هذا المبدأ. فإن ظهور المؤلّفة في النصّ معتمدةً ضمير المتكلّم ومستعيدةً ما فعلته أو ما وقع له في هذا الظرف أو ذاك، يبقى حضوراً خَفِراً، متباعد المرّات، قليل الحصول، نسبياً، وضئيل الحظّ من فصول النصّ ومحطّاته المختلفة.
هل هي إذن عائلة المؤلّفة اتّخذَتْها موضوعاً للكتاب مبتدئة بذكر جيلٍ منها لم تدركه فعلاً هو جيل جدّها وجدّتها لأبيها. وبعودة هذين من مهجرهما الأميركي الذي تزوّجا فيه وأنجبا، قبل عقود كثيرة، تفتتح المؤلّفة روايتها... هذه العودة حصلت بطريق البحر في زمن كان معوّل القرية في مواصلاتها مع العاصمة على سيّارتين منهكتين لا غير. أما هجرة الجدّ فيظهر أنها كانت قد حصلت في عهد قريب إلى الحرب العالمية والأولى وإلى نشوء الدولة اللبنانية في أعقابها. المدّة التي يتناولها الكتاب وتسمّيها المؤلّفة "معبر الوقت"، هي على وجه التحديد تلك العقود الستّة أو السبعة التي انقضت على أسرتها وعلى القرية التي هي منها بين حربين: الحرب العالمية الأولى والحرب اللبنانية الأخيرة في سنواتها الأولى... وذاك أن حرب لبنان هذه شهدّت تغييراً فادحاً في أحوال القرية وسكّانها، وفي أحوال العائلة بالتالي، هو التغيير الذي يسجّل الكتاب معالمه وتتوقّف الرواية مع حصوله معتدّةً باستوائه نهايةً لعهد وبداية لعهد آخر وكأنّما به أتمّ "الوقت" عبوره.
مع ذلك لا يبدو اعتبار هذا الكتاب سيرةً عائلية أو "ساغا" للعائلة تعييناً وافياً بالحاجة لنسبته إلى نوع أدبي. وذاك أن عرض أحوال العائلة وتقلّب الأيام بها لا يبدو مُراداً بحدّ ذاته ههنا. هكذا تحظى والدة المؤلّفة، مثلاً، بحضور في النصّ أوقَع من حضور والدها ومن حضور شقيقها وشقيقتيها. هذا مع العلم أن الكتاب مهدىً إلى أفراد من العائلة بينهم الثلاثة الأخيرون. ثم إن ما يطالعنا به الكتاب من قصّ ووصف يفيض عن حدود العائلة من كلّ جانب. يفيض ليعتمد القرية مسرحاً له يقيم لها ما يفيها حقّها من الاعتبار فلا يتجاوز حدودها إلا بمقدار ما تتجاوز حدود نفسها. سنعلم في الصفحة الأخيرة من الكتاب أن القرية هي بزبدين في أعالي المتن أو على المفترق بين المتنين أو "بين الكنيسة وصنين" على قول واحد آخر من أبنائها. وسنكون قد علمنا أن القرية مسيحية مارونية ودرزية مع غلبة عددية للمسيحيين واستحكام للقلة الدرزية في الحيّ العلوي يعوّض هذه الغلبة. وسنكون قد فهمنا من تعداد معالم القرية أنها صغيرة: ليس في ساحتها، عند بدء حوادث الكتاب، سوى كنيسة واحدة وبقّالين اثنين فضلاً عن السيّارتين...
على أن خطّ الفصل العائلي هو الذي ينتظم حياة القرية مستوعباً الخطّ الطائفي أو مسخّراً هذا الخطّ وحائلاً دون انفراده بفاعلية خاصّة به ما خلا الحرص على المجاملة. والمجاملة مضبوطة بحروفها، معلومة النصوص والأوضاع: تتبادلها الجماعتان عالمتَين أن الخلل في حركة أو عبارة، في هذا المضمار، غير جائز قطعاً إذ هو قد ينتهي إلى مصيبة. لكن هذه اللياقة التي تستوي مصدّاً لميراث العنف القديم، لا تمنع خط الفصل العائلي من شقّ القرية كلّها إلى معسكرين يتشكّل كلّ منهما من جناحٍ عائلي مسيحي وآخر درزي. ويبدو العنف مأذوناً به في هذه الصيغة التي تستبقي له حدوداً ووتائر قابلة للتدبّر. فلا يتورّع رجال من الدروز عن دخول حرم الكنيسة منتصرين فيها لحلفائهم المسيحيين حالما يدخل هؤلاء في شجار مع خصومهم العائليين بين جدران الكنيسة. هذا ولا يقتصر مفعول الحلف العائلي على الشجار. فحين يتّخذ أحد الجناحين المسيحيين قراراً بالانفراد بكنيسة جديدة له يبنيها، يحضر الحلفاء الدروز الاجتماع المنعقد لاختيار قدّيس تسمّى الكنيسة باسمه. ويدلي الدروز بدلوهم في هذا الموضوع مفضّلين أن يُختار قدّيس من المحاربين يواجه مار إلياس شفيع الكنيسة الأخرى ومبدين تحفّظهم حيال ميل المسيحيين إلى اعتماد "امرأة" شفيعة للكنيسة: امرأة اتّفق أنها السيدة العذراء!
تتجه الرواية إلى تبيان مُحْكم لكيفية إطاحة الحرب هذه الصيغة وفرضها، وهي لا تزال بعيدة عن أبواب القرية، نوعاً من الإفراط في التشاور وإظهار الأُلْفة يتّخذ صيغة السهرات الدورية المشتركة بين الطائفتين لكنه يشي، في الواقع، بانفراد كلّ من الطائفتين بهواجسها وبنزوعها الجديد إلى التشكّل وحدة خوف ووحدة تحسّب في مواجهة الطائفة الأخرى. وهو ما يعني بطلاناً مرجّحاً لما كان لكلّ من الحلفين العائليين من فاعلية. وهو ما يسوّغ حركة التسلّح السرّي في الطائفتين. وهذه تروح تفرض نفسها على أكثر بيوت القرية بغضاً للعنف المسلّح ومنها بيت المؤلّفة. ولا يلبث، بعد الشكّ والشبهات، أن يحضر الخراب والهجران...
* * *
الكتاب "قصّة قرية" إذن إن شئنا استيحاءً بعيداً لعنوان من عناوين ديكنز. على أنه قصّة من نوعٍ محدّد تمليه الصفة القروية لمسرح حوادثه. هو، على وجه الدقّة، قصّة إثنغرافية لدنيا صغيرة "يعبر الوقت" بين حياة داخلية لها تحاصرها من بعيد ومن قريب عواملُ زوال لا تعيها وبين الهجوم الأخير لهذه العوامل، في ركاب الحرب، وهو الذي ستكون الدنيا بعده غير الدنيا ولن يشبه بعده شيء ما كانه قبله. هي قصّة إثنغرافية لإظهارها دنيا تقاوم الاعتراف بالتغيير الذي يسلك "معبر الوقت". وهي رواية تاريخية أيضاً لإظهارها هذا التغيير وهو يتسرّب إلى تلك الدنيا ثمّ يطيحها. ما الذي يسعف المؤلّفة، من بعد، في اعتمار قبّعة المحقّقة الإثنوغرافية لوصف عالم هي منه أصلاً ولا تزال منه (وهذه عبارتها) "على مرمى حجر"؟ يسعفها منفاها المديد في فرنسا ومنفى روايتها في اللغة الفرنسية، وهذا من غير أن يعني المنفى جفوةً أو غربة. المنفى مسافة أو بُعدٌ، لا ريب، ولكن المسافة والبعد يورثان خليطاً من الكفاءات والمشاعر لعلّ الشوق واحدٌ من أبعدها أثراً.
من صور هذا المنفى أن المؤلّفة تجد نفسها مسوقة إلى شروح "بَعْديّة" لعبارات من كلام القرية توردها أو لأشياء تسمّيها. وهو ما يستدعيه التقرير الإثنغرافي ويرجّح أن يبدو ناشزاً لقارئ الرواية. وهو ما كانت المؤلفة في غنى عنه (أو عن معظمه) لو انها كتبت بلسان قريتها. بل إن الازدواج بارز هنا ما بين فرنسية تهيمن الكاتبة على الحقيقي والمجازي من ثروتها البلاغية فتصول فيها صولة فارس لا يشقّ له غبار وبين مصطلح ومأثور لحياة قرية لبنانية وما تتصرّف به من تجهيز ماديّ وذهني وما تنطوي عليه من أفعال وتصوّرات ومن علاقاتٍ ومشاعر... وهي كلّها معروفة من المؤلّفة حقّ المعرفة أيضاً. ومؤدّى هذا الازدواج أن المؤلّفة تتصرّف بلغتين وعالمين في نصّ واحد. ولكنه تصرّف غير متناظر إذ هي تشرح واحداً من العالمين للآخر وتترجم إحدى اللغتين إلى بلاغة الأخرى.
في هذا كلّه تبدي مها بعقليني لورنس جودة في القريحة وخفّة ظلّ لا تجارَيان، فضلاً عن ثراء اللغة والمعرفة. هي تستثمر محطّات من سيرة قريتها لترسم بريشة العارف مشاهد مختلفة من الحياة القروية: تهيئة المنزل وتهيّؤ العائلة والقرية كلّها لاستقبال عائدين من المهجر، مثلاً، أو "عَوْنة" النساء المكلّفات صنع أقراص الكبّة المحشية لوليمة لا يُدرى عدد القادمين إليها. والمؤلّفة يستغرقها وصف هذه "الأعمال" إلى حدّ أنها قد تنسى، مثلاً، ذكر تناول العشاء الذي قدّمت فيه الكبّة فتذهب بنا على الفور إلى تناول الحضور من مسيحيين ودروز أقراصَ الحلوى وانتقالهم بعد ذلك إلى اللعب بالورق...
هذه المشاهد من حياة القرية ينطوي كلٌّ منها على رسالة ما، ساخرةٍ في الغالب، تشفّ عن موقف المؤلّفة من ماضٍ غادرته ولكنه ماضيها. وهو موقف الجمع الصعب بين الانتماء المستمرّ والمسافة التي تجيز التهكّم. والحقّ أن المؤلّفة تدبّر مناسبات التهكّم بنوع من الاختزال ومن المبالغة في رسم ملامح الأشخاص وتفاصيل التصرّفات. هذان الاختزال والمبالغة لا يوقعان الراوية في الماهوية إذ تقيها الطرافة والظرف هذا المنزلق. ولكنهما يتوصّلان مع ذلك إلى ماهيّات الظواهر بالمعنى الذي تعرّف فيه المقاربة الظواهرية نفسها بأنها طلَبٌ بـ"الاختزال" لـ"ماهيّات الظواهر".
تدبّر مها بعقليني لورنس مناسبات الوصف الإثنغرافي المشار إليها كما تدبَّر المؤامرات. فإذا شاءت أن تُطْلِعنا على غشّ الحرفيين في أعمال البناء، مثلاً، فضلاً عن شكوكها في نزاهة الإكليروس، استدعت مطراناً بحاله لتُجلسه على كرسيّ بيت الخلاء في منزل أسرتها المرمّم لتوّه... فينهار الكرسيّ تحت المطران ويتحطّم ولكنْ تَسْلم مؤخّرة هذا الأخير! وإذا شاءت أن تعبّر لنا عن مقتها ومقت أهلها للسلاح، جعلت والدتها تستخدم البندقية التي اضطرّت الأسرة إلى شرائها في فتح مجرور مسدود!...، إلخ.، إلخ. هذا الظُرف غيض من فيض البراعة الذي نقع عليه في هذه الرواية: البراعة في القصّ مشفوعةً بالاقتدار في تشكيل المشاهد وفي استنباط الحوار...
هي إذن رواية إثنغرافية على ما في هذا الوصف من تناقض بين طرفيه أو توتّر. فالرواية قوامها الوقت الذي يعبر، والإثنغرافيا تنحو إلى تجميد ما هو رفضٌ للضياع فيما هو لا ينفكّ يضيع. ولقد أتيح لنا في غير هذا المعرض أن نشير إلى أن الذين كرّسوا أعمالاً بين أواخر القرن التاسع عشر وأيّامنا هذه لوصف مظاهر من حياة القرية اللبنانية وتراثها أجمعوا على التصريح أنهم إنما جمعوا ما جمعوه من التقاليد المختلفة صوناً لها من ضياع وجدوه جارياً أو وشيكاً. وأبلغ ما نقع عليه من هذا القبيل إتّخاذ سلام الراسي لأوّل كتبه هذا العنوان "لئلّا تضيع"!... وأمّا ما ترويه مها بعقليني لورنس فقد ضاع فعلاً بفعلٍ مزدوج من نخر التاريخ لأصوله ومن عنف الحرب الرهيب.
هذا والمؤلّفة ليست بلا موقع من القرية التي جعلت هذا الردح من حياتها الماضية موضوعاً لروايتها. هي تعرف دروز قريتها وتعرف الأوصاف المتداولة للشخصية الدرزية حقّ المعرفة: من التصديق بالتناسخ إلى الخرافة القائلة أن الدروز يكرمون الضيف كثيراً ولكنهم يذبحونه (تقول المؤلّفة متهكّمة: لا يتمالكون أنفسهم عن ذبحه) إذا بات ليله في ضيافتهم!. وهي تعنى بإطلاعنا على أطرافٍ من ذلك كلّه ولا تتوانى في السخرية من الجانب الخرافي من بعضه أو من الجمود في بعضه الآخر، وهذا كلّه بالمودّة التي تميّز كلّ ما تقوله عن قريتها. ولكن موقعها بين مسيحيي القرية محفوظ. فما تقوله في صدد الدروز يلزم جانب الوصف الحسّي ولا ينفذ إلى دواخلهم. لا نطّلع في نصّها على سريرة درزي: لا نقع على درزي "يخمّن" أو "يظنّ" أو تخطر له خاطرة تبقى بينه وبين نفسه. فلا موضع لما يسمّى "أفعال القلوب" في ما تذكره الراوية عن دروز بزبدين. الرواية رواية القرية، لا ريب. ولكن موقع الذات في الرواية محفوظ لمسيحيي القرية وبينهم الراوية التي هي المؤلّفة.
ولعلّ واحدنا يغامر باستذكار إجمالي لما نتعلّمه من أحوال المجتمع اللبناني ومن دخول الحرب على حياته في كلّ من كتب المؤرّخين والاجتماعيين، من جهة، وفي أعمال أدبية من سويّة العمل الذي أهدته إلينا مها بعقليني لورنس أو غيره ممّا يُجاريه لنفرٍ من كبار الروائيين اللبنانيين، من الجهة الأخرى. فإذا فعلنا لم نتردّد كثيراً – في ما أحسب – في اختيار جواب للسؤال: أيّهما أجود وأثقل حمولة بمعرفة المجتمع والتاريخ: هذه الروايات الرفيعة السَمْت أم ما بين أيدينا من كتب التاريخ والاجتماع؟


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية