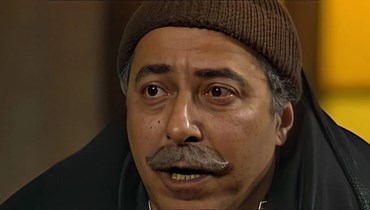كان "الملحق"، ولا يزال، منذ عدده الأوّل في العام 1964 حتّى يومنا هذا، على الرّغم من كلّ الطّلعات والنّزلات التي شهدها، صامداً في محراب الكلمة. مرّت فوق صفحاته، على مدى نصف قرن، أسماء لامعة كثيرة من الأدباء والفنّانين والمثقّفين والمفكّرين الذين رسموا بأقلامهم جانباً مشرقاً من لوحة لبنان الحضاريّة، بل من حداثة عالمنا العربيّ. منهم من خطفه الموت خبط عشواء، منهم من تشتّت في أصقاع الدنيا على أجنحة المغامرة، منهم من تمرّن فيه وانتقل إلى ملاعب أخرى، ومنهم من بقي واقفاً في أرضه يدافع بيديه ورجليه عن شرف الكلمة وكرامة الموقف. وإذ أقول هُم، فلأنّهم من مختلف المضارب والمشارب، لبنانيّين، وسوريّين، وفلسطينيّين، وخليجيين، وعراقيّين، ومصريّين، وسودانيين، وجزائريّين، وتونسيين، وليبيين ...إلخ. وقد استطاع، في خضمّ تقلّبات أمواجه المادّية والمعنويّة، أن يبقى منارة يهتدي بها المفكّرون، ومنصّة لتوليد الإبداع، ومدرجاً لاستمرار إقلاع الثقافة الطليعيّة وهبوطها، وخادماً أميناً للحرّية. وبقيَ قلبُه، على رغم كلّ الذبحات والسكتات التي تعرّض لها، يخفق بنوافذ الدهشة، ويتوهّج بنيران الحبّ، ويتطرّف إلى جانب الإنسانيّة والجمال.
طبعاً لا عهد لي به أيّام ستّيناته، أواخر زمن العزّ، أوائل زمن النكسات التي جرّت حروباً لم تعرف أن تنتهي. إذ حينها كنتُ أحبو في بقعة صغيرة من شمال لبنان لم تسلم ربوعها من نيران الاقتتالات الداخليّة- الخارجيّة التي أرخت بظلالها الثقيلة ردحاً من الزمن. لكن، في ما بعد، وبمحض المصادفة الجميلة، وقعتُ على بعض أعداده القديمة لدى أصدقاء، هنا وهناك، حيث شممتُ في أوراقه الصفراء رائحة زمن أغبر مجيد. فأدركتُ أهمّيته في اكتشافي له محرّكاً نقديّاً، وسجلاًّ ثقافيّاً، ورائداً مواكباً، وشاهداً على عصر مفعم بالقلق والتمزّقات. وازداد إدراكي أكثر لأهمّيته وريادته، حين أصدر أنسي الحاج كتابه "كلمات كلمات كلمات"، جامعاً فيه مقالاته "الملحقيّة" التي كانت تندرج يومها تحت العنوان نفسه. أمّا ذاك الذي عاد واستعيد صدوره في أوائل التسعينات، مع الياس خوري وكوكبة من الشبّان، ثمّ مع الياس خوري وعقل العويط، ثمّ مع عقل العويط وحده، فأستطيع القول، باعتزاز، إنّي ابن صفحاته الحبيبة. رعاني كعشبة بين الأصابع، كأب مُحبٍّ وقاسٍ معاً. تعلّمتُ منه ما لم يقله لي يوماً، وما لم أكن أتوقّعه. ودفعني، طوعاً وقسراً، إلى الكتابة في مواضيع لم تكن في حسباني: في الشعر، والترجمة، والنقد، واليوميّات، والتحقيقات على شتّى أنواعها، والموسيقى، والرياضة. أبواب أودت بي إلى أبواب، ونوافذ إلى نوافذ، وعلاقات إلى علاقات. تعرّفت من خلاله إلى كمّية هائلة من الكتّاب والشعراء، المخضرمين والجدد، الذين يترأسون اليوم غالبيّة الصفحات الثقافيّة في الجرائد المحلّية وملاحقها التابعة لها.
حارسُ ذاكرتنا الثقافيّة هو، آنَ اندثارها شيئاً فشيئاً، وفارسُ قيمها المجيدة، حين انقلابها رأساً على عقب. لا يكتفي بالذود عنها فحسب، بل يغامر ويخاطر فوق طرقها الوعرة، باحثاً، منقّباً، متمحّصاً، مبدعاً، خلاّقاً، جريئاً، على رزانة، وصرامة، ورجَحان فكر شميم. وقد حافظ، طوال مسيرته المضنية والمتعثّرة أحياناً، على مخاطبة العقل والوجدان معاً، ومقاومة كلّ ما يقمع ويخيف ويهين، وهدْم الضحل والكاذب والزائف، والمشاركة في إعلاء سلطة الكلمة والخيال، والتحميس على معانقة الحقيقة والجمال، والمساهمة بلا حساب في إهباب هواء الحرّية، وبعث الأمل والايمان.
تكفي التفاتة خاطفة إلى أعداده السابقة، ستّيناتها وتسعيناتها، وفي الألفية الجديدة، دون إمعان نظر في عناوينه وإيغال في محاوره، لتدرك مدى أهمّيته، وغناه، وتنوّعه، ومقدرته الفذّة على رصد التحوّلات الثقافيّة التي تمخّضت حوله، في لبنان والعالم العربيّ على حدّ سواء. بل أكثر من ذلك، وضع يده وسكّينه على الكثير من إشكاليّاتنا الفكريّة، وإطلاق الصرخات الحادّة في وجه العديد من القضايا الإنسانيّة الكبرى التي تشغل العالم.
كان كلّ سبت يصدر فيه "الملحق"، احتفالاً فريداً. تهرول، شتاء وصيفاً، إلى مكتبة قريبة في الجوار لتتروقّ عليه، وأوّلاً ملامسة أوراقه السمراء الطويلة الطازجة الساخنة التي تبدو طالعة لتوّها من فوهة مطبعتها. ثمّ، ما إن يمتلىء المكان الضيّق بزبائنه حتّى تأخذ لنفسك زاوية صغيرة تتّسع لحذائك، وتشكّ رأسك فيه. بعد أن تفلفشه على عجلة، خاطفاً بعينيك الزائغتين صباحاً عناوينه الرئيسة، مستمتعاً برسوماته المبهجة، تشتريه مع الجريدة، تضعه تحت إبطك وتخرج. ويبقى معك أسبوعاً حتّى صدور العدد التالي.
تأخذه معك في السيّارة. تضعه على الطاولة. تطرحه فوق الكنبة. تفرشه بطوله عرض السرير. وتحرص، جرّاء عادة استثنائيّة لديك، على أن تعمل جاهداً كي لا تطويه، وإن على غفلة، لئلاّ يفقد شيئاً من أناقته. كأنّك تريده أن يبقى جديداً وطريّاً. وحفاظاً عليه، تفكّر في أن تجمع أعداده بتسلسل تاريخيّ بين دفّتي مجلّد أسود سميك، كما يفعل الكثير من أصحابك. لكنّك لا تقوم بهذه المهمّة، لكسل متوارث فيك، ولتلذّذك غير المقصود باصفرار الزمن الذي يموّج ورقه ويعبث بعمره.
ما إن تعتاد عليه، أسبوعاً بعد أسبوع، وسنة تلو سنة، حتّى يمسك بك شغف انتظاره. ماذا يخبّئ لنا "الملحق" هذا السبت؟ هل ستكون عناوينه أكثر جرأة وقسوة؟ هل ستكون مواضيعه أكثر تنوّعاً وأشدّ عمقاً من عدده السابق؟ هل سيظهر فيه شاعر جديد صاعق يحمل البرق ويمتطي المجهول؟ ورسوماته الملوّنة المرافقة، هل ستبقى متوهجة وحدها باستقلاليّة تستطيع معها قصّها ووضعها في إطار؟ شيئاً فشيئاً، لا تعود تستغرب تلك الأسئلة التي تتمتم بها من طرف شفتك المزمومة، حين تكتشف أنّ قرّاء كثُراً سواك يتملّكهم هذا الشغف المماثل وذاك الانتظار نفسه. حتّى أنّك، ولشدّة تعلّقك الهوسيّ به، تلقي على نفسك أحياناً لوماً خفيفاً عابراً، تهمس به خجلاً من دون أن يسمعك أحد طبعاً: لماذا أطلب الكثير من "الملحق" في حين أنّني لا أعطيه إلاّ القليل؟ غير أنّك تعود لتضحك في سرّك متداركاً: كثيرٌ، هذا كثيرٌ عليّ!
ثمّ، وجرّاء متابعتك المستمرّة له، تستبدّ بك مجموعة من الإيضاحات من سبت إلى آخر، تتقاسمها مع مجموعة من الأصدقاء المتابعين له مثلك، كلغة مشتركة بينكم، التي تثير أحياناً لدى سامعها جهلاً بتدقيقات ربّما يكون هو في غنى عنها: كانت افتتاحيّة السبت الفائت إصابة مباشرة، هذا السبت أغرقتْ في الإنشاء، الأعداد الخاصّة فلتة شوط رائعة، هناك قصّة صغيرة قارصة في الصفحة ما قبل الأخيرة، التحقيقات موفّقة في أغلب الأعداد، الرسومات أحياناً وقحة أكثر من اللزوم، العدد الأخير ناشف...
أكثر من ذلك، تدفعك المسألة إلى نوع من إدمانه، ليس كمضمون فحسب، باعتباره لسان حالك، بل أيضاً كشكل: حجم صفحاته، نوع حرفه، طريقة صفّ مانشيتاته، عناوينه البرّاقة، تقسيمات صفحاته، عواميده الأفقيّة، تداخل رسوماته في المواضيع... حتّى لا يعود في مقدورك، على الرغم من محاولاتك المستمرّة الفاشلة، أن تنجح في قراءة سواه، أو على الأقلّ أن تستمتع الاستمتاع نفسه.
لكن الأجمل من ذلك كلّه، في هذه الحكاية الورقيّة الطويلة، أنّها لم تعد اليوم تعني الكثير للأجيال التي تلاحقت بعدك. لذا تشعر بأنّ تفرّداً مميّزاً لامس شخصك، ولازم طبعك، طوال مرحلة كبيرة من حياتك، ولا يزال، وإن بدا أحياناً وهميّاً، أو مبالغاً فيه في كثير من الأحيان. متعة لذيذة، أشبه باحتفال سرّي، أو بنزهة خارج رتابة الحياة القاتلة، تستدعي، فعلاً، سؤالاً غريباً مشدوداً إلى تناقض واضح: كيف تستطيع جريدة عموميّة، يُقال عنها إنّها خبز يوميّ، أن تشكّل لديك هذا القدر من الخصوصيّة؟
أُخذ على "الملحق"، في السنوات الأخيرة، انشغاله بالسياسة أكثر من الثقافة. كأنّما على الثقافة أن تبقى على مسافة من الجميع كي تبقى مقبولة من الجميع. وفي حال اهتمامها بالسياسة، فيجب ألاّ تقربها أو تقاربها، ولا ينبغي أن يكون لها مواقف حاسمة منها، بيضاء أو سوداء، بل عليها أنّ تكون براغماتيّة، وتظلّ رماديّة. هذا بالضبط ما يتنافى مع جوهر الثقافة المتمرّدة، المضادّة، الرافضة، الحالمة، التي لا تساوم ولا تهادن، وسلطتها من قوّة كلمتها. بل، على العكس، يجب أن تنطوي رسالتها الأساسيّة على حمل الشعلة، وقيادة الدفّة، والسير في الصفّ الأماميّ، والدفاع عن الحقيقة، والذهاب بلا تردّد وخوف إلى أبعد مجال ممكن من المستحيل.
أُخذ على "الملحق" أيضاً، وخصوصاً في الآونة الأخيرة، انحيازه الواضح والجريء إلى الثورة السوريّة. غير أنّ ذلك لم يكن من باب الانتقائيّة والاستثناء، بل من باب وقوفه العامّ إلى جانب الثورات العربيّة المُحقّة أينما اندلعت، وحرصه الشديد على صورة الوطن السياديّة كيفما ارتسمت، ومناصرته المظلومين والمضطهدين، ونبذه الطغيان والاستبداد، ودفاعه المستميت عن شعريّة الحلم والحرّية حتّى آخر نقطة حبر. فإذا كان من حقّ الشعوب أن تحلم بالحرّية، فمن واجب الثقافة الحقّة أن تواكبها، وتدافع عنها، وتدفع بها أقوى، بل أن تسبقها إذا تأخّرت في ركابها، وتعثّرت في سيرها.
واليوم، وفي ظلّ الفتن التي تمزّقنا، والانقسامات التي تفتّتنا، نحتاج إلى "الملحق" أكثر من أيّ وقت مضى، كصرخة في وجه البربريّة وأحمرها الذي يشرّ على كامل أطراف صفحات حياتنا اليوميّة.
أخيراً، ما الذي نتمسّك به غير هذه "الثقافة اللبنانيّة"، أو ما تبقّى من رحيقها الذي لا يزال ينفث قليلاً من هواء الحرّية في فضائنا المختنق؟
وإلاّ، نركب الريح على حلم مسوّس وأمل منخور.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية