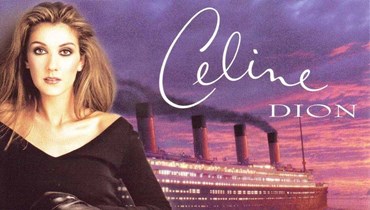بعد صمتٍ طويل قررتُ كشف سري: هذه قصة إغتصابي
بصفتي مديرة مكتب "الواشنطن بوست" في القاهرة، أعيش وأعمل محاطةً بخطر العنف الجنسي. غطّيتُ الحروب والاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط خلال الأعوام السبعة الماضية، وقد أمضيتُ خمسة منها في القاهرة، حيث التحرّش الجنسي هو تجربة شبه يومية. عندما لمّسني أحدهم وسط حشود المتظاهرين الذين تواجهوا مع عناصر الشرطة خارج جامع الأزهر في القاهرة في اليوم الرابع من انتفضة 2011، استدرت ولطمته على وجهه.
يقول لي أصدقائي إنني "قوية". لكنني لم أتمكّن من مواجهة الألم الذي حملته بداخلي طيلة 14 عاماً إلا بعد حضوري مقرراً مكثفاً لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة في تشرين الأول الماضي. قصدتُ اختصاصياً في علاج اضطرابات ما بعد الصدمة كي أتمكّن من تجاوز ما شهدته وخبرته بصفتي مراسلة في الشرق الأوسط وفي الحروب، وكي أتخطّى الخوف الذي سيطر على أحلامي وكان قد بدأ يؤثّر في عملي. أردتُ أن أتمكّن من الحفاظ على هدوئي عند سماع ضجيج مرتفع - بدلاً من الشعور بأن انفجاراً قد وقع كلما أُغلِق باب بقوة أو اشتعل الوقود في محرك سيارة ما.
لكنني أمضيت مع الاختصاصي وقتاً طويلاً في الحديث عن تجربة سابقة لا علاقة لها بالشرق الأوسط، وتكاد تتفوّق على تجاربي في الحروب: ذات ليلة عام 2001، عندما كان عمري 17 عاماً، زرت صديقاً في كليته وقد اغتصبني.
قبل انتشار الأخبار عن الاتهامات الموجّهة إلى بيل كوسبي بالاغتصاب، وما حُكي عن اغتصاب جماعي في جامعة فرجينيا، كنت أتفادى في شكل عام القراءة عن الاغتصاب. وكنت أتجنّب أيضاً الحديث عنه في تقاريري ونقل حالات الاغتصاب - مع أنني أتألم كثيراً للإقرار بهذا الأمر. عندما حاولت الكتابة عن مشكلة الاعتداءات الجنسية في مصر قبل عامَين، كانت لديّ معلومات جيّدة لإعداد تقرير ممتاز وكان التوقيت رائعاً - كان يوم عيد السان فالنتاين، وكذلك يوم الحراك ضد الاغتصاب. عرفت أنها قصة مهمة وأردت أن أكشفها إلى العلن، لكنني لم أستطع.
التخلص من العار
لقد ساعدتني تجربتي في العلاج على التخلّص من العار الذي حملته منذ سن المراهقة، وحفّزتني على البوح الآن. لقد استلهمت من استعداد الناجيات من الاغتصاب للحديث عن الاعتداءات التي تعرّضن لها، بعد سنين أو عقود من الواقعة. وقرّرت أن الوقت حان كي أحذو حذوهن. لا يفوت الأوان أبداً على رواية حادثة كهذه.
ليلة الاغتصاب
قبل نحو 14 عاماً، ذهبت لزيارة صديقي - سوف أسمّيه "إكس" - في حرم الكلية حيث يدرس. كنت أعتبره أحمق إنما لطيف يبدي اهتماماً بالآخرين، من نوع الأخ الأكبر؛ كنا قد تعارفنا في المرحلة الثانوية، وقد ربطنا نوع من الصداقة الأفلاطونية وكان كل واحد منا يأتمن الآخر على أسراره. لم أجده قط جذّاباً.
عندما التحق "إكس" بالكلية، انضم إلى إحدى الجمعيات الطالبية ووعد باصطحابي إلى حفلة جامعية حقيقية. كان والدايْ صارمَين إلى حد ما ولم يكونا ليسمحا لي عادةً بتمضية عطلة نهاية الأسبوع في ضيافة شاب في حرم جامعي، لكنهما سمحا لي لأن "إكس" كان صديقاً. ارتديت أجمل قمصاني - قميص زهري فاتح من دون أكمام مع ياقة عالية - وجينز Guess وقلادة جديدة كنت أحبّها كثيراً.
كان الحفل من تنظيم الجمعية الطالبية التي ينتمي إليها "إكس". أتذكّر أنني دخلت منزلاً فارغاً نسبياً وجلست بتوتر على أريكة. كان معظم الموجودين في الغرفة شباباً، وكنت حريصة على أن أبدو مرِحة ومسترخية. سألني "إكس" إذا كنت أريد شراباً؛ فأجبت بكل تأكيد. أحضر لي كوباً بلاستيكياً كبيراً مليئاً بشراب البانش الأحمر.
أتذكّر باقي أحداث تلك الليلة في ومضات من الصور والأصوات. لا أتذكّر شيئاً مما حدث بين جلوسي على الأريكة واحتسائي الشراب من ذلك الكوب وبين دفعي إلى المقعد الخلفي في سيارة لم تكن سيارة "إكس"، وكان يقودها شخص آخر اقتادنا إلى مكان ما. أظن أنني فقدت وعيي في مكان ما بين الأريكة والسيارة.
ثم وجدت نفسي ممدّدة على سرير "إكس" في غرفته في المساكن الطالبية، وكان هو فوقي يقبّلي ويداعب ثديَي.
شعرت وكأن السرير تحوّل كتلة من الرصاص الصلب. تشوّش نظري، وبدت الغرفة داكنة. شعرت بأنني لا أسيطر على جسدي، فيما كان "إكس" ينزع عني الجينز ومن ثم قميصي، وكان رأسي يتدلى من طرف السرير وجسدي متهاوياً على الفراش.
أتذكر بأنني شعرت فجأةً بالألم بين ساقَيّ وصرخت "لا" بأعلى صوت، كان صوتي أجش ورئتاي ثقيلتين. ردّدتها مراراً وتكراراً "لا، لا، لا". لكنني كنت عاجزة عن الحراك. حتى إنني لم أتمكّن من الجلوس. في نهاية المطاف، زال الألم.
كمّاشة أطبقت عليّ
لا أعرف كم كانت الساعة عندما استيقظت في الصباح التالي. كان رأسي ثقيلاً وكأن كمّاشة أطبقت عليه، وشعرت بغثيان شديد. بذلت جهداً كي أجلس؛ كان "إكس" ينام بقربي على السرير المزدوج الضيّق. كنت أرتدي قميصه ولا شيء سواها. لا أتذكّر أنني ارتديتها بنفسي.
كان المكان هادئاً.
وقفت فوجدت قميصي وسروالي الجينز وملابسي الداخلية وصدريّتي على الأرض. كانت قلادتي قد انكسرت نصفَين وتطايرت حبات الخرَز الصغيرة بين ثيابي. ورأيت على الأرض أيضاً واقياً ذكرياً وغلافه.
ارتديت سروالي وذهبت إلى الحمام حيث تقيأت بشدّة، وازداد شعوري بالغثيان. جلست هناك، ورحت أتقيأ في المرحاض حتى لم يبقَ في معدتي ما أتقيأه.
عندما عدت إلى الغرفة، طلبت من "إكس" أن يُعيدني إلى منزلي.
كان صباح سبت رمادياً، وقد التزمنا الصمت طوال طريق العودة. في منتصف الطريق، طلبت منه التوقّف جانباً كي أتقيأ على حافة الطريق العام. عندما وصلنا، خرجت من السيارة ودخلت المنزل. لم أرَه من جديد.
في الساعات الثماني والأربعين التي أعقبت عملية اغتصابي، رحت أتنقّل في منزلي - حتى إنني زرت منزل أحد الأصدقاء بهدف الاختلاط الاجتماعي - وكنت في حالة من الإنكار تحت وقع الصدمة. كانت كلمة "اغتصاب" تطارد تفكيري، وكأنه كابوس يلازمنا بعد الاستيقاظ. لكنني لم أستطع أن ألفظها بصوت عالٍ.
في تلك المرحلة، كنت أفتخر بأنني مراهقة تقدّمية وأعتبر نفسي من المدافعين عن حقوق المرأة. كنت أعرف كل شيء عن اغتصاب النساء من قبل أشخاص تجمعهم بهم معرفة، وعن مدى شيوعه. وكنت أعتقد أنني أذكى من أن أقع ضحية مثل هذا النوع من الجرائم القابل للتوقّع. وكنت أقول لنفسي إن هذا الاغتصاب يحصل مع الفتيات الأضعف والأكثر غباء، وإنني كنت أدرى بهذه الأمور. كنت أعرف أنه لا يجب أن يغفل نظرك عما يوضَع داخل كأسك في الحفلات.
لكنني لم أكن أعلم أن طالباً صالحاً وودوداً يمكن أن يكون مغتصباً. لم أكن أعلم أن الصديق الجيّد يمكن أن يغتصب صديقته. الغالبية الساحقة من ضحايا الاغتصاب الصغار في السن تعرف هوية المعتدي.
إكتئاب
بعد أسبوع من اغتصابي، بقيتُ مكتئبة ومنطوية على نفسي، وكنت لا أزال أحاول الإنكار. يبدو أن والدتي شعرت بأنه ثمة خطب ما، لكنني قلت لها إن كل شيء على ما يرام.
اتصلت بصديقتي المفضلة في ذلك الوقت، وهي صديقة مشتركة مع المغتصِب كانت أيضاً في الكلية نفسها. لكن كلمة اغتصاب علقت في حلقي، كانت أفظع من أن أتمكّن من لفظها. تلعثمت ولذت بالصمت. أخيراً أخبرتها، بتردّد، أن "إكس" استغلّ وجودي في غرفته. فقالت: "هل أنت واثقة آبي؟ يستحيل أن يفعل شيئاً من هذا القبيل".
بعد ذلك، لم أفعل شيئاً. لم أخبر والدَي. ولم أتكلّم مع محامٍ.
في حين أن معظم النساء والفتيات الأميركيات الواعيات لا يعرفن بالضرورة كيف يتفادين التعرض للاغتصاب من أحد معارفهن، يدرك معظمهن على الأرجح ما يحدث لضحايا الاغتصاب عندما يكشفن على الملأ ما حدث معهن. كنت، أنا ابنة السبعة عشر عاماً، أعرف أن ضحايا الاغتصاب يتعرّضن لتجربة قاسية جداً في المحاكم - وأن وكلاء الدفاع يدققون في حياتهم الخاصة، وتاريخهم الجنسي، وحتى في ثيابهم. تخيّلت حياتي تنهار من حولي؛ فكّرت في أن اسمي سيظهر في الصحف، وسوف ينقلب أصدقائي وجيراني وأهلي ومدرّبيّ ضدي، وسوف أصبح أنا المراهقة الضعيفة منبوذة، ويُدمَّر مستقبلي.
والأهم، كنت قد سمعت ما يكفي عن الاغتصاب لأدرك أن الضحية بحاجة إلى أدلة. وأنا لم أكن أملك أي دليل.
فقد انقضى يومان قبل أن أتمكّن من أن أقرّ بداخلي بأنني تعرضت للاغتصاب - وكانت هذه فترة كافية كي تزول أية آثار متبقية من السائل المنوي، ويرمي "إكس" الواقي الذكري وينظف الغرفة.
وصف التجربة
ولم أتمكّن من التلفظ بكلمة "اغتصاب" إلا بعد عام عندما دفعني الاكتئاب الشديد الذي كنت أعاني منه خلال سنتي الجامعية الأولى إلى طلب المساعدة من اختصاصي في علم النفس. وعندئذٍ فقط، عندما وصفت التجربة للاختصاصي، استوعبت أنني تعرّضت للتخدير، بواسطة مادة الـroofies على الأرجح - كما قال الاختصاصي - وهي المادة الأكثر شيوعاً في حالات الاغتصاب من قبل المعارف.
على مر السنين، تأرجحت بين هوامات العدالة الاقتصاصية - تخيّلت نفسي أكتب كلمة "مغتصب" بطلاء الرذاذ على الطريق الذي يقود إلى منزل والدَيه - والمحاولات الهادئة لإقناع نفسي بأنه مع مرور الوقت، سوف يتراجع وقع الذكرى علي.
لا أتوهّم مطلقاً أنه يمكن تحقيق أية نتيجة فعلية في حال رفع دعوى أمام المحكمة الآن. ليست هناك أدلة حسية. أعتقد أنه إذا اتصل أحدهم بـ"إكس" اليوم وسأله إذا كان قد فعل هذا، سيجيب بالنفي. هذا ما يحدث غالباً في حالات الاغتصاب.
أثر المخدر
منذ وقوع الحادثة، وعلى امتداد كل هذه السنين، غالباً ما تُراود ذهني صورة هاتف الطوارئ الذي مررت بقربه في رواق غرفة "إكس" فيما كنت أمشي متعثرة لبلوغ الحمام في صبيحة ذلك اليوم. على الرغم من شعوري بالغثيان والصداع، كنت أدرك وجهة استخدام الهاتف، وقد توقّفت لبرهة أمامه. كان يكفي أن أرفع سمّاعة الهاتف كي تأتي شرطة الحرم الجامعي. كانوا ليعثروا على الأدلة مبعثرة في الغرفة - الواقي الذكري، وبقايا قلادتي المفضلة التي تحطّمت عندما انتزع "إكس" قميصي. كانوا ليجروا لي فحصاً ويجدوا في دمي أثراً للمخدر الذي أعتقد أنه دُسّ في شرابي. كانت الأمور لتسلك منحى مختلفاً.
لكنني لم أرفع سمّاعة الهاتف.
تطاردني تلك اللحظة. تتسلّل إلى أفكاري عندما أكون حزينة أو مكتئبة. إنها السبب الرئيس في الغضب والإذلال وكره الذات وعدم الثقة التي تشوب بعضاً من علاقاتي الشخصية والمهنية. لماذا لم أرفع سماعة الهاتف؟
ساعدني الاختصاصي الذي يعالجني من اضطراب ما بعد الصدمة كي أدرك، وأتقّبل وأخيراً، أن قراري عدم رفع السمّاعة كان عقلانياً وليس دليلاً على عدم التحلي بالشجاعة.
على الرغم من كل ما تعلمته عن فداحة جرم الاغتصاب، بدا أن كل شيء في البيئة التي نشأت فيها يشير إلى أن إثارة ضجة حول الموضوع ليست بالفكرة الجيدة.
يؤلمني أن أفكّر في أن هناك نساء أخريات يتخذن الآن القرار "العقلاني" نفسه الذي اتخذته أنا. وفقاً لـ"الشبكة الوطنية لمكافحة الاغتصاب والاعتداء وسفاح القربى"، لا يمضي 97 في المئة من المغتصِبين يوماً واحداً في السجن. والسبب الأساسي هو أن معظم ضحايا الاغتصاب، وأنا منهن، لا يبلّغن الشرطة عن الجريمة.
ما معنى ذلك؟ يعني أنه بعد 14 عاماً، لا يزال مغتصبي حراً طليقاً يعيش حياة طبيعية، بحسب ما كشفه لي البحث الذي قمت به عبر موقع "غوغل". اليوم، ينجو جيل جديد من المغتصِبين في الجامعات بفعلتهم مرة أخرى. ولدى جيل جديد من ضحايا الاغتصاب أسباب كثيرة لالتزام الصمت.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية