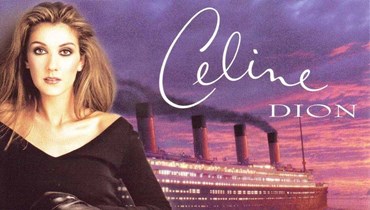ثمة واقعة "ممجوجة" يرويها الصحافي الأميركي توماس فريدمان عن الرئيس اللبناني الراحل كميل شمعون حول تقسيم العراق والمنطقة. يقول فريدمان: "كميل شمعون ثاني رئيس لبناني (بعد الاستقلال)، والرجل الذي خبر كثيراً من أوضاع المنطقة، كانت له توقعات ورؤى، كثيراً ما كانت تثير جدلاً، وتخلق متّفقين أقلّ ومختلفين معها أكثر، في منطقة وضعت على جيدها وقتئذ أيقونة الناصرية زهواً واعتناقاً وطموحاً في كرامة قومية. فضلاً عن أن شمعون كان السياسي الذي لم ينته دوره بخروجه من سدة الرئاسة اللبنانية، بل كثيراً ما كان يحرّك حوادث في بلاده، وأحياناً في المنطقة. وعندما اجتاح الجيش الاسرائيلي لبنان، طلبت قيادات لبنانية- من قادة الميليشيا المسيحية التي كانت في نزاع عسكري مع المنظمات الفلسطينية، وقت أن كانت هذه المنظمات تتمترس في لبنان من أجل إنشاء جبهة مع اسرائيل- من كميل شمعون إبداء رأيه في فكرة تقسيم لبنان، وذلك لإنشاء دولة مسيحية، فلم ترق لشمعون هذه الفكرة، وقال لمحدّثيه: "اسمعوا... لبنان لا يتقسم إلاّ اذا تقسّم العراق، فإذا شاهدتم العراق يتقسم، فهذا يعني بداية مرحلة الدويلات الطائفية والعرقية في المنطقة، وليس في لبنان فقط".
هذا الرأي الذي أبداه شمعون قبل أكثر من ثلاثة عقود، الوارد في كتب سياسية ومقالات، رأي رؤيوي تنبوئي اذ جاز التعبير، يجعلنا نتأمل بروية ما يجري في العراق في الوقت الراهن. ربما لم يقسَّم العراق رسمياً لكنه في حال أسوأ من التقسيم. يكفي ذكر "الداعشية" وما فعلته في جبل سنجار الإيزيدي وفي مدينتي الموصل وتكريت حتى تقشعر الأبدان. العراق، تالياً، يعيش في مرحلة أخطر بكثير من التقسيم. هي مرحلة احتلال من نوع آخر، اسمه الاحتلال "الداعشي" الذي يفتك بالأخضر واليابس ولا يتحمّل حتى وجود تمثال أبي تمام والأضرحة، ولا يقدّم للبشرية إلاّ الصورة الوحشية التي تقتل المجتمعات نفسياً.
ليس من الضروري في شيء أن تكون مقولة كميل شمعون عن العراق ولبنان صحيحة، لكنها في كل الاحوال إشارة إلى معنى آخر للسياسة وللرجل السياسي، يومئ إلى تبدّل الزمن وتبدل أحوال رجال السياسة. كان شمعون رؤيوياً يقدّم أفكاره ويصنع المفاجأت، وكان الكثير من أبناء جيله رؤيويين، حتى في الكتابة الصحافية. لكن يبدو أن "الرؤية السياسية" في هذه المرحلة تدحرجت الى المهوار، لمصلحة التعسف والخطب الجوفاء. على هذا، لم يعد مستغرباً أن تحفل الحياة اللبنانية بظاهرة المنجّمين والمشعوذين الذين يطلّون شهرياً وموسمياً على الشاسات والفضائيات، ويدلون بهذيانتهم وبيانات مخابراتهم وملقّنيهم، كأنهم العلامات البارزة عن الشؤم وزمن الخراب وضياع الرؤية والبوصلة. يتجلى هذا الضياع حين نعرف الكمّ الهائل من الجمهور اللبناني الذي يتابع غلاة الشعوذة التوقعية. اللافت أن المحطات التي تستضيف المشعوذين، تنتقد هذه الظاهرة، أليس في ذلك شكل من أشكال الفصام وشكل من أشكال "استحمار" المشاهدين؟!
ليس من الضروري في شيء أن تكون رؤية كميل شمعون في محلّها عن العراق، لكن المشكلات الشرق أوسطية، تنامت كلها في الواقع مع الغزو الاميركي للعراق عام 2003 وإسقاط صدّام حسن كردّ انتقامي على 11 ايلول عام 2001 الذي احتُفل لمناسبته الـ13 قبل أيام. بل إن المشكلات الكبرى في محيطنا، ولدت من لحظة بدء السباق التبشيري (والارهابي) بين "الجهاد الشيعي" المتمثل في الثورة الايرانية الخمينية عام 1979، و"الجهاد السني" المتمثل في الحركات السلفية الوهابية، اللذين يستعيران أدوات التاريخ والقرون الوسطى في حربهما المعلنة وغير المعلنة. راحت الحرب تضع العراق على سكة التصدع والفتك، فعاش الحرب الأولى والثانية والثالثة، حين دمّر صدام حسين العراق اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً وحين جاء نوري المالكي ليجهز على ما تبقى من العراق، بفئويته وجموحه السلطوي وولائه لإيران. ثم جاء أبو بكر البغدادي ليعيدنا ألفاً وخمسمئة عام الى الوراء، الى زمن السبايا والاسترقاق وقطع الرؤوس والصلب والتشميس. اللافت أن "داعش" كان بالنسبة إلينا أقرب الى مزحة "فايسبوكية"، فنتهكم على هذا التنظيم كأنه ابتكار جديد في اللغة. فجأةً، صار الوحش الذي يغرز أنيابه في رقابنا، أو يشحذ سكّينه ليذبحنا.
ما يقال عن واقع العراق ينطبق على واقع ليبيا واليمن وسوريا ولبنان وغزة والصومال. فقد انحدرت هذه البلدان من دول شبه فاشلة إلى دويلات وعشائر وعصابات و"دواعش" وبؤر إرهاب. تعاني هذه البلدان، اليوم، المحنة نفسها، متأرجحة بين خيارات دينية وأصولية وطائفية و"داعشية" (استبدادية هتلرية)، وبين عسكر فاشي متعفن يمارس سلوكيات وحشية لا تقلّ نازية عن أبي بكر البغدادي.
لقد بات واضحاً المشهد العراقي ومَن صنعه، من زمن صدام إلى زمن الأميركيين، فإلى زمن المالكي والايرانيين. وبات واضحاً المشهد في غزة، التي يعيش سكانها بين تعسف "حماس" ووحشية اسرائيل. وبات واضحاً المشهد السوري إلى أين! بين "التردد الأميركي" المقصود لغاية في نفس يعقوب، والسلبطة الروسية والجموح الايراني والسذاجة الأسدية والفشل العربي. بين هذا كله وذاك، انطحن الشعب السوري، وسُحقت كل الآفاق أمامه. لقد قتلوا الأمل الذي فيه وتركوا الأرض والفلاة للوحش "الداعشي". لقد نشأت الدويلات والأحياء الأمينة ومدن الأشباح والمقابر الجماعية والقتل الجماعي. يكفي مشهد إعدام "داعش" الجنود السوريين في الرقة ليطمر الأسد رأسه في التراب وينتحر. لا يختلف الواقع في اليمن. فالوحش الحوثي الشيعي لا يقلّ جوراً عن الوحش التكفيري السنّي. بقوة السلاح يغزو الحوثيون مناطق يمنية ويسطيرون عليها. البندقية في اليمن "أقوى" من العقل وأوهام الحوار. المسلحون الحوثيون رفعوا صورة السيد حسن نصرالله كأنهم يريدون نقل الانتصارات الوهمية إلى بلادهم. لقد غاب الاستقرار اليمني تحت أقدام الولاءات الخارجية. لم تنفع الثورة في تطوير النظام، ولم ينفع تنحّي علي عبدالله صالح في التخفيف من التوتر. هناك جموح لدى بعض اليمنيين للسلطة، وهناك جموح لتطييف اليمن.
قلنا إن ليبيا استراحت من "العقيد" معمّر القذافي بعد الثورة والتدخل الاطلسي. لكن يبدو أن العقيد الذي قُتل، قد أنبت العشرات من أمثاله. تخلصت ليبيا من جنون العقيد لتقع تحت رحمة وحوش الجماعات المسلحة والتدخلات الخارجية. من يعرف الآن، ليبيا في يد مَن؟ وإلى أين تتجه؟ ومَن يحكمها؟ جوهر المشكلة نفسه يدور في البلدان العربية ولا أحد يجرؤ على الحلّ، وربما لا يريد. هي المحنة ذاتها من ليبيا الى غزة وسوريا والعراق واليمن، من دون أن ننسى الحفلات الجهادية الإرهابية في سيناء أو في بعض مناطق تونس.
رياح السكاكين
بين هذه البلدان التي عاشت الثورات الشعبية و"حروب الردّة" على الثورات، كما وصفها فواز طرابلسي، يبدو أن لبنان يعيش رياح السموم ورياح السيوف ورياح السكاكين ورياح الصواريخ ورياح العكش ورياح العتمة والظلمة ورياح الفراغ ورياح العنصرية ورياح الفوضى. كانت قضية العسكريين المخطوفين في جرود القلمون كافية لتظهير حجم المأزق البنيوي الذي نعيشه. قال لي أحد الزملاء إن العسكري في أميركا عندما يحصل له مكروه أو يقع في الأسر، تتولى الدولة أموره. في لبنان يبدو العسكري ابن البيئات الاجتماعية والأهلية والطائفية وليس ابن الجيش. تكفي قراءة ما حصل في الشارع، وما لا يزال يحصل، بعد خطف العسكريين، لنعرف أقنعة الطوائف وأقنعة المؤسسة العسكرية نفسها.
لبنان وسط هذا الإقليم الهادر بالحروب والصراعات والفتن، كان حقل التجارب الأول للخراب والتوحش ولـ"حروب الآخرين على أرضنا". كان لبنان حقل التجارب الأول لجحيم الشعوب، من الذبح على الهوية الى التهجير والاغتيالات والفتن المتنقلة وخطف الرهائن واختفاء الأشخاص. لم تكن أبرز البلدان العربية والغربية بريئة من صناعة الوحش اللبناني. ولم تكن الطوائف اللبنانية بريئة من صناعة جحيمها ووحشها. المحنة أن الوحش بقي عملياً على أرض الجحيم هذه. توهمنا خيراً. قلنا إن الحرب اللبنانية انتهت، وإن اللبنانيين تعلّموا من مرارتها وكوابيسها، لكن أصحاب "المشاريع" الكبرى والأحلام الهذيانية حافظوا على الأدوات القاتلة التي تشعل الحرب في أيّ لحظة. فعدا ترسانات الأسلحة والصواريخ المتوافرة في المستودعات والشوارع، هناك التلفزيونات الفالتة خارج كل الضوابط، وهناك الأبواق المرتزقة التي تبثّ السموم اللفظية والحقد والكراهية في برامج "التوك شو"، وهناك الشبّيحة الذين ينتشرون في الشوارع وعلى النواصي، في رعاية الممانعة، وهناك منطق التخوين الدائم الذي فحواه مَن ليس معنا فهو ضدّنا، فضلاً عن الانتشار الغريب لرجال الدين والجمعيات الدينية واللحى المشكوك في أمرها.
هكذا، أمضينا نصف عمرنا في الحروب، نداوي الجروح ونسأل عن المخطوفين والقتلى الأبرياء، ونمضي النصف الآخر نتوقع الحرب يوماً بيوم. بين مدة وأخرى، هناك غزوة جديدة ومقتلة جديدة. من حرب نيسان 1995 إلى حرب تموز 2006، ومن 7 أيار إلى عبرا، ومن نهر البارد إلى عرسال، ومن سجن سمير جعجع إلى اغتيال رفيق الحريري، ومن اختفاء جوزف صادر إلى اغتيال محمد شطح، ومن اغتيال عماد مغنية إلى اغتيال حسان اللقيس.
المحنة الشرق أوسطية (اللبنانية تحديداً) الجديدة بدأت مع احتلال العراق وتفككه عام 2003، ثمّ مع اغتيال الحريري وما نجم عنها من انقسام عمودي وتصنيع لـ"الدواعش"، وزادت وتيرتها عندما اشتعلت التظاهرات في سوريا عام 2011 ضد بشّار الأسد الذي لا يريد إلاّ خلوده على الكرسي، وعندما أناطت بعض الجماعات اللبنانية لنفسها التدخل في الجحيم السورية. بدل أن تأتي ألسنة لهب الحرب السورية إلى لبنان، استبق بعض اللبنانيين الحرب وذهبوا الى سوريا وعادوا محمّلين في التوابيت. صرنا نحصي أرقام التوابيت كأن القتلى مجرد عدد. كانت الدولة بكل ألوانها الطائفية تتفرج أو "تنأى بنفسها". لم تحتكر الدولة قرار الحرب والسلم، حين كانت الحدود سائبة، جيئة وذهابا، بل تُركت سائبة عن قصد. بعضهم توهم سقوط بشار الأسد السريع ظناً منه أن سلطانه سيزداد نفوذاً وسيكرس نفسه ملكاً على دمشق، والبعض الآخر أعلن انتصاره الوهمي قبل الأوان، بل توهم الانتصار المبكر ودحر رأس الارهاب. عند كل منعطف كان يضخ في خطبه منطق الانتصارات الوهمية ظناً منه أنه وليّ هذه الأمة. بين وهم السقوط الأسدي ووهم الانتصار الإلهي، كان لسان النار يصل الى لبنان، فصارت "الدواعش" بيننا، على شرفة دارنا، في ودياننا وجبالنا، والأخطر أنها صارت في عقول البعض وفي نمط تفكيرهم. كل العناصر البدائية والوحشية والعنصرية حضرت في المشهد اللبناني، من الذبح إلى حرق الشعارات الدينية، المسيحية والاسلامية، الى ضرب العمال السوريين وحرق خيم النازحين. حضرت البدائية والخساسة أيضاً في تصريحات بعض الصحافيين والإعلاميين التي تدعو الى الغزو والفتك بالآخر.
منذ البداية فضّلت بعض الجماعات اللبنانية الحليف الإقليمي على ما يسمّى "العيش المشترك". توهمنا أفكاراً ميتافزيقية حول المقاومة لتبسط سلطانها على الدولة باسم "الممانعة". من البداية كان أصحاب مشاريع "العبور الى الدولة" غير جديين، لأنهم عند كل منعطف كانوا يفتكون بهذا الشعار. ومنذ البداية كان النظام السوري يريد أن يمتد لسان النار إلى لبنان، ليخفف الأعباء عن نفسه من خلال إشعال النار في جواره. أرسل العبوات في سيارة ميشال سماحة قبل أن يرسلها في سيارات بعض حلفائه في طرابلس، لأنه أراد أن يهتك ما بقي من لبنان. لا شك أن الدين في بعض جوانبه ينطوي على شيء من الاستبداد، ويدفع البعض الى التوحش مثل أي تنظيم ايديولوجي، لكن علينا أن نعرف أن صانع التوحش الحقيقي هو الاستبداد السياسي أكثر من الديني. بدأت الثورة السورية بتظاهرات سلمية، واستطاع النظام أن يعسكرها وأن "يدعّشها" هادفاً بكل السبل والوسائل الى "تدعيش" لبنان. بعض المعارضة السورية و"حزب الله" كانا في خدمة الأسد لنقل لسان النار الى لبنان و"تدعيشه"، ذهب "حزب الله" ليحارب التكفيرين في سوريا فأتى بهم الى جرود لبنان. وصل الوحش "الداعشي" والسادي إلى ديارنا، لأننا لم نتعظ من جحيم الوحش. ثمة من يريد توظيف هذا الوحش في السياسة، ويريد إيهام الأخرين ("الأقليات" تحديداً) بأن الوحش قادم وبأنه وحده القادر على حمايتهم. لا يتردد الوحش في تقديم ما يخدم غريمه، كأنهما حليفان بطريقة غير مباشرة، يخدم أحدهما الآخر في التوتير وإثارة الهلع والرعب. معركة عرسال وتداعياتها هي النموذج، وفيها تجلت الفضيحة السياسية والنيات المعفنة وهشاشة كل شيء في لبنان، من الأمن الى السياسة. لقد فضحت العقل الفاشي و"الداعشي" لدى الكثير من السياسيين. هناك من يفكر في محو عرسال من الوجود ليرفع راية النصر، ولا يعنيه أن يقتل مئات الأبرياء ومئات العسكريين. يهمه ان يستكمل الانتصار ويرفع الرايات. لقد أطلقوا الأناشيد قبل المعركة استعداداً لبدء المعركة، فانتهت المعركة بأقلّ الخسائر الممكنة، لكن لبنان دخل في مستنقع التوتير والابتزاز من مختلف الجهات؛ مستنقع الابتزاز والوحشية من المسلحين السوريين ومن "حزب الله".
كل ما يحصل في لبنان من بلاءات ومشكلات ونزاعات، أصله غياب المساواة و"الكيل بمكيالين" في التعاطي مع الأمور الأمنية والاقتصادية والسياسية، وفي فتح الحدود مع سوريا وغض النظر عن فريق ذهب بعتاده وعديده للدفاع عن بقاء نظام الاسد، فشجع "الجهاديين" لينغمسوا في التواصل مع المقاتلين المعارضين للنظام الأسدي في سوريا، ولم يكتفوا بالتعاطف مع الثائرين أو النازحين بل التحق بعضهم في القتال. هي الجحيم الطائفية والمذهبية والخوف من الآخر. إنه "اللاوعي الجمعي" الداعشي الذي تفرزه الأزمات والحروب، فيجعل كل شخص تحت جناح طائفته حتى لو كان معترضاً على سلوكها. ثمة أسماء شيعية اعترضت على قتال "حزب الله" في سوريا، لكن الاعتراض كان خجولاً وهو يظهر كم أن الجماعات اللبنانية أسيرة الخوف على الطائفة وانتصاراتها ومستقبلها.
في ظل المعمعة والفوضى، هناك وهم اسمه الأكثرية، وهناك وهم آخر اسمه الأقليات. مجرد ألفاظ من أحل التسلط، تشبه إلى حد كبير ألفاظ "الممانعة" و"المقاومة" الفارغة المضمون. واقعياً، هناك وحش "داعشي" متعدد الرأس يلتهم الجميع ولا يفرّق بين أكثري وأقلّوي، بل إن السنّي هدف له قبل الآخرين. من يتابع التقارير الإعلامية يدرك "شغف" الوحش "الداعشي" بقتل السنّة في مناطق الشام باعتبارهم من "المرتدّين"، وهو، على ما يقال، يفضّل قتل "المرتدّين" من السنّة على قتل "الكافرين" من الشيعة أو من أي طائفة اخرى. "الداعشية" للأسف، متوافرة بغزارة لدى كل الشعوب. يكفي أن نقرأ أرقام المقاتلين الأجانب الذي أتوا من أوروبا والمغرب العربي الى سوريا، لندرك هول ما يجري. كأن أوروبا بيئة حاضنة للإرهاب أكثر من بلاد المشرق. و"الداعشية" متوافرة لدى أركان الاستبداد الطائفي والديني. ولدى أركان النظام الأسدي. ليست سكاكين الذبح وحدها تصنع "التدعيش"، فبراميل الموت لا تقلّ خطورة، وسجون التعذيب والعبوات الناسفة ليست من جنس الملائكة!
"الداعشية" هي الوحش الذي خلقه الأسد ليلتهم الثورة السورية، لكن الوحش نفسه ارتدّ ليبدأ بالتهام الأسد نفسه. إنها اللعبة الفرانكشتانية التي بدأتها أميركا أولا مع تنظيم "القاعدة" في أفغانستان، الذي ما لبث أن قام بغزوة 11 أيلول.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية