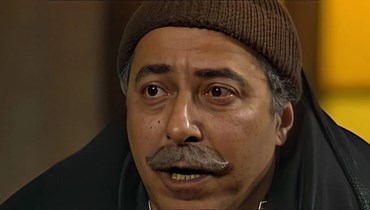أريد أن أدافع عن فكرة أن الثورة السورية توفر شروطاً أكثر ملاءمة لثورة في الكتابة، تتمثل أساساً في حضور كبير للتجربة الشخصية في ما يُكتب، على حساب أي مرجعيات عقدية وفكرية جاهزة من جهة، وبالتمايز عن كتابة عمومية وانطباعية، لا موضوع لها (ولا ذات كاتِبة إذاً). كان هذان صنفي الكتابة الشائعين في سوريا قبل الثورة، الأولى هي في الواقع دعاية أبدية للمرجع المقدس، والثانية تتحدث على كائنات غير موجودة: الوطن العربي، البلدان النامية، دول العالم الثالث... إلخ. الأولى دين، الثانية خرافة.
التحول نحو كتابة مغايرة يجد تكميله في شيئين، أولهما أن أكثر مَن كتبوا خلال الثورة وعنها شُبّان، لا تستعمر تفكيرهم مرجعيات نهائية، ولا تشوّش أفكارهم شكوك حول صلاحية تلك المرجعيات، بينما الثورة تجربة مشكِّلة لكلٍّ منهم، ولديهم سلفاً خبرات شخصية كبيرة؛ وثانيهما أن مَن تتفوق مرجعياتهم السابقة على تجاربهم الحية، وهم عموما من أجيال أكبر سناً، كانوا في الغالب متحفظين عن الثورة أو معادين لها صراحة. هذا ظاهر في خصوص شيوعيين وعلمانيين تسلطيين، لكنه ينطبق أيضاً على الإسلاميين الذين، وإن بدا أن الموجة الثورية تدفعهم إلى الأمام، انضمّوا إليها متأخرين، ويبدو تعلّقهم بنصوص معتقدهم، وفي صيغه الأكثر انغلاقاً، أقوى بما يقاس من انحيازهم للتحرر الاجتماعي والفردي. علاقتهم بنصوصهم لا تسمح بانبثاق حس شخصي، أو تفكير متحرر، أو امتلاك خاص للغة، أو للدين ذاته.
لدى هؤلاء وأولئك عالمهم الكتابي والفكري الخاص، المكتمل قبل الصراع، وفي استقلال تامّ عنه، فلا شيء لديهم يقولونه للثورة، غير الإيعاز لها بأن تشبههم، ولا يبدو أن للثورة ما تقوله لهم. لا ذات يمكن تكوّنها في هذه العوالم المكتملة، ولا حرية تالياً.
هل ينطبق ذلك على ثورات أخرى في المجال العربي؟ ربما بقدر أقلّ، لأنها استغرقت وقتاً أقصر بما لا يقاس، ولأنها لم تشكل قطيعة كبيرة مختارة وقسرية في حياة ملايين الناس، على ما هي الحال في سوريا. هناك نصوص متميزة جمعتها ليلى الزبيدي في كتاب Diaries of an Unfinished Revolution، بمساهة كتّاب من 8 دول عربية، تسجل معظم نصوصه حضوراً قويا للتجربة الشخصية والمشاركة الشخصية في أنشطة الثورة.
بفعل الصراع الكبير، خرج كثير من السوريين من ذواتهم إلى عالم يتغيّر وشاركوا في تغييره، وتحولوا من مناجاة النفس (المونولوغ) إلى التفاعل والعمل مع شركاء، والحوار (الديالوغ)، ومن مراقبة النفس إلى كسر التابوهات، وتقدّمت العين في الكتابة على الأذن، ودخل الجسد الصراع وتعرض للخطر. كانت العزلة التي فرضها الطغيان طوال عقود قد حبست الناس داخل نفوسهم، حتى حين لم تحبسهم في سجون وحشية. كسر السجون داخلية، وليس الخارجية وحدها، هو السيرورة المعرِّفة للثورة.
أيا تكن مآلاتها السياسية المباشرة أو القريبة، تحمل الثورة مقدمات ثورة في التفكير والثقافة، لم يعرف ما يقاربها أكثر متكلمي العربية منذ أجيال. لعلها الثورة الثانية بعد ما يسمّى "عصر النهضة العربي"، بين أواخر القرن 19 والحرب العالمية الثانية، وقد فتح اللغة العربية وأذهان متكلميها على واقع دنيوي متغير، وأدخل فنوناً وأصنافاً كتابية جديدة. لقد وسّعت الثورة دائرة ممكنات ما يمكن التفكير فيه على نحو غير مسبوق منذ أكثر من نصف قرن، وحطّمت تابوهات سياسية ما كان يتجاسر أحد تقريباً على تحطيمها، ووسّعت قاعدة العمل العام على نحو لم يتحقق ما يدانيه منذ الاستقلال قبل نحو 70 عاماً، وهي في سبيلها إلى تحدي تابوهات دينية بالسيرورة نفسها.
الثورة حرّرت ناشطين وكتّاباً ورفعت ثقتهم بأنفسهم، فهم يملكون تجارب ثمينة لا يحوز مثلها كتّاب أكثر تكريساً، انفصلت كلماتهم عن الواقع المعيش في لحظات تفجره، ولا يتاح مثلها أيضاً لمجايليهم الذين لم يشاركوا بأنفسهم في هذا الصراع الكبير المفتوح النهايات. وهي بهذا المعنى أحدثت انقلاباً في الحياة الشخصية لكلٍّ منهم. فكأن الواحد منا يبدأ حياة جديدة، أو يفتح سجلاً جديدا للتعلم والاكتساب والمشاركة.
ربما لهذا تشكّل الكتابة عن الثورة فعلاً ثورياً من حيث أن معنى الثورات هو امتلاك الكلام حول الشؤون العامة في الفضاء العام، بوصفه وجهاً أساسياً لامتلاك السياسة. كان الطغيان الأسدي قد صادر الكلام بوسيلتين. الأولى هي ببساطة قمع الرأي و"كمّ الأفواه"، وصولاً إلى منع عموم الناس من التعبير العلني عن أنفسهم. كثيرون سُجنوا وعذِّبوا لأنهم تكلموا، قبل جيل واليوم. الثانية هي فرض قوالب لغوية جامدة، تحول دون التعبير الشخصي، وفرض أساليب للكلام المنطوق والمكتوب، تخلو من الاعتراض على السلطة ومن التفكير الشخصي، ومن السجال وتسمية الأشياء بأسمائها، وتعتمد التعميم والمداورة والكلام الذي لا يقول شيئاً محدداً، ولا يتناول أوضاعاً محددة بعينها في زمان بعينه ومكان بعينه. حين كان يظهر سوريٌّ ما على شاشة التلفزيون أو في الإذاعة، كان يُختزَل إلى آلة استظهار تسترجع دون حياة، الخطاب الرسمي نفسه، المتمركز حول عظمة الرئيس واستثنائيته. المعلم في فيلم "الطوفان" للراحل عمر أميرالاي هو مثال السوري الذي لا شخصية له ولا كلام شخصياً، الأبكم فعلا. طوال عقود كانت المدرسة والجريدة والراديو والتلفزيون واللافتات و"المسيرات الشعبية العفوية"...، كلها كانت تقول جملة اسمية واحدة: الرئيس عظيم! وكانت المخابرات تعتقل وتعذّب وتحبس، وقد تقتل، مَن يقول عكس ذلك أو يقول كلامه الخاص في الفضاء العام. على هذا النحو ألغيت شخصيات السوريين، وانقلب كلامهم ضرباً من الصمت المسموع.
هذا الوضع النزّاع إلى الذاتية والقول والحكم الشخصي، تواطأ معه أو لم يتجاسر على تحدّيه جيل من الكتّاب والمتكلمين، يستخدم لغة عمومية، خالية من التجربة، لا تناقش أو تحاور غيرهم، تقول أشياء كثيرة من دون أن تقول شيئاً محدداً، لا تتحدى التابوهات السياسية، أو يترك أصحابها مرجعياتهم المكتملة تستعمر الخبرة وتفرض عليها الصمت. كيف لا نشعر بالذهول من أن مثقفين مكرسين في سوريا، يتواتر أن يتذمروا من أنهم لا ينالون التكريم الذي يتوقعونه لأنفسهم في بلدهم، لم يقولوا كلمة واحدة عن مذابح حماة وتدمر في جيل سبق، وعن جرائم ومذابح اليوم؟ خاطرة مثلاً عن حمزة الخطيب؟ تأملات من أي نوع عن مذبحة الكيميائي؟ بضعة سطور عن صناعة الموت في المقار الأمنية؟ كلمات عن البراميل المتفجرة أو صواريخ سكود؟ احتجاج على اعتقال أيٍّ كان؟ نص عن صورة مما يحصى من صور مذهلة عن الجريمة المستمرة؟ تضامن مع أحد ما؟ رثاء لقتيل مجهول في مذبحة ما؟
لا شيء. عمّ يكتُب الكتّاب إذاً؟ هل مثل هؤلاء أحرار؟ بأيّ شيء يختلفون عن العبيد؟
مقابل هؤلاء، انتزع كثيرون عبر الثورة الكلام الذي يعترض ويحتج، يمتلئ بالإحساس والتذكر والتجربة، وينطق باسم الجسد المنخرط في الصراع بكليته، ويجري التعبير عن الكل بقاموس شخصي. تكونت ذوات ولغات ومراكز مبادرة حية في الصراع والخطر وعبرهما. رزان زيتونة كتبت عما خبرت مباشرة، وانخرطت في الصراع شخصياً ومنذ البداية، مرسيل شحوارو كتبت (القليل للأسف) عن خبرة حية، ومثلهما نائلة منصور ورزان غزاوي وريم الغزي وسعاد نوفل ولينا عطفة وخولة دنيا وضحى حسن وهنادي زحلوط. وأكثرهن لسن كاتبات أصلاً، لكن كتبن إما من قلب الصراع، أو استنادا إلى تجربتهن فيه. لم يكنّ شاهدات، بل مشاركات فاعلات.
عبر امتلاك الكلام الجديد يتكون الناس كذوات فاعلة متحررة، يبنون لأنفسهم هويات جديدة، وأدواراً عامة جديدة. عملية الثورة متناقضة دونما شك، ما دمنا نرى صعود إسلاميين يسخّرون الاحتجاج العام لمصلحة تطلعهم إلى سلطة تقمع غيرهم، ويفرضون كلاماً بائتاً وفقيراً، يشارك الكلام البعثي مصادرة تجارب الناس وإخماد منابع المعنى والتعبير في نفوسهم. لكن لا يلزم شيء مختلف في مواجهة المتسلطين الجدد. الكفاح من أجل امتلاك الكلام والاجتماع والسياسة، هو ما من شأنه أن يكون عملاً محرراً لجمهور واسع يصعب أن يعود إلى أيّ بيت للطاعة، ولو بثمن الخراب العام.
ولو بثمن الخراب العام. بيت الطاعة الذي اسمه "سورية الأسد" هو الخراب العام + المذلة العامة.
لعل هذه مناسبة لمنازعة بعض الأساطير حول الثورة السورية. حين يقال إن الثورة بلا بعد ثقافي أو فكري، أرى أن العكس أقرب إلى الصواب، وأن هناك وعداً وفّرت الثورة ظروفه بتغير معنى الفكر والثقافة ذاته. لم يعد الأمر يتعلق بتعميمات منفصلة عن حياة الناس وجهودهم للتحكم بها، ولا بنظريات هادية لا نستطيع التوجه في الواقع دون استشارتها، ولا بتأملات مكرورة تجترّ أنا صاحبها وليس إلى أي تفصيل من حياة الناس وموتهم. يتعلق الأمر بالأحرى بطرق ذهاب وإياب مفتوحة بين الإحساس والفكرة، بين التجربة والمفهوم، بين الخبرة والكلمة، بين العناء والمعنى. نحن حيال عملية جديدة، لم تراكم الكثير بعد، لكنها كتابة بالعين التي ترى، لا بالإذن التي سمعت.
أسماء الكاتبات المشار إليهن تكفي للرد على أسطورة ثانية حول محدودية مساهمة النساء في الثورة السورية. مساهمة النساء متعددة الأوجه، تمتد من النشاط السياسي إلى المشاركة الميدانية المتنوعة، إلى تدبير شؤون حياة الجماعات المحلية في شروط بالغة المشقة، أحاطت بجوانب منها السينما الوثائقية السورية، إلى الكتابة.
هناك مساهمات كتابية لرجال أيضاً، لكن يجد المرء صعوبة أكبر في استحضار أسماء، وتبدو الكتابات الرجالية أقل انفتاحاً على المعيش، وأكثر ولاء لأساليب كتابة وتعبير عمومية ومجردة. ولا يزال يهيمن هنا جيل أكبر. متوسط أعمار النساء اللاتي ذكرت أسماءهن نحو 35 عاماً.
على عكس الانطباع المتعجل إذاً، قد يكون السجل الثقافي للثورة، على تشتته، أساسياً وأصلح لأن يبنى عليه من أيّ شيء سياسي. وقد يقال يوماً إن السوريين دشّنوا ثورة في الثقافة بينما كانوا يقومون بثورة سياسية مستحيلة.
لكن هذا الحضور الكبير للمعيش، وللنساء، في الكتابة، يحدّ منه اليوم شرط قاس: إن أكثر الأسماء المذكورة اضطرت للخروج من البلد والعيش في الشتات. أكثرهن بسبب النظام، وبعضهن بسبب جماعات دينية تشبهه: رزان زيتونة مخطوفة عند جماعات كهذه في غوطة دمشق، وتعرضت مرسيل شحوارو لخطف قصير ومضايقات من جماعة مشابهة في حلب. هذا، أعني العيش في الشتات، يفصل هؤلاء النساء، وكثيراً من الرجال أيضاً، عن موطن التجربة الحية الذي أنتجن أفضل أعمالهن وأفضل أعمالهم فيه. لعلنا للمرة الأولى نشعر أن "المنفى" قيد كتابي وثقافي، فوق كونه رضة نفسية وتقطيعاً لروابط اجتماعية وسياسية هي ما تشكل لحمة حياة كل واحد منا. لا يبدو أن مثقفين من جيل سبق شعروا بألم الانفصال عن أرض التجربة، بل لعلّهم من وجهة نظر الكتابة والثقافة كانوا يجدون في الخروج من البلد فرصة، وليس ضياعاً أو خسارة. كانت الكتابة فعلاً يحيل على مرجع لا على واقع، وعلى كتب لا على تجارب، وعلى "وعي" لا على خبرة حية، وعلى إجابات عن أسئلة معطاة، لا توليداً لأسئلة جديدة وأدوات تفكير جديدة.
بعض المثقفين السوريين من الجيل الأقدم تخلو كتاباتهم كلياً من أي مثال يحيل على واقع عياني، من وصف لتجربة معيشة، من مفاهيم تولدت من المعاينة الشخصية، تفكير وكتابة يدوران في عالم من المعاني المجردة والماهيات الثابتة. هذا وجه ثقافي للنكوص القروسطي الذي أصاب حياتنا العامة في العقود الأخيرة، يضاف إلى الوجه السياسي المتمثل في انقلاب البلد إلى مملكة سلالية (وهو ما كان يهدد مصر وتونس وليبيا واليمن أيضاً، وما يسوّغ الاعتقاد بأن ثورات تلك البلدان حققت شيئاً مهماً على رغم كل شيء، قطع طريق النكوص السلالي، هذا الذي تدفع سوريا اليوم ثمن ريادتها الفاجعة فيه)، والوجه الاجتماعي المتمثل في تطييف الثقافة والحياة العامة بدءاً من المركز السياسي، والوجه الديني المتمثل في الجهادية الإسلامية.
يظهر اليوم بفعل الثورة والانخراط فيها جيل جديد من الكاتبات والكتاب، يتميز عن سابقه بأنه مسؤول اجتماعياً ومنحاز سياسياً، ويبني هويته العامة على مسؤوليته وانحيازه.
على أن لهذا الجيل الجديد وكتابته الجديدة بالعين نقطة ضعف ظاهرة: ضعف الأدوات المفهومية والفنية التي تشكل جسراً للانتقال من التجربة والخبرة الشخصية إلى فكر وفن لهما قيمة عامة وإنسانية. نكتب بالعين، لكن نفتقر إلى العين الثانية، العين الداخلية التي تنظّم ما ترى، وتحول المحسوسات إلى معقولات. كانت هذه نقطة ضعفنا في زمن "ربيع دمشق" أيضاً: زاد عدد الكتاب، وكان "ربيع دمشق" والسنوات اللاحقة له ربيعاً للكتابة بعد أكثر من عقدين من الشفاهة الإجبارية والهرب في كل اتجاه من الواقع المعيش، لكن كتابتنا قلما اقترحت أدوات جديدة في التحليل والتفكير، وقلما راجعت نفسها ونظرت في نفسها. تحولنا بأنظارنا إلى الداخل السوري، وهذا شيء مهم بعد عقود من سياسة كتابية تهرب من سوريا نحو "الوطن العربي" و"العالم الثالث" و"البلدان النامية"، لكن ثابرنا عموماً على عادات كتابية قديمة وعمومية، فلا نضرب أمثلة، ولا نورد وقائع، ولا نذكر تفاصيل، ويستخدم أكثرنا فوق ذلك عدة مفهومية قديمة. هذا يهددنا اليوم أيضاً. الكتابة بالعين يمكن أن تتآكل إن لم تكن كتابة بعينين: العين التي ترى، والعين التي ترى العين التي ترى، وتهيمن عليها. رؤية الرؤية هي التي تولّد المفاهيم والنظريات والمناهج، والفلسفة، وهي التي تثبت ما تراه العين الأولى. نخسر عينينا معا إن لم نكسب العين الثانية بعدما كسبنا العين الأولى. الذات لا تتكون بمجرد الفعل، بل بالفعل على الفعل، بالفعل الثاني.
على رغم تعثرها وتناقضاتها قلبت الثورة كل شيء في حياة السوريين، وهي مناسبة كبيرة لنهضة ثقافية ثانية، نواجه فيها وجودنا كله. كانت النهضة الأولى استنفدت نفسها خلال ثلاثة أجيال، وارتدّت إلى ما سبقت الإشارة إليه من كتابة بلا موضوع، وبلا ذات تالياً؛ أو إلى انقلاب المرجع الناجز ذاتاً مبادرة، والكاتب موضوعاً للمرجع أو أداة له. للنهضة الثانية موضوع كبير جداً يعاود فرض نفسه: الدين، وقضايا الدين والسياسة والأخلاق والقانون والفن. لكنها نهضة تستبطن صراعاً سياسياً بالغ الاتساع والعنف ضد العبودية، وليست كلاماً مجرداً في الثقافة.
في أفقنا اليوم موجة تحررية جديدة، تؤسس نفسها عبر الصراع الحالي ضد العبودية الدينية والسياسية، وستطلق من كل بدّ قوى تحرر اجتماعي وسياسي جديدة.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية