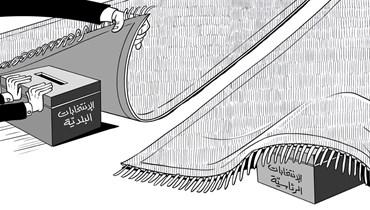غسان تويني ليس غائباً. ها هم الأصدقاء يجتمعون في حضوره، وحوله، داخل كتابٍ عنه، أصدرته "دار النهار" للتوّ، مسترجعةً ذكراه، التي لم تمضِ، لأن صاحبها حكيم في موته، قبل أن يكون، على هذه الحال، في حياته. هو لم يتنقل من الفلسفة إلى الصحافة والسياسة بالإنقطاع، والهجران، بل واظب على عيش كل الحقول بلا كلل أو تراجع، جامعاً بين حكمته وشجاعته، وبين فطنته وجرأته، مازجاً بين التفكر في القائم والإقدام على الجديد.
كان غسان تويني في ذلك كله، يمارس نفسه إغريقياً، وكان يبدل أيقوناته، التي أعانته على تحمل المعاناة والشقاء، وعلى مواجهة المحن المتسلسلة، من موت زوجته ناديا إلى قتل إبنه جبران، مروراً بوفاة إبنته نايلة نتيجة السرطان، وإبنه مكرم على إثر حادث سير. تحمّل تويني كل هذه المصائب، كأنه "عميد الحياة" قبل أن يكون "عميد الصحافة" في لبنان، هو الذي واظب على الحلم، مثلما يكتب في "رسائله إلى الرئيس الياس سركيس"، مشدداً على ضرورة الحلم، سائلاً عن بديله، فهل هو "التسليم بالأمر الواقع الإستسلامي؟ أليس أفضل أن نخلق نحن أمراً واقعاً جديداً؟".
المتعدد الحرّ
بالفعل، خلق تويني واقعاً جديداً عبر نشاطاته المختلفة، أكانت الصحافية، أم الديبلوماسية، أم السياسية بشكل عام. هذا ليس غريباً على "إنسان متعدد"، كما وصفه ميشال إده، الذي تحدث عن معركة الكتابة الدائرة بالكلمات والمواقف التوينية، بغاية الحرية. "دعوا شعبي يعيش!"، هذه الصرخة تقتضب هذه المعركة، حيث الشعب يمثل كل التوّاقين إلى التحرر، والإنتهاء من القمع والإستبداد. وهذا أيضاً ليس بعيداً عن جبران الجد، مؤسس "النهار"، الذي شارك في النهضة، وأدى أدواراً مهمة خلالها. فمن النهضة، خرجت "النهار"، لتكون جريدتها، ولتدوّي على صفحاتها صرخة العيش بحرية. ففي العام 1947، عاد غسان تويني من الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان يمضي سنواته الدراسية في جامعة هارفرد، إلى لبنان، نتيجة موت والده، آخذاً على عاتقه المسيرة الصحافية التي بدأها جبران الجد، ومن ثم انتقلت إلى جبران الإبن، قبل أن يغتاله أعداء الحرية. في هذا السياق لا بد من تذكّر تعريف تويني للصحافة: "فهي رواية الحق حتى يُعرَف. والشهادة بما حصل حتى الإستشهاد، ومحاولة إعلان ما سيحدث والتبشير به في ضوء تفسير ما هو حادث وإن انكر. بل أكثر. ماذا يبرر وجود الصحافة غير الرسالة؟ مأساة هذه الرسالة، رسالة الصحافة، انها انسانية كلها، لا ألوهة تشتريها فتخلد، قدرها أن تصارع التاريخ ساعات ودقائق لا أجيالاً وعصوراً. تموت كل يوم، كلما جفّ دمها الأسود على الورق الأبيض. وكثيراً ما تُصلَب قبل صياح الديك فيَصفر الورق ولا يبقى يُقرأ وبالكاد يُرى". ذاك، أن "الصحافة توجد حيث الحرية. بل الصحافة توجِد الحرية. ولكن مظهر الحرية الأول يظل الرأي العام".
بارح غسان تويني الفلسفة في أميركا، ليتحمل مسؤولية الصحافة في لبنان، تاركاً أطروحته عن كانط والأخلاق في السياسة، متسلماً أطروحات العرج السياسي اللبناني، التي برع في تقويمها، وفي التكلم مع شخصياتها، ورصد أحداثها الكثيرة. هذا، فضلاً عن دفع أثمان قول الحقائق في ردهاتها، وبين متاريسها. فالصحافة النهارية، التي عرّفها تويني بأنها صحافة معارضة، وليست صحافة المعارضة، تذهب في القبض على الوقائع السياسية، وربطها، ومقاربتها بالإتكاء على تماثل لها في التاريخين الحديث أو القديم، على ما كان ينهج عميدها في مقالاته، باحثاً عن الحقائق، ومطالباً بالديموقراطية. إذ "حول غسان تويني "نهاره" إلى أداة متفانية، تجاهر بالديموقراطية، كي يتضاعف عدد الديموقراطيين، الذين لا تحضر الديموقراطية بدونهم"، على قول ميشال إده.
حوار الحقيقة
ذلك، أن تويني لا يدافع عن الحرية فحسب، بل عن التحاور أيضاً، أو بالأحرى "حوار الحقيقة"، بحسب دومينيك دو فوليبان، الذي يصف تويني بـ"مفتاح الديبلوماسية اللبنانية"، والمقاوم الدائم ضد الخضوع والإذعان. وعلى الرغم من براعته في حقلي السياسة والصحافة، ظل يميل إلى الفكر والفلسفة، طامحاً إلى الإنشغال بهما، ما أدى إلى تمتعه بميزات كثيرة، يعيّنها صديقه سليم عبو بالذكاء، والإستقلال الفكري، والحس النقدي، والشجاعة، بالإضافة إلى الإستقامة. هذه السمات كلّها، تركته يجسد "الوعي" في لبنان، الذي ليس باستطاعته سوى ملاحظة الشارد والوارد في أمور البلاد، بدون أن يتخلى عن فعل الحوار.
"لقد كان آخر ممثلي التنوير العربي، مثلما كان أمير المعرفة"، كما يقول هنري لورنس، متذكراً صديقه، الذي التقى فيه العام 1980 في باريس.
على هذا الأساس، تتعدد النصوص- الشهادات، التي يضمها الكتاب، ويضم معها صداقة كثيرة، موضوعها غسان تويني، أكان الصحافي أم الديبلوماسي، أم "الإنسان"، الذي يعيش في داخله، والذي "لم يكن من السهل التعرف إليه، لأن غسان ذاته كان يخاف عليه وكان يحميه من ضوضاء الحياة وقساوة البشر". ذلك كله من خلال الصداقة، التي كانت عنده "شيئاً من الإيمان"، فـ"كان إن تأخرتَ عليه يرن الهاتف ليطمئن. كان يخاف على أصدقائه، لأنه كان إبن المأساة!"، على قول فيليب سالم. لكن هذه المأساة، لم تمنع تويني من المسامحة، وسلوكه سبيل الغفران، خصوصاً في تلك اللحظة القاتلة، التي وقف خلالها أمام نعش إبنه، داعياً إلى دفن الأحقاد، والإبتعاد عن الإنتقام: "أدعو اليوم (…) لا الى إنتقام ولا الى حقد ولا الى دم. أدعو الى أن ندفن مع جبران الأحقاد كلها والكلام الخلافي كله، وأن ننادي بصوت واحد ذلك القسم الذي أطلقه في ساحة الشهداء، يوم انتفاضة 2005 التي ذهب ضحيتها".
في السياق عينه، كتب تويني مرةً: "ما أعظم الإنتقام إذا كان يردّ على العنف بالسلام، ما أعظم الإنتقام إذا نحن اليوم انتقمنا من المؤامرة بأن نلبّي النداء، فنتوحد ونتحد لنعلن على الحرب حرباً، علّنا نقتل الموت بالحياة". ويكتب في نصٍ آخر، على إيمان أرثوذكسي: "غداً، تعود الحياة... درجوها لنا كلية طبيعية. هي الوجه الإنساني للقيامة. ولأنها حياة، وإنسانية، فإنها فعل مستمر، قيامة يومية، شرطها أن تتواصل في استمرارها إلى شيء من الأبدية التي فيها. فالدعوة اليوم- إذا من دعوة- ليست إلى تعذيب الذات، بل إلى تعزيتها".
والحال، أن في إطار هذه الصداقة، التي جمعت تويني مع الآخرين، ومع ذاته، يتكلم أوليفييه مونغان بالقول إن "تويني أضاف إلى فطنته، حساسية كبيرة"، وهذا جعله محاطاً بالكثير من الأصدقاء، الذين كانوا يرون فيه، مثل مونغان، مبدعاً للفضاءات العامة، أكان في مقالته الصحافية، أم في ممارساته السياسية، بالفضل عن تفاصيل حياته، ولا سيما أيقوناته، التي تزيّن أمكنته. يكتب عنه طلال الحسيني، أنه كان "الكاتب الناشر القارئ في عين الوقت. صديق عدوّ، إذا حاد فإلى جديد من العداوة والصداقة... ما أعرفه أنه كان مسرحاً لأشخاصه العديدة، ما أعرفه أيضاً هو أنني كنت، في لقائه، مدعواً سعيداً إلى المشاركة في هذا المسرح... كان غسان تويني يعرف أنه لا مفر من العالم، والحياة ليست سوى كيفية وجود، كذلك الموت، وإلا كيف وجدته، اليوم، في هذا البهاء؟".
الأسلوب
تتوالى الشهادات والنصوص في الكتاب، واقفةً على عوالم غسان تويني المختلفة، وراصدةً تحولاته السياسية والفكرية، مثلما هي الحال في النص الذي كتبه مروان حمادة، أو النصية والأسلوبية، كما في نص أحمد بيضون، المعنون "أسلوب". وقد ركزت هذه النصوص، وغيرها، على رفض تويني لكل منازع العنف، والتزامه النقاش، بالإضافة إلى حنكته الديبلوماسية التي تتمظهر في مقالاته، وفي مواقفه. فهو الذي غادر الحزب القومي السوري، عندما اغتال رياض الصلح، وابتعد عن كميل شمعون خلال أحداث العام 1958، كما تقرب من الإمام موسى الصدر إلخ. فلم يحاول مرةً أن يبرر عنفاً أو يغض النظر عن ظلم أو أذية. هنا، يستند مروان حمادة إلى سياسة تويني وموقفه، ليدعو المسيحيين والمسلمين في سوريا للتوحد في وجه الديكتاتور الأسدي، وللمحافظة على تعدديتهم في ظل جمهورية علمانية وديموقراطية. وهذا ما يحافظ بالتوازي على لبنان، الذي "لا يحكم ضد سوريا، ولا يحكم من سوريا" على حد سواء، بل عليه أن يكون حراً بقراراته، ولا سيما السيادية منها. في الأحوال كلها، هذا ما جسدته "النهار" في مسيرتها، رافعةً شعار عميدها: "دعوا شعبي يعيش". كأن الشعب في هذا المجال، هو الحاضر في لبنان وسوريا، وفي كل البلدان المحكومة بالديكتاتوريات والسلطات الإستبدادية. فهذه الجريدة، بحسب تويني، لا تدافع سوى عن الإنسان، وهو على تعريفه، "الذي له تاريخ، وهو إنسان الحاضرة، أي "المدينة"، من هنا المدنية والحضارة"، كما أنه الإنسان الحر، الذي له الحق في الحياة الدائمة.
لقد تعددت عوالم غسان تويني، التي جمع بينها بدون أن يفضّل عالماً على آخر، فيهمل هذا، ويهتم ذاك. فحين يتنقل من الصحافة إلى النشر على سبيل المثال، يدرك أن الحقلين لا يستويان على تعارض، كالقول إن العمل الصحافي هو المعركة، ومهنة النشر مجرد تسلية، أو إن الأول مسيرة يومية، والثاني تراثي. على العكس، كان تويني يرصد الإنقسام بين الحقلين، ليقع على الجامع بينهما أكثر، "فأمبراطورية الحبر والورق تحيا إثر الإخلاص والإبداع"، على قول فارس ساسين. في هذا المطاف، كان غسان تويني وفياً لزمانه، ولمهنته، ولسياسته، مثلما، مبتكراً فيها أيضاً. ذلك، نتيجة قوته الإغريقية، التي دفعته إلى تحمل المشقات كثيراً، وفي الوقت نفسه، أحاطته بأصدقاء كثر، يتذكرونه باستمرار، لأنه، بالنسبة إليهم، حكيمهم، وكريمهم الشجاع.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية