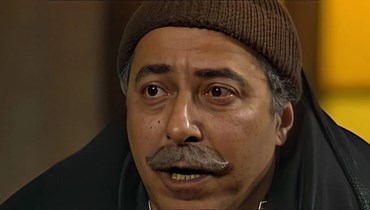أنهى الأستاذ جهاد الزين مقاله عن "المؤامرة التي تخدم الديموقراطية" ("قضايا النهار" 2013/12/31) بتذكيرنا بقول منسوب للزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك: "العرب رهان خاسر". لا ندري ما إذا كان أتاتورك قال هذه العبارة أم لا جازمين ولا ندري في أي سياق قالها إذا كان قالها فعلاً.
تكرار هذا القول اليوم في سياق تحميل العرب أوزار كل أوضاعهم الماضية والحالية المؤسفة يجب ألاّ يمر دون محاولة إجابة وتوضيح ينظر في الرأي الآخر وإن كان لا يتفق معه بالضرورة.
علينا أيضا التذكير أنه إذا كان أتاتورك قد قال تلك العبارة فعلاً فانه قالها حينما كانت أوروبا تقبل مجبرة، بسبب تحالفه مع روسيا البلشفية، باستقلال تركيا بعد الحرب العالمية الأولى ضمن شروط منها ألاّ تتعاون القيادة القومية التركية المنتصرة في حرب الاستقلال مع عرب سوريا والعراق الذين دعتهم إلى جهاد (نعم جهاد: وعندي من الوثائق ما يثبت ذلك) مشترك ضد الاستعمار في مرحلة نضالها الاستقلالي بين 1919-1923.
للأمانة ولضرورات السياق العام أعيد هنا الجملة ما قبل الأخيرة التي جعلت الأستاذ جهاد يتوصل إلى ضرورة تكرار القول المنسوب لأتاتورك: "... بعد التجربة الوخيمة للسياسة الخارجية التركية في العالم العربي يجب أن نتوقع موجة جديدة من "إعطاء الظهر" للعرب "وتكريس الانفتاح على الشعوب التركية ( في آسيا الوسطى والقوقاز) وأوروبا". أفترض أن هذا الاستنتاج السياسي جاء على خلفية ما جرى طوال السنوات الثلاث الماضية بعد اندلاع الثورات العربية، خاصة في سوريا وتداعياته على الوضع التركي. لقد كان "حزب العدالة والتنمية" بقيادة رجب طيب أردوغان واضحا في أنه حزب إسلامي في جمهورية علمانية. وعندما قال هذا الكلام صراحة في القاهرة انقلب الإخوان المسلمون على صداقته وعلى نموذجه. أما بالنسبة لسياساته تجاه الدول العربية عموماً والتي يقول الأستاذ الزين إنها "ساهمت بتدمير أهم هذه الدول وهي سوريا منذ فتحت حدودها لعسكرة الثورة المدنية في ذلك البلد". فعلى الرغم من موافقتنا على أن أردوغان ارتكب أخطاء في سياساته الداخلية التركية، فإن الكاتب يقفز فوق حقيقة أن الذي عسكر الثورة المدنية في سوريا لم يكن الجار التركي، بل النظام نفسه وحلفاؤه في إيران والعراق ولبنان الذين سارعوا بإرسال السلاح والعديد والعتاد إلى الداخل السوري لتعديل مسار الثورة السلمي ولحرف طبيعة الصراع وتحويله صراعاً طائفياً ومذهبياً لتغيير ميزان القوى على الأرض.
قام هؤلاء بإفراغ السجون من القتلة والمجرمين وتحويلهم عبر الترغيب والترهيب والتسليح إلى منظمات إسلاموية تكفيرية مزيفة على مقاس النظام وسياساته لإدخال الرعب إلى نفوس الأقليات كي تنحاز من موقع المتفرج المحايد إلى موقع المشارك الفعال في الثورة المضادة. منذ البداية كان رد فعل أنقرة، مثلاً، في حزيران 2012 على إسقاط إحدى طائراتها الحربية ومقتل طياريها قرب حدودها الجنوبية الغربية خافتا ليس لأن أنقرة ضعيفة عسكرياً، بل لأن ضغوطات واشنطن وموسكو عليها كي لا تتدخل عسكرياً كانت غلابة. وإلا كيف نفهم أن تقف أنقرة، عضو حلف شمال الأطلسي، موقف المتفرج على قصف المناطق المدنية القريبة من الحدود التركية الجنوبية بالبراميل المتفجرة دون أن تنبس بكلمة وتقصر مساعداتها، في الغالب، للاجئين السوريين على الخيام والاغطية وأرغفة الخبز؟ كان الغرب هو الذي خذل تركيا والعرب على حد سواء. كان الرهان على العرب والسوريين على وجه التحديد من رجال ونساء وأطفال رابحاً لأنهم قدموا بالفعل عشرات الآلاف من الشهداء على مدى سنوات.
عود على بدء
هذا على الجانب السياسي. أما السبب الثقافي-السياسي الأهم والأعمق مدى فهو افشال الغرب نفسه افكاره خارج حدوده: كان ما سمي بعصر النهضة العربية أي عصر الانتباه العربي للأفكار والممارسات الأوروبية الحديثة أيضا عصر مكر الغرب مكراً هائلاً في جانبيه الثقافي والسياسي معاً.
منذ البدايات :نزلت الحملة الفرنسية إلى الشاطئ المصري يقودها ضباط شباب لوحت بشرتهم شمس الثورة الفرنسية القائلة بالحرية والمساواة والإخاء حيث طفقوا يبشرون المصريين بأن أبناء فولتير وروسو مسلمون صحيحو الإسلام عكس المماليك الذين لا بد من ا لقضاء على تجاوزاتهم. لم تمر سوى سنتين إلا وكان هؤلاء الضباط أنفسهم يؤججون الصراع الطائفي في ارض الكنانة بتأليف فرقة عسكرية من الأقباط بقيادة المعلم يعقوب لمحاربة المسلمين المصريين.
قالت أوروبا للدولة العثمانية: "عليكِ التوقف عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأخذ بالقوانين الوضعية الأوروبية التي تضمن المواطنة والمساواة بين الجميع بغض النظر عن العرق أو الدين". قد يكون سلاطين آل عثمان وافقوا على مضض وتحت الضغط. لكن عندما بدأوا بتطبيق المواطنة والمساواة رفعت أوروبا البطاقة الحمراء وطالبت بالاستمرار بنظام الامتيازات الأجنبية وإمتيازات نظام الملل. وهكذا حل نظام حقوقي هجين لا هو أوروبي حديث ولا هو إسلامي أصيل في الدولة العثمانية منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى اليوم في الكثير من بلداننا.
حتى الإمام محمد عبده الذي مثل الحركة السلفية الاصلاحية الاسلامية (ثم الشيخ رشيد رضا الذي يُقال بأنه كان المؤسس الفكري لحركة الأخوان المسلمين) شدد في بداية حياته الفكرية على أن الخروج من فكرة الاستعباد هو فكرة أوروبية محضة، ولم يربطها بالشورى الإسلامية مثلاً. في سلسلة مقالاته عن الموضوع المذكور قبل الحرب العالمية الأولى تحدث عن "منافع الأوروبيين ومضارهم في الشرق". عندما نقرأ هذه المقالات نقرأ عما وجده من منافعهم دون ذكر لأي شيء عن مضارهم حينها. لكن نظرته تغيرت بعد أن وعى أن القارة الاستعمارية تعتقد اننا جديرون بالقبول بسياساتها الخارجية الفوقية لا بأفكارها الداخلية التنويرية.
من النهضة إلى النكبة
ما إن بدأ الشرق العربي بالتحديث الثقافي والإداري والعسكري على المثال الأوروبي حتى بدأت قارة الأنوار تنسج لنا خيوط المشروع الصهيوني الذي انتهى بنا إلى النكبة ثم إلى نكبات مستمرة إذ اختار حداثيو العالم الغربي تدفعينا ثمن إساءاتهم العنصرية في أوروبا نفسها قبل الحرب العالمية الأولى ثم بعد "المحرقة اليهودية" في الحرب العالمية الثانية. على اثر المقاومة للاستعمار قامت فرنسا بإهداء إسرائيل المفاعل الذري في ديمونا وما زالت ألمانيا (التي أُعجبنا بوحدتها مرتين) تكفر عن عنصريتها ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية بسياسة عنصرية مشابهة اليوم ضد العرب إذ تبني للكيان الصهيوني الأقوى والأشرس في المنطقة، مجانًا وبدون مقابل، غواصات تستطيع حمل القوة النووية تلك إلى أي مكان في العالم العربي. انتهجت أوروبا وما زالت تنتهج هذه السياسة لا من موقع سياسي استراتيجي فحسب، بل من موقع ثقافي أيضاً أخذ يتحدث منذ منتصف القرن السابق عن وحدة الحضارة المسيحية – اليهودية مؤسسةً بصورة مواربة لنظرية صراع الحضارات، أي أن أوروبا الثقافية- السياسية خانت قيمها الحديثة مرتين: مرة مع أقليتها اليهودية ومرة ثانية مع العرب ثم انطلقت في شراكة مع العالم الجديد في عدوان ثلاثي أميركي- أوروبي- إسرائيلي مستمر لا يمل ولا يكل على كل شبهة نهضة وطنية أو قومية مهما كانت شعاراتها وبرامجها لا فرق إذا كانت علمانية أو إسلامية.
على الرغم من ذلك كله فان البعض مثل الصديق الدكتور خالد زيادة يرى في كتابه الجديد ("لم يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب"، دار شرق الكتاب، 2013): "أن ما يجري حالياَ لا يتشابه مع الماضي فالتحرر المطروح اليوم ليس من الاستعمار وإنما من الأنظمة الأحادية وفي الوقت الذي لم تعد أوروبا مصدراً لأفكار كبرى ولم يعد لديها ما تقدمه للعرب. فالثورات في العالم العربي الراهن لا تدفعها الأفكار الكبرى وإنما تدفعها قضايا العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية كحقائق إنسانية شاملة". نتفق مع هذا الرأي، لكننا نزيد أن الأنظمة الأحادية كانت عادة متحالفة ولو من وراء ستار مع أوروبا الاستعمارية. كما أن أوروبا المستنيرة ساهمت في السابق في نشر الحقائق الإنسانية الشاملة. لكن هذا لا ينفي التناقض بين ما رآه المثقفون العرب في باريس ولندن من ايجابيات أوروبا في أوروبا: عدالتها وإنسانيتها وعلومها وحرياتها وبين ما خبره الذين رأوا أوروبا اللاأوروبية في آسيا وأفريقيا باستعمارها ولا عدالتها وتسلطها ونفاقها.
ومن شبه المؤكد أن مسألة الجوار العربي- الأوروبي والتاريخ العربي- الأوروبي المتداخل لقرون طويلة كان نقمة أكثر منها نعمة. وهذا قد يفسر، جزئياَ على الأقل، افتراق مسار تاريخنا الحديث عن تاريخ اليابان وبقية بلدان الشرق الأقصى. وحتى لا نُبرأ أنفسنا دون وجه حق لا يبقى لنا اليوم بعد أن وصلنا إلى استنتاج بأنه لم يعد لأوروبا ما تقدمه لنا من دروس سياسية سوى النفاق والإستغلال إلا أن نختار الطريق الأصعب ونصر على السير على طريق حضارة الغرب الحديثة على الرغم من الغرب وليس بسببه ولا بمعونته. فلقد حاربنا وسيستمر في محاربتنا في حال الإصرار على هذا الخيار لأنه لا يريد لنا سوى موقع دوني في عالم يسيطر هو عليه ويأمر فيه ليطاع. وما عدا هذا تفاصيل وهوامش على دفتر التاريخ الحديث.
مؤرخ واستاذ جامعي


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية