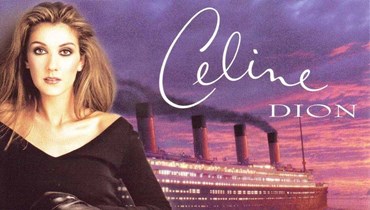أكثر ما لفت نظري خلال زيارتي السودان قبل عشرين عاماً فلسفة "غياب الساعة". ففي الثقافة المحلية، تحدد توقيت أي لقاء ظروفه، لا ساعته. فالزائر لا يتصل مسبقاً، ويحدد موعداً، بل "يسيّر" عليك عندما يشعر بأنه مشتاق لرؤيتك، أو بحاجة لمحادثتك، أو لشرب الشاي أو تناول الطعام معك. وبابك مفتوح على الدوام، يدخل ضيفك الذي تعرفه أو لا تعرفه، فيجلس في الفناء أو الصالون، ويتناول الكركديه أو الشاي أو الماء، وما تيسر من طعام. لا تسأله عن سبب زيارته، بل تنخرط معه في أحاديث الساعة حتى يبلغك بما يريد، أو يودعك ويرحل.
المواعيد السّودانية
ولأني صحافي، مرافق لوفد رأسه الأمير محمد الفيصل (رحمه الله)، لحضور اجتماعات مجلس إدارة "بنك فيصل" السوداني السنوية، ولأني ما زلت أؤمن بترتيب المواعيد، فقد طلبت من أحد مسؤولي البنك تنسيق لقاءات مع المسؤولين وقادة الأحزاب السياسية، لإعداد ملف نشرته على حلقات صحيفة "المدينة" التي عملت مديراً لتحريرها.
كان الترتيب باليوم لا بالساعة، فغدا نمر على زعيم "حزب الأمة"، ورئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، في الصباح، ثم ننتقل الى مرشد "السجادة الختمية" وزعيم "الحزب الاتحادي الديموقراطي"، محمد عثمان ميرغني، بعده، ربما ظهراً، أو بعد الظهر. وفي العصر نزور الخارجية أو قصر الرئاسة، وبين بين، نعدي على القاضي أو المحامي أو شيخ الطريقة. لم يكن هناك وقت محدد لكل اجتماع، فبحسب مجرى الأحاديث، وبحسب الظروف، يطول الكلام أو يقصر. فالوقت مفتوح، والقضايا مكررة.
"تغريباً"
لاحظت أيضاً كثرة استخدام الناس لكلمة "تقريباً" (وتنطق على الطريقة السودانية بحرف الغين "تغريباً"). فمثلاً، سيمرك "الزول" بعد الفطور، تقريباً. ويتصل بك بعد العشاء، تقريباً. وتواريخ الحوادث الفاصلة في تاريخ السودان تقريبية، وحتى موازنة البنك السنوية التي يفترض أن تكون أرقاماً محددة، يحتاط المحاسب العام فينهي تقريره، بـ"تقريباً".
والعلاقات بين رموز الطبقة الحاكمة والمعارضة "تقريبية" هي الأخرى. فالزعيم الإسلامي حسن الترابي، زعيم "المؤتمر الشعبي"، ومعلم وملهم الرئيس عمر البشير، كان في السجن حينها، وكان يزوره خصمه السياسي، الصادق المهدي، ويحضر له الطعام الذي أعدته شقيقته (وصال المهدي، زوجة الترابي). ويقضيان الساعات في الأحاديث السياسية والعائلية والعامة. الخلافات السياسية في السودان الصوفي تغلب عليها السماحة، لا العنف ولا التصفيات الدموية.
البيوت والقلوب المفتوحة
وتلك الرموز وغيرها من القيادات السياسية والعسكرية تمضي في حياتها اليومية من دون حراسات، فمنازلها، كبيرة وصغيرة، مفتوحة، ليلاً ونهاراً، كعامة الناس. وهي غالباً شقق وبيوت وفلل لا يمكن وصفها بالفاخرة. وهم يتنقلون بين أحياء الخرطوم مشياً أو بمركبة التوكتوك "الركشة الهندية"، أو بسيارات خاصة لعلية القوم، لا تزيد عن سيارة تويوتا كامري للوزير، أو جيب لاندركروز للجنرال. فالمساحة بين صاحب المنصب والمواطن، بين المدير والخفير، بين السياسي والصحافي، تقريبية هي الأخرى.
تراهم يجلسون على بساط واحد، الى سفرة واحدة يفترشونها على النيل، أو في أحواش البيوت والمزارع وأسطحها. وبغض النظر عن التوجهات السياسية والفكرية لـ"ناس السودان"، وبعد كل نقاش صاخب ومناظرة حادة الاختلاف، ينتهي كل شيء فجأة عندما يدعو المستضيف الجمع الى مائدة الطعام، أو يقف شاعر صوفي ليلقي مدائحه النبوية، أو منشد ليصدح بقصائد عربية فصيحة أو يغني باللهجة المحلية. وفي نهاية اللقاء يودع الناس بعضهم بعضاً بالأحضان. وقد يتواعدون على لقاء اليوم التالي في مجلس ما، أو مقهى أو عزاء شهيد (من ضحايا الحرب مع الانفصاليين الجنوبيين)، أو حفل زواج أو مولد نبوي. والمواعيد في كل الأحوال "تقريبية" تقدر بمطالع الشمس وزوالها وغروبها.
ساعة المستعمر
سألتهم عن سر غياب الساعة في بيوتهم ومكاتبهم، وحتى معاصمهم، فسألوني بدورهم عن أهميتها. وقادنا الحوار الفلسفي الى رأيين: رأي شاركني فيه بعض المصرفيين والمهنيين والمغتربين بأهمية الدقة في ضبط المواعيد والأرقام، كحضور الدوام وبرامج الأعمال وجداول الدراسة، ومواعيد وصول الرحلات الجوية ومغادرتها، ورأي آخر يرى أن الحياة أوسع من أن نضيّقها بالقيود. فأوقات الصلاة مثلاً، حددت شرعاً بحركة الشمس، والشهور العربية والتقويم الإسلامي بحركة القمر. ولم يدخل التوقيت بالساعة والدقيقة والثانية في هذا وذاك إلا مع المستعمر، الذي استعبد الشعوب بمخترعاته وآلاته، واسلحته العسكرية والمدنية (ومنها الساعة)!
عشرون عاماً مضت، وما زالت التقريبية في حياة السودان حاكمة. فمنذ غادر المستعمر، الذي كان يضبط إيقاع الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية، قامت حكومات وأحزاب ورحلت. ونجحت انقلابات عسكرية وفشلت. وتناوب على الحكم في البلاد المدنيون والعسكريون، اليساريون والإسلاميون، الديموقراطيون والمحافظون. حاربت جميعها عقوداً لتوحيد البلاد بشمالها العربي وجنوبها الأفريقي، بشرقها البحري وغربها القبلي. وأهملت كلها خطط التنمية والبناء. فعاشت البلاد على النفط والذهب والرعي وتحويلات المغتربين والمساعدات الخارجية. وبدلاً من أن يحولها النيلان الأبيض والأزرق سلة غذاء العالم العربي، أغرقت الفيضانات الموسمية المدن والقرى والمزارع البدائية.
الفروق الغائمة
لا مسافة تُذكر بين حكم وحكم، ولا تواريخ مفصلية تنسب إليها تحولات عظيمة، ولا فارق حقيقياً في تقديري بين عسكري ومدني، يساري ويميني، حزبي ومستقل، فالكل نتاج ثقافة شعبية أزلية، يسودها الإحساس بأن الزمن لا نهائي، والخيارات مفتوحة، والمواقف سيالة، والمراحل متداخلة. الشعب يريد الشيء نفسه. والطبقة الحاكمة والمتعلمة، ليست على عجلة من أمرها لتحقيق أبسط مطالبه.
فسقف المطالب يخفضه الزهد وتحدده القناعة، وهي اليوم، لا تزيد عن توافر الخدمات العامة والمتطلبات الحياتية وفرص العمل للجميع والتمكين للمرأة والشباب. أي باختصار العودة الى ما كان عليه السودان في الخمسينات. أما "الهياط" السياسي المتعلق بالتشريع، والتطبيع، والتوجهات الفكرية، والعلاقات الدولية، فيكاد يكون "علكة" النخب، يشغلون بها أنفسهم وأتباعهم عن المطالب الحقيقية، والخطط التنموية، والمشاريع المستقبلية. ويفسرون بها فشل الإدارة في توفير أبسط مقومات الحياة، ويستخدمونها مراكبَ للوصول الى السلطة، والاستفراد بها، وتحقيق الطموحات الشخصية.
منجزات الثّوار
سبعون عاماً "تقريباً" منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1956، وما زالت أقصى طموحات السوداني العودة الى ما كان عليه عندما كانت الخرطوم من أبرز العواصم العربية والأفريقية تمدناً وتطوراً وديموقراطية. وعندما كانت جامعاتها ومستشفياتها ومحاكمها ومزارعها ومطاراتها وموانئها وسككها الحديدية تقاس بالمدن الأوروبية. وعندما كانت أحزابها ونقاباتها وصحافتها في أعلى مدارج الوعي والحرية والديموقراطية.
خرج المستعمر بساعة "بيغ بن" التي وقتت مشاريعه التنموية، وجاء أصحاب العمائم والجلابيب، القبعات والطواقي والبيريهات العسكرية، بلا ساعات ولا تقاويم، بلا برامج ولا استراتيجيات، ليتناوبوا على الحكم والإدارة، الفكر والهرطقة، الأهازيج والشعارات. وليخرج كل منهم كما دخل، بلا إنجاز ولا بصمة، ولا رصيد إلا في حسابه البنكي.
عودة المستقبل
ولعل أكثر وأعظم ثروات السودان، الثروة البشرية، وأعظم منتجاتها وصادراتها هم نخب المفكرين والعلماء والمهنيين الذين هاجروا الى مشارق الأرض ومغاربها، فأسهموا في بناء البلدان وتعليم الشعوب. وهذه العقول والخبرات والمواهب هي أيضاً أكبر خسائر بلد النيلين. فما عدا تحويلات المغتربين لأسرهم وأقاربهم، حرمت البلاد من تلك الروافع المليونية (وهي ملايين حقيقية وليست تقريبية أو وهمية كملونيات المعارضة!) التي كان بإمكانها إعادة السودان العظيم الى مكانته التاريخية ومكانه الحضاري ومقعده المستقبلي في قطار التنمية والتطور والرخاء.
وحتى نخرج من الدائرة الزمنية المغلقة، ولا نغني مع فيروز "يا داره دوري فينا، ضلي دوري فينا"، المطلوب عودة المغترب بعلمه واستثماراته و"ساعته"، وتنحي الطبقة الحاكمة بفسادها وسوء إدارتها، وتسليم القيادة والإدارة الى جيل طموح بلا "دروشة" و"تمهل" و"تواضع". ومن دون ذلك لن نخرج من دائرة الساعة الرملية التي تستجر الماضي لحساب الحاضر، الى دائرة الساعة الرقمية التي ترصد الحاضر لتنشد المستقبل.
نُشر على "النهار العربي"


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية