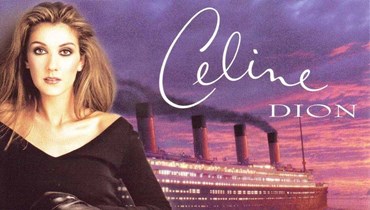خالد باطرفي
بعنوان، "تويتر"... السيد الرئيس، كتب خالد باطرفي في "النهار العربي": بكبسة زر ألغت كبرى شركات التواصل الاجتماعي الأميركية حسابات رئيس أقوى دولة في العالم، بعدما راقبته فترة، وحذّرت من بعض تغريداته، وعلقت على بعضها. أي أنها وضعت نفسها قاضياً وجلاداً في محكمة الرأي العام، ومقنناً لحرية التعبير.
هذا الترسيم الذاتي لمديري شركات تجارية لم ينتخبهم أحد، أثار جدلاً حاداً في بلد يشهد انقساماً أكثر حدة. فمن يؤيد الرئيس الذي صوّت له 70 مليون أميركي، ويتبع حسابه 88 مليون متابع، وأولئك الذين يؤمنون بحرية الرأي والتعبير في أقوى ديموقراطية على وجه الأرض، وأكثر مصدّر لها ومدافع عنها في العالم، يعارضون هذا التقنين ويخشون هذه السلطة أياً كانت المبرارات الآنية. ومن يعارضون الرئيس ويخشون تأثيره الضار في الرأي العام، وتأجيجه المشاعر المتطرفة التي أدت الى اقتحام مبنى الكونغرس، يؤيدون التحجيم ويجدون له العذر في الظرف الآني، وإن كانوا لم يعلنوا تأييدهم أو معارضتهم لاستمرار ذلك وشموليته مستقبلاً.
الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، فبمجرد إعلان ترامب أنه يتفاوض مع منصات أخرى أكثر انفتاحاً على آرائه وأقل تكميماً للأفواه، مثل "برالر"، وترحيب تلك المنصات باستضافة حسابه بلا قيود على ما يغرد به، وما لوّح به من مشاريع لإنشاء منصات جديدة، أعلنت "غوغل" و"أبل" أنهما سيلغيان تطبيقات هذه المنصات من متاجر برامجهما "غوغل بلاي" و"أبل ستور"، وتحظرهما من العمل على أجهزتها.
إذاً هي الرقابة الإعلامية! ففي بلد تفاخر منذ تأسيسه بسوقه المفتوح للرأي والأفكار، مهما تباينت واستغربت ورُفضت، واعتبرت الصحافة عين الشعب على الحكومة، وثبتت حرية التعبير في دستورها، نسمع ونرى آراء لنخبة الساسة والأكاديميين والمثقفين تطالب بحرمان هذه المزايا على من لا يستحق. ولو قبل المعارضون بهذا التقييد، فستبقى مشكلة تحديد المستحق، ومن يملك حق التحديد. وسيلحق بذلك سؤال عن الناخبين. فإذا كان هناك من لا يحق له تشكيل رأيه والتعبير عنه، فهل سيمتد ذلك الى حقه في الترشح لمنصب عام أو التصويت لمن يمثل رأيه؟
الإجابة عن ذلك ستعني الفرق بين ديموقراطية واشنطن وديموقراطية الملالي، بين حقوق المواطن والناخب الأميركي وحقوق نظيره العربي. فكم حاضرت فينا النخب الأميركية عن الحرية المطلقة في التعبير والأحزاب والبرامج الانتخابية مهما صادمت القيم المحلية، والعقائد الدينية، وقادت الى التطرف والعنف والصدام مع السائد والمألوف. فهل آن الأوان لنحاضر فيها نحن عن خطورة ذلك على القيم الأميركية ومستقبل الديموقراطية والسلم الاجتماعي؟ أم أن الولي الفقيه والرئيس الأبدي سيتقويان بالموقف الأميركي في شرعنة فلترة الأحزاب والمرشحين وبرامجهم ومنصاتهم وخطابهم السياسي والعقدي والاجتماعي؟ وكيف ستواجه أميركا مبدأ الحزب الواحد والعقيدة الواحدة في الصين، وفرضهما على النظام المختلف في هونغ كونغ، إذا كانت هي ستحكم بالمبدأ نفسه؟
لست مؤيداً لترامب، ولا أقر خطابه العنصري والتحريضي، ولا تمسّكه بالسلطة ورفضه للهزيمة، ولكنني أرى أن الكل في ذلك سواء. فالحزب الديموقراطي رفض فوز الرئيس الجمهوري وعمل منذ اليوم الأول على عزله ومقاضاته ومحاربته حتى الأسبوع الأخير من ولايته بالاتفاق مع الإعلام الليبرالي واليساري الأميركي والغربي. كما مارس أسلوبه نفسه في الكذب والتحريض، وصنفه عنصرياً وأيديولوجياً وألّب عليه السود والأقليات، ورفض الاعتراف بأي من إنجازاته الاقتصادية لمصلحة كل هذه الفئات، وكونه الرئيس الوحيد في التاريخ الأميركي الذي لم ينخرط في حروب دولية، بل عمل على إنهائها، وواجه إرهاب الدولة (إيران) والميليشوي، (داعش والقاعدة و"حزب الله")، وقضى على عدد من أخطر إرهابيي العالم، مثل أبو بكر البغدادي وقاسم سليماني.
وعندما ارتكب ثوار "حياة السود مهمة" جرائم مدنية، منتصف العام الماضي، أدت الى حرق وتخريب ومقتل رجال شرطة، وحوصر البيت الأبيض وحاول المتظاهرون اقتحامه، طالب الديموقراطيون رجال الأمن بضبط النفس، وعارضوا الاستعانة بالحرس الوطني، ووقفوا ضد محاكمة المخربين. ولم يكتفوا بعدم معارضة التحريض الإعلامي ضد الرئيس ورجال الشرطة، بل شاركوا فيه. ولم يطالبوا الجماهير بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، كما انتقدوا التجمعات الانتخابية للرئيس والمتظاهرين من أتباعه.
وقتها لم تمارس إدارة "السيد الرئيس" في "تويتر" و"فايسبوك" و"إنستغرام" صلاحيات الحجب لآراء أتباع منظمات إرهابية مثل "انتيفا"، ولقيادات يسارية وعنصرية وأيديولوجية متطرفة تنادي بخفض ميزانيات أجهزة الشرطة، وتحجيم دورها، وإعادة تأهيلها، أو إلغائها تماماً. ولا تلك التي نادت بحرق مقار الشرطة وهدم التماثيل والرموز التاريخية، ومهاجمة مقار حكومية، وغلق الشوارع، ومواجهة رجال الأمن بالقنابل الحارقة.
وفي الوقت الذي يسمح "السيد الرئيس" لشركات التواصل الاجتماعي بمهاجمة ترامب والمطالبة بمحاكمته وتجريمه وعزله، تمسح تغريداته التي يفسر بها موقفه، ويدافع فيها عن نفسه، وحتى تلك التي يشجب فيها عنف المتظاهرين ويطالبهم بالعودة الى بيوتهم.
إذا لم يكن هذا هو الكيل بمكيالين، والتحيّز مع الآراء المختلفة وضدها، والتحكم من دون تفويض في الجدل الفكري السائد، فماذا يكون؟
الخطورة هنا في تكريس الاستقطاب والانقسام وتحوّل ردود الفعل من التعبير السلمي عن الرأي الى ما هو أخطر. وأميركا التي تبيع السلاح من دون حتى الالتزام بقيود العمر لبيع السجائر والخمور والأفلام الإباحية، قد تسلك الطريق نفسه الذي سلكته في منتصف القرن التاسع عشر وأدى الى الحرب الأهلية.
يبدو أن الإعلام الأميركي، والغربي عموماً، استعرب أكثر من العرب. فعلى الأقل، لدينا الرأي والرأي الآخر، فهناك "الجزيرة" و"الميادين" و"المنار"، وهناك "العربية" و"سكاي نيوز" و"المجد". وعلى منصات التواصل الاجتماعي والمدونات يمكنك أن تتابع وتشارك في الآراء المعبرة عن كل المحاور والاتجاهات والأطياف، بلا قيد ولا رقيب.
وعلى الأقل عندنا إعلام بألف رئيس، ولا يستطيع أي منهم أن يدّعي أنه "السّيد الرئيس"!


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية