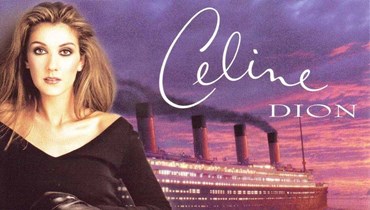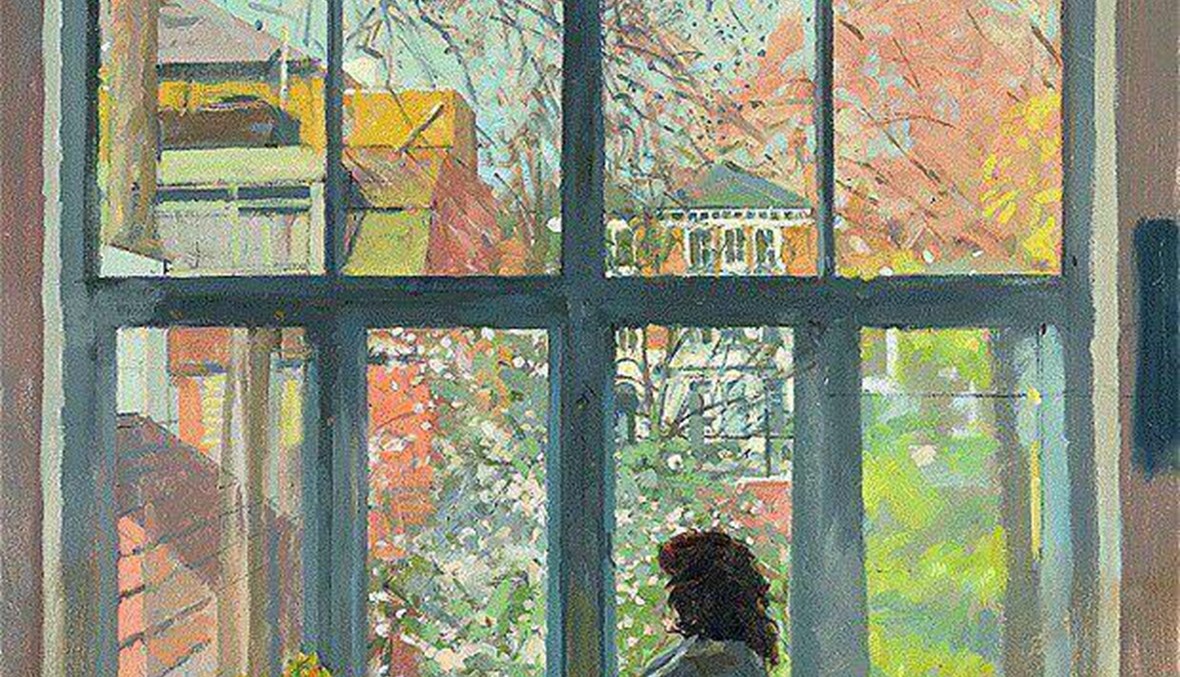(تحيّة لروح جدّي)
وأخيرًا، ها هي العائلة مجتمعة حول مائدة الغداء – وذلك بفضل الحجْر المنزلي طبعًا – بعدما دأب الحاضرون، لسنوات عديدة خَلَت، على تناول الطعام كلٌّ على طريقته وبتوقيته الخاص... بعدما هدأت جلبة الملاعق في الصحون، انطلقت الأحاديث في شجونها، وجُلُّها منزعجٌ، متبرّمٌ، متشائمٌ، كئيب. ودار حوارٌ، واحتدم النقاش. واغتنم الأب فرصة انعقاد "الهيئة العامّة" للعائلة، ليلقيَ خطابًا، وَدَّ لو استطاع خوض غماره منذ أمدٍ بعيد.
- حسنًا، أنا أعترف. لم يكن لنا شيءٌ ممّا لديكم الآن... لم يكن لنا ألعابكم الكهربائية الجميلة، ولا اقتربنا يومًا من اكتناه ما تحملونه من أجهزةٍ ذكيّة، ولا حتى في الحلم. لا، لم يكن لنا شيءٌ ممّا لكم من الثياب القشيبة والأحذية الأنيقة اللمّاعة، لم يكن لنا من سياراتكم الفارهة، وعطوركم الثمينة، وساعاتكم البرّاقة، شيءٌ على الإطلاق. أما غرفكم المريحة الدافئة المجهزّة التي تحتوي العالم بأسره، فهذا ما لم يكن لِيخطُر لنا في بال... نعم أعترف بذلك، وبدون أدنى تردّد . ولكن دعوني أخبركم بما كان لنا.
وهنا ارتسمت الابتسامات الماكرة على الوجوه. تماسك الأب وتابع، فالفرصة لن تسنح كلّ يوم:
- أقول، كان لنا الكثير. لا، لا، لن أخبركم عمّا سبق وأخبركم به "أنيس فريحة" في كتابه "اِسمع يا رضا"، وجُلّه واقعيٌّ وصادق. فقد ترمونني بالرجعيّة والتخلّف.
فقاطعه "دجيمي" ابنه الأكبر "مرندحًا":
- "كِل شي عَم يِغلا ويزييييد. أَيْوا، زياد الرحباني!"
وكانت التفاتةٌ صارمةٌ أخمدت التّهريج في مهده. وتابع الأب:
- ليس هذا... إنّما سأخبركم بما لا تتوقّعون. سأخبركم بأنّنا – على فقرنا – كنّا سعداء، سعداء وكفى. فاحكموا أنتم في ما كان سبب سعادتنا!... وأنا اليوم وقد أوغلت في طورِ الكهولة، وفيما أسترجع ملامح من ماضٍ عبَر، تستوقفني محطاتٌ مضيئةٌ من الذكريات، وجُلّها راجعٌ إلى عهد الطفولة. ذلك الفردوس الصائِر إلى زوال كلّما طارت بنا السّنون، وتقدّمت بنا سُبُل الحضارة. قد يقول قائلٌ: إنّ الدماغ البشري يسارع إلى حذف الذكريات الحزينة من الوجدان كما تَحذف كرياتُ الدم الجراثيمَ المعادية، وهذا من تداعيات الإعجاز في عمليّة الخلق، ربّما. ولكن ما هَم. فلنُسَرَّ بما يطفو على صفحة الذات ولندعِ القعر يبتلعُ الأحزانَ ما شاء...
- لم تخبرنا بعد بما كان لديكم... (أردفت "ريم" ابنة السادسة عشر ربيعًا).
فاستدركت الأم قائلة:
- لنحتسِ القهوة في غرفة الجلوس. فحماسة والدكم واستفاضته في هذه المواضيع لا تتناسبُ مع وضعيّة الجلوس على هذه الكراسي الخشبيّة المتعِبة.
وانتقلت "الهيئة التأسيسيّة" إلى الصالون. وقبل أن يبقَّ المُحاضر بَحْصَته، تنفّس الحاضرون الصُّعداء.
- نعم ، "أثمنُ ما كان عندنا في الجبل، شيوخُنا المباركون"، والقول –كما لا تعرفون طبعًا– لفؤاد سليمان.
ولكنَّ دجيمي مهرّج العائلة تساءل بتعجّب:
- ومَن يكون هذا الآخر أيضًا؟
ردّ الأب بتهكّم:
- هذا الآخر يا ذكيّ هو الذي رسم "درب القمر" قبل أن يشرّفَه أصحابُك الأميركيّون ببضعةَ عشر عامًا.
فتنطّح صغير العائلة:
- وما دخلنا نحن بالشيوخ، فنحن مسيحيّون؟!
- يا حبيبي، يا قلبي، يا عيوني، شيوخنا تعني كبارنا. تعني جدودنا. جدودكم أنتم. أفهمت الآن؟
فسدّ الصغير فمه سدًّا هرمسيًّا، وانفجر الجميع بالضحك. وتابع الأب قائلاً:
- أنتم لم يتسنَّ لكم أن تترعرعوا وسط جدٍّ وجدّة، بحكم التطوّر الحضاري، وتوزّع السكن في شتّى أنحاء البلاد. أمّا نحن، فكان لنا ذلك. لقد ربينا في كنف شيوخنا المباركين أولئك.
وكانت إيماءةٌ صغيرة من الوالدة كافية لتجعل الأجهزة الذكيّة تُخلي أماكنها في الأيادي المنهمكة. فتابعَ الأب:
- كانت السنوات السبعة الأولى من طفولتي كافيةً لتضعَ جدّي لأمّي في موقع الصدارة في وجدان ذاك الطفل النّهم للحياة، الذي هو أنا. ذاك أنّ جدّي "الشيخ" كان فردًا أساسيًّا من أفراد العائلة. ومردُّ ذلك أنّني كنت عليلًا، دونما سبب يذكر، طيلة سنتي الأولى. ولمّا كنت الحفيد الأوّل، فقد تراكض الجدّ لمساعدة والديَّ في الاهتمام بي والتخفيف عنهما. ولا ينسى أبناء القرية ذلك الشعر الأشقر يلمع في رائعة النهار، متنزّهًا بين الحقول، محمولًا على كتفي جدّه "الشيخ" الذي يحدو له بأهزوجته المبتكرة: "يا جدّي، يا جدّي..."، ريثما يغفو. وما عتّمت أن تماثلتُ للشفاء ودونما سبب أيضًا. ولكنني كنت قد أٌصبت بداء التعلّق المَرَضيّ بذلك الجدّ الحنون. فأمسيتُ لا أدع فرصة للذهاب إليه إلّا اغتنمتها. وإن قلّت الفرص عمدت إلى التمارض، فيحضر جدّي سريعًا. وهكذا دواليك، حتى غدوت أُمضي الأسبوع مناصفةً بين بيتنا وبيته.
إذا كان البِكرُ أميرًا في كنفِ والديه، فإنّه بلا شكّ الملك المتوّج في منزل جدّيه. ألم يَقُلِ المثل: "ما أعزّ من الولد إلّا ولد الولد"؟ دعْكَ من الحَصانة التي يتمتّع بها، أسوةً بالوزراء والنّوّاب في بلداننا المتخلّفة. وإذا بالجداول قد تحطّمت كلّها؛ فلا مواقيت ثابتةً للطّعام أو للاغتسال أو للنوم، ولا سطوة للأهل، ولا هيبة أيضًا. إنّما الفوضى العارمة. والويلُ كلّ الوَيْل لمن يعترض على ذلك، فإنّ الجدّ لهُ بالمرصاد.
ولكن سرعان ما اكتشفت أنّ حنان جدّي لم يكن إلّا استنسابيًّا. وقد تكشّف لي وجهٌ آخر لهذا الجدّ الحنون. وما زلت أسائِل نفسي حتّى اليوم، ما الذي جمع ذلك الرّجل العاطفيّ، النّزِق، المتوتّر، السَّليط اللسان بزوجته البسيطة الهادئة المطمئنّة؟ ولكن لا جواب...
غير أنّ جدّي "الشيخ" كان يمتلك إلى جانب خفَّة الجسم وخفّة الحركة، خفّةً في الظلّ محبّبة، جعلت خطاياه -على كثرتها- تُمَّحى بسرعة قياسيّة لدى أهله ومعارفه، فتُبَيِّضَّ صفحته أكثر من الثّلج، أسوَةً بصاحب المزامير، ولكن من دون توبة.
سألته مرّةً: "ما شأنُكَ وجبل الشيخِ ذاك ، وكلاكما تحملان الاسم نفسه؟ فأجابني من دون أن يرفَّ له جَفنٌ: "يا جدّي كلّ شيخ له حصّته في هذا الجبل. وقبل أن يزورني عزرائيل ستكون حصّتي قد كُتبَت باسمك."
وإن أنسَ لا أنسَ يوم أغاظني خالي، ونحن نتناول طعام الفطور، فأخذت في البكاء. وإذا بجَدّي مُهرولًا من باب الحديقة، متوعِّدًا ابنه الوحيد، وفي يده مِنجلٌ يُلوّح به مردّدًا: "شو عملت بابن اختك يا ابن الكلب؟" فلاذ خالي بالفرار، هو الذي لم يكن يكبرني إلّا ببضع سنوات. نعم، لقد كنتُ نقطة ضعف جدّي، ممّا جعلني عامل وساطة بينه وبين أفراد عائلته فيما بعد.
والتفت الأب، فرأى عيون الحاضرين ساجية سارحة في الفراغ. فسُرَّ إذ أيقن أنّ حديثه قد أفلت العنان لخيال أبنائه، فراحوا يتمثّلون ذلك الجدَّ على حقيقته، مع حفيده. ويأسفون لعدم إمكانيّة تواصلهم هم أيضًا مع جدِّهم في قريته البعيدة... وتابع:
- نعم ، كان جَدّي مزارعًا. ولكن كيف أقول، لم تكن الزّراعة لترضيه. فكان يعتبر نفسه قد خُلِق لعملٍ أسمى. أمّا الوظيفة، فلم تكُن تتناسب مع شخصيّته الحُرّة المتفلِّتة من كلّ قيد وكلّ مسؤوليّة؛ ورغم ذلك خاض غِمارها. ولكنّه لم يصمُد. فعاد إلى حقله، يَشبع حينًا ويجوع أحيانًا، "فيُشَقِّع" في الدِّين.
فقال الصغير:
- شو يعني "يْشَقِّع" في الدِّين يا بابا؟
فغمزت الأم الأب، وعضَّت على شفتها السفلى. فتدارك وقال:
- يْصَلّي يا حبيبي، يْصَلّي.
وتابع متوجّهًا إلى بقيّة أبنائه:
- أراكم صامتين تُسَرّحون الخيال لتُدركوا ما أخبرتكم به... أمّا أنا فكنت أعيش كلّ ذلك حرفيًّا. وليس كما تعيشون اليوم مع أجهزتكم المحمولة، بعوالِمها الافتراضيّة الباردة، داخلَ غُرَفكم أو زنزاناتكم الاختياريّة، لا فرق. لقد عايشتُ كلّ ما تشاهدونه على شاشاتكم. رأيت الأفعى تبتلعُ الدّجاجة "البيّاضة" في الخمِّ قبل أن يُرديها جدّي؛ وذاك العزاء لِلجدّة الذي استمرَّ بضعة أيّام. كما سمعت جلَبَة الذئب يطفرُ بالجَدْيِ من فوق سور الحديقة. أمّا الثّعالب فقد اعتدنا على سماع جوقاتها السّمفونيّة على مقربة من آخر الدوّارة. أنتم اليوم تهرعون إلى اقتناء الكلاب والقطط، فتجعلوها على الأسِرّة وفي الأحضان، لا لشيء سوى لفيضٍ عاطفيّ عَقيم. أمّا نحن، فكانت الحاجة إلى الحماية ما دفعنا إلى ذلك. وكان محظورًا علينا بالتالي إدخالُها عتبات البيوت.
غير أنّهُ ذات فجرٍ، وقد أخلى جَدّي فراشَه متوجّهًا إلى عمله في الحقول، وكنت قد دأبتُ على النّوم بجانبه، برغم نصائح الجدّة لدواعٍ صحيّةٍ تزعمها، إلا أنّني تمنّعت. كان فراشنا ممدودًا على الأرض تحت النّافذة. في ذلك الصّباح الباكر، ارتقى هِرّان فاسقان عتبة الشّباك فوق رأسي تمامًا، وقد شاءا تصفية حسابٍ لهما قديم. فنشب العراك، وتقوّس الظّهران، وعلا مواءٌ أشبَهَ بالعُواء. وما هي إلّا لحظات حتى هوى الغريمان إلى الدّاخل، فأكملا المعركة فوق لحافي. ولَولا رحمة الله وصراخ الجدّة وانسحاب الغريمين اللدودين، لكنت بلّلت فِراشَ جَدّي بالدّموع، وبأشياء أخرى.
هذا غيضٌ من فيض ذكرياتي مع جدّي. أمّا والوضع في لبنان اليوم كما تعرفون، إذ قام مسؤولوه بسرقته فإفلاسه، من دون أن يرفَّ لهم جفن، فقد آن لي أن أكشفَ النّقاب عن حياة جدّي الليليّة، ما دامت كلمة "سرقة" قد حُذِفَت من قواميس القانون، لتحلّ مكانها كلمةُ "هدْر" في المال العام. لا، أرجو ألّا يُساءَ فهمي في ما قصدته من مشاريع ليليّة. فلئِن كان جدّي، وسيّما في شبابه، قِبلة أنظار "الفاضلات" من نساء القرية، فإنّ سنيّ العمر قد ذهبت بالمكارِم كلّها.
نعم ، كانت لجدّي مشاريعه الليليّة، ولكنّها كانت مشاريع من نوعٍ آخر...
إنّ أسوأ ما قد يُصاب به الإنسان لوثتان: لعب القمار، وحمّى البحث عن الكنوز، وكلتاهما تورِثان البطالة والفقر. وكان جدّي من روّاد الهواية الثانية. وهذا ما كان يفسّر ارتداء جدّتي الفقيرة لبعض الحُليّ، مثل الخواتم والأقراط والأساور، بين الحين والآخر. ولكنّ جَدّي لا يلبث أن يبيعها، ضاربًا برِضى "الشيخة" زوجته عرْضَ الحائط. فراحت هي الأخرى تسخط عليه شيئًا فشيئًا، وهي ترجو الله ألّا يضع أمامه سوى الأقلام. عَجبت لطِلْبتها تلك، ولما استوضحتُها أخبرتني حكاية "القلم الفينيقي"؛ وها أنا أنقلها على طريقتي، محاولًا استحضار المشهد المضحك المبكي:
في منتصف ليلة تشرينيّة غاب قمرها وادلهمّ ليلها، خرج من بيت جدّي ثلاثة أشباح تحت جنح الظلام، مدجّجين بما تيسَّرَ من المعاول والرّفوش والمصابيح، مُيَمّمينَ شطرَ الوادي. فهناك على تلّة صغيرة مطلّة على النهر، تقبع بضع خرائب، يقال إنّها تعود للإله "مرقُد"، وهو إلَه الرّقص عند الفينيقيّين. وقد ارتأى فريق الأشباح ذاك، وبعد رصدٍ مسبق للموقع وما يحتويه من الرّموز والإشارات، أن يُصارَ إلى إِحداث حفرة في نقطة معلومة عند أسفل الصخر الكبير. وهكذا كان. وبعد ساعتين من العمل المُضني، وصل "المنقّبون" إلى دهليز ضيّق، أودى بهم إلى حجرة واطئة قليلة الارتفاع محفورة في الصخر الأصمّ. هي حجرة الدّفنِ بِلا شك.
وهناك، على أرض الغرفة التي غمرتها إلى نصفها طبقة ناعمة من التّراب المُتَحلِّب مع مياه السّقف خلال مئات السّنين، تمدَّد ثلاثة هياكل عظميّة بشكل متوازٍ. وبوشِرَ العمل. جدّي يحفر التّراب بمعوَلٍ صغير، فيتفحّص المعاصم والأصابع والأعناق في الهياكل. ولكن عبثًا. لا أساور، لا خواتم ولا أقراط. فكلّ ما كان هناك هو عبارة عن بضعة مصابيح فخّارية عتيقة، وقمقم صغير من الزّجاج الشفاف.
وراح المعلِّم حنّا، رفيق جدّي، يغربلُ التّراب داخل المقبرة، عَلّه يجد شيئًا من مثل قرط أو قطع صغيرة من العملة المعدنيّة... ولكن، أيضًا لا شيء. وهنا راح جَدّي المُنهَك، وَبمشهدٍ سورياليٍّ فاقَ كلَّ تصوُّر، يَهوي بمطرقته الصّغيرة على الجماجم الرّاقِدة على رجاءِ القيامة، فتتطاير شظاياها في كلّ أرجاء المقبرة؛ مُتَوجِّهًا، وبشكلٍ شخصيٍّ، إلى صاحبِ كلّ جمجمةٍ بالقول: "كايِن فَقير مِتلنا يا أخو الهَيْك وِلـْ هَيْك"؟
وعند بزوغ الفجر، لَملمَ الخائبونَ عُدّتهم. وقبل أن يهمّوا بالخروج، وبين الأتربة، وجد جدّي أداةً مستطيلة قد غَشِيها الوحل المتراكم. عالجها قليلاً، فظهر ما يشبه القلم! فأحجمَ كي لا يتلفَ اللُقية الأثريّة، ريثما يعرضها على الشّاري المُرتقَب.
وفي طريق العودة، أثنى "الداشرون" على حضارةٍ عظيمةٍ، كان لها من التقدُّم أن اخترعَت أقلامها الخاصّة منذ آلاف السنين.
وأتى الشّاري بعد يومين، ملتفِعًا بجلبابٍ من السِّرّيّة والرَّيبة. وعندما عُرضت عليه الغلَّة الأثريّة، وفيها بضعة أضراس ضخمة، وقمقم من الزجاج والفخاريّات، والقلم المجيد، توجّه بغريزته نحو "القلم الفينيقيّ". فتح شنطة العدّة خاصّته، وأخذ يعالج القلمَ بمساحيق متنوّعة. وعندما انجلَت الأوساخ، راح يقهقه قائلاً: "روحو تْخَيَّبو، هيدا قلم فينيقي؟ هيدا باركِر مْصَدّي". ففغرَ جدّي فمه ضاربًا كفًّا بِكفّ. أمّا المُعلِّم "حنّا"، فقد عقدتِ الدّهشة لسانه، إذ عرف في "القلم الفينيقي" قلمَ الباركِر الفضّي الذي اشتراه منذ شهرين، من "بسْطة" الأشياء المستعملة في سوق النبطية؛ ولا بدَّ أن يكون قد سقط من جيبِ سترتهِ أثناء قيامه بِغربلةِ التّراب!
وأنهى الأب كلامه قائلاً:
- "شفتوهلّأ شو كان عنّا؟ قال أجهزة ذكيّة قال".
قالها مُبتهجًا، لأنّ أبناءه قد سافروا معه، ولأوَّل مرّة، في دُنيا الخيال. هذا الخيال الذي أطاحت به التكنولوجيا منذ أمدٍ بعيد. ولِكنَّ الأمَّ، وقد انتبهت فجأة لما كان يجري، وضعت يدها على فمِها محاولة إخفاء ضحكتها، إذ أيقنت أنّه فيما كانت الأجهزة الذكية ترقد على الأريكة بسلام، كانت السّمّاعات الصغيرة الـ"وايرلِس" ما تزال تصدح بالموسيقى داخل الآذان الطّويلة مغرقةً الأولاد في عالم التكنولوجيا بعيدًا عن رواية والدهم.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية