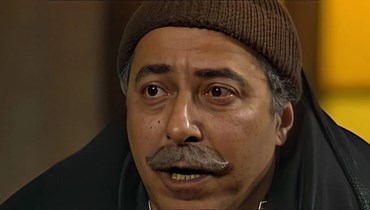موعد مع يوناس ميكاس في طيف سنواته الـ95: نعيش في حضارة مملّة!
يوناس ميكاس في الخامسة والتسعين اليوم. وأنت تجلس أمامه طوال أربعين دقيقة لتتأمل تفاصيل وجهه وهو يتحدّث، لا يمكن التغاضي عن حقيقة ان الزمن نحته ولم يترك فيه أي شيء خارج سطوته، بدءاً من صوته الذي يرتجف وصولاً إلى بطء حركته. سلسلة مشاعر متضاربة غمرتني وأنا انتظره في ردهة أحد الفنادق في لوكارنو، لينهي كلامه مع صحافي سبقني إلى لقائه. كنت ذهبتُ قبل نصف ساعة من الموعد المتفّق عليه وفي داخلي شعورٌ بالتوتر: فأمامي كلّ تاريخ سينما الأندرغراوند في رجل واحد. رجل، على الرغم من الشيخوخة، لا يزال يتنقّل إلى مناطق بعيدة من مكان اقامته ليقدّم فيلماً مقتبساً من سيرته، "لم يكن عندي مكان أذهب إليه"، اخراج دوغلاس غوردن، حيث يروي بصوته تفاصيل حياته في معسكرات الاعتقال النازية (مخيم ألمشورن). سيرة مؤلمة أوصلته إلى الولايات المتحّدة مهاجراً، عند نهاية الحرب العالمية الثانية.
ميكاس، الذي ارتبط اسمه بسلفادور دالي وآندي وارهول وآلن غينسبرغ، يقول عنه مارتن سكورسيزي إنه الرجل الذي أعطاه الرغبة في الاخراج، وهو نوعاً ما عرّاب جيل الستينات في أميركا، وربما أول من اشتغل على سينما اليوميات المصوّرة. في الآتي، لقاء خاص مع هذا المخرج الليتواني، الأب المؤسس لسينما الأندرغراوند النيويوركي. رجل لا يزال على عجلة دائمة، فهناك الكثير لم ينجزه بعد.
[[video source=youtube id=2aIol21yI78]]
* إلى عنصرَي النصّ والصوت، ما هي مساهمتك الفعلية في فيلم دوغلاس غوردن، "لم يكن عندي مكان أذهب اليه"؟
- هذا كلّ شيء. طُلب إليّ أن أطالع الكتاب بصوتي كي يسجّله، وهذا ما فعلته. ولم يكن عندي أدنى فكرة عمّا سيفعله بالتسجيل. ولكني كنت مأخوذاً بالفضول. هنا، في لوكارنو، شاهدتُ الفيلم للمرة الأولى، وأعتقد أن ما أتمّه غوردن جيد جداً.
* طوال مسيرتك السينمائية، اهتم بك العديد من السينمائيين، وهذه ليست المرة الأولى. ماذا يسعك أن تقول في هذا الاهتمام؟
- (ضحك). ليس عندي أي تعليق. أقوم فقط بما أشعر بأنني ملزم القيام به. لا أستغرب انكباب الآخرين عليّ، لأنني متعدد النشاط؛ فأنا أخرج الأفلام لكني أيضاً أعرضها بوتيرة يومية. تجدني متورطاً جداً في مسألة المحافظة على التراث الفيلمي. لقد كتبتُ أيضاً مقاربات نقدية للأفلام لسنوات مديدة، لذا كوني أنشط في هذه المجالات كلها، لمستُ أناساً مختلفين بطرق مختلفة. نتيجة هذا، يعرفني ناس كثر.
* "لم يكن عندي مكان أذهب إليه" ليس فيلم صور، إنه فيلم أصوات، من ضمنها صوتك الذي تروي به سيرتك الحافلة...
- في النهاية هو فيلم. لا يوجد فيلم يقتصر على الصور، هناك دائماً صوت. السينما أعقد من ذلك. في النهاية، ما هي الصورة؟ علامَ تقتصر؟ أيّ لون هو صورة! الشاشة السوداء صورة للسواد. والسواد يفعل فيك أشياء على المستوى الانفعالي. في حين ان الأحمر يفعل فيك شيئاً آخر. التشكيليون يعرفون ذلك جيداً. كلّ لون يستفز فيك شعوراً معيناً، ومثله الأصوات. للمناسبة، هل شاهدتَ العرض الصحافي للفيلم أو العرض الجماهيري؟ أسألك لأن العرض الجماهيري أقيم في صالة بائسة جداً، لا تصلح لمشاهدة فيلم. كانت تحتاج إلى المزيد من العتمة. يبدو ان المهرجان فعل كلّ شيء لتخريب الفيلم لكن الفيلم صمد. المخرج بذل جهداً لصناعته، ولكن على الذي يعرض أي فيلم أن يحبّ ما يعرضه ويقدّمه في صيغته الفضلى. إلاّ أن النحو الذي اقتُرح فيه الفيلم على الجمهور لم يكن مقبولاً (...).
نام جون بايك، المخرج الكوري، أنجز فيلماً كلّه أبيض. بياض نراه بوضوح تام، وما تراه في الفيلم هو تفاصيل العرض: الغبار الذي يتطاير أمام العدسة، تجاعيد الصورة، هناك الكثير من التفاصيل التي تبقي العينين مفتوحتين والذهن واعياً. ففيلم دوغلاس يعطيك المزيد من هذا. عظمة السينما هي في أنها تحملك من الأقصى إلى الأقصى.
[[video source=youtube id=_qj-LMIsM8c]]
* اليوم، بات الناس يشاهدون الأفلام بأيّ طريقة، حتى على هواتفهم المحمولة...
- لأنهم لا يكترثون. يريدون فقط الاطلاع على مجريات القصة. وهذا سهل الحصول عليه. خلال المشاهدة، هم يأكلون ويشربون ويلعّبون الأولاد. هذه طريقتهم لقتل الملل، إنه أحد أوجه الترفيه السائد. فنحن نعيش في حضارة مملّة جداً. لا يوجد شيء يفعله الناس. فهذه هي السينما عندههم.
* هل بدأت علاقتك بالسينما مبكراً؟
- لا. ترعرتُ في مزرعة تقع في قرية صغيرة. شاهدتُ أول فيلم في حياتي عندما كنت في الخامسة عشرة. لم تكن لدينا صالات سينما في القرية. ثم، بعد سنوات، عندما انتقلتُ من القرية إلى المدينة، لم أحظَ بعدد أكبر من الأفلام. كان في مقدوري مشاهدة خمسة أو ستة أفلام كلّ عام، لا أكثر.
* قلت مرة ان الحياة كانت مملة في القرية.
- (يحتدّ) أبداً. في القرية، لم تكن حياتنا مملّة. الحياة في المزرعة على قدر كبير من الثراء. كنّا نغني ونرقص وننخرط في الطبيعة. كنت أقصد أن الحياة المدينية في نيويورك هي المملة. على الناس أن يعودوا إلى حضن الطبيعة، ويأكلوا من حصادهم الزراعي ومن تربية المواشي. عوضاً من ذلك، تراهم يركضون إلى المدن. هذه تراجيديا الحضارة الحالية وكارثتها، كونها ترتكز على الثقافة المدينية. هنا في لوكارنو لديهم أجمل احاطة طبيعية. المطر والخضرة والجبال. المنطقة مزدهرة لأن فيها الكثير من السياحة. إلا أنهم، أكرر مرة جديدة، لا يكترثون إلى نوعية العرض. في أي حال يُعرض الفيلم في المهرجان، هذا آخر همّ عندهم؟ هذه هي الحضارة التي نعيش فيها. اني أشعر بخيبة أمل كبيرة.
[[video source=youtube id=n2sK_EuH_KU]]
* قلت مرة ان الحبكة غير ضرورية في الفيلم.
- أحياناً هي ضرورية. كما الحال عند هوميروس، اذ ينقل لنا التاريخ، حيث كلّ تفصيل له مكانه وأهميته لفهم تلك الحقبة. السينما لي هي كالشجرة التي عليها الكثير من الأغصان. الأفلام التي تهتم بالسرد أو أفلام الحركة، هذه نجدها على أغصان معينة. هناك أيضاً غصنٌ للسينما الشاعرية والوثائقي والسينما الاستقصائية. في بعض الأحيان، الحكاية أو الحبكة ضرورية جداً. اذا لم تتابع الحبكة في فيلم لهيتشكوك فلن تفهم أي شيء. ذلك ان كلّ شيء محسوب ومخطط بطريقة دقيقة. ما سيحصل بعد عشر دقائق مرتبط بما يحصل الآن. إذا توقفتَ عن المتابعة، فلن تفهم ماذا سيحصل لاحقاً. في فيلم شاعري، حيث لا وجود لقصّة، التتابع غير مهم. الأمر أشبه بأغنية تغنّيها للتعبير عن حماستك أو غبطتك. السرد شيء أفقي، فيه بداية ومنتصف ونهاية، وهو يسير من نقطة إلى أخرى بالغاً الذروة الدرامية. الأغنية تأخدك في احساس عمودي. طبعاً، هناك أنواع مختلفة من الغناء. خصوصاً في آسيا، هناك أغانٍ لا تنتهي، هذا على صعيد الشكل. فيلم دوغلاس غوردن سردي جداً لكن بنيته شاعرية. الكثير مما تراه متروك للمُشاهد كي يجد له التفسير، هناك فراغات كما الحال في أي قصيدة تطالعها فتكتشف فيها أشياء جديدة مع كلّ مطالعة. إنها نوع القصائد التي تورّطك. الرجل الذي نسمعه (أنا)، قرأ الكتاب والآن يتذكّر مقطعاً من هنا ومقطعاً من هناك. ليس ثمة كرونولوجيا. الفيلم يوفّر لك احساس السؤال ماذا يعني أن تكون شخصاً متشرّداً وتتهجر من بلدك وتتوجه إلى حيث لا يريدك أحد. هكذا كانت الأوضاع في أيامنا، وهكذا هي اليوم. إلا أن وضعنا كان أفضل بكثير، فمنظّمة اللاجئين التابعة للأمم المتحّدة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت تكترث لملايين اللاجئين في أوروبا. كانت ترسل إلينا ما نحتاجه وتهتم بنا جيداً. اليوم، هذا أمر مستحيل! لا يستطيع أحد أن يهتم بالجميع؛ إنها فوضى عارمة، فيترتّب على اللاجئين عيش تجارب مأسوية. حالياً، لا تستطيع حتى إرسال الاسعافات. تحاول أن تدعمهم بمواد غذائية، فتتعرض للقصف (ضحك). لم تكن هذه حالتنا بعد الحرب العالمية الثانية، طبعاً كنّا نعلم أن لا أحد يرغب بوجودنا، ولكن كان وضعنا أفضل بكثير.
* لو أنجزتَ الفيلم بنفسك، هل كنت لتنجزه بطريقة مختلفة جداً؟
- هذا فيلمه. لم أنوِ يوماً إنجاز فيلم عن سيرتي. كتبتُ مذكّراتي، وهذا يكفي. الفيلم فكرة غوردن، فكرة راودته بعد قراءة الكتاب. كانت له رؤية معينة، ونفّذها ضمنها. وأعتقد أنه فعلها بشكل جيد.
[[video source=youtube id=n2sK_EuH_KU]]
* كنتَ من الأوائل الذين أنجزوا افلاماً طويلة... ما هو مفهوم الوقت لديك في السينما؟
- الوقت هو المساحة التي تمتلكها لتطوير استنتاجك أو خلاصة القول. الفيلم هو "أورغانيزم" حيّ يأخد وقته ليتبلور. هناك حكّاؤون شاطرون وحكّاؤون بائدون. الشاطر يعرف كيف يمسك بخيوط الحكاية. كلّ شيء في الوجود يستوجب أن تكون له مساحته الزمنية. أحياناً تلجأ إلى الطول كي تقتحم قلب الأشياء وتتورّط قلباً وقالباً في ما تقوله. قصر الوقت لا يسعفك في بعض الظروف.
* بناءً علام تختار "جانر" الفيلم؟
- الموضوع هو الذي يملي عليّ الـ"جانر" الذي يجب أن أستخدمه. الموضوع الذي كان يدور في بالي أملى عليّ ذات مرة فيلماً من خمس ساعات. الفيلم كان عن سيرتي العائلية مع ما تنطوي من ولادات ونشوء. كانت ملحمة أسرية كاملة. لم يكن جائزاً طرح هذا بـ17 دقيقة. كان في حوزتي الكثير من المواد.
بعض الأفلام ذات الشكل السردي يضمر شاعرية. حتى كلاسيكيات دوفجنكو، "الأرض" مثلاً، فيها قصة وليس فيها قصة. هناك شيء من الفسيفساء يأخذ شكل قصيدة. تجد أن هذه القطعة ليست متصلة بقطعة أخرى إلا بالاحساس وليس بتوالي الحوادث. ترى أمثال دوفجنكو يبنون موزاييكاً. خذ هوميروس أو دانتي، هذان يرويان قصصاً عظيمة من خلال بنية ولغة شاعرية. عموماً، لا يوجد فصل واضح بين السردي وغير السردي. بل يوجد، إنما في حالات قصوى فقط، حيث من الواضح أنه لا قصة، بل تعبير بالغ عن شعور. في المقابل، هناك حالات قصوى نقيضة، حيث تتجلى بوضوح ذروة الرواية. في كلّ فنّ، نجد هذين الطرفين الأقصيين: في الأول احتفاء بالتجريد وفي الثاني تكريس للواقعية. في النهاية، نحن نتعاطى مع كاميرا، والكاميرا تصوّر ما يوجد أمامها، والضوء يدخل إليها.
[[video source=youtube id=MWLN2DcKSLc]]
* هل تأقلمتَ مع تقنيات التصوير الجديدة؟
- نعم. لا يمكننا العمل بسوى التقنيات الحديثة، فهذا المتوافر الآن. الشريط لا يزال موجوداً، وأعتقد أنه يجب الحفاظ عليه. على المتاحف أن تحتفظ بنسخ الأفلام المصوّرة بالشريط وتحتفط بآلات عرضها كذلك، ويجب عدم الاكتفاء بالنسخ الرقمية. أتمنى ألاّ يتم التفريط بهذا الارث الهائل. ما صُوِّر بالفيلم يجب أن يُعرض بالفيلم، وما صُوِّر بالديجيتال عليه أن يُعرض بالديجيتال. كما الحال في الفنّ التشكيلي. طبعاً، هناك كتب للرسوم واللوحات، ولكن إذا أردتَ التحديق إلى لوحة لجيوتّو أو أيّ رسّام آخر، فعليك أن تذهب إلى المتحف وتتأمل النسخة الأصلية. الكتاب يعطيك فكرة، ولكن ليس كتجربة ملاقاة اللوحة الأصلية.
* ما الذي بقي من سينما الأندرغراوند اليوم التي كنت أحد أعمدتها؟
- ما عُرف بسينما الأندرغراوند، تطور ومدّ السينما غير السردية بشرعية. اليوم، لا يُمكن تجاهل أهمية السينما التي لا تروي حكاية. سابقاً، كانت السينما الروائية هي السائدة، وإذا قرأتَ بازان أو بارت، ستدرك ذلك. السينما بالنسبة لهما كانت السينما السردية. السينما الشعرية وُجدت منذ العشرينات، ولكن إذا قرأتَ بازان لن تعرف بوجودها. هناك حقبة كاملة من السينما تمّ تجاهلها حتى حلول الستينات، حين تمّ تحديث السينما وإرجاعها إلى زمنها. لكن على كتّاب السينما الحاليين تحديث أنفسهم.
* في الماضي، أجريتَ نقداً للنقد. ألا تزال على بعض مواقفك من النقد؟
- لا يزال رأيي هو نفسه. النقد هو كلّ هؤلاء الذين يتوزعون بين مَن أحبّوا فيلماً ومَن لم يحبّوه. عندما كتبتُ النقد، كتبته فقط عن الأفلام التي أحببتها. إذا لم يعجبني فيلم فلِمَ الكتابة عنه؟ على النقد أن يحمّس الناس على مشاهدة الفيلم. إذا لم يعجبك فيلم، فقد يُعجب آخر. وربما لم تفهمه بشكل جيّد. ذوق شخص واحد ليس معياراً لجودة أو لرداءة. عندما أنجزنا أفلامنا - وهي اليوم من الكلاسيكيات - كلّ النقّاد حطّوا من شأنها وقالوا فيها كلاماً في منتهى السلبية. أنا كتبتُ: إنها أفلام جيدة جيدة جيدة. وكنت محقاً (ضحك).
* بما أننا في بلاد غودار، دعني أسألك رأيك بما صرّح به مراراً عن موت السينما...
- السينما ستبقى طالما هناك بشرية. لا يمكن اختزال فنّ الصور التي تتحرك على الشاشة لا بالسيللولويد ولا بأيّ تكنولوجيا حديثة. الأمر أعقد من ذلك بكثير. لا يتوقف وجود السينما على الأداة إنما على المخيّلة.
[[video source=youtube id=cmZTcQj2M0I]]
"هؤلاء الذين لم يكن أحد ينظر في وجوههم"...
يوناس ميكاس هرمٌ سينمائي. لكن الرجل يفضّل كلمة "مؤفلم" لوصفه. ليس هناك أكثر عذوبة من كلماته عندما يحملنا إلى سيرته المعذبة في "لم يكن عندي مكان أذهب إليه". نشر ميكاس أول قصائده وهو في الثانية عشرة من عمره، قصائد تصف الحياة القروية في ليتوانيا العشرينات. مجموعته الشعرية الأولى ألّفها في المعسكر النازي العام 1946، وكانت عن الأجواء السائدة في قريته قبل وصول الدبابات السوفياتية ثم النازية. أشعاره مشبعة بأوجاع تلك المرحلة التي شكّلته إلى الأبد.
خلال الحرب، انضمّ ميكاس إلى المقاومة المسلّحة، نشر مطبوعات ممنوعة، رفع كتابات مناهضة لستالين. اشترى كاميراه الأولى من ماركة "بوليكس" فور وصوله إلى نيويورك العام 1949. اكتشف السينما في مخيّمات اللاجئين. كان الجنود الأميركيون يعرضون أفلاماً مثل "كنز سييرا مادريه" لجون هيوستون. في نيويورك، بات التصوير هاجسه، رغبةً منه في توثيق حياة المنفيين. "هؤلاء الذين كانوا يأتون إلى أميركا بلا أي شيء، ولم يكن أحد ينظر في وجوههم"، يقول المخرج التسعيني. في مقابلة يروي أنه شعر بواجب نقل حياة هؤلاء لأنه كان الوحيد الذي يعرفهم من الداخل ويعرف معاناتهم.
يعتبر ميكاس الكاميرا كالساكسوفون، على مستخدمها التدرب جيداً قبل أستعمالها. الـ"بوليكس" التي تصدر صوتاً مزعجاً عند تشغيلها، صاغت كاراكتيره السينمائي ونحت أسلوبه. لم يكن ينوي يوماً الانخراط في السينما التجريبية، لا بل كان يحلم بهوليوود. إلا ان غوصه في المشهد الفني فتح له آفاقاً جديدة. كانت نيويورك وقتذاك حاضنة تيّارات فنية مختلفة، تتقاطع في بيئة واحدة جماعة جيل الـ"بيت" وآندي وارهول. يقول انه عندما يكتشف فيلماً عظيماً، يشعر بالحاجة إلى التحدّث عنه وتعريفه للآخرين. عندما اطلق مجلة "فيلم كالتشر"، في منتصف الخمسينات، لم يكن هناك في الولايات المتحدة، بحسب قوله، مجلة سينما من نوعية "دفاتر السينما". واجه الرقابة التي استدعته بتهمة الترويج للفحش يوم عرض فيلماً لجان جينيه. وناضل ضد مافيوزية النقابات التي كانت تفرض عليه وعلى جماعته صناعة الأفلام بشروط معينة، ولما رفضوا الرضوخ كانت الصالات التي تعرض أفلامهم تتعرض للتخريب. يقول ميكاس إنه لا يمتلك أي منهجية في العمل. مع انتشار الكاميرات الرقمية الصغيرة، تراه يسحبها من جيبه كلما شعر بالحاجة إلى التقاط شيء ما. لا تخطيط مسبقاً، لا سيناريو... ينجز المونتاج في رأسه، ويفكّر أقل ما يمكن. يجد إلهامه في اللحظة.
[[video source=youtube id=DlC350qW3i0]]
رغبة نشأت من تحت الجزمة
يروي يوناس ميكاس في كتاب مذكراته "لم يكن عندي مكان أذهب اليه"، سنوات التشرد والفقر والشقاء التي عاشها أثناء المراهقة، قبل أن يُعقتل في معسكر ألمشورن الألماني، حيث بقي خمس سنوات، ثم هاجر إلى أميركا. أول كاميرا تصوير فوتوغرافية حصل عليها في سن السابعة عشرة عندما كان لا يزال في ليتوانيا. أول كليشيه أراد التقاطها كانت لعبور الجيش الروسي من بلدته "لتحريرنا من أنفسنا"، كما يقول. يصف المشهد بدقة، حيث الغبار يتصاعد من الآليات العسكرية، الفقر، الملابس الممزقة، الجوع، الخراب. وقف المراهق يراقب اللحظة، أراد تخليدها. ولكن حتى قبل أن يرن في أذنه صوت الكليك، هجم عليه ضابط، التقط الكاميرا من يده، أخرج منها الفيلم وأتلفه بعدما وضعه تحت جزمته. هذه اللحظة، يقول ميكاس، هي التي جعلته يرغب في حمل الكاميرا إلى الأبد. هنا ولدت رغبته، من قلب اليأس والقسوة.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية